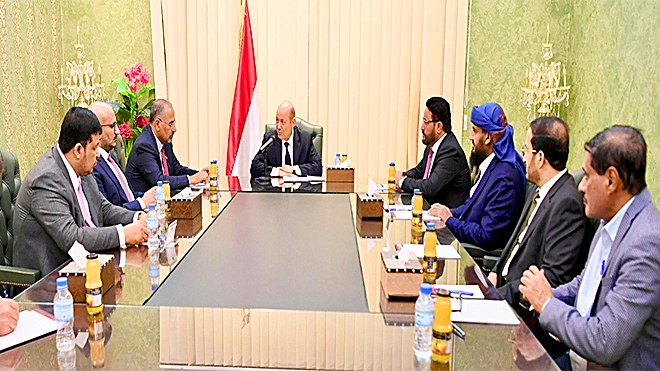> د.هشام محسن السقاف:
لاشك أن تجربة الصحافة في بلادنا تجربة مثمرة، والسير على بلاط صاحبة الجلالة قد لايكون سيراً في بعض الحالات، وقد يكون ركضاً إلى الوراء في حالات أخرى، وقد يتسع الهامش على غير هدى من الضوابط المهنية وأخلاقيات الصحافة بفعل دافعين وواقفين من وراء سطور الكلمات ومن بين خفايا المعاني حتى ليحل لهذه الصحيفة أو المنشور على تعبير أخينا العزيز هشام باشراحيل أو بالأصح للكتبة القائمين عليها أكل لحم (أخيهم) المسلم الحي والميت على السواء، والقدح في المحصنات، وما ذلك على المتجردين من القيم والأخلاق والتربية الحسنة بعزيز.
ولكن أردت من القول أو الخوض في شأن التجربة أنها شكلت في جانبها المهني والأخلاقي نقلة نوعية بعد جفاف سني الثورة والجمهورية والاستقلال، مستفيدة من نسائم الإفساح الديمقراطي الذي رافق الجمهورية الثالثة (الجمهورية اليمنية) التي تمخضتها الوحدة اليمنية فجادت بحجم طموحات المواطن اليمني، لولا أن شابها التقاسم في بدايته بين شريكي الوحدة ثم أزمة الحرب المؤسفة.
في جنوب الوطن كانت تجربة الصحافة العدنية قبل الاستقلال رائدة، ليس على مستوى الوطن المشطر وإنما على مستوى الجزيرة العربية، والريادة لم تأت هبة من الإدارة البريطانية، ولكن انتزعت بفضل نضالات وتصميم جيل من الرواد الذين استفادوا من القوانين البريطانية لصالح اتجاهاتهم الوطنية والقومية، لذلك لم نر أن الأمر برمته كان عسلاً مصفى وإنما انتزاع حقوق والتشبث بها على زخم الجماهير ودعمها في ظل تطورات متسارعة تشهدها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية وإفرازاتها على المستوى العالمي ككل.
بينما تجربة شمال الوطن (المتوكلي) في هذا الجانب تتسم بقدر كبير من الصعوبة والتعقيد بالاتساق مع تعقيدات النهج السياسي الحاكم الغريب والعجيب والقادم من عصور غابرة، وفيما عدا (حكمة) الوريث في 1938 التي غايرت في المتن والشكل كل ما هو قائم، بل وتحدته بصلابة المواقف المعلنة فيها، فإن نجمها الذي بزغ في غير موسمه على ما يبدو سرعان ما أفل ووجدت آراء الأحرار اليمنيين الناقمين على حكم الإمامة في عدن وأهل عدن وصحافة عدن ملجأ وكهفاً منيعاً يقيهم سيف الإمام ولو إلى حين، ولو أن عدن التي استقلت استقلالا ناجزاً في العام 1967 كانت قد أبقت (قياداتها) على تلك الحياة الليبرالية بنكهة صحافتها المتعددة الاتجاهات والأهواء لكان أمر عظيماً، ولكن هيهات هيهات، فالقراءة الواعية لظروف تلك الفترة وملابسات الثورة والاستقلال والتداخلات الدولية والإقليمية وتجربة وثقافة الثوريين الحكام وحتى أعمارهم وآفاقهم الفكرية لم تكن لتؤهلهم للعب دور أكبر ولا أكثر من ذاك الذي لعبوه بإرادتهم أو بدونها بخيره وشره، بحيث لم تكن التجربة الصحفية الليبرالية في عدن هي وحدها الضحية، بل كان الضحايا الكثر يمتدون في أفق التخريب الثوري والشرعية الثورية إلى الجلادين أنفسهم الذين غدوا ضحايا في دورات تالية.
في الشمال لم تكن الأمور بأفضل حال مع تعقيدات المجتمع القبلي المغلق الذي فتحت أبوابه الثورة، ولكن الذين دخلوا على خط الارتزاق من الثورة أكثر من الذين حملوا مشروعاً وطنياً لبناء دولة حديثة، ومع الغوص في عمق التباين السياسي والاجتماعي داخل الصف الثوري - الجمهوري ومعوقات الحرب الأهلية ودخول القبيلة والجيش معادلا مؤثرا لاستلام الحكم وتبادل الأدوار فيه فإن نصيب الحداثة والديمقراطية وحرية الكلمة سيبقى مؤجلاً في الشمال، كما في الجنوب، لذلك قد يصدق على أولئك الرجال هنا وهناك ما قاله (بوسويه) في رثاء (كونديه): «ألا بعداً لأولئك الأبطال الذين لا إنسانية فيهم!. إنهم قد يستحقون احترامنا وإعجابنا ككل ما هو خارق للطبيعة، لكن قلوبنا ليست معهم».
لقد كان بالإمكان أن تنهض العنقاء من بين الرماد، أو هكذا بدا الأمر في الثاني والعشرين من مايو 1990، إلا أن العنقاء شكل من اللاوعي أو قل الخرف الأسطوري لم تكن لتستفيق هكذا وتلقي التحية على الحالمين قراءة حروف النصاعة والألق المكتمل مع فنجان الصباح دون أن يكون لمعوقات الإنس وقوى الإعاقة التاريخية هنا وهناك دور في تعطيل لحظة نهوض العنقاء ولو إلى حين، ونكون بذلك مثل الذين لم يصدقوا زرقاء اليمامة تلك المرة فعمدوا إلى سمل عينيها، ولكني أجزم رغم ذلك كله أن جزءا غير يسير قد نهض أو تحرك من الجسد الخرافي لعنقاء الرماد، وكدت في يوم من أيام العام 1992 أبدد الوقت بعزمي كتابة رسالة الماجستير عن صحافة الوحدة، وقد استسهلت- في البدء - بحر العامين، فكدت أغرق في موج متلاطم من الأوراق المليئة بالحبر الأسود، وهي تطالع القراء في شكل صحيفة جديدة وأخرى جديدة ثم واحدة وواحدة، وكأنني أمام صحيفة تبزغ مع شمس كل صباح، فما وجدت بيدي من حيلة إلا أن أغوص في مجلة «العربي» بموادها الدسمة وأعوامها الثلاثين (حتى العام 1992).
ولوشئنا الصدق فإن حالة المجتمع اليمني المتعدد الثقافات والرؤى والتباينات في ذات الأفق الوطني الكبير بحاجة ملحة للديمقراطية والليبرالية والتعددية في السياسة والكلمة للوصول إلى جوهر الحقيقة، إن كان المقصود فعلاً خطب ود (الحقيقة)، ولا أعني بالحقيقة هنا (الحقيقة المطلقة)، كما في الفلسفة، بقدر ما أعني بناء الدولة اليمنية الحديثة والعصرية القائمة على الحريات الديمقراطية، وفي الصميم منها حرية الكلمة، وسوف أتمثل هنا تعقيدات المجتمع الهندي في الملل والنحل والمذاهب والأديان والأعراف والديانات واللغات، لكنه يستقيم في منظومة حكم ليبرالية فدرالية، كأكبر مكون ديمقراطي في الكون، ونكون نحن كمجتمع مقارنة به (أنموذجيين تماماً) بعيداً عن كل تلك الفسيفساء المعقدة، ينقصنا فقط الأخذ بالديمقراطية مسلكاً لبناء الدولة اليمنية التي طال انتظارها، لا أن نقدم خطوة ونؤخر أخرى في ذات المربع، مكتفين بالرؤيا التي لم تصدق إلا في أجزاء منها (أننا دولة ديمقراطية).
ولكن أردت من القول أو الخوض في شأن التجربة أنها شكلت في جانبها المهني والأخلاقي نقلة نوعية بعد جفاف سني الثورة والجمهورية والاستقلال، مستفيدة من نسائم الإفساح الديمقراطي الذي رافق الجمهورية الثالثة (الجمهورية اليمنية) التي تمخضتها الوحدة اليمنية فجادت بحجم طموحات المواطن اليمني، لولا أن شابها التقاسم في بدايته بين شريكي الوحدة ثم أزمة الحرب المؤسفة.
في جنوب الوطن كانت تجربة الصحافة العدنية قبل الاستقلال رائدة، ليس على مستوى الوطن المشطر وإنما على مستوى الجزيرة العربية، والريادة لم تأت هبة من الإدارة البريطانية، ولكن انتزعت بفضل نضالات وتصميم جيل من الرواد الذين استفادوا من القوانين البريطانية لصالح اتجاهاتهم الوطنية والقومية، لذلك لم نر أن الأمر برمته كان عسلاً مصفى وإنما انتزاع حقوق والتشبث بها على زخم الجماهير ودعمها في ظل تطورات متسارعة تشهدها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية وإفرازاتها على المستوى العالمي ككل.
بينما تجربة شمال الوطن (المتوكلي) في هذا الجانب تتسم بقدر كبير من الصعوبة والتعقيد بالاتساق مع تعقيدات النهج السياسي الحاكم الغريب والعجيب والقادم من عصور غابرة، وفيما عدا (حكمة) الوريث في 1938 التي غايرت في المتن والشكل كل ما هو قائم، بل وتحدته بصلابة المواقف المعلنة فيها، فإن نجمها الذي بزغ في غير موسمه على ما يبدو سرعان ما أفل ووجدت آراء الأحرار اليمنيين الناقمين على حكم الإمامة في عدن وأهل عدن وصحافة عدن ملجأ وكهفاً منيعاً يقيهم سيف الإمام ولو إلى حين، ولو أن عدن التي استقلت استقلالا ناجزاً في العام 1967 كانت قد أبقت (قياداتها) على تلك الحياة الليبرالية بنكهة صحافتها المتعددة الاتجاهات والأهواء لكان أمر عظيماً، ولكن هيهات هيهات، فالقراءة الواعية لظروف تلك الفترة وملابسات الثورة والاستقلال والتداخلات الدولية والإقليمية وتجربة وثقافة الثوريين الحكام وحتى أعمارهم وآفاقهم الفكرية لم تكن لتؤهلهم للعب دور أكبر ولا أكثر من ذاك الذي لعبوه بإرادتهم أو بدونها بخيره وشره، بحيث لم تكن التجربة الصحفية الليبرالية في عدن هي وحدها الضحية، بل كان الضحايا الكثر يمتدون في أفق التخريب الثوري والشرعية الثورية إلى الجلادين أنفسهم الذين غدوا ضحايا في دورات تالية.
في الشمال لم تكن الأمور بأفضل حال مع تعقيدات المجتمع القبلي المغلق الذي فتحت أبوابه الثورة، ولكن الذين دخلوا على خط الارتزاق من الثورة أكثر من الذين حملوا مشروعاً وطنياً لبناء دولة حديثة، ومع الغوص في عمق التباين السياسي والاجتماعي داخل الصف الثوري - الجمهوري ومعوقات الحرب الأهلية ودخول القبيلة والجيش معادلا مؤثرا لاستلام الحكم وتبادل الأدوار فيه فإن نصيب الحداثة والديمقراطية وحرية الكلمة سيبقى مؤجلاً في الشمال، كما في الجنوب، لذلك قد يصدق على أولئك الرجال هنا وهناك ما قاله (بوسويه) في رثاء (كونديه): «ألا بعداً لأولئك الأبطال الذين لا إنسانية فيهم!. إنهم قد يستحقون احترامنا وإعجابنا ككل ما هو خارق للطبيعة، لكن قلوبنا ليست معهم».
لقد كان بالإمكان أن تنهض العنقاء من بين الرماد، أو هكذا بدا الأمر في الثاني والعشرين من مايو 1990، إلا أن العنقاء شكل من اللاوعي أو قل الخرف الأسطوري لم تكن لتستفيق هكذا وتلقي التحية على الحالمين قراءة حروف النصاعة والألق المكتمل مع فنجان الصباح دون أن يكون لمعوقات الإنس وقوى الإعاقة التاريخية هنا وهناك دور في تعطيل لحظة نهوض العنقاء ولو إلى حين، ونكون بذلك مثل الذين لم يصدقوا زرقاء اليمامة تلك المرة فعمدوا إلى سمل عينيها، ولكني أجزم رغم ذلك كله أن جزءا غير يسير قد نهض أو تحرك من الجسد الخرافي لعنقاء الرماد، وكدت في يوم من أيام العام 1992 أبدد الوقت بعزمي كتابة رسالة الماجستير عن صحافة الوحدة، وقد استسهلت- في البدء - بحر العامين، فكدت أغرق في موج متلاطم من الأوراق المليئة بالحبر الأسود، وهي تطالع القراء في شكل صحيفة جديدة وأخرى جديدة ثم واحدة وواحدة، وكأنني أمام صحيفة تبزغ مع شمس كل صباح، فما وجدت بيدي من حيلة إلا أن أغوص في مجلة «العربي» بموادها الدسمة وأعوامها الثلاثين (حتى العام 1992).
ولوشئنا الصدق فإن حالة المجتمع اليمني المتعدد الثقافات والرؤى والتباينات في ذات الأفق الوطني الكبير بحاجة ملحة للديمقراطية والليبرالية والتعددية في السياسة والكلمة للوصول إلى جوهر الحقيقة، إن كان المقصود فعلاً خطب ود (الحقيقة)، ولا أعني بالحقيقة هنا (الحقيقة المطلقة)، كما في الفلسفة، بقدر ما أعني بناء الدولة اليمنية الحديثة والعصرية القائمة على الحريات الديمقراطية، وفي الصميم منها حرية الكلمة، وسوف أتمثل هنا تعقيدات المجتمع الهندي في الملل والنحل والمذاهب والأديان والأعراف والديانات واللغات، لكنه يستقيم في منظومة حكم ليبرالية فدرالية، كأكبر مكون ديمقراطي في الكون، ونكون نحن كمجتمع مقارنة به (أنموذجيين تماماً) بعيداً عن كل تلك الفسيفساء المعقدة، ينقصنا فقط الأخذ بالديمقراطية مسلكاً لبناء الدولة اليمنية التي طال انتظارها، لا أن نقدم خطوة ونؤخر أخرى في ذات المربع، مكتفين بالرؤيا التي لم تصدق إلا في أجزاء منها (أننا دولة ديمقراطية).