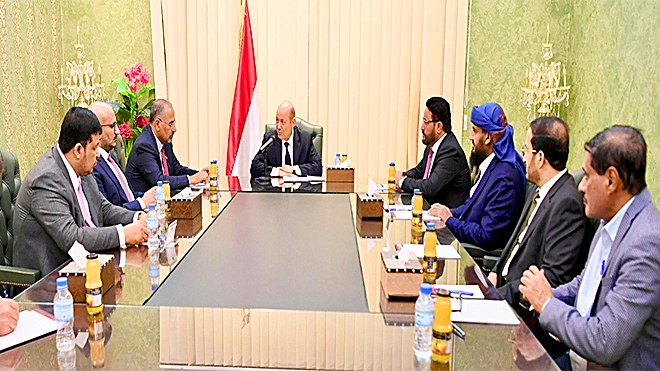> قادري أحمد حيدر:
وفي هكذا وضع لا يعني بأية فائدة من المحاكم التجارية، أو السجل التجاري، أو السجل العقاري، أو السجل المدني، جميعها أشكال وأدوات تخدم مصالح القوى الاجتماعية والسياسية التقليدية.
وتكرس في واقع الممارسة البيئية التقليدية القائمة. يذهب المستثمرون بوثائق ملكياتهم الموثقة في السجل العقاري إلى أقسام الشرطة والمحاكم والقضاء، ويرد عليهم بأن ذلك ليس حجة قاطعة، حيث يتم التلاعب بكل شيء في واقع غياب الدولة المؤسسية وسلطة القانون، لأن الدولة ليست لكل مواطنيها، بل لفئة معينة دون أطياف وشرائح المجتمع كافة، ومن هنا يبرز تشجيع مراكز القوى في الحكم لظاهرة حمل السلاح، والثأر والعنف، إن رموز وجماعات اقتصاد الوجاهة أو رموز رأس المال المعنوي، رأس المال السياسي، الذين دفعت بهم الصدفة التأريخية البحتة إلى قمة الحكم، هم من يقفون اليوم ضد قانون تنظيم حمل السلاح وليس منعه بالمطلق، وهم من يخرقون القوانين ويتحايلون عليها في واقع الممارسة، ويستخدمون نفوذهم في السلطة لإفساد القضاء وإبعاد الشرفاء عن مواقع القضاء أو نفيهم إلى أقاصي الريف البعيدة في أحسن الأحوال، وهم من يدخلون شركاء مع رموز الإستثمار من الرأسمالية المحلية والأجنبية، وهم من يتلاعبون ويسمسرون في قضية الأرض كيفما يشاؤون، وينهبون ويعتدون على أرض وحقوق وملكيات الأفراد، والدولة، كما في المحافظات الجنوبية والشرقية، ما يجعل آفاق التنمية والاستثمار والتحديث غير ممكن إن لم يكن مستحيلاً.. فقد تحول الفساد معهم إلى أيديولوجية ونظام استشرى في جميع مفاصل حياة المجتمع ومصالح الناس الصغيرة والكبيرة (الفساد الصغير والكبير )، وهو ما يحيلنا أبداً إلى الضرورة الوطنية والتاريخية لدولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة لكل مواطنيها.. السؤال الغائب الكبير، وهو ما دفع الرئيس في برنامجه الانتخابي الأخير إلى الإشارة إليه أكثر من مرة، ما يستوجب تحوله إلى فعل وتطبيق يمارس على صعيد الواقع ويطال حياة الناس ومصالحهم وليس في بقائه شعارا أيديولوجيا يعبر عن لحظة انتخابية عابرة، لكسب أصوات الناخبين والتلاعب بمشاعرهم، بملامسة وتر الحاجة السياسية والوطنية والتاريخية للدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، والعبرة هنا في تحول الخطاب الرئاسي الانتخابي إلى واقع وممارسة، فقد شبعنا خطابات ووعوداً ، وأكثر ما يخيفنا هو وعود الحكومات العربية ورؤسائها في فترات الأزمات، والانتخابات، التي لا يتحقق منها في الغالب شيء بعد أن ينفض السامر، فالخطاب العربي الرسمي عودنا أن طعم وعوده أمرُّ من علقم الواقع وأسوأ من فساده الذي كان، لأن ما يأتي بعد الوعود هو حالة من الانتقام من حلم الناس ومعاقبتهم على التجرؤ على الحلم، خاصة بعد أن تحولت وعود الثورة العربية الاستقلالية إلى ضدها ونقيضها في واقع الممارسة.. بل أن بعضها انتهى إلى حالة من العداء لكل شعارات ومضامين الوعود بالإصلاح والتغيير والثورة .. فهل سيتحول برنامج الرئيس الانتخابي إلى وعود محققة في الواقع وتنتقل إلى حدود الإنجاز، هذا ما يجب أن نراهن عليه على كل إحباطاتنا وأوهامنا الأيديولوجية المستعدة لاستدعاء ما يناقض الوعود، تماشياً مع ما هو جار، حتى لو قادتنا نياتنا الطيبة إلى جهنم، مع تقديري أن المثل القائل «من مشنقة إلى مشنقة فرج» غير صحيح، ويعكس عقلاً تواكلياً، وهو ما يفسر حالة الأغلبية الصامتة في معظم الأقطار العربية.
إن تعايش وتضايف أنماط إنتاجية مختلفة قديمة وحديثة، وعلى الغلبة النسبية لسيادة أو حضور أسلوب الإنتاج الرأسمالي التابع، في صورة اقتصاد الصناعة الخفيفة المحدودة ، وتجارة الاستيراد والتصدير، إلى جانب الاقتصاد الموازي من مصادر التهريب وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، وتجارة العملة ، وتوظيف القوة في اللعب في قضية الأرض والعقارات، والاستئثار بالمناقصات الرسمية للدولة، وغنيمة القطاع العام باسم الخصخصة، وإعادة التكيف الهيكلي بالتوازي مع إزاحة قوى الرأسمال المحلي التقليدي، في قطاع الصناعة، والتجارة والأعمال، والمقاولات والعقارات، كل ذلك عاق إمكانية التطور الطبيعي والتدريجي للرأسمالية المحلية، وجعلها بين فكي كماشة اقتصاد العولمة وشروط البنك والصندوق، ومنظمة التجارة العالمية، مما يحوله من اقتصاد تابع إلى اقتصاد أكثر هامشية، وبين حصار رأس المال المعنوي أو اقتصاد المكانة والوجاهة، الذي يحاصره ويحد من حركته الاقتصادية الطبيعية ونموه الدستوري والقانوني، حتى إن وجدت التشريعات المنظمة للاستثمار فهي غير قابلة لأن معظم ما يجري ويتم خارج الدستور والقانون، خاصة بعد تحول الفساد إلى سلطة وقوة تملك من الأدوات والآليات ما يعوق قدرة الأجهزة التشريعية والقضائية والقانونية والدستورية على تنفيذه أو تحقيقه، ومن هنا تمت الخصخصة خارج القانون بل وفي بعضها قبل إصدار القانون، وهو ما يفسر ظاهرة هجرة الرأسمال الوطني إلى الأسواق العالمية، بعد هجرة العقول وخوف المستثمرين من المغامرة غير محسوبة العواقب على مصائر رساميلهم .. إذا كانت الأرض لا تمتلك أية حرمة أو قدسية حتى وهي في ملكية أسرتك لقرون وبحوزتك من البصائر والوثائق ما يكفي، إلى جانب تأكيدات القضاء، وأوامر رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، حيث لا حرمة ولا اعتبار سوى لقانون القوة وليس لقوة القانون والحق، وفي ظل واقع كهذا وعلاقات وممارسات لا تحتكم للدستور ولا القوانين النافذة، ويتقدم عليها قانون القوة، وحكم الأعراف والقيم القبلية العصبية من الصعب الحديث عن تنمية اقتصادية وطنية مستقلة، أو فتح منافذ حقيقية لتحديث ثقافة المجتمع وتنميته.
والنتيجة أن نمط الإنتاج الرأسمالي المشوه والتابع يدخل مع هيمنة القوى الاجتماعية السياسية التقليدية في مجال ودائرة اقتصاد الغنيمة ومزاجية الإدارة الفردية والشخصانية، ولا صلة حقيقية لها بمفهوم وقانون اقتصاد السوق، الذي تحكمه عملية موضوعية اقتصادية تنموية مستقلة عن رغبات الحاكمين أو المتنفذين، ومن هنا نلحظ ضغوط الجهات الأوروبية الاقتصادية والمالية المانحة، وشروطها لضبط إيقاع المسألة الاقتصادية في إطار أنظمة وقوانين عمل وإدارة مؤسسية وقانونية، وهو ما بدأت بعض أقطاب السلطة تتنبه له وتحاول تدارك مخاطره وتبعاته على مستقبل البلاد، واقتصادها وتنميته الإنتاجية المستقلة، ولا أقرأ في خطاب الرئيس الانتخابي الأخير 2006 - 2013 سوى بداية استشعار لخطوة المنحى والتوجه الذي تسير فيه البلاد، المهم أن يتحول الخطاب من القول إلى الفعل والتطبيق، ويدخل دائرة الإنجاز في صورة عمل مؤسسي، وخطوة على طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ولتجاوز واقع الثنائيات القاتلة التي أصبحت تشكل معوقاً جدياً أمام أي تحول مؤسسي سياسي ديمقراطي، وأمام أي تنمية أو تحديث.
وعلى ذلك فلا غرابة أن تهيمن على حياتنا الفكرية والسياسية، والثقافية والاجتماعية سلطة الثنائيات المدمرة، حيث الخطاب يتأرجح بين خطاب ما قبل الحداثة - الخطاب البطرياركي - وخطاب الحداثة والتحديث وإن على استحياء، خطاب حداثي محاصر ومقهور والقسم الأعظم من هذا الخطاب يتم مصادرته أو احتوائه في جبة الخطاب الإعلامي الرسمي، وفي الأيديولوجية السائدة، القادم من التعليم التقليدي المتخلف، ومن مناهج المدارس والجامعات، وبرامج التلفزيون الثقافية الهابطة، والثقافة الأصولية، وثقافة العنف التي يفرزها المجتمع، إن هذا الخطاب الثقافي الحداثي يجري استغراقه من خلال عنف البنية الاجتماعية والثقافة التقليدية، بعد أن توظف قسماً هاماً منه لخدمة مصالحها المباشرة، ولتكريس البنية التقليدية المهيمنة. وكأن البنية الاجتماعية في اليمن تجمع في داخلها اليوم « المجتمع الأبوي المعاصر (… ) الذي لم يتوصل إلى تحقيق الحداثة بمعناها الأصيل، (وهو كذلك) ليس تقليدياً بكل معنى الكلمة، أي أنه يعيش في ظل خطابين: في ظل خطاب الحقيقة الشاملة الكلية، وفي ظل خطاب الحقيقة الحديثة المحدودة (… ) أنه عاجز عن التعامل مع أي منهما بشكل عقلاني منتظم يمكنه من إرساء علاقته بالماضي (بالتاريخ) أو بالواقع (بالحاضر) أو بالمستقبل، من خلال وعي ذاتي مستقل»(6)، ولا يمكننا ونحن في سياق هذه القراءة لهذه الفقرة المحورية في الورقة إنكار أن الثورتين على الإمامة وعلى الاستعمار - بدرجات متفاوتة - قد أحدثتا أو مارستا خلخلة حقيقية في بنية النظام الاجتماعي التقليدي البطرياركي خاصة في الشطر الشمالي الذي كان يقبع في كهف ناء خارج العصر .. وإن لم تستطع الثورة إحداث زحزحة حقيقية للبنية الاجتماعية التقليدية التي ظلت فاعلة ومؤثرة على مسار التطور السياسي والاجتماعي، والثقافي للبلاد، وتحديداً من بعد الخامس من نوفمبر 1967م الذي أعاد بقوة تجديد إنتاج البنية المشيخية التقليدية في أجلى صور تغييرها عن دور ووظيفة جديدين، وعلى حساب القوى الاجتماعية الجديدة، بدأ معها يتشكل مضمون صراع جديد بين قوى التحديث، ورموز المشيخة القبلية التي دفعت إلى قمة السلطة، بعد أن ظلت خارجها طيلة عهود الإمامة، وهي مرحلة جديدة بكل المقاييس من تطور الدولة، والسلطة، والمجتمع في اليمن الشمالي.. وبعد الوحدة والحرب جرى تعميم ونمذجة الحالة على كل مجتمع ما بعد الوحدة، وحين أشرت في سياق الفقرة الأولى من الورقة - المقدمة - إلى أن الإشكالية كامنة في المفهوم والرؤية وفي الواقع، ومن أن الواقع معقد وشديد التداخل والتشابك يختلط فيه العلمي بالغيبي، والإيماني بالعقلاني، والخرافي بالواقعي، والتاريخي بالأسطوري، لم أكن أقصد خطاباً إنشائياً وبلاغياً وخطاباً مجازياً، بقدر ماهو تحليل لمضمون علاقات الواقع ومعطياته وحقائقه التي تتضايف في داخله كل هذه التشابكات وأنماط التفاعلات الثقافية والاجتماعية والقيمية التي من الصعب في العديد من الحالات تحديد الفواصل والحدود فيما بينها، حيث نشهد تموضعات فكرية وثقافية متناقضة داخل الفئة الاجتماعية والشريحة الطبقية الواحدة، التي تجمعهم مصلحة مادية اقتصادية مشتركة، وسبب ذلك في تقديري يتمثل في عدم الفصل بين المجال السياسي، وبين المجال الاجتماعي، ومن جانب آخر يعود إلى حالة التناقض بين المعرفة والمصلحة التي تقود حتماً إلى الخرافة، ووقوف الناس ضد مصالحهم الطبقية والاقتصادية، وأكبر دليل على ذلك حين نجد قطاعاً واسعاً من القبائل والفلاحين يعطون أصواتهم الانتخابية لمن يمثلون نقيض مصالحهم الواقعية والتاريخية، ولمن يسومونهم العذاب، ومن المهم هنا التأكيد على أن «أول شروط النظر العلمي هو الاعتراف باستقلال الواقع وتميزه عن العقل، وهذا الاستقلال يعني أنه لا ينبغي الخلط بين المفهوم الذي نصوغه، وبين الواقع موضوع الفهم القائم خارج العقل، فليس تعيين حقيقية هذا الواقع من الأمور البسيطة، ولا استجلاء مفهومه من المعطيات العفوية، بل ربما كان مفهوم الواقع هو المفهوم الأكثر صعوبة وقدرة على التملص من الوعي والهرب إلى أمام الإدراك، لأنه لا يمثل شيئاً آخر سوى هذا التحول الدائم والمتناقض والمتشعث الذي لا يمكن الإمساك به وتنظيمه إلا بفرض وعي خارجي عليه، والاختيار فيه بين إمكانات ووجوه لا توجد إلا بالعمل معاً»(7).. ومن هنا تبرز أهمية امتلاك الأدوات المعرفية في إعادة قراءة الواقع، وفهم تموضعاته المادية والسياسية الفكرية عبر تشخيص موضوعي لحقائق الواقع كما هي، بعد رفعها إلى مستوى القراءة التحليلية السوسيولوجية وتقليص التدخل الأيديولوجي إلى أقصى حد، حتى لا نجد أنفسنا أمام قراءة لا صلة لها بالواقع، ولن يتحقق ذلك دون الاعتراف بحقائق المجتمع المتعددة والمتنوعة وفتح قنوات حوار فيما بينها، حوار موضوعي عقلاني نقدي، فالديمقراطية أولاً وقبل كل شيء ثقافة وعمل مؤسسي، وهي ثانياً تعتمد الحوار والقبول بالآخر كما هو، والديمقراطية تعني المساواة، والعدالة، والحوار هو الأساس الذي تتقاطع على قاعدته جميع هذه المفردات..
«فالحوار ليس كلاماً فارغاً ولكن استراتيجية وطنية هدفها إعادة بناء التفاهم الوطني كشرط لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وهو الطريق الوحيد لخلق مناخ جديد ينزع فتيل الحرب ويضع حداً لحالة القطيعة والغربة وضعف الاتصال والتواصل العقلاني، بين مختلف القوى، والذين يقفون ضد الحوار اليوم هم الذين اختاروا طريق استخدام العنف والقوة»(8).
وغالباً ما يكون سبب اللجوء لاستخدام القوة والعنف، غياب الدولة الحديثة المؤسسية، دولة لكل مواطنيها، وحين تغيب الدولة وفي مجتمع مدجج بالسلاح الخفيف والثقيل كحالنا في اليمن يغدو العنف والقتل ملمحاً بارزاً من ملامح وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية، ويتحول الثأر إلى ظاهرة، فما بالكم حين تكون جهات متنفذة تغذي عملية الثارات(9) وتشجع على حمل السلاح، وما يجعل الفلاح والقبيلي، والمواطن عامة يعطي ولاءه للانتماءات ما قبل الوطنية أو الانتماءات التحتية - القبيلة، العشيرة، الطائفة، المنطقة، والجهة، إنما هو غياب دولة المواطنة، دولة الحق والمؤسسات، ففي هذه الانتماءات الصغيرة يجدون ملاذهم الأخير وشكلاً من أشكال رعايتهم وحماية حياتهم ومصالحهم، والدفاع عن حقوقهم المهدورة، في واقع غياب القضاء المستقل والتحاقه بالسلطة، ومن هنا يأتي تفسير عودة العديد من الناس، بل ومجاميع من المثقفين والسياسيين نساءً ورجالاً للاحتماء بقبائلهم أو البحث عن أصول قبيلة تسندهم، وعودة العديد منهم للسؤال عن أنسابه ومشجر أسرته وعائلته ، المذهبي والديني، والقبلي، والعرقي إذ أصبحت الهويات الصغيرة التحتية الرمز البديل لغياب الهوية الوطنية الجامعة في صورة الدولة المؤسسية الحديثة -وهو ما سنأتي إلى بحثه لاحقاً- وقد ارتفع صخب البحث عن الهويات الصغيرة - تحت الوطنية - بعد حرب 1994م حين شهدنا العديد من أبناء المدن، وتحديداً مدينتي عدن، وتعز، وغيرهما من المدن الرئيسة يبحثون عن أصولهم القبلية والعرقية والمذهبية، ومشجر أنسابهم وعشائرهم والمصادر الأولى لأجدادهم الأوائل، وبالصدفة التاريخية البحتة يكتشف العديد منهم أن أصولهم تعود إلى حاشد وبكيل، وإلى كهلان، وهمدان الكبرى، وإلى ما قبل ذلك، إذاً نحن أمام ردة ثقافية، ونكسة اجتماعية وطنية طالت أعماق الروح والثقافة والوجدان، ناهيك عن عودة الأصولية الدينية التكفيرية الباحثة عن عقود زواج الآباء لتحديد شرعية نسب الأبناء والأحفاد بعد عقود من تاريخ الزواج، لم نعد اليوم بحاجة إلى سلطة إكراهية استغرقت الدولة في داخلها وأوصلتنا إلى ما نحن عليه من تمزق وتفكك وخراب في كل أقطار المنطقة العربية، إننا بحاجة إلى دولة مؤسسات مدنية حقوقية، دولة لكل مواطنيها، دولة مؤسسية ترسخ منظومتها القيمية والدستورية، كل الانتماء لها، وليكون توزع الولاء السياسي اختيارياً وفقاً للمشارب الفكرية والسياسية والثقافية، وبحسب التوزع الطبقي والمصالح الاقتصادية والمادية للأفراد، أو وفقاً لخياراتهم الأيديولوجية والسياسية، لأن الانتماء يكون لقضية كلية كبرى الوطن والشعب، بمفهومه المجرد والعام، والولاء بحسب التوزعات الطبقية والفكرية والسياسية، والحزبية، ونتيجة تداخل المجال السياسي بالاجتماعي في بلداننا ضعيفة التطور الاقتصادي الرأسمالي، غالباً ما تكون إحداثيات الفرز السياسي اعتباطية وعبثية وعدمية ولا تجسد روح المصالح الاقتصادية للناس، وهو ما سبق التلميح إليه تاماً.
إن تأكيد برنامج الرئيس الانتخابي على فكرة تداول السلطة سلمياً، يعني بدء الإقرار بأن موقع الرئاسة الأولى حق لكل يمني من أية قبيلة أو عشيرة أو منطقة كانت، ولأي مذهب انتمى إليه ، ومن أي طبقة أو فئة اجتماعية، وعند هذه اللحظة يتحول مبدأ تداول السلطة السلمي إلى حقيقة ممارسة، بعيداً عن احتكار الرئاسة الأولى في طبقة أو فئة أو قبيلة، أو مذهب، وبذلك يكسر برنامج الرئيس الانتخابي قضية حدية وعلى درجة عالية من الحساسية تتعلق بالرئاسة الأولى، وسلطة الدولة. وبذلك يمكن القول إننا نفتتح أولى آليات مداخل تحديث ثقافة المجتمع وتنميته ديمقراطياً. فإذا كانت ثورة 26 سبتمبر 1962م كسرت حدة احتكار الإمامة السلالية للحكم الذي بقي محصوراً في «البطنين»، فإننا اليوم ومن خلال مبدأ التداول السلمي للسلطة نفتتح باب الرئاسة الأولى لكل البطون ولجميع اليمانين من كافة مناطق وجهات اليمن، وهنا يصبح اليمن وطناً لكل أبنائه.
وعندئذ نكون قد بدأنا الدخول إلى فضاءات دولة المؤسسات الحديثة، دولة يتحدد فيها اسم الحامل السياسي لرأس الدولة بشكل دوري ولكل المواطنين دون أي اعتبار للقبيلة والطائفة والمذهب والجهة، ودون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة، دون أن نجيب عن سؤال المواطنة، وسؤال دولة المؤسسات.. وفي الدولة المؤسسية الجمهورية المدنية الحديثة لا مجال لتوريث الحكم تحت أي مسمى كان. ومن المهم هنا التأكيد على تأكيد البرنامج الانتخابي للرئيس الفائز علي عبد الله صالح حين حدد فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين كما ينص عليها الدستور، ما يعني ألا رجعة عن النص الدستوري، وأن من حق المواطن الآخر أن تؤول إليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة، وحين يتحقق ذلك نستطيع القول إننا بدأنا ندخل فضاءات الحداثة والمدنية، ودولة المؤسسات.
وتكرس في واقع الممارسة البيئية التقليدية القائمة. يذهب المستثمرون بوثائق ملكياتهم الموثقة في السجل العقاري إلى أقسام الشرطة والمحاكم والقضاء، ويرد عليهم بأن ذلك ليس حجة قاطعة، حيث يتم التلاعب بكل شيء في واقع غياب الدولة المؤسسية وسلطة القانون، لأن الدولة ليست لكل مواطنيها، بل لفئة معينة دون أطياف وشرائح المجتمع كافة، ومن هنا يبرز تشجيع مراكز القوى في الحكم لظاهرة حمل السلاح، والثأر والعنف، إن رموز وجماعات اقتصاد الوجاهة أو رموز رأس المال المعنوي، رأس المال السياسي، الذين دفعت بهم الصدفة التأريخية البحتة إلى قمة الحكم، هم من يقفون اليوم ضد قانون تنظيم حمل السلاح وليس منعه بالمطلق، وهم من يخرقون القوانين ويتحايلون عليها في واقع الممارسة، ويستخدمون نفوذهم في السلطة لإفساد القضاء وإبعاد الشرفاء عن مواقع القضاء أو نفيهم إلى أقاصي الريف البعيدة في أحسن الأحوال، وهم من يدخلون شركاء مع رموز الإستثمار من الرأسمالية المحلية والأجنبية، وهم من يتلاعبون ويسمسرون في قضية الأرض كيفما يشاؤون، وينهبون ويعتدون على أرض وحقوق وملكيات الأفراد، والدولة، كما في المحافظات الجنوبية والشرقية، ما يجعل آفاق التنمية والاستثمار والتحديث غير ممكن إن لم يكن مستحيلاً.. فقد تحول الفساد معهم إلى أيديولوجية ونظام استشرى في جميع مفاصل حياة المجتمع ومصالح الناس الصغيرة والكبيرة (الفساد الصغير والكبير )، وهو ما يحيلنا أبداً إلى الضرورة الوطنية والتاريخية لدولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة لكل مواطنيها.. السؤال الغائب الكبير، وهو ما دفع الرئيس في برنامجه الانتخابي الأخير إلى الإشارة إليه أكثر من مرة، ما يستوجب تحوله إلى فعل وتطبيق يمارس على صعيد الواقع ويطال حياة الناس ومصالحهم وليس في بقائه شعارا أيديولوجيا يعبر عن لحظة انتخابية عابرة، لكسب أصوات الناخبين والتلاعب بمشاعرهم، بملامسة وتر الحاجة السياسية والوطنية والتاريخية للدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، والعبرة هنا في تحول الخطاب الرئاسي الانتخابي إلى واقع وممارسة، فقد شبعنا خطابات ووعوداً ، وأكثر ما يخيفنا هو وعود الحكومات العربية ورؤسائها في فترات الأزمات، والانتخابات، التي لا يتحقق منها في الغالب شيء بعد أن ينفض السامر، فالخطاب العربي الرسمي عودنا أن طعم وعوده أمرُّ من علقم الواقع وأسوأ من فساده الذي كان، لأن ما يأتي بعد الوعود هو حالة من الانتقام من حلم الناس ومعاقبتهم على التجرؤ على الحلم، خاصة بعد أن تحولت وعود الثورة العربية الاستقلالية إلى ضدها ونقيضها في واقع الممارسة.. بل أن بعضها انتهى إلى حالة من العداء لكل شعارات ومضامين الوعود بالإصلاح والتغيير والثورة .. فهل سيتحول برنامج الرئيس الانتخابي إلى وعود محققة في الواقع وتنتقل إلى حدود الإنجاز، هذا ما يجب أن نراهن عليه على كل إحباطاتنا وأوهامنا الأيديولوجية المستعدة لاستدعاء ما يناقض الوعود، تماشياً مع ما هو جار، حتى لو قادتنا نياتنا الطيبة إلى جهنم، مع تقديري أن المثل القائل «من مشنقة إلى مشنقة فرج» غير صحيح، ويعكس عقلاً تواكلياً، وهو ما يفسر حالة الأغلبية الصامتة في معظم الأقطار العربية.
إن تعايش وتضايف أنماط إنتاجية مختلفة قديمة وحديثة، وعلى الغلبة النسبية لسيادة أو حضور أسلوب الإنتاج الرأسمالي التابع، في صورة اقتصاد الصناعة الخفيفة المحدودة ، وتجارة الاستيراد والتصدير، إلى جانب الاقتصاد الموازي من مصادر التهريب وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، وتجارة العملة ، وتوظيف القوة في اللعب في قضية الأرض والعقارات، والاستئثار بالمناقصات الرسمية للدولة، وغنيمة القطاع العام باسم الخصخصة، وإعادة التكيف الهيكلي بالتوازي مع إزاحة قوى الرأسمال المحلي التقليدي، في قطاع الصناعة، والتجارة والأعمال، والمقاولات والعقارات، كل ذلك عاق إمكانية التطور الطبيعي والتدريجي للرأسمالية المحلية، وجعلها بين فكي كماشة اقتصاد العولمة وشروط البنك والصندوق، ومنظمة التجارة العالمية، مما يحوله من اقتصاد تابع إلى اقتصاد أكثر هامشية، وبين حصار رأس المال المعنوي أو اقتصاد المكانة والوجاهة، الذي يحاصره ويحد من حركته الاقتصادية الطبيعية ونموه الدستوري والقانوني، حتى إن وجدت التشريعات المنظمة للاستثمار فهي غير قابلة لأن معظم ما يجري ويتم خارج الدستور والقانون، خاصة بعد تحول الفساد إلى سلطة وقوة تملك من الأدوات والآليات ما يعوق قدرة الأجهزة التشريعية والقضائية والقانونية والدستورية على تنفيذه أو تحقيقه، ومن هنا تمت الخصخصة خارج القانون بل وفي بعضها قبل إصدار القانون، وهو ما يفسر ظاهرة هجرة الرأسمال الوطني إلى الأسواق العالمية، بعد هجرة العقول وخوف المستثمرين من المغامرة غير محسوبة العواقب على مصائر رساميلهم .. إذا كانت الأرض لا تمتلك أية حرمة أو قدسية حتى وهي في ملكية أسرتك لقرون وبحوزتك من البصائر والوثائق ما يكفي، إلى جانب تأكيدات القضاء، وأوامر رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، حيث لا حرمة ولا اعتبار سوى لقانون القوة وليس لقوة القانون والحق، وفي ظل واقع كهذا وعلاقات وممارسات لا تحتكم للدستور ولا القوانين النافذة، ويتقدم عليها قانون القوة، وحكم الأعراف والقيم القبلية العصبية من الصعب الحديث عن تنمية اقتصادية وطنية مستقلة، أو فتح منافذ حقيقية لتحديث ثقافة المجتمع وتنميته.
والنتيجة أن نمط الإنتاج الرأسمالي المشوه والتابع يدخل مع هيمنة القوى الاجتماعية السياسية التقليدية في مجال ودائرة اقتصاد الغنيمة ومزاجية الإدارة الفردية والشخصانية، ولا صلة حقيقية لها بمفهوم وقانون اقتصاد السوق، الذي تحكمه عملية موضوعية اقتصادية تنموية مستقلة عن رغبات الحاكمين أو المتنفذين، ومن هنا نلحظ ضغوط الجهات الأوروبية الاقتصادية والمالية المانحة، وشروطها لضبط إيقاع المسألة الاقتصادية في إطار أنظمة وقوانين عمل وإدارة مؤسسية وقانونية، وهو ما بدأت بعض أقطاب السلطة تتنبه له وتحاول تدارك مخاطره وتبعاته على مستقبل البلاد، واقتصادها وتنميته الإنتاجية المستقلة، ولا أقرأ في خطاب الرئيس الانتخابي الأخير 2006 - 2013 سوى بداية استشعار لخطوة المنحى والتوجه الذي تسير فيه البلاد، المهم أن يتحول الخطاب من القول إلى الفعل والتطبيق، ويدخل دائرة الإنجاز في صورة عمل مؤسسي، وخطوة على طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ولتجاوز واقع الثنائيات القاتلة التي أصبحت تشكل معوقاً جدياً أمام أي تحول مؤسسي سياسي ديمقراطي، وأمام أي تنمية أو تحديث.
وعلى ذلك فلا غرابة أن تهيمن على حياتنا الفكرية والسياسية، والثقافية والاجتماعية سلطة الثنائيات المدمرة، حيث الخطاب يتأرجح بين خطاب ما قبل الحداثة - الخطاب البطرياركي - وخطاب الحداثة والتحديث وإن على استحياء، خطاب حداثي محاصر ومقهور والقسم الأعظم من هذا الخطاب يتم مصادرته أو احتوائه في جبة الخطاب الإعلامي الرسمي، وفي الأيديولوجية السائدة، القادم من التعليم التقليدي المتخلف، ومن مناهج المدارس والجامعات، وبرامج التلفزيون الثقافية الهابطة، والثقافة الأصولية، وثقافة العنف التي يفرزها المجتمع، إن هذا الخطاب الثقافي الحداثي يجري استغراقه من خلال عنف البنية الاجتماعية والثقافة التقليدية، بعد أن توظف قسماً هاماً منه لخدمة مصالحها المباشرة، ولتكريس البنية التقليدية المهيمنة. وكأن البنية الاجتماعية في اليمن تجمع في داخلها اليوم « المجتمع الأبوي المعاصر (… ) الذي لم يتوصل إلى تحقيق الحداثة بمعناها الأصيل، (وهو كذلك) ليس تقليدياً بكل معنى الكلمة، أي أنه يعيش في ظل خطابين: في ظل خطاب الحقيقة الشاملة الكلية، وفي ظل خطاب الحقيقة الحديثة المحدودة (… ) أنه عاجز عن التعامل مع أي منهما بشكل عقلاني منتظم يمكنه من إرساء علاقته بالماضي (بالتاريخ) أو بالواقع (بالحاضر) أو بالمستقبل، من خلال وعي ذاتي مستقل»(6)، ولا يمكننا ونحن في سياق هذه القراءة لهذه الفقرة المحورية في الورقة إنكار أن الثورتين على الإمامة وعلى الاستعمار - بدرجات متفاوتة - قد أحدثتا أو مارستا خلخلة حقيقية في بنية النظام الاجتماعي التقليدي البطرياركي خاصة في الشطر الشمالي الذي كان يقبع في كهف ناء خارج العصر .. وإن لم تستطع الثورة إحداث زحزحة حقيقية للبنية الاجتماعية التقليدية التي ظلت فاعلة ومؤثرة على مسار التطور السياسي والاجتماعي، والثقافي للبلاد، وتحديداً من بعد الخامس من نوفمبر 1967م الذي أعاد بقوة تجديد إنتاج البنية المشيخية التقليدية في أجلى صور تغييرها عن دور ووظيفة جديدين، وعلى حساب القوى الاجتماعية الجديدة، بدأ معها يتشكل مضمون صراع جديد بين قوى التحديث، ورموز المشيخة القبلية التي دفعت إلى قمة السلطة، بعد أن ظلت خارجها طيلة عهود الإمامة، وهي مرحلة جديدة بكل المقاييس من تطور الدولة، والسلطة، والمجتمع في اليمن الشمالي.. وبعد الوحدة والحرب جرى تعميم ونمذجة الحالة على كل مجتمع ما بعد الوحدة، وحين أشرت في سياق الفقرة الأولى من الورقة - المقدمة - إلى أن الإشكالية كامنة في المفهوم والرؤية وفي الواقع، ومن أن الواقع معقد وشديد التداخل والتشابك يختلط فيه العلمي بالغيبي، والإيماني بالعقلاني، والخرافي بالواقعي، والتاريخي بالأسطوري، لم أكن أقصد خطاباً إنشائياً وبلاغياً وخطاباً مجازياً، بقدر ماهو تحليل لمضمون علاقات الواقع ومعطياته وحقائقه التي تتضايف في داخله كل هذه التشابكات وأنماط التفاعلات الثقافية والاجتماعية والقيمية التي من الصعب في العديد من الحالات تحديد الفواصل والحدود فيما بينها، حيث نشهد تموضعات فكرية وثقافية متناقضة داخل الفئة الاجتماعية والشريحة الطبقية الواحدة، التي تجمعهم مصلحة مادية اقتصادية مشتركة، وسبب ذلك في تقديري يتمثل في عدم الفصل بين المجال السياسي، وبين المجال الاجتماعي، ومن جانب آخر يعود إلى حالة التناقض بين المعرفة والمصلحة التي تقود حتماً إلى الخرافة، ووقوف الناس ضد مصالحهم الطبقية والاقتصادية، وأكبر دليل على ذلك حين نجد قطاعاً واسعاً من القبائل والفلاحين يعطون أصواتهم الانتخابية لمن يمثلون نقيض مصالحهم الواقعية والتاريخية، ولمن يسومونهم العذاب، ومن المهم هنا التأكيد على أن «أول شروط النظر العلمي هو الاعتراف باستقلال الواقع وتميزه عن العقل، وهذا الاستقلال يعني أنه لا ينبغي الخلط بين المفهوم الذي نصوغه، وبين الواقع موضوع الفهم القائم خارج العقل، فليس تعيين حقيقية هذا الواقع من الأمور البسيطة، ولا استجلاء مفهومه من المعطيات العفوية، بل ربما كان مفهوم الواقع هو المفهوم الأكثر صعوبة وقدرة على التملص من الوعي والهرب إلى أمام الإدراك، لأنه لا يمثل شيئاً آخر سوى هذا التحول الدائم والمتناقض والمتشعث الذي لا يمكن الإمساك به وتنظيمه إلا بفرض وعي خارجي عليه، والاختيار فيه بين إمكانات ووجوه لا توجد إلا بالعمل معاً»(7).. ومن هنا تبرز أهمية امتلاك الأدوات المعرفية في إعادة قراءة الواقع، وفهم تموضعاته المادية والسياسية الفكرية عبر تشخيص موضوعي لحقائق الواقع كما هي، بعد رفعها إلى مستوى القراءة التحليلية السوسيولوجية وتقليص التدخل الأيديولوجي إلى أقصى حد، حتى لا نجد أنفسنا أمام قراءة لا صلة لها بالواقع، ولن يتحقق ذلك دون الاعتراف بحقائق المجتمع المتعددة والمتنوعة وفتح قنوات حوار فيما بينها، حوار موضوعي عقلاني نقدي، فالديمقراطية أولاً وقبل كل شيء ثقافة وعمل مؤسسي، وهي ثانياً تعتمد الحوار والقبول بالآخر كما هو، والديمقراطية تعني المساواة، والعدالة، والحوار هو الأساس الذي تتقاطع على قاعدته جميع هذه المفردات..
«فالحوار ليس كلاماً فارغاً ولكن استراتيجية وطنية هدفها إعادة بناء التفاهم الوطني كشرط لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وهو الطريق الوحيد لخلق مناخ جديد ينزع فتيل الحرب ويضع حداً لحالة القطيعة والغربة وضعف الاتصال والتواصل العقلاني، بين مختلف القوى، والذين يقفون ضد الحوار اليوم هم الذين اختاروا طريق استخدام العنف والقوة»(8).
وغالباً ما يكون سبب اللجوء لاستخدام القوة والعنف، غياب الدولة الحديثة المؤسسية، دولة لكل مواطنيها، وحين تغيب الدولة وفي مجتمع مدجج بالسلاح الخفيف والثقيل كحالنا في اليمن يغدو العنف والقتل ملمحاً بارزاً من ملامح وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية، ويتحول الثأر إلى ظاهرة، فما بالكم حين تكون جهات متنفذة تغذي عملية الثارات(9) وتشجع على حمل السلاح، وما يجعل الفلاح والقبيلي، والمواطن عامة يعطي ولاءه للانتماءات ما قبل الوطنية أو الانتماءات التحتية - القبيلة، العشيرة، الطائفة، المنطقة، والجهة، إنما هو غياب دولة المواطنة، دولة الحق والمؤسسات، ففي هذه الانتماءات الصغيرة يجدون ملاذهم الأخير وشكلاً من أشكال رعايتهم وحماية حياتهم ومصالحهم، والدفاع عن حقوقهم المهدورة، في واقع غياب القضاء المستقل والتحاقه بالسلطة، ومن هنا يأتي تفسير عودة العديد من الناس، بل ومجاميع من المثقفين والسياسيين نساءً ورجالاً للاحتماء بقبائلهم أو البحث عن أصول قبيلة تسندهم، وعودة العديد منهم للسؤال عن أنسابه ومشجر أسرته وعائلته ، المذهبي والديني، والقبلي، والعرقي إذ أصبحت الهويات الصغيرة التحتية الرمز البديل لغياب الهوية الوطنية الجامعة في صورة الدولة المؤسسية الحديثة -وهو ما سنأتي إلى بحثه لاحقاً- وقد ارتفع صخب البحث عن الهويات الصغيرة - تحت الوطنية - بعد حرب 1994م حين شهدنا العديد من أبناء المدن، وتحديداً مدينتي عدن، وتعز، وغيرهما من المدن الرئيسة يبحثون عن أصولهم القبلية والعرقية والمذهبية، ومشجر أنسابهم وعشائرهم والمصادر الأولى لأجدادهم الأوائل، وبالصدفة التاريخية البحتة يكتشف العديد منهم أن أصولهم تعود إلى حاشد وبكيل، وإلى كهلان، وهمدان الكبرى، وإلى ما قبل ذلك، إذاً نحن أمام ردة ثقافية، ونكسة اجتماعية وطنية طالت أعماق الروح والثقافة والوجدان، ناهيك عن عودة الأصولية الدينية التكفيرية الباحثة عن عقود زواج الآباء لتحديد شرعية نسب الأبناء والأحفاد بعد عقود من تاريخ الزواج، لم نعد اليوم بحاجة إلى سلطة إكراهية استغرقت الدولة في داخلها وأوصلتنا إلى ما نحن عليه من تمزق وتفكك وخراب في كل أقطار المنطقة العربية، إننا بحاجة إلى دولة مؤسسات مدنية حقوقية، دولة لكل مواطنيها، دولة مؤسسية ترسخ منظومتها القيمية والدستورية، كل الانتماء لها، وليكون توزع الولاء السياسي اختيارياً وفقاً للمشارب الفكرية والسياسية والثقافية، وبحسب التوزع الطبقي والمصالح الاقتصادية والمادية للأفراد، أو وفقاً لخياراتهم الأيديولوجية والسياسية، لأن الانتماء يكون لقضية كلية كبرى الوطن والشعب، بمفهومه المجرد والعام، والولاء بحسب التوزعات الطبقية والفكرية والسياسية، والحزبية، ونتيجة تداخل المجال السياسي بالاجتماعي في بلداننا ضعيفة التطور الاقتصادي الرأسمالي، غالباً ما تكون إحداثيات الفرز السياسي اعتباطية وعبثية وعدمية ولا تجسد روح المصالح الاقتصادية للناس، وهو ما سبق التلميح إليه تاماً.
إن تأكيد برنامج الرئيس الانتخابي على فكرة تداول السلطة سلمياً، يعني بدء الإقرار بأن موقع الرئاسة الأولى حق لكل يمني من أية قبيلة أو عشيرة أو منطقة كانت، ولأي مذهب انتمى إليه ، ومن أي طبقة أو فئة اجتماعية، وعند هذه اللحظة يتحول مبدأ تداول السلطة السلمي إلى حقيقة ممارسة، بعيداً عن احتكار الرئاسة الأولى في طبقة أو فئة أو قبيلة، أو مذهب، وبذلك يكسر برنامج الرئيس الانتخابي قضية حدية وعلى درجة عالية من الحساسية تتعلق بالرئاسة الأولى، وسلطة الدولة. وبذلك يمكن القول إننا نفتتح أولى آليات مداخل تحديث ثقافة المجتمع وتنميته ديمقراطياً. فإذا كانت ثورة 26 سبتمبر 1962م كسرت حدة احتكار الإمامة السلالية للحكم الذي بقي محصوراً في «البطنين»، فإننا اليوم ومن خلال مبدأ التداول السلمي للسلطة نفتتح باب الرئاسة الأولى لكل البطون ولجميع اليمانين من كافة مناطق وجهات اليمن، وهنا يصبح اليمن وطناً لكل أبنائه.
وعندئذ نكون قد بدأنا الدخول إلى فضاءات دولة المؤسسات الحديثة، دولة يتحدد فيها اسم الحامل السياسي لرأس الدولة بشكل دوري ولكل المواطنين دون أي اعتبار للقبيلة والطائفة والمذهب والجهة، ودون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة، دون أن نجيب عن سؤال المواطنة، وسؤال دولة المؤسسات.. وفي الدولة المؤسسية الجمهورية المدنية الحديثة لا مجال لتوريث الحكم تحت أي مسمى كان. ومن المهم هنا التأكيد على تأكيد البرنامج الانتخابي للرئيس الفائز علي عبد الله صالح حين حدد فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين كما ينص عليها الدستور، ما يعني ألا رجعة عن النص الدستوري، وأن من حق المواطن الآخر أن تؤول إليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة، وحين يتحقق ذلك نستطيع القول إننا بدأنا ندخل فضاءات الحداثة والمدنية، ودولة المؤسسات.