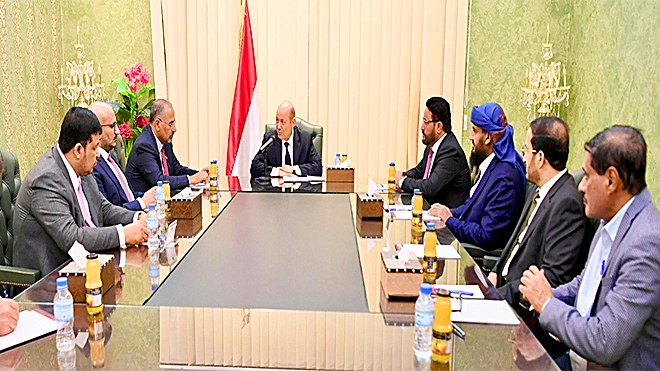> محمد حمادة إمام
حَقًّا، بلادي وإنْ جارتْ عليَّ عزيزة، هذا إذا جارت، فما بالنا إن لم يتعدَّ أهلُها، ولم تجُر، فلم ولن يَقْدِر الإنسانُ على التنكر لوطنه، وطرْد حُبِّه له مِن جَنَانِه، وكيانِه.
«فالحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب، مِن رقة القلب وعلامات الرشد؛ لما فيه من الدلائل على كرَم الأصل، وتمام العقل.
قال أعرابيٌّ: لا تَشْكُ بلدًا فيه قبائلُك، ولا تَجْفُ أرضًا فيه قوابلُك، وقال آخرُ: ليس الإنسان أقنعَ بشيء منه بوطنه؛ لأنه يتبرَّم بكل شيء رديء، ويتذمَّم مِن كل شيء كريه، إلا مِن وطنِه وإنْ كان رديء التربة، كريه الغذاء، ولولا حبّ الناس للأوطان، لَخَرِبَ أخابثُ الأرض والبلدان».
فهذا القاضي، أبو عبد الله محمد بن [أبي] عيسى، يُصوِّر مشاعره، ويعرضها مع أحاسيسه، بعد أن خرج من الأندلس إلى غيرها، يومَها ذَرَفَتْ عيناه الدمع على أيام الشباب، التي كانت في جبين الدهر كواكبَ سواطعَ، ونجومًا لوامعَ، فهي أيام مكتظَّة بالمآثِر والمعالي؛ حيث كان يتنقل في قرطبة، بين الأحبَّة في إيناس وأمان، وقد أعاد إليه ذكراها وُرْقٌ مغرِّدة، فإذا به حينئذ يُقِيم موازنةً بين ماضِيه المجيد، وشبابِه السعيد، الذي التحَف بنضارته، وأتحَف روحَه ببهجة رفاقه وأحبته - وبين حاله المروِّع في المشيب؛ فيقول:
ماذا أُكَابِدُ مِنْ وُرْقٍ مُغَرِّدة
على قضيبٍ بذات الجِزْعِ مَيَّاسِ
رَدَّدْنَ شَجْوًا شَجَا قلبَ الخليِّ فَهَلْ
في عَبْرةٍ ذرفتْ في الحُبِّ مِن بَاسِ
ذكَّرْنه الزَّمنَ الماضي بقُرطبَةٍ
بين الأحبَّة في أَمْنٍ وإيناسِ
هُمُ الصَّبابةُ لولا همةٌ شَرُفَتْ
فَصَيَّرَتْ قَلْبَهُ كالجنَدْلِ القَاسِي
عن الدَّنِفِ المُضْنَى بِحَرِّ هَواها
إلى أن يقول:
فيا لَلشَّباب الغضِّ أنهج بُرْدُهُ
ويا لَرياضِ الَّلهْوِ جَفَّ سَفَاها
وما هي إلا الشَّمْسُ حَلَّتْ بمفْرقي
فأعْشَى عُيونَ الغانياتِ سَنَاها
وعينُ الصِّبا عارَ المشيبُ سَوادَها
فَعَنْ أيِّ عَيْنٍ بَعْدَ تِلْك أُرَاها
سَلامٌ على شَرْخِ الشَّبابِ مُرَدَّدٌ
وآهًا لِوَصْل الغانياتِ وآها
ويا لديار اللهو أقوَتْ وسُومها
ومَحَّتْ مغانيها وصَمَّ صَدَاها
وهذا ابن زيدون، يُصوِّر حَنينه إلى موطن أحبابه، ومعهد صباه وشبابه، إذ كانت الذكريات تُرسِل ظلَّها إليه، وتنشر ثوبها عليه، مرسلًا إلى تلك الديار تحيَّة، تفيض حسرة، وتقطر أسًى ولوعة... وها هو - الآنَ - تسيل أدمُعه، كاللؤلؤ، فيقول
على الثَّغَبِ الشهديِّ مني تَحَّيةٌ
ذَكَتْ وَعَلَى وَادي العقيق سَلامُ
ولا زال نَوْرٌ في الرّصافةِ ضاحكٌ
بأرجائها يَبْكي عَلَيْه غَمَامُ
مَعاهد لَهْوٍ لم تزل في ظِلَالهِا
تُدَارُ عليه للمُجونِ مُدامُ
فإنْ بانَ منِّي عهدُها فبِلَوْعةٍ
يُشَبّ لها بَيْن الضّلُوع ضِرامُ
تَذكَّرتُ أيامي بها فتبادرتْ
دُموعٌ كما خان الفريدَ نظامُ
ذكْريات أضرمتْ في قلبه النيران، وجعلَت الدموع تسيل أنهارا. وفي أثر اللهو والترف عليه، وفي أعلاق شعره، يقول الأستاذ أحمد ضيف: «وكان لأخلاقِ ابنِ زيدون، والبيئة التي عاش فيها، وميول الناس إلى اللهو أثرٌ عظيمٌ في شِعره. فقد كان للمُجُون مسحةٌ خاصَّة في النَّظْم والنَّثْر
كان مجونه هو وأهل أوانه، سببًا في طيران صرخاتهم كل مطارٍ، وتعالي صيحاتِ الأنين والحنين إلى الأوطان والأوطار.
وكثيرًا ما يَغْضَب المرءُ، ولكنه سرعان ما يحنُ إليه، ويئن مِن وطأة الاغتراب ذاكرًا مآربَ قضاها الشباب هنالك، فتُثمر تلك الذكرى أفانينَ مِن الصّوَر، تسيل رقةً، وتمُوج عذوبة وسلاسة.
وللقُدماء كلماتٌ مأثورة في الحنين، ممَّا يدلّ على نُبْل هذه العاطفة، وعُمْقها في النفس الإنسانية.
وللعرب - خاصة الأندلسيين - نصيبٌ كبير، وحظٌّ وافر من الأشعار في هذا الفن، رابطين فيها بين الحنين إلى الأوطان، والحنين إلى الشباب وأيامه وذكرياته.
ماذا أُكَابِدُ مِنْ وُرْقٍ مُغَرِّدة
على قضيبٍ بذات الجِزْعِ مَيَّاسِ
رَدَّدْنَ شَجْوًا شَجَا قلبَ الخليِّ فَهَلْ
في عَبْرةٍ ذرفتْ في الحُبِّ مِن بَاسِ
ذكَّرْنه الزَّمنَ الماضي بقُرطبَةٍ
بين الأحبَّة في أَمْنٍ وإيناسِ
هُمُ الصَّبابةُ لولا همةٌ شَرُفَتْ
فَصَيَّرَتْ قَلْبَهُ كالجنَدْلِ القَاسِي
وهذا ابن دراج القسطلي، يبكي شبابَه، الذي بَلِيَتْ بُرُوده وثيابُه، ويندب دياره، التي كانت عامرة أيامَه بصنوف اللَّهو والتصابي، معدِّدًا توابع فقدِه، وما كثَّرت لديه من حسرات، وتتابع الآهات فيقول
أضاء لها فجرُ النّهَى فَنَهَاَهَا عن الدَّنِفِ المُضْنَى بِحَرِّ هَواها
إلى أن يقول:
فيا لَلشَّباب الغضِّ أنهج بُرْدُهُ
ويا لَرياضِ الَّلهْوِ جَفَّ سَفَاها
وما هي إلا الشَّمْسُ حَلَّتْ بمفْرقي
فأعْشَى عُيونَ الغانياتِ سَنَاها
وعينُ الصِّبا عارَ المشيبُ سَوادَها
فَعَنْ أيِّ عَيْنٍ بَعْدَ تِلْك أُرَاها
سَلامٌ على شَرْخِ الشَّبابِ مُرَدَّدٌ
وآهًا لِوَصْل الغانياتِ وآها
ويا لديار اللهو أقوَتْ وسُومها
ومَحَّتْ مغانيها وصَمَّ صَدَاها
أخَذ المُجُون حظًّا وافرًا لدى كثير من الأندلسيين، في شبابهم خاصة، ولما بان عنهم، واستعار بياض المشيب سواد عين الشباب، الذي كان يَرى به الوجودَ جميلًا، كثُر لهم مُثُول ذكرى اللهو والسرور، ووحشة آثار الديار، ومرارة هجر الحِسَان، وجفاف رياض الأنس.
فيا لهم من رجال يُصوِّرون بخاطرهم ولبِّهم، ومشاعرهم، ملاعبَ صِباهم، فتهفو إليها أرواحهم، وتضطرم نيرانُ الحنين والأشواق إليها، وإلى الرفاق والأحباب؛ ولذا فإنهم كثيرًا ما يَطلبون مِن سُحب الربيع المبادرةَ بسقْي هذه الأطلال، ميادين الصِّبا، وملاعب الحسان، ومنبت السرور والأشجان، لِتُثمر وتُزهر، محدثة عن عهد الشباب الأزهر.
على الثَّغَبِ الشهديِّ مني تَحَّيةٌ
ذَكَتْ وَعَلَى وَادي العقيق سَلامُ
ولا زال نَوْرٌ في الرّصافةِ ضاحكٌ
بأرجائها يَبْكي عَلَيْه غَمَامُ
مَعاهد لَهْوٍ لم تزل في ظِلَالهِا
تُدَارُ عليه للمُجونِ مُدامُ
فإنْ بانَ منِّي عهدُها فبِلَوْعةٍ
يُشَبّ لها بَيْن الضّلُوع ضِرامُ
تَذكَّرتُ أيامي بها فتبادرتْ
دُموعٌ كما خان الفريدَ نظامُ
ذكْريات أضرمتْ في قلبه النيران، وجعلَت الدموع تسيل أنهارا. وفي أثر اللهو والترف عليه، وفي أعلاق شعره، يقول الأستاذ أحمد ضيف: «وكان لأخلاقِ ابنِ زيدون، والبيئة التي عاش فيها، وميول الناس إلى اللهو أثرٌ عظيمٌ في شِعره. فقد كان للمُجُون مسحةٌ خاصَّة في النَّظْم والنَّثْر
كان مجونه هو وأهل أوانه، سببًا في طيران صرخاتهم كل مطارٍ، وتعالي صيحاتِ الأنين والحنين إلى الأوطان والأوطار.