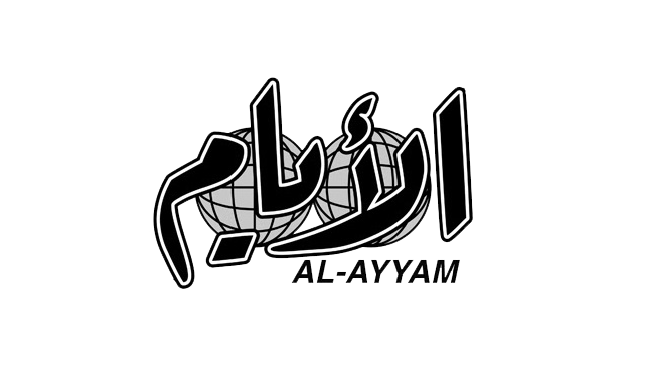> «الأيام» أديب قاسم:
الموضوع الأساسي في القصائد الآنفة أو جزئياتها يتوقف على الإحساس بوجود تمرد وسخط على أوضاع اجتماعية (ومشهدية) تمر بها حاضرة التمدن: (عدن) وإنسانها البسيط الواعي لكل الظروف التي تحتاجها لتغير من جوهر المدينة.. إنها- القصائد - مثال للتعاطف مع الذين نشب بينهم وبين الحياة صراع. وهي تعبر عن الحياة العدنية تعبيراً واقعياً ناقداً، من خلال تقديم الرجل العادي كمحور للدراما، وإيجاد دراما شاعرية تضرب بجذورها في أساليب وعادات أهل عدن.
ومن هنا يكون السقاف قد صاغ من حياة أناس عدن البسطاء أغنية أرضية: عدن تقف عاجزة حيرى وسط عالم غريب تشكله القبيلة، أي تـأثير العقلية القبلية والارتباطات الشعائرية المتخلفة عن ركب التمدن الذي سارت عليه الطبقات الأساسية في عدن ، عالم فقدت فيه مكانتها القديمة وأمنها المادي.. الذي طبع هذا الساحل وجعل من سكانه تجاراً ومصطافين وادعين وبحارة يأخذون ويعطون، أي يتأثرون ويؤثرون بالعالم الواسع الذي يتعاملون معه، والذي جعل منها كياناً جغرافياً (سياسياً) واحداً، أي مجتمعاً واحداً ذا حياة مشتركة مميزة. وأصبح كل ذلك بالنسبة لعالم وسط بحري فردوساً مفقوداً. وهو -أي الشاعر- يحاول التخقفيف عنها، فبماذا؟.. بأن تجد راحتها في الشعر!.. بمكاشفاته «الذاتية» جراء إحساسه المفرط بالواقع في حوارية الصمت والغضب.. ومن أجل استنهاض هذا الواقع إلى حد امتلاكه للبحر: الصخب والعنف!.. هذا هو في المشهد الرابع الذي حمل عنوان «عدن» من قصيدته الطويلة: (مشاهد من سيناريو:«بائع متجول»..):
- إني والعربهْ..
مشغولٌ فوق رصيف الصبح الحار
قلبي يستقبل كلَّ ضجيج الأرصفة العدنيهْ
والشجرات المتباعدة الخطوات
تسقط في عيني..
وأنا تحت الشمس
أسوّي قميص الريح
محتبياً يجلس حولي البحر
فأراقب مئذنة في الأفق تلوحْ
... ياعدن احتمليني
إني أسئلة وجروحْ
احميني من عتمة روحي
واعطيني ضياءات ووضوحْ:
- هل يبقي الصمت هو السيف
ودم القرية مسفوحْ
من باع نهارك ياعدن
أو.. ترك ليالي الظلم
على الطرقات تفوحْ؟
... ها إني أنا جئتُ
أصرخ في صوت منكسر مبحوح:
فليبق البحر لنا السيِّد
ودمانا أشرعةً وصروحْ
في المشهد الذي مرَّ، بدا من الواضح لنا أن الشاعر كان مهّد لاحتمالات الغضب المتصاعد من عتمة الروح المغلفة بالصمت، بمشهد موسيقي درامي.. غاية في الروعة!.. مشهد افتتاحي رئيسي لمدينة عدن. ثم وهي تستوعب عناصر إنسانية وغير إنسانية (تضمنتها فكرة القصيدة) حيث تتخذ الصورة الجمالية دليلاً على نقيضها.. حدد الشاعر السقاف به موقفه من خلال تصويره لما يعتزُّ له وينفر منه.. وهي ميزة للوعي أو الشعور الخاص المرتبط بشيء موضوعي (صورة المدينة البحرية الجميلة المعرضة للتلوث.. وللفقر وللضياع) هذه الفكرة المتضمنة في قصيدة ت.س.إليوت: «الضغينة Spleen» مثلما في اليباب أو الأرض الخراب The Waste Land، وكما يرى فيها الناقد الأمريكي ليونارد أنجر Leonayd Unger:«وحيث بيئة من الناس والأشياء تؤلف «اتحاداً بليداً على شر» لا يستطيع الهم أن يقف في وجهه».. وتتنافر الأصوات الإنسانية بين عالم الجمال والحياة الوادعة المتآلفة في انسجامها، وعالم القبح في الواقع.
على أني ربما كنت قد أغفلت ماهنالك من أهمية لكل عمل شعري في بنائه أي في التنظيم الشكلي لأجزاء العمل الفني، وطبيعة كل جزء على حدة شأن هذه القصيدة: (مشاهد من سيناريو:«بائع متجول»..) التي تتألف من ست متتاليات غير منقطعة.. وحيث تنتقل الأفكار لا حسب تراكمها، بل وفق نظام محدد لا غنى عنه لتركيب صحيح للصورة التي رغب في رسمها وعرضها أمام العالم، وهو من الأمور الحيوية التي تحدد وتحكم العلاقة بين هذه الأجزاء.. ومن خلالها إنما تبعث الحياة كلية في القصيدة حيث تتحدد الرؤية الفنية الكاملة. وعلى القارئ بضوء هذا الإيحاء أن يرجع إلى النص الذي تتقاطع فيه الصراعات الثقافية للتاريخ ولعصرنا وعلى ما فيه من قدر كبير من التماسك والترابط للقصيدة (المأساة) في جوهرها.. أي ليدرك طبيعة ذاك العمل الشعري، حيث نرى في هذا الصراع الذي يصور الإحساس بالانفصال والاندماج في آن واحد معاً، بين القرية أو معاناة القرية التي يفر من بين يديها الماء، فيتدفق بدلاً عنه الباعة المتجولون إلى عدن (في جو إنساني)، وفيما الحديث هنا عن الإنسانية العادية.. وبين المدينة في هذا التصوير الدرامي للخيبة التي منيت بها عدن.. ويقوي لدينا الإحساس بالنظرة المتضادة إلى الشيء الواحد في الصراع بين ثقافتين، إحداها تاريخية كما هي حال القرية، والأخرى هي لعصرنا كما هي عدن.
وتصوير الشاعر لهذا الصراع فيه إسقاط واع للصراع الذي في دخيلته.. لشعوره المجزأ بين الواقع الإنساني للبائع المتجول (أي سلطان الفقر) القادم من القرية وهو بالنسبة لعدن: الهمجي أو الشرير المعذب في الأرض!.. نظرة تستخلص الخير من أقصى الشر- وبين المدينة التي أخذت تفِرّ من بين يدي الزمن العدني الساحر. هذا الذي يصور لنا فعل القصيدة في هذا الانفصال والاندماج في آن واحد.
فالقصيدة مبنية على إدراك الشاعر الواعي لهذا الصراع الذي تتحرك وتتدخل فيه العلاقات على نحو هارموني وقد اتخذ طابع السيناريو الذي تتبدل فيه المشاهد أو تتبادل منه الأمكنة بشكل تداخلي حيث تتحول القرية إلى داخل المدينة ، أو تتحول المدينة إلى قرية فقيرة لتتماهى فتفقد سمات العصر:صورة المجتمع المدني المزدهر! -وهذه في النهاية هي: عدن!
***
الوعي بالذات - مرة أخرى - هو الصفة الغالبة في شعر «عبدالرحمن السقاف» ويعتبر في المقام الأول من الأهمية لطبيعة رؤياه الإبداعية.. حيث يمكن للتأملات الذاتية أن تكون مصدراً للكثير من الحقائق العامة. وفي هذا أصل التجربة الإنسانية، وهي التي تبحث عن تفسير منهجي متكامل للحياة.
عبر هذا المنطلق نصل إلى الشاعر السقاف وهو يدلف إلى الألفية الثالثة لما كان من «عابري القرون» لنتوقف على أسلوبه المتجدد حيال حساسية اللغة في رحلته مع الشعر الصافي. ونقصد (بالصافي) كما قرّبه لنا الشاعر الفرنسي «بول فاليري» (1954-1871م) أكبر شعراء فرنسا في القرن العشرين، عملاً فنياً يكون صافياً خالياً من العناصر غير الشعرية.. على أني قد ذهبت به إلى شفافية الروح المتصوفة التي تبصر ما وراء الجسد من «رؤى» وكالمصير، لا تخالطها مادة الحياة، ولكن نقاء سرائر الإنسان في ملكوت الله الواسع المنزهة عن أعلاق الإنسان الفانية أو متعلقاته الأرضية.. وهو حين يتطلع من علٍ، إلى هذا الوجود الذي نعيش صراعاته وقد خلّفه الشاعر وراءه، بنظرة كلية. وخارج مدلولات اللغة التي نتعاطاها سواء في الحديث الدارج أم في التعبير الشعري.. فالشعر لصافي إنما هو عنصر شعري شديد الروعة!
والأساس في هذا، أننا نجد في أسلوبه المتأخر الكثير من الكناية والمجاز في نوع من الغنائية العالية مما ينبئ عن أن القالب الأساسي في كل علاقة تنشأ بينه وبين المحبوب أو الطبيعة أو الكون تتحول إلى داخله في سعيه لاكتشاف الذات في المحبوب.. ومنها تكون متعته المستمرة:
سألت النهر عنها
قال: رؤى
سألت جبال الهمّ عنها
قالت: رؤى
سألت البحر
نعم قال أيضاً رؤى
ولما ذهبت مع رفّة الريح
سمعت صداي يقول:
رؤى
يا رؤى
يا رو...
...
...
أين ترى يا قلب روح رؤى
(قصيدة: إليها)
ينادي ابنته «رؤى» التي دخلت في إحدى دورات الحياة فغيّبته وراءها - فيه خصام المحب مع الحبيب، وليست مما يتضمن تمرداً جسدياً، بل تمرداً ميتافيزيقياً عن الحالة الإنسانية.. لا شيء يريد بعد الآن غير ملامسة تلك الروح التي ألفها وضمها بين جناحيه، كأني به يقول في سره: أتألم عندما أنظر إليها أبحث فيها عن «رؤاي» التي لم يبق من الماضي فيها غير أطياف لعب وحب كأنما ستار من ضباب يلّفني في غلالاته الرقيقة وهي تمضي في سراديب «الحياة» الصغيرة التي تبعدني عما عشت ألقاه لديها من تعاطف. أستشعر أن غداً أو بعده سيفنى هذا الجسم ولن يبقى منه سوى شعلة صغيرة وهاجة تهتف:
رؤى
يارؤى
يارو..
غير أن «رؤى» السقاف تتسع للكون، فروحه هو في توقها وتحليقها النهائي تنزع إلى رؤية الحياة رؤية شعرية كاملة.. تشتعل بداخله رؤى تشمل جميع العلائق (ابنته - الإنسان - النهر - الجبل - البحر- الريح) وتُوّحدها بالكون. هذا هو نوع بحثه المستمر أو خصامه مع الدنيا خصام المحب، وهو ما يتحقق بالانفصال والاندماج في آن واحد معاً.. ولك أن تبحر في تلك النقاط (...)، حيث تسامى الصوت إلى صمت عميق، وهي التي يخلّفها الشاعر ويتركها معلّقة في صداه البعيد في المدى اللامتناهي.
ومن هنا يكون السقاف قد صاغ من حياة أناس عدن البسطاء أغنية أرضية: عدن تقف عاجزة حيرى وسط عالم غريب تشكله القبيلة، أي تـأثير العقلية القبلية والارتباطات الشعائرية المتخلفة عن ركب التمدن الذي سارت عليه الطبقات الأساسية في عدن ، عالم فقدت فيه مكانتها القديمة وأمنها المادي.. الذي طبع هذا الساحل وجعل من سكانه تجاراً ومصطافين وادعين وبحارة يأخذون ويعطون، أي يتأثرون ويؤثرون بالعالم الواسع الذي يتعاملون معه، والذي جعل منها كياناً جغرافياً (سياسياً) واحداً، أي مجتمعاً واحداً ذا حياة مشتركة مميزة. وأصبح كل ذلك بالنسبة لعالم وسط بحري فردوساً مفقوداً. وهو -أي الشاعر- يحاول التخقفيف عنها، فبماذا؟.. بأن تجد راحتها في الشعر!.. بمكاشفاته «الذاتية» جراء إحساسه المفرط بالواقع في حوارية الصمت والغضب.. ومن أجل استنهاض هذا الواقع إلى حد امتلاكه للبحر: الصخب والعنف!.. هذا هو في المشهد الرابع الذي حمل عنوان «عدن» من قصيدته الطويلة: (مشاهد من سيناريو:«بائع متجول»..):
- إني والعربهْ..
مشغولٌ فوق رصيف الصبح الحار
قلبي يستقبل كلَّ ضجيج الأرصفة العدنيهْ
والشجرات المتباعدة الخطوات
تسقط في عيني..
وأنا تحت الشمس
أسوّي قميص الريح
محتبياً يجلس حولي البحر
فأراقب مئذنة في الأفق تلوحْ
... ياعدن احتمليني
إني أسئلة وجروحْ
احميني من عتمة روحي
واعطيني ضياءات ووضوحْ:
- هل يبقي الصمت هو السيف
ودم القرية مسفوحْ
من باع نهارك ياعدن
أو.. ترك ليالي الظلم
على الطرقات تفوحْ؟
... ها إني أنا جئتُ
أصرخ في صوت منكسر مبحوح:
فليبق البحر لنا السيِّد
ودمانا أشرعةً وصروحْ
في المشهد الذي مرَّ، بدا من الواضح لنا أن الشاعر كان مهّد لاحتمالات الغضب المتصاعد من عتمة الروح المغلفة بالصمت، بمشهد موسيقي درامي.. غاية في الروعة!.. مشهد افتتاحي رئيسي لمدينة عدن. ثم وهي تستوعب عناصر إنسانية وغير إنسانية (تضمنتها فكرة القصيدة) حيث تتخذ الصورة الجمالية دليلاً على نقيضها.. حدد الشاعر السقاف به موقفه من خلال تصويره لما يعتزُّ له وينفر منه.. وهي ميزة للوعي أو الشعور الخاص المرتبط بشيء موضوعي (صورة المدينة البحرية الجميلة المعرضة للتلوث.. وللفقر وللضياع) هذه الفكرة المتضمنة في قصيدة ت.س.إليوت: «الضغينة Spleen» مثلما في اليباب أو الأرض الخراب The Waste Land، وكما يرى فيها الناقد الأمريكي ليونارد أنجر Leonayd Unger:«وحيث بيئة من الناس والأشياء تؤلف «اتحاداً بليداً على شر» لا يستطيع الهم أن يقف في وجهه».. وتتنافر الأصوات الإنسانية بين عالم الجمال والحياة الوادعة المتآلفة في انسجامها، وعالم القبح في الواقع.
على أني ربما كنت قد أغفلت ماهنالك من أهمية لكل عمل شعري في بنائه أي في التنظيم الشكلي لأجزاء العمل الفني، وطبيعة كل جزء على حدة شأن هذه القصيدة: (مشاهد من سيناريو:«بائع متجول»..) التي تتألف من ست متتاليات غير منقطعة.. وحيث تنتقل الأفكار لا حسب تراكمها، بل وفق نظام محدد لا غنى عنه لتركيب صحيح للصورة التي رغب في رسمها وعرضها أمام العالم، وهو من الأمور الحيوية التي تحدد وتحكم العلاقة بين هذه الأجزاء.. ومن خلالها إنما تبعث الحياة كلية في القصيدة حيث تتحدد الرؤية الفنية الكاملة. وعلى القارئ بضوء هذا الإيحاء أن يرجع إلى النص الذي تتقاطع فيه الصراعات الثقافية للتاريخ ولعصرنا وعلى ما فيه من قدر كبير من التماسك والترابط للقصيدة (المأساة) في جوهرها.. أي ليدرك طبيعة ذاك العمل الشعري، حيث نرى في هذا الصراع الذي يصور الإحساس بالانفصال والاندماج في آن واحد معاً، بين القرية أو معاناة القرية التي يفر من بين يديها الماء، فيتدفق بدلاً عنه الباعة المتجولون إلى عدن (في جو إنساني)، وفيما الحديث هنا عن الإنسانية العادية.. وبين المدينة في هذا التصوير الدرامي للخيبة التي منيت بها عدن.. ويقوي لدينا الإحساس بالنظرة المتضادة إلى الشيء الواحد في الصراع بين ثقافتين، إحداها تاريخية كما هي حال القرية، والأخرى هي لعصرنا كما هي عدن.
وتصوير الشاعر لهذا الصراع فيه إسقاط واع للصراع الذي في دخيلته.. لشعوره المجزأ بين الواقع الإنساني للبائع المتجول (أي سلطان الفقر) القادم من القرية وهو بالنسبة لعدن: الهمجي أو الشرير المعذب في الأرض!.. نظرة تستخلص الخير من أقصى الشر- وبين المدينة التي أخذت تفِرّ من بين يدي الزمن العدني الساحر. هذا الذي يصور لنا فعل القصيدة في هذا الانفصال والاندماج في آن واحد.
فالقصيدة مبنية على إدراك الشاعر الواعي لهذا الصراع الذي تتحرك وتتدخل فيه العلاقات على نحو هارموني وقد اتخذ طابع السيناريو الذي تتبدل فيه المشاهد أو تتبادل منه الأمكنة بشكل تداخلي حيث تتحول القرية إلى داخل المدينة ، أو تتحول المدينة إلى قرية فقيرة لتتماهى فتفقد سمات العصر:صورة المجتمع المدني المزدهر! -وهذه في النهاية هي: عدن!
***
الوعي بالذات - مرة أخرى - هو الصفة الغالبة في شعر «عبدالرحمن السقاف» ويعتبر في المقام الأول من الأهمية لطبيعة رؤياه الإبداعية.. حيث يمكن للتأملات الذاتية أن تكون مصدراً للكثير من الحقائق العامة. وفي هذا أصل التجربة الإنسانية، وهي التي تبحث عن تفسير منهجي متكامل للحياة.
عبر هذا المنطلق نصل إلى الشاعر السقاف وهو يدلف إلى الألفية الثالثة لما كان من «عابري القرون» لنتوقف على أسلوبه المتجدد حيال حساسية اللغة في رحلته مع الشعر الصافي. ونقصد (بالصافي) كما قرّبه لنا الشاعر الفرنسي «بول فاليري» (1954-1871م) أكبر شعراء فرنسا في القرن العشرين، عملاً فنياً يكون صافياً خالياً من العناصر غير الشعرية.. على أني قد ذهبت به إلى شفافية الروح المتصوفة التي تبصر ما وراء الجسد من «رؤى» وكالمصير، لا تخالطها مادة الحياة، ولكن نقاء سرائر الإنسان في ملكوت الله الواسع المنزهة عن أعلاق الإنسان الفانية أو متعلقاته الأرضية.. وهو حين يتطلع من علٍ، إلى هذا الوجود الذي نعيش صراعاته وقد خلّفه الشاعر وراءه، بنظرة كلية. وخارج مدلولات اللغة التي نتعاطاها سواء في الحديث الدارج أم في التعبير الشعري.. فالشعر لصافي إنما هو عنصر شعري شديد الروعة!
والأساس في هذا، أننا نجد في أسلوبه المتأخر الكثير من الكناية والمجاز في نوع من الغنائية العالية مما ينبئ عن أن القالب الأساسي في كل علاقة تنشأ بينه وبين المحبوب أو الطبيعة أو الكون تتحول إلى داخله في سعيه لاكتشاف الذات في المحبوب.. ومنها تكون متعته المستمرة:
سألت النهر عنها
قال: رؤى
سألت جبال الهمّ عنها
قالت: رؤى
سألت البحر
نعم قال أيضاً رؤى
ولما ذهبت مع رفّة الريح
سمعت صداي يقول:
رؤى
يا رؤى
يا رو...
...
...
أين ترى يا قلب روح رؤى
(قصيدة: إليها)
ينادي ابنته «رؤى» التي دخلت في إحدى دورات الحياة فغيّبته وراءها - فيه خصام المحب مع الحبيب، وليست مما يتضمن تمرداً جسدياً، بل تمرداً ميتافيزيقياً عن الحالة الإنسانية.. لا شيء يريد بعد الآن غير ملامسة تلك الروح التي ألفها وضمها بين جناحيه، كأني به يقول في سره: أتألم عندما أنظر إليها أبحث فيها عن «رؤاي» التي لم يبق من الماضي فيها غير أطياف لعب وحب كأنما ستار من ضباب يلّفني في غلالاته الرقيقة وهي تمضي في سراديب «الحياة» الصغيرة التي تبعدني عما عشت ألقاه لديها من تعاطف. أستشعر أن غداً أو بعده سيفنى هذا الجسم ولن يبقى منه سوى شعلة صغيرة وهاجة تهتف:
رؤى
يارؤى
يارو..
غير أن «رؤى» السقاف تتسع للكون، فروحه هو في توقها وتحليقها النهائي تنزع إلى رؤية الحياة رؤية شعرية كاملة.. تشتعل بداخله رؤى تشمل جميع العلائق (ابنته - الإنسان - النهر - الجبل - البحر- الريح) وتُوّحدها بالكون. هذا هو نوع بحثه المستمر أو خصامه مع الدنيا خصام المحب، وهو ما يتحقق بالانفصال والاندماج في آن واحد معاً.. ولك أن تبحر في تلك النقاط (...)، حيث تسامى الصوت إلى صمت عميق، وهي التي يخلّفها الشاعر ويتركها معلّقة في صداه البعيد في المدى اللامتناهي.