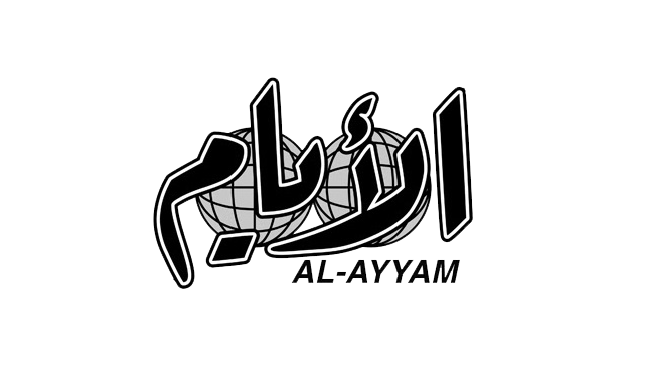> «الأيام» مازن سالم صالح:
النسيب فن عربي خالد يندرج تحت أغراض الشعر العربي المعروفة.. ويقال دائما للشعراء والمبدعين نبوءات خاصة تتعزز بالملكات الشعورية والرهافة الحسية والصيغ البيانية والصور الشعرية عند الشعراء منهم.. فتبين مؤداها بصدق وإحساس لاينقصه الانفعال ولايعوزه الاحتيال لبلوغ الكمال الفني والأدبي، وطبعا الكمال لله بدون أدنى شك.
ويقال إن أمير الشعراء العرب في كل العصور امرأ القيس الكندي أو ذا القروح كما يعرف أو الملك الضليل كما يلقب لما دنت منيته بأنطاكية وجد قبر امرأة عربية قد دفنت هناك فأنشد:
أجارتنا إن المزار قريب
وإني مقيم ما أقام عسيب
أجارتاه إني غريب ها هنا
وكل غريب للغريب نسيب
والنفس البشرية مجبولة على الحزن ومفطورة على الانفعال والتأثر، لكن لحظات السعادة قد تنسى أحيانا، بينما لحظات الشقاء والتعاسة لاتبارح الذاكرة، وأحيانا تستحضر للندب إلى الحزن في تجليات ترسم لحظات الرحيل أو اقتراب الأجل.. ولقد تميز شعراء العربية دون سواهم في هذا الباب، فأثروا الشعر العربي بروائع النسيب من قصائد خلدت في مختلف العصور.
بيد أن رثاء النفس قد تجلى في أبرع وأبدع صوره الشعرية وزخم تجلياته المرئية من المشهد الشعري في العصر الأموي الذي يطالعنا بقصيدة رائعة عدت من عيون الشعر العربي في غرض الرثاء عبر كل عصور الأدب العربي، وهي لمالك بن الريب المازني التميمي.. الذي خلد ببلاغته الفائقة في آن واحد سيرة معبرة عن حياة شاعرها.. أجمع المؤرخون على فرادتها وتميزها، من حيث دقة التصوير التعابير .. علاوة على المضمون الفني للقصيدة، والأدبي من حيث المكانة التاريخية، ولمنزلتها البلاغية التي تقدمت وقفزت بشاعرها عصرين إلى الأمام من عصور الأدب العربي المتسلسلة.. فأضحى بها في مرتبة متقدمة تبوأها بفضل هذه القصيدة، وهو التالي في الزمان بعصرين من حيث القياس التاريخي والأدبي وعلى طريقة «وإني وإن كنت الأخير زمانه...».
لكن فلسفة مالك بن الريب هنا فلسفة تختلف عن فلسفة أبي العلاء المعري من حيث الماديات والوجوديات والنهايات، فهي فلسفة سهلة تقريرية ومباشرة تتعجل الرحيل وتترقب النهاية في رقة روحية خالية من التأويلات العقدية كالتي عند أبي العلاء وغيره، وإن كان القاسم المشترك بينهما مشاهد القبور وحتمية الرحيل، لكن مالك بدلا من أن يجهد نفسه في العبث والحساب والعقاب كان لديه يقين جازم بتحقق هذه الحتمية بنسب مستوفاة.. فبدأ يرصد هذه النهاية عند هذه النقطة.. بل عند تلك اللحظة.. لحظة ما بعد الموت، على اعتبار أن حالة تحققه لديه يقينية، وأنه لا محالة مدركه وتحديدا من مشاهد القبر، ومن منلوج الحزن الوفير والعميم الذي ألفه وجسده وخاطب به رفيقه.. وإن كان الاعتقاد لدي شخصيا هنا وحتى في غير ذلك ورود الخطاب بصيغة المثنى عبر خطاب الاثنين ليس لوجودهما الفعلي ولحضورهما المادي، ولكن لأنه عرف شعري متداول تواضع عليه الشعراء العرب منذ القدم، ويكثر تبيانه عند امرئ القيس وطرفة بن العبد وغيرهما، ونراه عند مالك في نهايات حزينة.. يمكن لنا أن نرصدها ونلمس أثرها وصداها حتى في مواضع أخرى من القصيدة المرادة، وإن كانت فكرة الأبيات واحدة من حيث النص والمضمون باختلاف الشكل طبعا، وفيها يقول:
لقد لامني عند القبور على البكا
رفيقي لتذراف الدموع السوافك
فقالا: أتبكي على كل قبر رأيته
لقبر ثوى بين اللوى والدكادك
أمن أجل قبر في الملا أنت نائح
على كل قبر أو على كل هالك
فقلت له إن الشجى يبعث الشجى
فدعني فهذا كله قبر مالك
مهارة شعرية وبلاغية وسردية في رسم استباقية الموت بشجاعة محسودة وتكرار وثيق بيقين الرحيل كما أسلفنا من خلال مفردة القبر التي تكررت ست مرات في الأبيات الأربعة السابقة، وأضحت بمثابة الثيمة التي ارتكزت عليها بنية القصيدة أو مفتاح الدائرة الدلالية التي يمكن الولوج إليها من خلالها أو عبرها.. وإذا كانت مفردة القبر هي الصورة الظاهرة في لوحة مشهدية الموت عند مالك فإن الشجى هو الخلفية الأولى للوحة في هذه الأبيات والغضا هو الخلفية الثانية للوحة في القصيدة المرادة، فيما ظلت القبور المرئية المباشرة أو المرثية الأنيسة للوحة الكاملة بصورتها وظلها من المنظور الشعري والبصري في الحالتين معا لنفس القصيدة، على أنه يمكن التأكيد تاليا وثانية أن خطاب الاثنين يأتى مجاراة لعرف شعري متواضع كأسلوب فني وشعري متبع ومتدارج من خلال النظر للبيت الأخير، وصدره تحديدا في «فقلت له إن الشجى يبعث الشجى».. وفي صدر البيت الأول «فقالا...»، فثنى الفعل ثم رد كجواب على مخاطب واحد من مصدر واحد.. وإن كان ثنى في «فقالا...» على سبيل المعية ومجاراة للضرورة الشعرية، والحال يمكن تضمينه أو القياس عليه حتى في الحالة الثابتة في «أقول لأصحابي ارفعوني لأنني..» والخطاب هنا بصيغة الجمع، وعند «فيا صاحبا رحلي دنا الموت فانزلا..» بصيغة المثنى.
وبعيدا عن الرواية التاريخية للسيرة الحياتية للشاعر سنركز أو سنقصر تركيزنا هنا على الرواية الشعرية بجماليتها السردية وعوالمها الخيالية والحقيقية معا لمنطق الموت الذي فرضه بإرادته عبر استعجال الرحيل.. لكن القضاء ومشيئة الله سابقة في كل زمان ومكان طبعا.. والقصيدة معبرة عن حالة شعرية خاصة بغرائبية لها هواجسها الاستدلالية من المعطى الشعري فلسفيا وروحيا وأدبيا، مع استمرارها تاريخيا من مناسبة القصيدة وحدثها مع الرجوع إلى مآثر الوداع ومشاعر الاغتراب لألم الرحيل الفاجع عند مرو بخراسان في إيران، غريبا وحيدا عن الديار والأهل والسكن في المدينة المنورة، ومع مطلعها نورد هذه الأبيات التي فيها يقول:
ألا ليت شعري هل أبيت ليلة
بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه
وليت الغضا ماشى الركاب لياليا
لقد كان في أهل الغضا لو دنا القضا
مزار ولكن القضا ليس دانيا
لما تراءت عند مرو منيتي
وحل بها جسمي وحانت وفاتيا
أقول لأصحابي ارفعوني لأنني
يقر بعيني أن سهيلا بدا ليا
ولاتحسداني بارك الله فيكما
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا
والقصيدة طويلة وممتعة وجميلة إلا أنني آثرت التوقف عن هذا البيت عنوة، بعد أن ندب إلى رثاء نفسه ووصف ثم عدد مفاخره وبكى الديار بكاء حارا بأثيرية الغضا وحتمية القضاء أو الخلفية الأخرى كما أسلفنا، حتى ألفت نظركم إلى تودده وتعشمه من صاحبيه بمونولوج خطابي بترجيعه الاثنين كرسم جمالي لبهائية الموت ببياض صفحته هربا من ديالوج الحزن الذاتي لخطاب الواحد/ المفرد وقفزا عليه بسوداوية الحزن الفردي ووحشته القاتلة وغربته، فما بالك إذا كان بشمائل الرحيل في كنف الموت.. أعود وأقول مستدركا إن اليقين لديه بنسبه المستوفاة كما قلت.. جعل الرحيل لحظة خالدة بأبدية الموت إلى حين ساعة البعث يخلدها ويجسدها مالك برسم مشهدية القبر في حكائية نادرة وغرائبية طريفة.. وإلا لما تمادى بثبات عقدي لربما في أن يجعل وصيته الختامية من الدنيا لأصحابه أن يوسعا له حفرته أو قبره بعرض مأمول من باطن الأرض ذات العرض.. والسؤال هنا لماذا لم يقل ذات الطول؟
والجواب لايحتاج إلى فلكي طبعا.. ليس ذلك وحسب، ولكن أن يكون هذا الإيساع من غير حسد وبدعوة مباركة لهما منه خشية عليهما وترفقا منه بهما.. لا أسفا عليه أو إشفاقا لحاله، فهو فيها كما يقول بلسان الحال الشعري «مقيم لياليا...».
لعمري إنها مشاهد إبداع خالدة لفرائحية الموت بيقين شجاع لايمكن تصورها أو التنبؤ بها إلا من وحي هذه الصور الشعرية والفنية والأدبية والتاريخية التي أبدعها وأثراها مالك بن الريب وخلدها مجسدة بصورها المتعددة وغير المعتادة فغيرت النمطية السائدة عن الموت إبداعيا وأدبيا فقط، ولله في عباده وخلقه شؤون.
المراجع:
-1 تاريخ الأدب العربي/ العصر الأموي - د.شوقي ضيف.
-2 مجلة العربي العدد (588).
-3 مجلة الكويت العدد (252).
ويقال إن أمير الشعراء العرب في كل العصور امرأ القيس الكندي أو ذا القروح كما يعرف أو الملك الضليل كما يلقب لما دنت منيته بأنطاكية وجد قبر امرأة عربية قد دفنت هناك فأنشد:
أجارتنا إن المزار قريب
وإني مقيم ما أقام عسيب
أجارتاه إني غريب ها هنا
وكل غريب للغريب نسيب
والنفس البشرية مجبولة على الحزن ومفطورة على الانفعال والتأثر، لكن لحظات السعادة قد تنسى أحيانا، بينما لحظات الشقاء والتعاسة لاتبارح الذاكرة، وأحيانا تستحضر للندب إلى الحزن في تجليات ترسم لحظات الرحيل أو اقتراب الأجل.. ولقد تميز شعراء العربية دون سواهم في هذا الباب، فأثروا الشعر العربي بروائع النسيب من قصائد خلدت في مختلف العصور.
بيد أن رثاء النفس قد تجلى في أبرع وأبدع صوره الشعرية وزخم تجلياته المرئية من المشهد الشعري في العصر الأموي الذي يطالعنا بقصيدة رائعة عدت من عيون الشعر العربي في غرض الرثاء عبر كل عصور الأدب العربي، وهي لمالك بن الريب المازني التميمي.. الذي خلد ببلاغته الفائقة في آن واحد سيرة معبرة عن حياة شاعرها.. أجمع المؤرخون على فرادتها وتميزها، من حيث دقة التصوير التعابير .. علاوة على المضمون الفني للقصيدة، والأدبي من حيث المكانة التاريخية، ولمنزلتها البلاغية التي تقدمت وقفزت بشاعرها عصرين إلى الأمام من عصور الأدب العربي المتسلسلة.. فأضحى بها في مرتبة متقدمة تبوأها بفضل هذه القصيدة، وهو التالي في الزمان بعصرين من حيث القياس التاريخي والأدبي وعلى طريقة «وإني وإن كنت الأخير زمانه...».
لكن فلسفة مالك بن الريب هنا فلسفة تختلف عن فلسفة أبي العلاء المعري من حيث الماديات والوجوديات والنهايات، فهي فلسفة سهلة تقريرية ومباشرة تتعجل الرحيل وتترقب النهاية في رقة روحية خالية من التأويلات العقدية كالتي عند أبي العلاء وغيره، وإن كان القاسم المشترك بينهما مشاهد القبور وحتمية الرحيل، لكن مالك بدلا من أن يجهد نفسه في العبث والحساب والعقاب كان لديه يقين جازم بتحقق هذه الحتمية بنسب مستوفاة.. فبدأ يرصد هذه النهاية عند هذه النقطة.. بل عند تلك اللحظة.. لحظة ما بعد الموت، على اعتبار أن حالة تحققه لديه يقينية، وأنه لا محالة مدركه وتحديدا من مشاهد القبر، ومن منلوج الحزن الوفير والعميم الذي ألفه وجسده وخاطب به رفيقه.. وإن كان الاعتقاد لدي شخصيا هنا وحتى في غير ذلك ورود الخطاب بصيغة المثنى عبر خطاب الاثنين ليس لوجودهما الفعلي ولحضورهما المادي، ولكن لأنه عرف شعري متداول تواضع عليه الشعراء العرب منذ القدم، ويكثر تبيانه عند امرئ القيس وطرفة بن العبد وغيرهما، ونراه عند مالك في نهايات حزينة.. يمكن لنا أن نرصدها ونلمس أثرها وصداها حتى في مواضع أخرى من القصيدة المرادة، وإن كانت فكرة الأبيات واحدة من حيث النص والمضمون باختلاف الشكل طبعا، وفيها يقول:
لقد لامني عند القبور على البكا
رفيقي لتذراف الدموع السوافك
فقالا: أتبكي على كل قبر رأيته
لقبر ثوى بين اللوى والدكادك
أمن أجل قبر في الملا أنت نائح
على كل قبر أو على كل هالك
فقلت له إن الشجى يبعث الشجى
فدعني فهذا كله قبر مالك
مهارة شعرية وبلاغية وسردية في رسم استباقية الموت بشجاعة محسودة وتكرار وثيق بيقين الرحيل كما أسلفنا من خلال مفردة القبر التي تكررت ست مرات في الأبيات الأربعة السابقة، وأضحت بمثابة الثيمة التي ارتكزت عليها بنية القصيدة أو مفتاح الدائرة الدلالية التي يمكن الولوج إليها من خلالها أو عبرها.. وإذا كانت مفردة القبر هي الصورة الظاهرة في لوحة مشهدية الموت عند مالك فإن الشجى هو الخلفية الأولى للوحة في هذه الأبيات والغضا هو الخلفية الثانية للوحة في القصيدة المرادة، فيما ظلت القبور المرئية المباشرة أو المرثية الأنيسة للوحة الكاملة بصورتها وظلها من المنظور الشعري والبصري في الحالتين معا لنفس القصيدة، على أنه يمكن التأكيد تاليا وثانية أن خطاب الاثنين يأتى مجاراة لعرف شعري متواضع كأسلوب فني وشعري متبع ومتدارج من خلال النظر للبيت الأخير، وصدره تحديدا في «فقلت له إن الشجى يبعث الشجى».. وفي صدر البيت الأول «فقالا...»، فثنى الفعل ثم رد كجواب على مخاطب واحد من مصدر واحد.. وإن كان ثنى في «فقالا...» على سبيل المعية ومجاراة للضرورة الشعرية، والحال يمكن تضمينه أو القياس عليه حتى في الحالة الثابتة في «أقول لأصحابي ارفعوني لأنني..» والخطاب هنا بصيغة الجمع، وعند «فيا صاحبا رحلي دنا الموت فانزلا..» بصيغة المثنى.
وبعيدا عن الرواية التاريخية للسيرة الحياتية للشاعر سنركز أو سنقصر تركيزنا هنا على الرواية الشعرية بجماليتها السردية وعوالمها الخيالية والحقيقية معا لمنطق الموت الذي فرضه بإرادته عبر استعجال الرحيل.. لكن القضاء ومشيئة الله سابقة في كل زمان ومكان طبعا.. والقصيدة معبرة عن حالة شعرية خاصة بغرائبية لها هواجسها الاستدلالية من المعطى الشعري فلسفيا وروحيا وأدبيا، مع استمرارها تاريخيا من مناسبة القصيدة وحدثها مع الرجوع إلى مآثر الوداع ومشاعر الاغتراب لألم الرحيل الفاجع عند مرو بخراسان في إيران، غريبا وحيدا عن الديار والأهل والسكن في المدينة المنورة، ومع مطلعها نورد هذه الأبيات التي فيها يقول:
ألا ليت شعري هل أبيت ليلة
بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه
وليت الغضا ماشى الركاب لياليا
لقد كان في أهل الغضا لو دنا القضا
مزار ولكن القضا ليس دانيا
لما تراءت عند مرو منيتي
وحل بها جسمي وحانت وفاتيا
أقول لأصحابي ارفعوني لأنني
يقر بعيني أن سهيلا بدا ليا
ولاتحسداني بارك الله فيكما
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا
والقصيدة طويلة وممتعة وجميلة إلا أنني آثرت التوقف عن هذا البيت عنوة، بعد أن ندب إلى رثاء نفسه ووصف ثم عدد مفاخره وبكى الديار بكاء حارا بأثيرية الغضا وحتمية القضاء أو الخلفية الأخرى كما أسلفنا، حتى ألفت نظركم إلى تودده وتعشمه من صاحبيه بمونولوج خطابي بترجيعه الاثنين كرسم جمالي لبهائية الموت ببياض صفحته هربا من ديالوج الحزن الذاتي لخطاب الواحد/ المفرد وقفزا عليه بسوداوية الحزن الفردي ووحشته القاتلة وغربته، فما بالك إذا كان بشمائل الرحيل في كنف الموت.. أعود وأقول مستدركا إن اليقين لديه بنسبه المستوفاة كما قلت.. جعل الرحيل لحظة خالدة بأبدية الموت إلى حين ساعة البعث يخلدها ويجسدها مالك برسم مشهدية القبر في حكائية نادرة وغرائبية طريفة.. وإلا لما تمادى بثبات عقدي لربما في أن يجعل وصيته الختامية من الدنيا لأصحابه أن يوسعا له حفرته أو قبره بعرض مأمول من باطن الأرض ذات العرض.. والسؤال هنا لماذا لم يقل ذات الطول؟
والجواب لايحتاج إلى فلكي طبعا.. ليس ذلك وحسب، ولكن أن يكون هذا الإيساع من غير حسد وبدعوة مباركة لهما منه خشية عليهما وترفقا منه بهما.. لا أسفا عليه أو إشفاقا لحاله، فهو فيها كما يقول بلسان الحال الشعري «مقيم لياليا...».
لعمري إنها مشاهد إبداع خالدة لفرائحية الموت بيقين شجاع لايمكن تصورها أو التنبؤ بها إلا من وحي هذه الصور الشعرية والفنية والأدبية والتاريخية التي أبدعها وأثراها مالك بن الريب وخلدها مجسدة بصورها المتعددة وغير المعتادة فغيرت النمطية السائدة عن الموت إبداعيا وأدبيا فقط، ولله في عباده وخلقه شؤون.
المراجع:
-1 تاريخ الأدب العربي/ العصر الأموي - د.شوقي ضيف.
-2 مجلة العربي العدد (588).
-3 مجلة الكويت العدد (252).