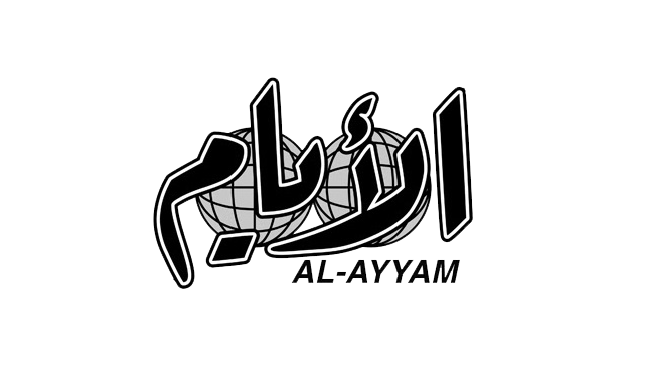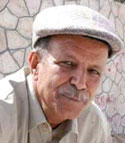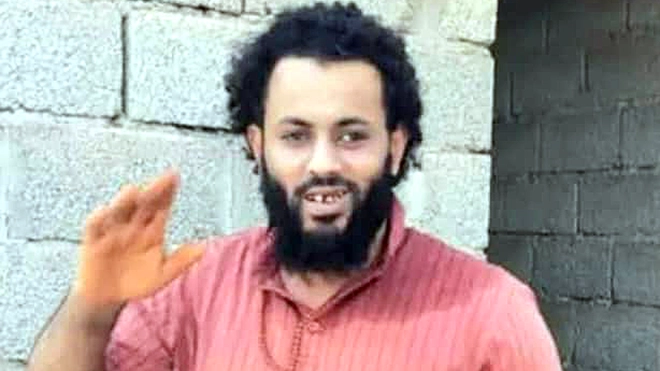> «الأيام» العرب اللندنية:
في خطوة مفاجئة ومبهمة المعالم، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف هجماتها في البحر الأحمر، في محاولة واضحة لخفض التصعيد في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأمن البحري العالمي. ورغم شحّ التفاصيل وتناقض التقارير حول طبيعة هذا الاتفاق وحدوده، فإن الإعلان وحده أحدث تحولات في قراءة المشهد اليمني والإقليمي، إذ رأى كثيرون فيه مقدمة محتملة لتصعيد بري قادم داخل الأراضي اليمنية، لاسيما بعد مؤشرات على تحركات عسكرية موازية واستعدادات من أطراف إقليمية للانخراط بشكل أوسع في الصراع.
ويأتي هذا التطور في وقت بالغ التعقيد، إذ تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليًا وخارجيًا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية في المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة داخل الإدارة، والانقسام الواضح بين جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات المرحلية، وآخر يميل إلى الحسم الميداني ومراكمة المكاسب بالقوة، يعكسان تخبطًا في تحديد الأهداف الحقيقية من هذه الصفقة. فبينما يروّج البعض لهذا الاتفاق على أنه خطوة نحو السلام، يرى مراقبون أنه لا يعدو كونه مناورة تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة من المواجهات.
ومنذ منتصف مارس، شنت الولايات المتحدة أكثر من ألف غارة جوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الراكب الخشن". ورغم أن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نتائج هذه الضربات، فإن منظمات مستقلة أكدت وقوع خسائر بشرية جسيمة.
وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 158 مدنيًا وإصابة 342 آخرين، إلى جانب سقوط أكثر من 68 مهاجرًا أفريقيًا في ضربة جوية على مركز احتجاز في صنعاء. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان صور الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن خلال سنوات الحرب السابقة، وتثير التساؤلات حول جدوى الخيار العسكري مجددا، في ظل واقع ميداني لم يتغير كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف.
ومن الناحية الاستراتيجية، لم تؤد الضربات الجوية إلى تراجع فعلي في قدرات الحوثيين، بل إن الجماعة نجحت مجددا في امتصاص الهجمات وإعادة تموضعها، كما حدث في السابق خلال حملة التحالف بقيادة السعودية، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر استهداف مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة الثامن والعشرين من أبريل عندما كادت حاملة الطائرات الأميركية “هاري إس ترومان” أن تتعرض لضربة مباشرة، وسقطت طائرة أف – 18 في البحر، ما زاد من مخاوف القيادة العسكرية الأميركية من انزلاق أكبر. كما فُقدت طائرة أخرى من الطراز ذاته في حادث لاحق لم تُعلن تفاصيله كاملة.
ومع استمرار هذه التطورات، بدأت أصوات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُحذر من مغبة التورط في جبهة معقدة وغير محسومة، تعيد إلى الأذهان عثرات التورط الأميركي الطويل في العراق وأفغانستان. وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا أن تنظر بعض الأطراف إلى الاتفاق البحري على أنه تكتيك مؤقت يهدف إلى تهدئة الجبهة البحرية التي استنزفت واشنطن ماديًا وعسكريًا، دون أن يُغلق الباب أمام التصعيد البري.
ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأميركية إن هناك مؤشرات على وجود خطة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستفيدة من الغطاء الجوي الأميركي. ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق البحري مجرد "وقف مؤقت" يُستخدم لإعادة الانتشار وإعادة تنظيم الجبهات، تمهيدا لجولة جديدة من المعارك.
ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحسم البري واقعيًا إذا ما قورن بالتجارب السابقة. فالحوثيون، بعد نحو عقد من الحرب، باتوا يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وقدرات عسكرية أكثر تنظيما مما كانت عليه في بدايات النزاع. كما أن طبيعة الجغرافيا في الشمال اليمني، حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، تمنحهم أفضلية في الدفاع، وقد أثبتوا مرارا قدرتهم على امتصاص الهجمات المباغتة وإعادة التموضع بسرعة. أضف إلى ذلك شبكة الدعم الإيراني غير المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقًا مستمرًا من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة.
لكن الأخطر من ذلك، أن أي تصعيد بري لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في ذروته، والعمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الجنوب اللبناني.
وفي هذا السياق، فإن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يُفسر على أنه جزء من استراتيجية إقليمية شاملة تستهدف الضغط على طهران، أو على العكس، قد يوفر لطهران ذريعة لتوسيع تدخلها في الجبهات المتعددة، ما يعقّد حسابات الجميع ويزيد من احتمالية انفجار إقليمي أوسع. ومن جانب آخر، فإن طبيعة الأطراف اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعدد ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث عن “هجوم بري حاسم” أقرب إلى التمنّي منه إلى الخطة الواقعية.
ورغم الاعتراف الدولي بها لا تملك القوات الحكومية اليمنية وحدها القوة الكافية لتحقيق اختراق ميداني حاسم، في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر. ووسط هذا المشهد، يزداد الشك في أن الاتفاق البحري قد يكون مجرد واجهة لتجميل خيار عسكري باهظ الثمن، لا على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على المستوى الإنساني.
وستعيد أي مواجهة برية خطر المجاعة إلى الواجهة، خصوصا مع هشاشة سلاسل الإمداد، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، بالتزامن مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه تعطيل مسارات الإغاثة الحيوية التي تصل إلى الملايين من اليمنيين.
والمفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، وهو المطلب الذي ربط به الحوثيون إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أوفوا بهذا التهديد فعليا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية في استثمار هذه المؤشرات لبدء عملية سلام شاملة في اليمن، لا تقتصر على الملف البحري، بل تشمل البُعد السياسي والاقتصادي والأمني للنزاع.
وفي هذا السياق، تبدو إدارة ترامب مطالبة بالإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: كيف سينتهي هذا المسار؟ فالاتفاقات المؤقتة التي تفتقر إلى رؤية سياسية متكاملة سرعان ما تتحول إلى وقود لجولات جديدة من العنف. وإذا ما قررت واشنطن مرة أخرى أن تعمّق انخراطها في صراع مفتوح دون هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار مأسوي لما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان.
ويقف اليمن اليوم على مفترق طرق حقيقي. فإما أن يُستثمر الاتفاق البحري الهش لبناء مسار سياسي شامل يراعي المصالح الوطنية اليمنية بعيدا عن رهانات الخارج، وإما أن يُستخدم كغطاء لتوسيع رقعة المواجهة، ما يُنذر بجولة جديدة من الصراع الذي قد يكون أكثر دموية وتدميرا من كل ما سبق. والخيار الأخير، في حال حدوثه، سيكون كارثة إنسانية جديدة سيدفع ثمنها الملايين من المدنيين.
ويأتي هذا التطور في وقت بالغ التعقيد، إذ تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليًا وخارجيًا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية في المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة داخل الإدارة، والانقسام الواضح بين جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات المرحلية، وآخر يميل إلى الحسم الميداني ومراكمة المكاسب بالقوة، يعكسان تخبطًا في تحديد الأهداف الحقيقية من هذه الصفقة. فبينما يروّج البعض لهذا الاتفاق على أنه خطوة نحو السلام، يرى مراقبون أنه لا يعدو كونه مناورة تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة من المواجهات.
ومنذ منتصف مارس، شنت الولايات المتحدة أكثر من ألف غارة جوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الراكب الخشن". ورغم أن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نتائج هذه الضربات، فإن منظمات مستقلة أكدت وقوع خسائر بشرية جسيمة.
وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 158 مدنيًا وإصابة 342 آخرين، إلى جانب سقوط أكثر من 68 مهاجرًا أفريقيًا في ضربة جوية على مركز احتجاز في صنعاء. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان صور الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن خلال سنوات الحرب السابقة، وتثير التساؤلات حول جدوى الخيار العسكري مجددا، في ظل واقع ميداني لم يتغير كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف.
ومن الناحية الاستراتيجية، لم تؤد الضربات الجوية إلى تراجع فعلي في قدرات الحوثيين، بل إن الجماعة نجحت مجددا في امتصاص الهجمات وإعادة تموضعها، كما حدث في السابق خلال حملة التحالف بقيادة السعودية، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر استهداف مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة الثامن والعشرين من أبريل عندما كادت حاملة الطائرات الأميركية “هاري إس ترومان” أن تتعرض لضربة مباشرة، وسقطت طائرة أف – 18 في البحر، ما زاد من مخاوف القيادة العسكرية الأميركية من انزلاق أكبر. كما فُقدت طائرة أخرى من الطراز ذاته في حادث لاحق لم تُعلن تفاصيله كاملة.
ومع استمرار هذه التطورات، بدأت أصوات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُحذر من مغبة التورط في جبهة معقدة وغير محسومة، تعيد إلى الأذهان عثرات التورط الأميركي الطويل في العراق وأفغانستان. وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا أن تنظر بعض الأطراف إلى الاتفاق البحري على أنه تكتيك مؤقت يهدف إلى تهدئة الجبهة البحرية التي استنزفت واشنطن ماديًا وعسكريًا، دون أن يُغلق الباب أمام التصعيد البري.
ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأميركية إن هناك مؤشرات على وجود خطة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستفيدة من الغطاء الجوي الأميركي. ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق البحري مجرد "وقف مؤقت" يُستخدم لإعادة الانتشار وإعادة تنظيم الجبهات، تمهيدا لجولة جديدة من المعارك.
ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحسم البري واقعيًا إذا ما قورن بالتجارب السابقة. فالحوثيون، بعد نحو عقد من الحرب، باتوا يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وقدرات عسكرية أكثر تنظيما مما كانت عليه في بدايات النزاع. كما أن طبيعة الجغرافيا في الشمال اليمني، حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، تمنحهم أفضلية في الدفاع، وقد أثبتوا مرارا قدرتهم على امتصاص الهجمات المباغتة وإعادة التموضع بسرعة. أضف إلى ذلك شبكة الدعم الإيراني غير المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقًا مستمرًا من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة.
لكن الأخطر من ذلك، أن أي تصعيد بري لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في ذروته، والعمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الجنوب اللبناني.
وفي هذا السياق، فإن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يُفسر على أنه جزء من استراتيجية إقليمية شاملة تستهدف الضغط على طهران، أو على العكس، قد يوفر لطهران ذريعة لتوسيع تدخلها في الجبهات المتعددة، ما يعقّد حسابات الجميع ويزيد من احتمالية انفجار إقليمي أوسع. ومن جانب آخر، فإن طبيعة الأطراف اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعدد ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث عن “هجوم بري حاسم” أقرب إلى التمنّي منه إلى الخطة الواقعية.
ورغم الاعتراف الدولي بها لا تملك القوات الحكومية اليمنية وحدها القوة الكافية لتحقيق اختراق ميداني حاسم، في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر. ووسط هذا المشهد، يزداد الشك في أن الاتفاق البحري قد يكون مجرد واجهة لتجميل خيار عسكري باهظ الثمن، لا على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على المستوى الإنساني.
وستعيد أي مواجهة برية خطر المجاعة إلى الواجهة، خصوصا مع هشاشة سلاسل الإمداد، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، بالتزامن مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه تعطيل مسارات الإغاثة الحيوية التي تصل إلى الملايين من اليمنيين.
والمفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، وهو المطلب الذي ربط به الحوثيون إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أوفوا بهذا التهديد فعليا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية في استثمار هذه المؤشرات لبدء عملية سلام شاملة في اليمن، لا تقتصر على الملف البحري، بل تشمل البُعد السياسي والاقتصادي والأمني للنزاع.
وفي هذا السياق، تبدو إدارة ترامب مطالبة بالإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: كيف سينتهي هذا المسار؟ فالاتفاقات المؤقتة التي تفتقر إلى رؤية سياسية متكاملة سرعان ما تتحول إلى وقود لجولات جديدة من العنف. وإذا ما قررت واشنطن مرة أخرى أن تعمّق انخراطها في صراع مفتوح دون هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار مأسوي لما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان.
ويقف اليمن اليوم على مفترق طرق حقيقي. فإما أن يُستثمر الاتفاق البحري الهش لبناء مسار سياسي شامل يراعي المصالح الوطنية اليمنية بعيدا عن رهانات الخارج، وإما أن يُستخدم كغطاء لتوسيع رقعة المواجهة، ما يُنذر بجولة جديدة من الصراع الذي قد يكون أكثر دموية وتدميرا من كل ما سبق. والخيار الأخير، في حال حدوثه، سيكون كارثة إنسانية جديدة سيدفع ثمنها الملايين من المدنيين.