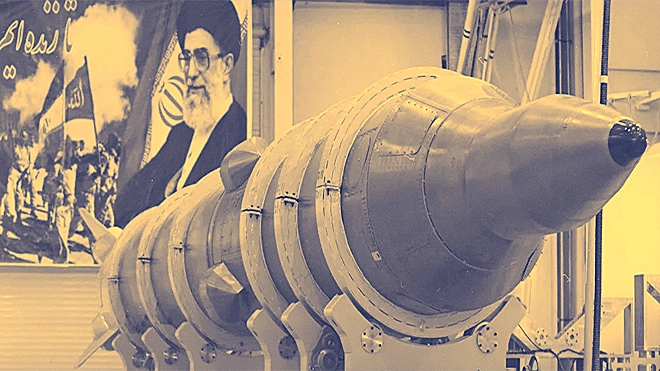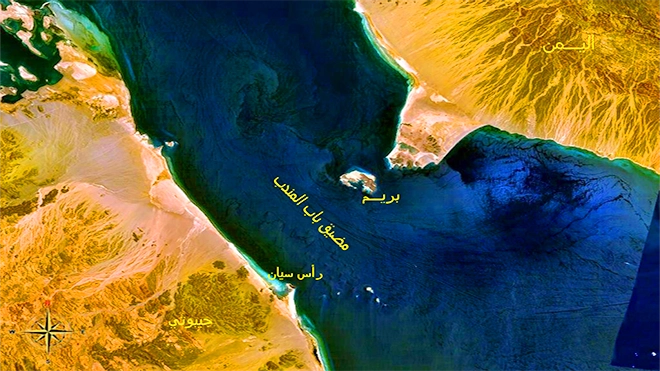> عوض بامدهف
عادة اتخذتها منذ أمد طويل، تجسدت في أن أقف أمام شاطئ البحر عند اللحظة الفارقة بين نهاية ووداع عام انصرم واستهلالة عام جديد مقبل.
وفي هذه اللحظة الفارقة أحاول جاهدا استغلالها على أحسن وجه، حيث أقضيها وأنا أتأمل كل شيء من حولي، وأعيد قراءة محتوى دفتي دفتر عام مضى.. بكل ما حفل به من أحداث ووقائع وتقلبات ونجاحات وإخفاقات.
ولأقف متأملا أوراق وصفحات دفتر عام جديد ما زالت ناصعة البياض لم تسود بعد بالأحداث المتباينة، وكذا البقع الملونة تراودني آمال وطموحات، بل ورجاءات في أن يكون القادم والآتي أفضل وأجمل.
لا أتذكر ما هي الأسباب الدافعة للقيام بهذا الفعل الغريب؟ ولا متى كانت البداية في التعامل مع هذه العادة العجيبة؟.
المهم في الأمر أني وجدت نفسي أسيرا طواعية لهذه العادة العجيبة، والمتكررة مع كل دور للأيام والزمن.. ربما يرجع الأمر ـ وهذا مجرد اجتهاد ذاتي ليس إلا ـ إلى تلك الصلة الوثيقة بين حركة الأمواج البادئة المنتهية والرائحة الغادية في إيقاع سرمدي منتظم بديع، وكذا حركة المد والجزر ذات الشكل الانسيابي التلقائي من ناحية، وتعاقب السنين وكر الأعوام بتواصل أزلي دائم من ناحية أخرى (ربما).
ما الفارق الفاصل بين مساحة العامين الرقمية وبلغة الأرقام والأعداد شديدة التعقيد لا يتعدى بأي حال من الأحوال 12 شهراً أو 365 يوما في السنة البسيطة أو 366 يوما في السنة الكبيسة.
ولأني لا أجيد التعامل مع الأرقام والتخاطب بلغتها المعقدة والمقيتة في مثل هذه المواقف.. إذا سأحاول جاهدا تقديم إجابتي الخاصة.
ولم أكد أنتهي من ترديد هذه العبارة في إطار حواري مع الذات حتى كانت قدمي قد وصلت بي إلى القرب من جسر صيرة فاتكأت على حاجزه الخشبي العتيق الذي تآكلت أجزاء كثيرة منه بفعل عوامل التعرية من أمواج البحر وحرارة الشمس وعبث الإنسان.
وواصلت عندها حواري الهامس والخافت.. كم يساوي العام في حياة الإنسان؟ فسحة عابرة تقصر بمقدار لحظات السعادة.
الأمر سيان فهي لا شك في ذلك ماضية في طريقها المرسوم له وبلا توقف أو انتظار أو نتائج.
ولحظتها.. أحسست بحركة يد تهزني وبشدة وإلحاح وإصرار.. وتخرجني وتنزعني من عالمي الخاص.. وكانت تلك هي يد صديقي.
التفت نحوه.. (أهلا).. قلتها بسرعة محاولا العودة إلى ما كنت فيه، ولكن صديقي لم يدع لي الفرصة لأحقق هذه الأمنية.
حيث شد على يدي بحرارة واضحة قائلا: “فينك يا صاحبي؟”.
أجبته بفتور شديد “في الدنيا يا عزيز”.
وبحركة سريعة وجدت نفسي مرغما وعلى غير إرادة مني أن أحتل المقعد المجاور له في سيارته الفارهة التي انطلقت بنا تسابق الريح، وتنهب الطريق نهبا، وبسبب تلك السرعة المجنونة المنفلتة، ورعونة السائق وكبرياء وتمرد السيارة الفارهة كدنا نقع في براثن حوادث جمة.. ورغم هذا كله ظلت السيارة المجنونة وسائقها الطائش تمضي بنا فرحة مختالة.
وفجأة أوقف صديقي سيارته الطائشة، والتفت ناحيتي، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة زهو وانتصار قائلا بنبرة مرحة: “لقد بلغنا المقصد، تفضل يا عزيزي بالنزول”، قالها صديقي وكان الأسبق بالنزول من السيارة.
ودلفنا إلى بهو الملهى الليلي الذي ارتدى أبهى حلة وتلألأت الأضواء في واجهته، وحيث يقامر السامر في صحنه الدائري البديع، وقد تشكلت الأضواء بألوان قوس قزح.. فيما الأصوات الصاخبة تملأ المكان حيث السيادة المطلقة هنا للضجيج والفوضى والدخان الخافت الملون يعلو ويتصاعد في أجواء ذلك الصحن الدائري الرحيب، ودورة الكؤوس قد أطاحت بالألعاب، واختلط الحابل بالنابل في لوحة قاتمة الألوان.
لا.. لا.. ليس هذا مكاني، وما هكذا يكون الاحتفال بهذه اللحظة الفارقة.. ردتتها وأنا أتخذ وضع الانصراف، وبالخطوة السريعة، ولم أتوقف في السير الحثيث حتى حققت العودة الموفقة إلى نقطة ومحطة بدايتي المتجددة عند جسر صيرة، وبرفقة ممتعة وبهيجة في رحاب البحر والأمواج والنسيم العليل، واسترجاع شريط الذكريات المرة والحلوة.. (والعود أحمد)، كما يقولون.
وفي هذه اللحظة الفارقة أحاول جاهدا استغلالها على أحسن وجه، حيث أقضيها وأنا أتأمل كل شيء من حولي، وأعيد قراءة محتوى دفتي دفتر عام مضى.. بكل ما حفل به من أحداث ووقائع وتقلبات ونجاحات وإخفاقات.
ولأقف متأملا أوراق وصفحات دفتر عام جديد ما زالت ناصعة البياض لم تسود بعد بالأحداث المتباينة، وكذا البقع الملونة تراودني آمال وطموحات، بل ورجاءات في أن يكون القادم والآتي أفضل وأجمل.
لا أتذكر ما هي الأسباب الدافعة للقيام بهذا الفعل الغريب؟ ولا متى كانت البداية في التعامل مع هذه العادة العجيبة؟.
المهم في الأمر أني وجدت نفسي أسيرا طواعية لهذه العادة العجيبة، والمتكررة مع كل دور للأيام والزمن.. ربما يرجع الأمر ـ وهذا مجرد اجتهاد ذاتي ليس إلا ـ إلى تلك الصلة الوثيقة بين حركة الأمواج البادئة المنتهية والرائحة الغادية في إيقاع سرمدي منتظم بديع، وكذا حركة المد والجزر ذات الشكل الانسيابي التلقائي من ناحية، وتعاقب السنين وكر الأعوام بتواصل أزلي دائم من ناحية أخرى (ربما).
ما الفارق الفاصل بين مساحة العامين الرقمية وبلغة الأرقام والأعداد شديدة التعقيد لا يتعدى بأي حال من الأحوال 12 شهراً أو 365 يوما في السنة البسيطة أو 366 يوما في السنة الكبيسة.
ولأني لا أجيد التعامل مع الأرقام والتخاطب بلغتها المعقدة والمقيتة في مثل هذه المواقف.. إذا سأحاول جاهدا تقديم إجابتي الخاصة.
ولم أكد أنتهي من ترديد هذه العبارة في إطار حواري مع الذات حتى كانت قدمي قد وصلت بي إلى القرب من جسر صيرة فاتكأت على حاجزه الخشبي العتيق الذي تآكلت أجزاء كثيرة منه بفعل عوامل التعرية من أمواج البحر وحرارة الشمس وعبث الإنسان.
وواصلت عندها حواري الهامس والخافت.. كم يساوي العام في حياة الإنسان؟ فسحة عابرة تقصر بمقدار لحظات السعادة.
الأمر سيان فهي لا شك في ذلك ماضية في طريقها المرسوم له وبلا توقف أو انتظار أو نتائج.
ولحظتها.. أحسست بحركة يد تهزني وبشدة وإلحاح وإصرار.. وتخرجني وتنزعني من عالمي الخاص.. وكانت تلك هي يد صديقي.
التفت نحوه.. (أهلا).. قلتها بسرعة محاولا العودة إلى ما كنت فيه، ولكن صديقي لم يدع لي الفرصة لأحقق هذه الأمنية.
حيث شد على يدي بحرارة واضحة قائلا: “فينك يا صاحبي؟”.
أجبته بفتور شديد “في الدنيا يا عزيز”.
وبحركة سريعة وجدت نفسي مرغما وعلى غير إرادة مني أن أحتل المقعد المجاور له في سيارته الفارهة التي انطلقت بنا تسابق الريح، وتنهب الطريق نهبا، وبسبب تلك السرعة المجنونة المنفلتة، ورعونة السائق وكبرياء وتمرد السيارة الفارهة كدنا نقع في براثن حوادث جمة.. ورغم هذا كله ظلت السيارة المجنونة وسائقها الطائش تمضي بنا فرحة مختالة.
وفجأة أوقف صديقي سيارته الطائشة، والتفت ناحيتي، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة زهو وانتصار قائلا بنبرة مرحة: “لقد بلغنا المقصد، تفضل يا عزيزي بالنزول”، قالها صديقي وكان الأسبق بالنزول من السيارة.
ودلفنا إلى بهو الملهى الليلي الذي ارتدى أبهى حلة وتلألأت الأضواء في واجهته، وحيث يقامر السامر في صحنه الدائري البديع، وقد تشكلت الأضواء بألوان قوس قزح.. فيما الأصوات الصاخبة تملأ المكان حيث السيادة المطلقة هنا للضجيج والفوضى والدخان الخافت الملون يعلو ويتصاعد في أجواء ذلك الصحن الدائري الرحيب، ودورة الكؤوس قد أطاحت بالألعاب، واختلط الحابل بالنابل في لوحة قاتمة الألوان.
لا.. لا.. ليس هذا مكاني، وما هكذا يكون الاحتفال بهذه اللحظة الفارقة.. ردتتها وأنا أتخذ وضع الانصراف، وبالخطوة السريعة، ولم أتوقف في السير الحثيث حتى حققت العودة الموفقة إلى نقطة ومحطة بدايتي المتجددة عند جسر صيرة، وبرفقة ممتعة وبهيجة في رحاب البحر والأمواج والنسيم العليل، واسترجاع شريط الذكريات المرة والحلوة.. (والعود أحمد)، كما يقولون.