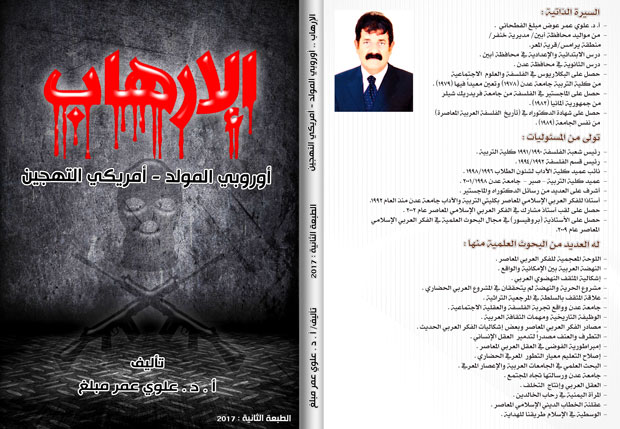> أ. د. علوي عمر مبلغ*
ومرة أخرى نقول إن المصالح السياسية الماثلة شيء، وإن
التناقضات العقائدية والثقافية شيء آخر، ولا ننصح العرب إلاَّ بأن يكونوا
سياسيين حينما يأتي وقت السياسة والمصالح الراهنة، وأن يكونوا أصحاب حضارة
وثقافة أخرى، حينما يجيء وقت الثقافة والحضارة. والغرب مع ضرورة مراعاة
مصالحه الآنية أو الراهنة لن يفرط أبدًا في أي شيء مما تحققت له من
الانتصارات، وسيظل يرى منذ الآن أن حضارته هي الحضارة السيدة المتفوقة وأن
الحضارات المتناقضة معها، وعلى وجه الخصوص الحضارة العربية الإسلامية هي
المعنية والمقصودة بعدم انسجامها ومخالفتها للقيم الغربية. إن هذه الحضارة
أي حضارتنا من وجهة النظر الغربية لن تكون سوى حضارات همجية إرهابية
ومتخلفة.
وفي ظل هذه الصورة لعلاقة الغرب بالإسلام أو أكثر تحديدًا الغرب بالعرب يمكننا أن نسجل تصورًا بسيطًا لمستقبل ما للثقافة العربية.
أولاً: لا شك أن التطورات والأحداث والهزات التي شهدها العالم منذ منتصف الثمانينات، قد تركت تأثيراتها على العالم العربي من حيث الانقلاب الذي أحدثته في فرضياته ومسلماته القومية والسياسية وتحالفاته الاستراتيجية وسايكلوجيته.
ثانيًا: يصعب عزل الثقافة عن واقعها الاجتماعي والسياسي، ولهذا فالثقافة العربية في حاجة عاجلة إلى إرساء أولويات وأهداف قومية وسياسية واجتماعية واقتصادية جديدة.
ثالثًا: لن تحظى الثقافة العربية عمومًا بالمكانة الدولية التي تستحقها إلاَّ إذا استردت الشخصية العربية إحساسها بالكرامة والثقة بالنفس ثم ازداد تعميق تشبثها بحضارتها وتاريخها.
رابعًا: الانعزال أو الانكفاء على الذات وليس هو الحل، أو ليس هو الموقف المطلوب في مواجهة التحدي المتعدد الجوانب الذي يواجهه العالم العربي، ومن الضروري إزجاء مزيد من التشجيع على العودة إلى جذور الحضارة العربية والإسلامية وتاريخها لاستلهام روح انطلاقة جديدة، مع الأخذ بالمناخ المباح والمتاح مما أنجزه الغرب نفسه من مناهج ووسائل وأفكار في ضوء خصوصيات مجتمعنا العربي المحلية.
خامسًا: إن على منابر الفكر والثقافة في العالم العربي دورًا كبيرًا في الأخذ بزمام المبادرة على صعيد مقاومة نزعة الاستسلام السياسي الغبي لكل ما هو مستورد من قوى النفوذ الجديدة في العالم، فحالة الصدمة العربية، الهزائم والاضطهادات، كانت إلى وقت ليست ببعيد ما تنفك تفرز شعورًا عميقًا بالشك في مصداقية كل ما هو عربي الهوية والانتماء، بما في ذلك القيم الإنسانية والروحية التي يبشر بها الإبداع الثقافي في جميع مناحيه، فمن مهمته تلك المنابر أن تسهم في إذكاء الروح الجديدة التي ترمي إلى استلهام “المحلي” والثقة به، ومن مهمتها أيضًا أن تبسط حقيقة العلاقة الحضارية مع الغرب ومع قوى النفوذ الأخرى.
سادسًا: نحن لا نصادر الآخر ولا ننكر أهمية الالتقاء به، سياسيًا ضمن ما تمليه مصالحنا، وثقافيًا ضمن ما تقتضيه ضرورات الحوار وشرعية الاقتباس وتلامح التجارب، ومراجعات الإنجاز، ولكن هذا المفهوم للعلاقة المتوخاة بالغرب، لا يمكن أن يحجب الحجم الصارخ لحضوره والقوي بيننا، ومثوله الشديد في هاجس تفكيرنا، ورسوخه المتمكن في مناهجنا، فلا بد أن نتفق على أن حضارتنا العربية المعاصرة – لا سيما في وجهها المادي – هي في التقويم النهائي – حضارة مغلوبة، وبالتالي مقلدة وتابعة ومستهلكة (بكسر اللام) وفضلاً عن هذا المنظور الموجع لحقيقة الوجه المادي لحضارتنا المعاصرة فإن الخطر لا يقف عند حدود الإنجاز التكنولوجي في مجالاته المختلفة، بل يمتد إلى أدوات تشكيل الوعي العلمي والمعرفي والإبداعي. وهذا هو الأهم، فالثورة الكبيرة التي تحققت في مجال نقل المعلومات، والتسهيلات العجيبة التي حدثت وتحدث في ميادين الاتصال، عملت كلها على تكريس تبعية منطقتنا وعلى تعزيز شهوات الاستهلاك فيها، إضافة إلى ذلك فإن انتصار الأيديولوجية الغربية مؤخرًا قد يعود فيخدعنا ومعنا كل الشعوب الضعيفة الأخرى فيزيد فينا الانبهار بالآخر أي “المعجزة” ومهما كان حجم الالتفاف إلى المحلي والثقة به، إلاَّ أن حجم الهجوم يُعد أكبر مما نتصور. إننا هنا نلح على الإمعان في تعزيز كل الإمكانات المحافظة على المقومات الذاتية وحمايتها من أي ضعف طارئ أو ذوبان في مغريات أطروحات الآخر، ولكن دعوة لهذه تظل في مؤداها الأخير صيغة فضفاضة لا تجد في المناهج العربية القائمة ما يمكن أن يحولها فعلاً – إلى برامج طموحة – تستطيع أن تقحم تلك المقومات الذاتية إلى واجهة الفعل بما يتلاءم مع منطق العصر ولغته ومفاهيمه، فالحق إن هناك عددًا من العوامل التي تعرقل النية في وضع أمثال تلك البرامج الطموحة، أو هي تفسد التفكير فيها من الأساس، وليس أول تلك العوامل الضعف العام الذي يهيمن على الواقع العربي ككل، وليس أخرها بهوت العقلية العربية نفسها، ووهنها وافتقادها إلى المنهجية العلمية وشجاعة التحليل والتجرد من العواطف السمحة.
سابعًا: إن الإنجاز التكنولوجي الغربي ليس له أن يكون إنجازًا محايدًا، على الرغم مما قد يبدو عليه مما هو خلاف لذلك. إن ذلك الإنجاز واقعيًا، سيظل يحمل تحت معطفه شيئًا من أيديولوجيات الآخر وطريقة تفكيره ومفاهيمه وأسلوبه في المعيش وفهمه الحياة وموقفه منها، وفي الإنجاز التكنولوجي الغربي تعزيز لحضوره وتأكيد لقوته، وأمام هذا النوع من السيادة لا بد من العمل منذ الآن على خلق أجيال تستطيع أن تستوعب حركة الإنجازات العلمية كي تتجاوز هذه الأمة على المدى البعيد عن مستوى الاستهلاك إلى مستوى الخلق والإبداع، وهذا يتطلب مراجعة شاملة وصميمية لكل مناهج التعليم لتتواءم مع حاجات التقدم والقوة والمنافسة والانعتاق من ظروف الاتكال على الغير والإذعان والاستكانة.
لقد عبرَّ الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والبالغ من العمر 78 عامًا قائلاً: “ثمة شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متعجرفة ومتسلطة ومنطوية على نفسها إلى حدٍ بعيد، وبأننا فخورون بثرواتنا، مؤمنون بأننا نستحق أن نكون الأمة الأكثر غنى وقوة ونفوذًا في العالم، واعتقد أنهم يشعرون بأننا لا نلتزم لهم كثيرًا، وهذا صحيح غالبًا”.
ومع ذلك فإن اتجاهات العولمة، وبخاصة الأمريكية، تسير في طريقين متعاكسين، فهي من جهة شديدة الاعتزاز بهويتها والحرص عليها، ومن جهة أخرى ترفض الاعتراف بالهويات الوطنية للشعوب الأخرى.
ومهما يكن الأمر، فإن التحديث والنمو اللذين تشهدهما العولمة الأمريكية لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافي في المجتمعات غير الغربية، بل يؤديان إلى المزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب، التي تستطيع إيجاد تيار ثقافي مضاد يقف في مواجهة روح الهيمنة – التي تنطوي عليها هذه العولمة، فكرة ونطاقًا وتطبيعًا وممارسة – وفي التعامل مع الآثار المترتبة عليها.
لقد أضحى الحق في التنوع الثقافي والاندماج مع ثقافات الشعوب الأخرى اليوم قاعدة من قواعد القانون الدولي، وذلك استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقات التي تحكم علاقات التعاون الثقافي بين المجموعة الدولية، وفي كفالة هذا الحق من حقوق الإنسان، وتأكيدًا على الخصوصية الثقافية فقد جاء في المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي:
أ- “لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامها والمحافظة عليها.
ب- من حق كل شعب، ومن واجبه أن ينمي ثقافته.
ج- تشكل جميع الثقافات بما فيها من تنوع خصب، وبما بينها من تباين وتأثير متبادل جزءًا من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعًا”.
كما أنه من المعلوم أن الأمم والشعوب التي تمتلك مكونات حقيقية لهويتها الوطنية وثقافتها القومية، ترفض التبعية والذوبان في ثقافات غيرها، وتفشل كل مخطط لإفنائها، ولا تقبل بأن تفرِّط في ذاتيتها. وتحرص على أن تحافظ على وجودها، ولما كانت العولمة هي ظاهرة العصر وسمته، وأن الوقوف في وجهها أو محاولة تجنبها أو العزلة عنها، إنما هو خروج على العصر وتخلف وراءه، فعلينا الإقبال على دراسة عناصر هذه العولمة، وفهم مكوناتها، والتنبه لاتجاهاتها، ثم التعامل معها من موقع الثقة بالنفس، والإدراك العميق لخصائص ثقافتنا، واستخراج كوامنها الأصلية، وتفعيلها مع تلك الثقافة العالمية الوافدة، أخذًا وعطاء، مع امتلاكنا القدرة على الإسهام والمشاركة.
ومع علمنا أن هذا المجال لا يتسع للحديث عن العولمة وإشكالياتها، فإن مثل هذا الموضوع سبق لصاحب هذا الكتاب نشر بحث كامل حوله في وقت سابق، ونحن هنا نتقيد بعنوان الموضوع والمتعلق بطابع الهوية العربية الإسلامية ووصفها بالإرهاب من الآخر.
الخطاب الديني – والإرهاب
يشهد الفكر العربي الإسلامي تحولاَّت مهمة، رغم التفاوت في درجاتها ودوائرها ومداها الزمني وطبيعة البُنى الجدلية التي أفرزتها، ورغم التيارات السكونية التي ظلت تستعصي على الحل وتعد مظاهره لونًا من الردّة والانحراف، وهي تيارات لا يستهان بشأنها ونفوذها والمساحات التي تغطيها إلى درجة ربما يغيب خلالها اثر التطورات تلك، وتكتسب من وجهة نظر بعضهم طابعًا شكليًا لا يلج إلى بنية الخطاب أو استراتيجيته، “فمنذ لحظة التكوين الأولى لهذا الفكر، راحت تطرح الأسئلة الكلامية والفلسفية لتتبلور في عصر الترجمة والانفتاح على الميراث الإنساني وازدهار الفلسفة وعلوم الشريعة واللغة والعلوم الطبيعية وغيرها. وفي ظل سياق الترَّدي الاجتماعي دخل الفكر حقبة الغزالي، وارتبك الموقف من المعرفة كما تجلى في “تهافت الفلاسفة” وراج لون طافح من التصوف فانحسرت الرؤية العقلانية، وبخاصة مع صعود تيار المدرسة النصية”.
إننا بحاجة ملحة وماسة إلى خطاب نقدي عربي جديد، وقبل الشروع في تحديد معالم المشروع النقدي الجديد، يحدد بنا الانتباه إلى جملة من الوقائع التي أصبحت بمنزلة المسلَّمات التي يجب أخذها بعين الحسبان في عملية التأسيس الجديدة ونذكر منها على سبيل المثال:
الأولى: أن الثقافة الغربية الحديثة التي هي في حقيقتها، ثمرة ثقافات وطنية متعددة، شرقية وغربية، أصبحت ثقافة عالمية لا يمكن تجاهلها أو العيش خارجها، وهي ثقافة يمكن وصفها بثقافة “القوة والاقتدار” وهذا يعني أن لا مهرب لنا، كما أن لا مهرب لغيرنا من شعوب وثقافات أخرى، من الانفتاح على هذه الثقافة الحديثة والتفاعل معها، وألا حكمنا نحن وغيرنا على أنفسنا بالانعزال والموت المحتم.
الثانية: أن علاقات الغرب الأوربي بالمشرق العربي بصرف النظر عن أشكالها وأدوارها وتطوراتها – أصبحت علاقات تاريخية لا انفكاك لها بين عالمين متجاورين على الرغم من فترات التوتر التي رافقتها والمآسي الكبيرة التي تمخضت عنها، وقد كانت على الدوام في صالح الإنسانية العام – نظرًا للنتائج الإيجابية التي حملتها في شتى العلوم والمعارف والفنون، والتي رفعت بالإنسانية أشواطًا كبيرة في سبيل الرُقي والتقدم.
الثالثة: أن التمسك بعنجهية بالأصالة والتراث، وأمجاد الماضي التليد والسلف الصالح، دون نظر نقدي جدي إلى التراث الديني والفكري والسياسي، لا يفيدنا شيئًا كما لا يغير الغرب في المقابل، مهما بلغ من قوة واقتدار، النظر إلينا تارةً كإرهابيين يهددون السلام العالمي، وطورًا كأصحاب ثروات كبيرة نبددها في غير الصالح الإنساني العام، فالعالم يجب أن يتسع لجميع ساكنيه وليس لأحد أن يدَّعي وحدة الحق في تقرير ما هو أصلح للإنسانية.
الرابعة: أن الأصولية الدينية الجذرية التي تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى حركات سياسية كبرى على امتداد العالمين العربي والإسلامي في المنطقة الأفرو – آسيوية لن تكون في المدى البعيد، على الرغم من الانتصارات الكبرى التي حققتها ضد الهجمة الغربية الشرسة، الرد الحاسم على هذه الهجمة وإن بدأ للبعض أن الدين هو القاعدة الأساسية لتحصين الذات وحمايتها من الآخر.
والآن كيف السبيل إلى الخروج من التبعية إلى الاستقلال، وما هي شروط الخطاب النقدي الجديد الذي نحتاجه في مرحلة الانتقال هذه، وما دور المثقفين الحقيقيين في هذه المرحلة بالذات؟.
ترى د/ فهمية شرف الدين: “ان النظر في سمات هذا العصر لا بد أن يتم من زاويتين: الأولى: هي العولمة حيث نبني في أفقها ومعها مجموعة من المعايير والقيم وأنماط السلوك الثقافية التي تشكل الإطار الفعلي للرؤى الجديدة للعالم. والثانية: هي الخصوصية حيث نبني في أفقها ومعها مواقف الدفاع عن الذات والرفض، مع كل ما تحمله هذه المواقف من إشكاليات تتعلق بتحديد أوليات الدفاع وأشكالها وتحديد مساحات الرفض وكيفيات صياغة الأهداف”.
وتنتهي “إلى دعوة المفكرين العرب إلى أن يتموضعوا في هذا العالم وبه ومعه، فيساهمون في إنتاج رؤى جديدة له، وفي إنتاج تصورات جديدة للحياة الاجتماعية العربية تسمح بتشكل البُنى الذهنية وفق معطيات الخصوصية، لكنها تنسجم – في الوقت نفسه – مع مناخ العصر وتعترف بالزمن الوضعي المتغيّر”.
وعليه فإن شروط قيام خطاب نقدي جديد تتركز حول الإشكاليات التالية:
أولاً: لا يكفي الناقد أو المثقف الجذري أن يعلن عن فشل الوعي البطريركي الحديث، إذا كان له أن يستقل، وان يحدث التغيير الجذري المطلوب على صعيد الفكر والممارسة، كما على صعيد المجتمع والدولة، بل عليه أن يتحرر أيضًا من علاقة التبعية الجديدة للمدارس والمناهج الغربية.
ثانيًا: تحديد الإشكاليات الحقيقية المنبثقة من الواقع، واقعنا نحن، كمشكلة التجزئة السياسية والاستيطان، والأصولية الدينية والتخلف الاقتصادي والثقافي، ومعالجتها بالأساليب والمقاربات الذي يفرضها هذا الواقع الراهن نفسه، لا باستيراد المناهج والأساليب الجاهزة من الخارج.
ثالثًا: الإقلاع عن تناول موضوعات تعكس قضايا المجتمع الغربي المعاصر أكثر مما تعكس واقع مجتمعنا العربي المعاصر.
وليس المقصود من هذه الدعوة رفض الفكر الغربي الحديث، بل التأكيد على ضرورة خلق موقع مستقل عنه حينما ننصرف إلى مجابهة قضايانا الاجتماعية والفكرية المختلفة كل الاختلاف عن قضاياه، فإذا كان الخطاب النقدي السائد في الغرب اليوم يدور حول قضايا وإشكاليات ما اتفق على تسميتها بمرحلة ما بعد الحداثة ويمثل نزعة تشكك في كل شيء بدًا بالتراث الفكري الأوربي وصولاً إلى الحضارة الغربية، القائمة بكليتها ويلجأ في نقده إلى مناهج جديدة كالبنيوية والتفكيكية والتحليل النفسي، فإن قضايا وإشكاليات المجتمع العربي وما سميَّ بمجتمع ما قبل الحداثة هي مرحلة تجاوزها الغرب منذ أكثر من قرنين من الزمن. وتختلف بالتالي مناهج مقاربتها عن المناهج الجديدة المكتشفة في غرب ما بعد الحداثة.
رابعًا: عدم التقوقع في التراث والاستغناء به عن كل جديد في العالم، والانفتاح بثقة على الثقافات العالمية بلا مركبات نقص أو عقد استعلاء – فالاستقلال الفكري لا يعني الانعزال عن العالم – بل يعني شق طريق مستقل يقوم على وعي بالذات مستقل قادر على تجديد إشكالياته الفكرية، وانتقاء ما يناسبه من أساليب ومناهج بحثية ومعرفية، والقادر في الوقت نفسه على معالجة هذه الإشكاليات لا من موقع التجديد الأكاديمي كما يفعل معظم مثقفينا أو ما نسميها “الرفاهية والترف الأدبي” بحسب تعبير د/ هشام شرابي بل من موقع المسؤولية التاريخية والالتزام الاجتماعي.
“وإذا كان بوسع الكتاب الغربيين أمثال دريدا وليوتار ودولوز أن يضعوا فكرة الالتزام السياسي الذي قال به سارتر والوجوديون في الأربعينيات والخمسينيات، ويركزوا على الحوار النظري وقضايا الإستومولوجيا ومعاني النصوص الأدبية والفلسفية، فإن المثقفين والكتاب العرب لا يسعهم السير في هذا الاتجاه إذا هم تمسكوا بمسؤولياتهم التاريخية، ورفضوا التخلي عن التزاماتهم إزاء قضايا شعوبهم ومجتمعاتهم، وأنهم لفاعلون حتمًا”.
ولذا فقد بات من الملح اليوم إعادة قراءة مضامين الخطاب الديني الإسلامي وإعادة قراءة صيرورته التاريخية والواقعية أيضًا، وإعادة بعث نوعية جديدة من الخطاب العالمي الكامن أساسًا في بنية الخطاب الديني الإسلامي العالمي، وحتى يستطيع الخطاب الديني الإسلامي المعاصر تخطي عقبات القراءة التقليدية والماضوية لمضامينه يجب أن يتحصن بالأسس والقواعد المنهجية التالية:
1 - الفهم العميق والدقيق لمضامين ومكونات الخطاب الديني الإسلامي في بُعدية المقدس والاجتهادي.
2 - الفهم العميق والدقيق لمضامين ومكونات الخطاب الديني الإسلامي في بُعديه المحلي والعالمي وحدودهما الفاصلة بينهما، بنيةً وتوجهًا وتأثيرًا.
3 - الفهم العميق والدقيق لمكونات الخطاب الديني الإسلامي في إطار سياقه التاريخي التجريبي.
4 - فقه المعطيات الواقعية المحلية والإقليمية والعالمية منها بشكل أخص وأدق – والتمييز بين ما يجب أن يوجه للمدعوين المحليين – وبين ما يجب أن يوجه للآخر المتعدد عالميًا.
5 - عدم إهمال التراكمات الإنسانية الحضارية الأفقية والعمودية، في جانبيها العلمي المعرفي الفلسفي والثقافي الفكري والتطبيق التكنولوجي.
“وأن تأتي لهذا الخطاب الديني الانفتاح على الآخر وفتح منظومته الدينية لقراءة وفهم الآخر، قراءة علمية متأنية، وليس لقراءة المستشرقين والمستغربين”.
وساعتها ستتأكد أصالة وصلاحية الخطاب الديني الإسلامي محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما ستتأكد أيضًا أصالة وصلاحية نظرته للآخر، وصلاحية الأمر الإلهي وهو بطلب فتح الحوار الكريم بقوله الكريم: “ولقد وصَّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون”. التي ستكون طريقة نحو العالمية الكوكبية:
“وإذا كان الخطاب الديني المعاصر الموجه إلى المسلمين لم يتمكن من النهوض بالأمة وبناء الإنسان وإثراء الفكر وتصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنه قد عجز في مخاطبة غير المسلمين باللغة التي يفهمونها والأسلوب الأقدر على إقناعهم فأثمر ذلك سوء فهم لمعطيات هذا الدين وسماحته”.
وانعكست الحقائق ليصبح الإسلام في المنظور الدولي دين إرهاب وسفك دماء، واعتداء عل الحريات وقهر وقمع لحريات وحقوق الإنسان. ويرجع ذلك غلى كثير من الأسباب وأهمها عدم قدرتنا على تأهيل دُعاة قادرين على التعامل مع العقلية غير المسلمة، ولعل ما يثير الدهشة أن نرى عددًا من هؤلاء الدعاة يخاطبون الآخر من غير المسلمين بالحجج القرآنية والنهج النبوي الشريف متناسين أن هؤلاء لا يؤمنون أصلاً بالكتاب والسُنة، ولا يقتنعون إلاَّ بالأدلة المادية والحجج والبراهين العقلية والأمثلة الحياتية وذلك بأسلوب هادئ بعيدًا عن الصراخ والصياح، ولعل أبرز ما يجب أن يميز الخطاب الديني الإسلامي هو ربطه بالعقل واحترامه له، وفي ضوء هذه الحقيقة يجب أن يتحول هذا الخطاب نحو التفكير الحر. وما أكثر الآيات القرآنية التي تخص الإنسان على أن يفكر ويتدبر، ويطلق سراح عقله ليستنبط به من حقائق علمية لظواهر هذا العالم.
ويكفي “أن نذكر أن القرآن الكريم قد ذكر العقل باسمه ومشتقاته نحو خمسين مرة، كما ذكر أولي الألباب بضع عشرة مرة وأولي النهى أكثر من مرة وبلغ من تقدير الإسلام للعقل أن جعل معجزته، وهي القرآن الكريم معجزة عقلية ترتبط بالعقل في كل زمان ومكان”.
* عميد كلية الآداب - جامعة عدن
المراجع في الكتاب
أ. د. علوي عمر مبلغ*
وفي ظل هذه الصورة لعلاقة الغرب بالإسلام أو أكثر تحديدًا الغرب بالعرب يمكننا أن نسجل تصورًا بسيطًا لمستقبل ما للثقافة العربية.
أولاً: لا شك أن التطورات والأحداث والهزات التي شهدها العالم منذ منتصف الثمانينات، قد تركت تأثيراتها على العالم العربي من حيث الانقلاب الذي أحدثته في فرضياته ومسلماته القومية والسياسية وتحالفاته الاستراتيجية وسايكلوجيته.
ثانيًا: يصعب عزل الثقافة عن واقعها الاجتماعي والسياسي، ولهذا فالثقافة العربية في حاجة عاجلة إلى إرساء أولويات وأهداف قومية وسياسية واجتماعية واقتصادية جديدة.
ثالثًا: لن تحظى الثقافة العربية عمومًا بالمكانة الدولية التي تستحقها إلاَّ إذا استردت الشخصية العربية إحساسها بالكرامة والثقة بالنفس ثم ازداد تعميق تشبثها بحضارتها وتاريخها.
رابعًا: الانعزال أو الانكفاء على الذات وليس هو الحل، أو ليس هو الموقف المطلوب في مواجهة التحدي المتعدد الجوانب الذي يواجهه العالم العربي، ومن الضروري إزجاء مزيد من التشجيع على العودة إلى جذور الحضارة العربية والإسلامية وتاريخها لاستلهام روح انطلاقة جديدة، مع الأخذ بالمناخ المباح والمتاح مما أنجزه الغرب نفسه من مناهج ووسائل وأفكار في ضوء خصوصيات مجتمعنا العربي المحلية.
خامسًا: إن على منابر الفكر والثقافة في العالم العربي دورًا كبيرًا في الأخذ بزمام المبادرة على صعيد مقاومة نزعة الاستسلام السياسي الغبي لكل ما هو مستورد من قوى النفوذ الجديدة في العالم، فحالة الصدمة العربية، الهزائم والاضطهادات، كانت إلى وقت ليست ببعيد ما تنفك تفرز شعورًا عميقًا بالشك في مصداقية كل ما هو عربي الهوية والانتماء، بما في ذلك القيم الإنسانية والروحية التي يبشر بها الإبداع الثقافي في جميع مناحيه، فمن مهمته تلك المنابر أن تسهم في إذكاء الروح الجديدة التي ترمي إلى استلهام “المحلي” والثقة به، ومن مهمتها أيضًا أن تبسط حقيقة العلاقة الحضارية مع الغرب ومع قوى النفوذ الأخرى.
سادسًا: نحن لا نصادر الآخر ولا ننكر أهمية الالتقاء به، سياسيًا ضمن ما تمليه مصالحنا، وثقافيًا ضمن ما تقتضيه ضرورات الحوار وشرعية الاقتباس وتلامح التجارب، ومراجعات الإنجاز، ولكن هذا المفهوم للعلاقة المتوخاة بالغرب، لا يمكن أن يحجب الحجم الصارخ لحضوره والقوي بيننا، ومثوله الشديد في هاجس تفكيرنا، ورسوخه المتمكن في مناهجنا، فلا بد أن نتفق على أن حضارتنا العربية المعاصرة – لا سيما في وجهها المادي – هي في التقويم النهائي – حضارة مغلوبة، وبالتالي مقلدة وتابعة ومستهلكة (بكسر اللام) وفضلاً عن هذا المنظور الموجع لحقيقة الوجه المادي لحضارتنا المعاصرة فإن الخطر لا يقف عند حدود الإنجاز التكنولوجي في مجالاته المختلفة، بل يمتد إلى أدوات تشكيل الوعي العلمي والمعرفي والإبداعي. وهذا هو الأهم، فالثورة الكبيرة التي تحققت في مجال نقل المعلومات، والتسهيلات العجيبة التي حدثت وتحدث في ميادين الاتصال، عملت كلها على تكريس تبعية منطقتنا وعلى تعزيز شهوات الاستهلاك فيها، إضافة إلى ذلك فإن انتصار الأيديولوجية الغربية مؤخرًا قد يعود فيخدعنا ومعنا كل الشعوب الضعيفة الأخرى فيزيد فينا الانبهار بالآخر أي “المعجزة” ومهما كان حجم الالتفاف إلى المحلي والثقة به، إلاَّ أن حجم الهجوم يُعد أكبر مما نتصور. إننا هنا نلح على الإمعان في تعزيز كل الإمكانات المحافظة على المقومات الذاتية وحمايتها من أي ضعف طارئ أو ذوبان في مغريات أطروحات الآخر، ولكن دعوة لهذه تظل في مؤداها الأخير صيغة فضفاضة لا تجد في المناهج العربية القائمة ما يمكن أن يحولها فعلاً – إلى برامج طموحة – تستطيع أن تقحم تلك المقومات الذاتية إلى واجهة الفعل بما يتلاءم مع منطق العصر ولغته ومفاهيمه، فالحق إن هناك عددًا من العوامل التي تعرقل النية في وضع أمثال تلك البرامج الطموحة، أو هي تفسد التفكير فيها من الأساس، وليس أول تلك العوامل الضعف العام الذي يهيمن على الواقع العربي ككل، وليس أخرها بهوت العقلية العربية نفسها، ووهنها وافتقادها إلى المنهجية العلمية وشجاعة التحليل والتجرد من العواطف السمحة.
سابعًا: إن الإنجاز التكنولوجي الغربي ليس له أن يكون إنجازًا محايدًا، على الرغم مما قد يبدو عليه مما هو خلاف لذلك. إن ذلك الإنجاز واقعيًا، سيظل يحمل تحت معطفه شيئًا من أيديولوجيات الآخر وطريقة تفكيره ومفاهيمه وأسلوبه في المعيش وفهمه الحياة وموقفه منها، وفي الإنجاز التكنولوجي الغربي تعزيز لحضوره وتأكيد لقوته، وأمام هذا النوع من السيادة لا بد من العمل منذ الآن على خلق أجيال تستطيع أن تستوعب حركة الإنجازات العلمية كي تتجاوز هذه الأمة على المدى البعيد عن مستوى الاستهلاك إلى مستوى الخلق والإبداع، وهذا يتطلب مراجعة شاملة وصميمية لكل مناهج التعليم لتتواءم مع حاجات التقدم والقوة والمنافسة والانعتاق من ظروف الاتكال على الغير والإذعان والاستكانة.
لقد عبرَّ الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والبالغ من العمر 78 عامًا قائلاً: “ثمة شعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متعجرفة ومتسلطة ومنطوية على نفسها إلى حدٍ بعيد، وبأننا فخورون بثرواتنا، مؤمنون بأننا نستحق أن نكون الأمة الأكثر غنى وقوة ونفوذًا في العالم، واعتقد أنهم يشعرون بأننا لا نلتزم لهم كثيرًا، وهذا صحيح غالبًا”.
ومع ذلك فإن اتجاهات العولمة، وبخاصة الأمريكية، تسير في طريقين متعاكسين، فهي من جهة شديدة الاعتزاز بهويتها والحرص عليها، ومن جهة أخرى ترفض الاعتراف بالهويات الوطنية للشعوب الأخرى.
ومهما يكن الأمر، فإن التحديث والنمو اللذين تشهدهما العولمة الأمريكية لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافي في المجتمعات غير الغربية، بل يؤديان إلى المزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب، التي تستطيع إيجاد تيار ثقافي مضاد يقف في مواجهة روح الهيمنة – التي تنطوي عليها هذه العولمة، فكرة ونطاقًا وتطبيعًا وممارسة – وفي التعامل مع الآثار المترتبة عليها.
لقد أضحى الحق في التنوع الثقافي والاندماج مع ثقافات الشعوب الأخرى اليوم قاعدة من قواعد القانون الدولي، وذلك استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقات التي تحكم علاقات التعاون الثقافي بين المجموعة الدولية، وفي كفالة هذا الحق من حقوق الإنسان، وتأكيدًا على الخصوصية الثقافية فقد جاء في المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي:
أ- “لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامها والمحافظة عليها.
ب- من حق كل شعب، ومن واجبه أن ينمي ثقافته.
ج- تشكل جميع الثقافات بما فيها من تنوع خصب، وبما بينها من تباين وتأثير متبادل جزءًا من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعًا”.
كما أنه من المعلوم أن الأمم والشعوب التي تمتلك مكونات حقيقية لهويتها الوطنية وثقافتها القومية، ترفض التبعية والذوبان في ثقافات غيرها، وتفشل كل مخطط لإفنائها، ولا تقبل بأن تفرِّط في ذاتيتها. وتحرص على أن تحافظ على وجودها، ولما كانت العولمة هي ظاهرة العصر وسمته، وأن الوقوف في وجهها أو محاولة تجنبها أو العزلة عنها، إنما هو خروج على العصر وتخلف وراءه، فعلينا الإقبال على دراسة عناصر هذه العولمة، وفهم مكوناتها، والتنبه لاتجاهاتها، ثم التعامل معها من موقع الثقة بالنفس، والإدراك العميق لخصائص ثقافتنا، واستخراج كوامنها الأصلية، وتفعيلها مع تلك الثقافة العالمية الوافدة، أخذًا وعطاء، مع امتلاكنا القدرة على الإسهام والمشاركة.
ومع علمنا أن هذا المجال لا يتسع للحديث عن العولمة وإشكالياتها، فإن مثل هذا الموضوع سبق لصاحب هذا الكتاب نشر بحث كامل حوله في وقت سابق، ونحن هنا نتقيد بعنوان الموضوع والمتعلق بطابع الهوية العربية الإسلامية ووصفها بالإرهاب من الآخر.
الخطاب الديني – والإرهاب
يشهد الفكر العربي الإسلامي تحولاَّت مهمة، رغم التفاوت في درجاتها ودوائرها ومداها الزمني وطبيعة البُنى الجدلية التي أفرزتها، ورغم التيارات السكونية التي ظلت تستعصي على الحل وتعد مظاهره لونًا من الردّة والانحراف، وهي تيارات لا يستهان بشأنها ونفوذها والمساحات التي تغطيها إلى درجة ربما يغيب خلالها اثر التطورات تلك، وتكتسب من وجهة نظر بعضهم طابعًا شكليًا لا يلج إلى بنية الخطاب أو استراتيجيته، “فمنذ لحظة التكوين الأولى لهذا الفكر، راحت تطرح الأسئلة الكلامية والفلسفية لتتبلور في عصر الترجمة والانفتاح على الميراث الإنساني وازدهار الفلسفة وعلوم الشريعة واللغة والعلوم الطبيعية وغيرها. وفي ظل سياق الترَّدي الاجتماعي دخل الفكر حقبة الغزالي، وارتبك الموقف من المعرفة كما تجلى في “تهافت الفلاسفة” وراج لون طافح من التصوف فانحسرت الرؤية العقلانية، وبخاصة مع صعود تيار المدرسة النصية”.
إننا بحاجة ملحة وماسة إلى خطاب نقدي عربي جديد، وقبل الشروع في تحديد معالم المشروع النقدي الجديد، يحدد بنا الانتباه إلى جملة من الوقائع التي أصبحت بمنزلة المسلَّمات التي يجب أخذها بعين الحسبان في عملية التأسيس الجديدة ونذكر منها على سبيل المثال:
الأولى: أن الثقافة الغربية الحديثة التي هي في حقيقتها، ثمرة ثقافات وطنية متعددة، شرقية وغربية، أصبحت ثقافة عالمية لا يمكن تجاهلها أو العيش خارجها، وهي ثقافة يمكن وصفها بثقافة “القوة والاقتدار” وهذا يعني أن لا مهرب لنا، كما أن لا مهرب لغيرنا من شعوب وثقافات أخرى، من الانفتاح على هذه الثقافة الحديثة والتفاعل معها، وألا حكمنا نحن وغيرنا على أنفسنا بالانعزال والموت المحتم.
الثانية: أن علاقات الغرب الأوربي بالمشرق العربي بصرف النظر عن أشكالها وأدوارها وتطوراتها – أصبحت علاقات تاريخية لا انفكاك لها بين عالمين متجاورين على الرغم من فترات التوتر التي رافقتها والمآسي الكبيرة التي تمخضت عنها، وقد كانت على الدوام في صالح الإنسانية العام – نظرًا للنتائج الإيجابية التي حملتها في شتى العلوم والمعارف والفنون، والتي رفعت بالإنسانية أشواطًا كبيرة في سبيل الرُقي والتقدم.
الثالثة: أن التمسك بعنجهية بالأصالة والتراث، وأمجاد الماضي التليد والسلف الصالح، دون نظر نقدي جدي إلى التراث الديني والفكري والسياسي، لا يفيدنا شيئًا كما لا يغير الغرب في المقابل، مهما بلغ من قوة واقتدار، النظر إلينا تارةً كإرهابيين يهددون السلام العالمي، وطورًا كأصحاب ثروات كبيرة نبددها في غير الصالح الإنساني العام، فالعالم يجب أن يتسع لجميع ساكنيه وليس لأحد أن يدَّعي وحدة الحق في تقرير ما هو أصلح للإنسانية.
الرابعة: أن الأصولية الدينية الجذرية التي تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى حركات سياسية كبرى على امتداد العالمين العربي والإسلامي في المنطقة الأفرو – آسيوية لن تكون في المدى البعيد، على الرغم من الانتصارات الكبرى التي حققتها ضد الهجمة الغربية الشرسة، الرد الحاسم على هذه الهجمة وإن بدأ للبعض أن الدين هو القاعدة الأساسية لتحصين الذات وحمايتها من الآخر.
والآن كيف السبيل إلى الخروج من التبعية إلى الاستقلال، وما هي شروط الخطاب النقدي الجديد الذي نحتاجه في مرحلة الانتقال هذه، وما دور المثقفين الحقيقيين في هذه المرحلة بالذات؟.
ترى د/ فهمية شرف الدين: “ان النظر في سمات هذا العصر لا بد أن يتم من زاويتين: الأولى: هي العولمة حيث نبني في أفقها ومعها مجموعة من المعايير والقيم وأنماط السلوك الثقافية التي تشكل الإطار الفعلي للرؤى الجديدة للعالم. والثانية: هي الخصوصية حيث نبني في أفقها ومعها مواقف الدفاع عن الذات والرفض، مع كل ما تحمله هذه المواقف من إشكاليات تتعلق بتحديد أوليات الدفاع وأشكالها وتحديد مساحات الرفض وكيفيات صياغة الأهداف”.
وتنتهي “إلى دعوة المفكرين العرب إلى أن يتموضعوا في هذا العالم وبه ومعه، فيساهمون في إنتاج رؤى جديدة له، وفي إنتاج تصورات جديدة للحياة الاجتماعية العربية تسمح بتشكل البُنى الذهنية وفق معطيات الخصوصية، لكنها تنسجم – في الوقت نفسه – مع مناخ العصر وتعترف بالزمن الوضعي المتغيّر”.
وعليه فإن شروط قيام خطاب نقدي جديد تتركز حول الإشكاليات التالية:
أولاً: لا يكفي الناقد أو المثقف الجذري أن يعلن عن فشل الوعي البطريركي الحديث، إذا كان له أن يستقل، وان يحدث التغيير الجذري المطلوب على صعيد الفكر والممارسة، كما على صعيد المجتمع والدولة، بل عليه أن يتحرر أيضًا من علاقة التبعية الجديدة للمدارس والمناهج الغربية.
ثانيًا: تحديد الإشكاليات الحقيقية المنبثقة من الواقع، واقعنا نحن، كمشكلة التجزئة السياسية والاستيطان، والأصولية الدينية والتخلف الاقتصادي والثقافي، ومعالجتها بالأساليب والمقاربات الذي يفرضها هذا الواقع الراهن نفسه، لا باستيراد المناهج والأساليب الجاهزة من الخارج.
ثالثًا: الإقلاع عن تناول موضوعات تعكس قضايا المجتمع الغربي المعاصر أكثر مما تعكس واقع مجتمعنا العربي المعاصر.
وليس المقصود من هذه الدعوة رفض الفكر الغربي الحديث، بل التأكيد على ضرورة خلق موقع مستقل عنه حينما ننصرف إلى مجابهة قضايانا الاجتماعية والفكرية المختلفة كل الاختلاف عن قضاياه، فإذا كان الخطاب النقدي السائد في الغرب اليوم يدور حول قضايا وإشكاليات ما اتفق على تسميتها بمرحلة ما بعد الحداثة ويمثل نزعة تشكك في كل شيء بدًا بالتراث الفكري الأوربي وصولاً إلى الحضارة الغربية، القائمة بكليتها ويلجأ في نقده إلى مناهج جديدة كالبنيوية والتفكيكية والتحليل النفسي، فإن قضايا وإشكاليات المجتمع العربي وما سميَّ بمجتمع ما قبل الحداثة هي مرحلة تجاوزها الغرب منذ أكثر من قرنين من الزمن. وتختلف بالتالي مناهج مقاربتها عن المناهج الجديدة المكتشفة في غرب ما بعد الحداثة.
رابعًا: عدم التقوقع في التراث والاستغناء به عن كل جديد في العالم، والانفتاح بثقة على الثقافات العالمية بلا مركبات نقص أو عقد استعلاء – فالاستقلال الفكري لا يعني الانعزال عن العالم – بل يعني شق طريق مستقل يقوم على وعي بالذات مستقل قادر على تجديد إشكالياته الفكرية، وانتقاء ما يناسبه من أساليب ومناهج بحثية ومعرفية، والقادر في الوقت نفسه على معالجة هذه الإشكاليات لا من موقع التجديد الأكاديمي كما يفعل معظم مثقفينا أو ما نسميها “الرفاهية والترف الأدبي” بحسب تعبير د/ هشام شرابي بل من موقع المسؤولية التاريخية والالتزام الاجتماعي.
“وإذا كان بوسع الكتاب الغربيين أمثال دريدا وليوتار ودولوز أن يضعوا فكرة الالتزام السياسي الذي قال به سارتر والوجوديون في الأربعينيات والخمسينيات، ويركزوا على الحوار النظري وقضايا الإستومولوجيا ومعاني النصوص الأدبية والفلسفية، فإن المثقفين والكتاب العرب لا يسعهم السير في هذا الاتجاه إذا هم تمسكوا بمسؤولياتهم التاريخية، ورفضوا التخلي عن التزاماتهم إزاء قضايا شعوبهم ومجتمعاتهم، وأنهم لفاعلون حتمًا”.
ولذا فقد بات من الملح اليوم إعادة قراءة مضامين الخطاب الديني الإسلامي وإعادة قراءة صيرورته التاريخية والواقعية أيضًا، وإعادة بعث نوعية جديدة من الخطاب العالمي الكامن أساسًا في بنية الخطاب الديني الإسلامي العالمي، وحتى يستطيع الخطاب الديني الإسلامي المعاصر تخطي عقبات القراءة التقليدية والماضوية لمضامينه يجب أن يتحصن بالأسس والقواعد المنهجية التالية:
1 - الفهم العميق والدقيق لمضامين ومكونات الخطاب الديني الإسلامي في بُعدية المقدس والاجتهادي.
2 - الفهم العميق والدقيق لمضامين ومكونات الخطاب الديني الإسلامي في بُعديه المحلي والعالمي وحدودهما الفاصلة بينهما، بنيةً وتوجهًا وتأثيرًا.
3 - الفهم العميق والدقيق لمكونات الخطاب الديني الإسلامي في إطار سياقه التاريخي التجريبي.
4 - فقه المعطيات الواقعية المحلية والإقليمية والعالمية منها بشكل أخص وأدق – والتمييز بين ما يجب أن يوجه للمدعوين المحليين – وبين ما يجب أن يوجه للآخر المتعدد عالميًا.
5 - عدم إهمال التراكمات الإنسانية الحضارية الأفقية والعمودية، في جانبيها العلمي المعرفي الفلسفي والثقافي الفكري والتطبيق التكنولوجي.
“وأن تأتي لهذا الخطاب الديني الانفتاح على الآخر وفتح منظومته الدينية لقراءة وفهم الآخر، قراءة علمية متأنية، وليس لقراءة المستشرقين والمستغربين”.
وساعتها ستتأكد أصالة وصلاحية الخطاب الديني الإسلامي محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما ستتأكد أيضًا أصالة وصلاحية نظرته للآخر، وصلاحية الأمر الإلهي وهو بطلب فتح الحوار الكريم بقوله الكريم: “ولقد وصَّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون”. التي ستكون طريقة نحو العالمية الكوكبية:
“وإذا كان الخطاب الديني المعاصر الموجه إلى المسلمين لم يتمكن من النهوض بالأمة وبناء الإنسان وإثراء الفكر وتصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنه قد عجز في مخاطبة غير المسلمين باللغة التي يفهمونها والأسلوب الأقدر على إقناعهم فأثمر ذلك سوء فهم لمعطيات هذا الدين وسماحته”.
وانعكست الحقائق ليصبح الإسلام في المنظور الدولي دين إرهاب وسفك دماء، واعتداء عل الحريات وقهر وقمع لحريات وحقوق الإنسان. ويرجع ذلك غلى كثير من الأسباب وأهمها عدم قدرتنا على تأهيل دُعاة قادرين على التعامل مع العقلية غير المسلمة، ولعل ما يثير الدهشة أن نرى عددًا من هؤلاء الدعاة يخاطبون الآخر من غير المسلمين بالحجج القرآنية والنهج النبوي الشريف متناسين أن هؤلاء لا يؤمنون أصلاً بالكتاب والسُنة، ولا يقتنعون إلاَّ بالأدلة المادية والحجج والبراهين العقلية والأمثلة الحياتية وذلك بأسلوب هادئ بعيدًا عن الصراخ والصياح، ولعل أبرز ما يجب أن يميز الخطاب الديني الإسلامي هو ربطه بالعقل واحترامه له، وفي ضوء هذه الحقيقة يجب أن يتحول هذا الخطاب نحو التفكير الحر. وما أكثر الآيات القرآنية التي تخص الإنسان على أن يفكر ويتدبر، ويطلق سراح عقله ليستنبط به من حقائق علمية لظواهر هذا العالم.
ويكفي “أن نذكر أن القرآن الكريم قد ذكر العقل باسمه ومشتقاته نحو خمسين مرة، كما ذكر أولي الألباب بضع عشرة مرة وأولي النهى أكثر من مرة وبلغ من تقدير الإسلام للعقل أن جعل معجزته، وهي القرآن الكريم معجزة عقلية ترتبط بالعقل في كل زمان ومكان”.
* عميد كلية الآداب - جامعة عدن
المراجع في الكتاب
أ. د. علوي عمر مبلغ*