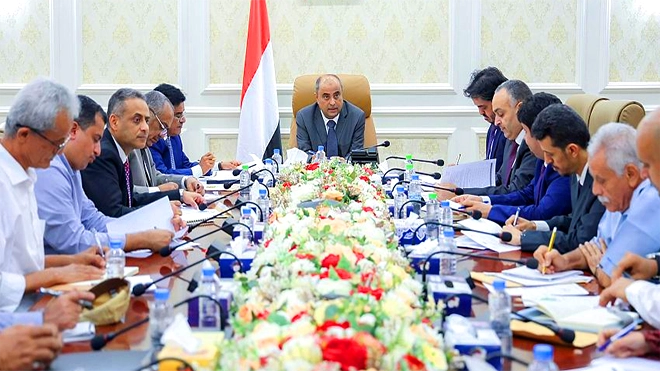> صالح طاهر سعيد
تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن الرابطة الوثيقة التي ترتبط من خلالها العلاقات المكانية بالعلاقات السياسية، وهي تشكل محاولة في التأسيس الفلسفي لفكرة الإصلاح السياسي، الذي بات مطلباً ملحاً لتجاوز التحديات الخطيرة الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا اليوم، وهي التحديات ذاتها التي تواجهها الأمة العربية بأكملها، ولما كان الإصلاح السياسي يمثل الجزء المحوري في أي إصلاحات أخرى مزمعة، فهو إصلاح وإعادة بناء للدولة ووحدتها، فماذا نعني حين نتحدث عن إصلاح الدولة وضرور إعادة بنائها؟ إننا نعني بذلك الأرض، الجماعات البشرية التي عليها، ثم طبيعة التنظيم السياسي الذي ينظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد والجماعات. وبمعنى آخر فإن ثلاثية الأرض والإنسان والسلطة وعلاقاتها ببعضها شكلت جوهر التاريخ وغايته بما فيه من نقاط القوة والضعف، وبالتالي فإن الحديث عن أي إصلاح لا بد له أن يتأسس عبر مناقشة لهذه العناصر الثلاثة وما أثمرته من علاقات اكتسبت طابعها الحقوقي في السياق التفاعلي التاريخي بين الأرض والإنسان، وهو التفاعل الذي حرصنا بقدر استطاعتنا أن نعرضه في سياق هذه المقالة.
لقد خلق الله عز وجل هذا الكوكب، كوكب الأرض، وهو جزء بسيط من هذا الكون الفسيح، وخلق عليه كل أشكال الحياة من أبسطها حتى أرقاها وأكثرها تعقيدا (الإنسان) الذي سخر الأرض وما عليها لخدمة متطلبات بقائه، ارتباطاًَ بخاصية العقل التي ميز بها الله الإنسان دون غيره من المخلوقات، استخلفه على هذه الأرض وأمره بألا يفسد فيها وأن يديرها إدارة عقلانية تنسجم والقوانين المحكمة الدقة، المصمم عليها هذا الكون المخلوق الكبير في حجمه المتسم بالتنوع الشديد، والبالغ التعقيد في تكوينه وعلاقاته.
وانسجاماً مع فكرة الخلق واستجابة الكائنات العاقلة لأوامر الخالق، دخل الإنسان في علاقة تفاعل مع الطبيعة بهدف السيطرة عليها وتسخيرها لتلبية احتياجات البقاء. وبمؤازرة تلك العلاقة وامتداداً لها دخل في علاقات مع أمثاله من بني البشر، وهي علاقات اتخذت أشكالاً عدة، تارة أخذت الشكل التحالفي، وتارة أخرى سارت في منحى التنافر والتناحر بحسب الموقف والسباق الذي يجرى بين الجماعات على حيازة الأرض، التي ترى كل جماعة أن في استثمارها ما يكفي لتلبية احتياجاتها واحتياجات تزايد أعدادها. وبحسب علاقات القرابة والجوار، وطبيعة التحديات التي تبرز هنا وهناك، تشكلت التحالفات بين الجماعات البشرية وهي تحالفات كان هدفها في الغالب بلوغ درجة من القوة تستطيع الجماعات المتحالفة من خلالها تأمين حماية ما كسبته من حيازات مكانية، وتأمين ذاتها أكان ذلك من حيث اكتساب المقدرة على مواجهة غزوات الجماعات البشرية الأخرى، أو عن حاجة مثل تلك التحالفات لبلوغ مستوى أفضل من التعاون والتكامل في تحقيق استغلال أوسع وأفضل للحيازات المكانية التي يسيطرون عليها.
هذا الحراك الإنساني في المكان والزمان هو ما نسميه التاريخ، وفي السياق التاريخي تشكلت خرائط التوزع المكاني (الجغرافي) وما عليها من خرائط توزع الكتل السكانية، بمعنى آخر أن التاريخ كان قد أثمر بنيتين: بنية توزع المكان، وبنية مطابقة لها شكلت ملامح توزع المجتمعات الإنسانية.
تلك العمليات التاريخية وما أثمرته من بنى كانت المجتمعات الإنسانية قد أنجزتها في مراحل مبكرة من التاريخ. ولو أن البشرية أدركت ذلك في حينه لتجنبت كل أشكال الشرور والحروب، ولكانت في مستوى غير ما نحن عليه اليوم من التطور والرقي، ولكن يبدو أن في ذلك حكمة، فالنضج لا يأتي إلا متأخراً والتاريخ لا يصير واضحاً إلا بعد اكتماله، وبمعنى آخر أن مسار التاريخ تحركه في الأصل الدوافع المرتبطة بالغرائز والأهواء، ولكنه يسير تدريجياً نحو إخضاع تلك الغرائز والأهواء لسيطرة العقل، وهذا ما نلاحظه لدى الإنسان الفرد في مراحل حياته حين يمر بالطفولة والصبا والمراهقة والشباب والنضج، ويمكن القول إن في ذلك صورة مصغرة لمراحل التاريخ الإنساني برمته.
الأرض وامتلاكها تميزت وتحددت للجماعات البشرية في السياق التاريخي، بل وفي مراحله المبكرة، وكان الإخلال بهذا التميز والتحديد سبباً مباشراً في عدم استقرار المجتمعات والغزوات المتبادلة وحروب الكر والفر فيما بينها حين كان قانون القوة هو القاعدة السائدة في العلاقات بين الجماعات البشرية، وكانت تتحدد في ظل سيادة تلك القاعدة حدود أي جماعة بشرية كبرت أو صغرت بالخط الذي يصله جيشها ويكون قادراً على حمايته، ولأن هذا القانون، قانون القوة والغزو، يتحرك وفق منطق الغرائز والأهواء ولا يمت بصلة إلى العقل، فقد كان سبباً في مآسي الإنسانية، وهو الأمر الذي أدركته المجتمعات البشرية بعد كل هذا التاريخ الطويل، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى التي ألحقت دماراً بالمجتمع الإنساني حين وجد ذلك الإدراك صداه في أول قرارات عصبة الأمم.
في كتابه القيم عن العروبة والإسلام ص 119، كتب الباحث العربي المصري د. عصمت سيف الدولة متناولاً عنصرالأرض وعلاقة الدولة به، قائلا: «إن كل ذلك التاريخ الذي امتد إلى مئات القرون كان يجرى في ظل قاعدة مستقرة، كان ينظر لها بأنها القاعدة الشرعية لعلاقة الدولة بالأرض. تلك القاعدة هي ما يعرف باسم (حق الفتح)، وهو حق لم يتفق المجتمع البشري على إنهاء شرعيته إلا عام 1919م حين وُضع عهد عصبة الأمم على إثر الحرب الأوربية الأولى، أما قبل ذلك وعلى مدى التاريخ كله، فقد كان الاستيلاء بالقوة على أية أرض يكسب القائمين بذلك حق ملكيتها وضمها إلى ممتلكاتهم، وهو حق يعرفه الغالب ويعترف به المغلوب». وبمعنى ما أن السيادة حتى ذلك الوقت لـ (حق القوة) وليس لـ (قوة الحق)، وكان الشعار الدائم لتلك المراحل هو ذلك الشعار المشمول في عبارة القائد التاريخي الشهير الكسندر الأكبر حين سُئل قبل وفاته «لمن يترك ملكه فردد شعار العصر كله: لمن هو أعظمكم قوة» (نفس المرجع ص/122).
ولما كان ذلك المبدأ منافياًَ لمنطق العقل وقيم العدالة، فقد كان سبباً مباشراً في اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار على امتداد التاريخ، ولكنه أفضى إلى حقيقة أن اتساع الكتل السكانية المتحاربة جراء التحالفات مع بعضها البعض في حروب الدفاع عن الذات، قد فرض وجوده على فضاءات جغرافية محددة، وهو الأمر الذي أوجد توازناً بات من الصعب تجاوزه، هذه اللحظة سجلت لحظة انتهاء مرحلة أو دور من أدوار التاريخ كانت ثمرتها بلوغ لحظة القوة التي فرضت توازناً جراء اتساع حجم التحالفات القبلية الكبرى، وهي اللحظة التي تحددت فيها خرائط التوزع المكاني بين التجمعات البشرية (الاقاليم)، وهذه كانت المقدمة التي تأسست عليها فكرة التوازن الداخلي للدول، والذي اعتمدت صيغته السياسية بشكل (الفيدراليات). هذا العامل اتسعت بموجبه ساحة العقل على حساب تراجع واضح لمساحة القوة، وحينها كان لا بد لحق (الفتح) أن يخلي مكانه لحق (تقرير المصير).( المرجع نفسه 26). واتفق منذ ذلك الوقت على أن أي شكل من أشكال التوحد بين الجماعات أو الشعوب والأمم ينبغي له أن يقوم على فكرتي الشراكة والديمقراطية والتوفيق بين مفهومي السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، أو بالأحرى بين وجهي السيادة الداخلي والخارجي، وهذا يعني أن الأطراف الداخلة في الاتحاد يكون كل منها سيداً على أراضي اقليمه، وهذا هو ما يعرف بمبدأ السيادة الداخلية، وهو أمر ثبتته معظم دساتير الدول الديمقراطية ومن بينها الدستور الأمريكي، حيث أدخل كنص دستوري ضمن أولى التعديلات التي أجريت على الدستور في الولايات المتحدة الأمريكية - ربما كان ذلك في عهد رئاسة ابراهام لنكولن. وأصبحت هذه القاعدة ثابتة في العلاقات الداخلية لمعظم دول العالم، وبالذات الديمقراطية منها، وأخذت طابعاً ملزماً حين أصبحت قاعدة منصوصاً عليها في القانون الدولي. ويجرى التعامل بمفهوم سيادة الدولة على أراضيها كمفهوم قانوني أيضاً، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الدول الأخرى، بمعنى آخر أن مفاهيم سيادة الدولة، أراضي الدولة، هي مفاهيم يقصد بها الوجه الخارجي لمعنى السيادة، فسلطة الدولة الموحدة هنا مفوضة بما هي منتخبة من السادة المنضوين تحت لوائها في التحدث مع الغير باسم سيادة الدولة، ومفوضة بحمايتها والدفاع عنها، ولكنها ليست مفوضة بأي حال من الأحوال في حق التصرف بالأرض وملكيتها، فالسادة المحليون (الأقاليم ) من خلال سلطتهم المحلية المنتخبة هم دون غيرهم معنيون بذلك ولا يحق للوكيل (سلطة الدولة) أن يحل محل المالك (الشعب) بمكوناته الإقليمية، وعلينا أن ندرك أن مفهوم السيادة جاء من ساد يسود فهو سيد، والسيد هو المالك والمتصرف وصاحب الحق.
بالنظر إلى تطور وعي المجتمعات البشرية وإدارتها لمثل هذه الحقائق، فقد أجمعت أن أي شكل من أشكال التوحيد بين الأمم والجماعات بعد ذلك ينبغي له أن يقوم على اعتماد مبدأ الشراكة والديمقراطية بديلاً عقلانياً مقبولاً يحل كل طرائق الضم والإلحاق التي كانت سائدة في الماضي. فالمبدآن مختلفان تماماً وينتمى كل منهما إلى عصور تاريخية مختلفة أيضاً، فقد تفرع مبدأ الضم والإلحاق عن ما عرف باسم حق القوة وينتمى إلى عصور ولّى زمانها، في حين تفرع مبدأ الشراكة والديمقراطية عن مبدأ حق تقرير المصير، وينتمى إلى عصرنا الحاضر، عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهنا لا بد أن نشير إلى أن مبدأي الشراكة والديمقراطية لم يجر ابتداعهما عبثاً، فقد جرى تأسيسهما من واقع الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة التي حققتها المجتمعات الإنسانية صغرت أم كبرت، وعلى الأخص حقها في أراضيها. فعلى قاعدة الاعتراف بالبنى المكانية (خارطة توزع الأرض بين الكتل السكانية) التي تحددت وتميزت وعلى مدى قرون طويلة من الزمان بالاعتراف بهذه الحقيقة، تحدد مفهوم الشراكة بين المكونات التي شكلت البنية الاتحادية للدولة وتحددت الديمقراطية وسيلة مثلى أو آلية تتحقق من خلالها فكرة الشراكة، وهنا تبرز أهمية فهم إشكالية الديمقراطية، فهمها كفكرة، فهمها كبنية، فهمها كفعل. فهي بنية مؤسسية تضم في تكوينها كل مكونات الشراكة التي تتألف منها الدولة الموحدة، فالديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تهدف إلى تحقيق غاية الشراكة والتوازن بين مكونات الدولة، ولتتحول الفكرة إلى واقع حقيقي لا بد من الاتفاق على البنية المؤسسية التي ينبغي أن تقوم على الفهم والاعتراف ببنى التوزع المكاني (الجغرافي) وما يقابلها من بنى توزع الكتل السكانية وما أثمرته من علاقات توازن فيما بينها، وتصميم ذلك في هيكلية بنيوية لممارسة ديمقراطية تضمن تحقيق الشراكة الموجودة بين أطراف الاتحاد الذي تتألف منه الدولة. فهذه الكتلة السكانية أو تلك تستمد قوة حقها في الشراكة من واقع امتلاكها للأرض التي تسيطر عليها وتمتلكها منذ آلاف السنين، فقد حدث هنا شبه اندماج بين الجغرافيا والإنسان على هذا الحيز المكاني أو ذاك، حتى أن مسألة الهوية أصبحت تعرف إما بالتسمية المكانية أو بالعرقية القبلية لا فرق بين هذا وذاك بفعل قوة هذا الحق المعترف به. هذه المناقشة توصلنا إلى لحظة تبرز فيها حاجتنا إلى التمييز بين ما هو ثابت وما هو متحول، لنتمكن من التمييز بين الأسس الثابثة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة وبين الفعل السياسي المتحول داخل البنى السياسية الثابتة. وبهذا المعنى فإن الثابت المكاني إلى جانب ثابت الكتل السكانية المتشكلة عبر التاريخ يمثلان الأساس المتين الذي تبنى عليه السياسة، التي عادة ما تبدأ بالاتفاق على تسمية البنية أو الأجزاء المكونة للدولة والذين سيشكلون فيما بعد أطراف الحق أو السادة المقررين للكيفية التي ستسير بها شؤون الدولة التي ارتضوا التوحد تحت لوائها. واتفاق البنية يأخذ بعين الاعتبار ذلك الثابت المكاني والإنساني الذي انتجه التاريخ، وهو عادة ما يسمى باتفاق وحدة الدولة وبنائها، أي أنه بمثابة التصميم الهندسي للساس الذي يقوم عليه البنيان، وفي ذلك تكمن أهميته القصوى، وهو اتفاق ينبغي له أن يشكل فيما بعد روح الدستور، الذي عادة ما يتصف بالثبات ولا يخضع للتغيير إلا في الحالات النادرة جداً ولبعض بنوده وبموافقة أطراف العقد كلها، فهو اتفاق أولاً ودستور ثانياً ترتبط به كل المسائل الكبرى مثل الوطن والانتماء الوطني والهوية بل ووحدة الدولة بمفهومها القانوني وحقيقة وجودها الفعلي، وبالتالي فإن اتفاقاً كهذا من شأنه إعلاء قوة الحق وحمايته، وغايته تكمن فيما يمتلكه من دلالات مطمئنة لكل الأطراف المنضوية تحت لواء الدولة الموحدة، ويجعلها تطمئن لبعضها البعض بأن كلاً منهم يشكل عامل قوة للآخر ولا يستهدفه أو يستهدف أرضه أو يعمل على إلغائه، وهذا المنهج في عمليات التوحد بين الشعوب والجماعات هو وحده دون غيره يستطيع إغلاق الثغرات أمام تدخلات الخارج. إن ثبات وأولوية ما أسميناه (اتفاق وحدة الدولة وبنائها) أو اتفاق البنية والعلاقات الحقوقية بين أجزائها يستمد من ثبات الجغرافيا وما تشكل عليها من تجمعات سكانية نتيجة علاقاتها المتشكلة عبر التاريخ، كما يستمد أولويته من ضرورة وجود تصميم أو تنظيم تخطيطي يمنع حدوث التصادم بين القوى الاجتماعية والسياسية التي ستندفع لممارسة نشاطها داخل المجتمع الموحد.
وإذا كان ذلك هو الثابت وما يتم التأسيس عليه من اتفاقات وبنى تكتسب صفتها الشرعية بعد أن تتحول إلى روح تشكل مضمون الدستور، فإنه بذلك يهيئ الأرضية لظهور المتحول أو المتغير، وهو بعدي ثانوي بالنسبة للأول وفيه يسمح بهامش الاتفاق والاختلاف بعكس الأول الثابت الذي ينبغي له أن يكون محط اتفاق كامل لارتباطه المباشر بوحدة الدولة، وعليه يتوقف وجود الوحدة من عدمها، وعادة ما يكون ذلك الاختلاف المسموح به في إطار التحول مقيداً بالاتفاق الأول الثابت حتى لا يتحول الاختلاف إلى تصادم، وفكرة المتحول أو المتغير وما يترتب عليه من هامش الاتفاق والاختلاف بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية يستمد مشروعيته وضرورة الاعتراف به من حقيقة وجود التنوع الهائل في الوسط الذي يتعامل معه الناس من ناحية، وحقيقة التفاوت في النظر العقلي الذي يتمتع به الناس في تقييمهم للأشياء والظواهو والأحداث من ناحية أخرى، ولأنه لا أحد يستطيع الادعاء بأنه وحده يمتلك الحقيقة فإن الناس تقر في الغالب بأن الاختلاف رحمة لأنه يتضمن في الأصل مساراً أو بحثاً عقلياً يهدف الوصول إلى الحقيقة. يرتبط الشق الأول (الثابت) بوحدة الدولة وبنائها في حين يرتبط الشق الثاني (المتحول) بالنظام السياسي والآليات البنيوية لتنظيم الفعل السياسي والاجتماعي وما يدخل في إطارها من أفكار، أحزاب، منظمات ومؤسسات مجتمع مدني، وهي تكون في الغالب في حالة حراك وتغير مستمر، ولكنها حركة وتغيير عادة ما تكون مقيدة بمضامين الاتفاق الأول (الأم) الذي ينبغي له أن يتحول إلى دستور، فهو المعيار المرجعي للحكم على صواب أو خطأ أي شكل من أشكال الحركة والنشاط السياسي والاجتماعي في البلاد .. إنه أشبه بالنظام المروري الذي ينظم الحركة في المدن الكبرى المزدحمة. ويتوقف نجاح فعل البنى والسياسات المرتبطة بالشق الثاني على درجة دقة وإحكام الاتفاق الأول وعلى مستوى مطابقته أو بالأحرى انسجامه مع حقائق الواقع ومعطياته الجغرافية والتاريخية، فهو يمثل الاتفاق على الأصول ولم يبق الاختلاف إلا في الفروع، وتأخذ الصورة منحىً أكثر وضوحاً عندما يتوفر لنا الإلمام المعرفي ببنية الدولة، أي دولة، فهي تتألف من أرض وسكان وسلطة، والثابت فيها الأرض والإنسان في حين يدخل العنصر الثالث (السلطة) ضمن مفهوم المتحول أو المتغير، فالثابث هو الأساس الذي يتحدد عليه شكل وحركة المتحول مثلما تتحكم الشمس في مدارات الكواكب التي تدخل في إطار المجموعة الشمسية.
وفي الختام نود التأكيد على أن يؤخذ بمبدأ التوازن الحقوقي بين مكونات الدولة، كما شكلها المسار التاريخي السابق لوجودها، واعتماد بنية مؤسسية تهيئ لممارسة ديمقراطية تنتج شراكة فعلية لكل أصحاب الحق .. يعتبر مبدأً صالحاً يمكن تطبيقه داخل أي دولة، وهو كفيل بأن يجعل منها دولة ديمقراطية تؤمن علاقة متوازنة بين عناصر البنية، كما هو قابل أيضاً لأن يشكل مدخلاً مناسباً تقوم عليه الاتحادات الإقليمية الكبرى بل والنظام العالمي برمته، فالإطار الأكبر لا يلغي ما يسبقه زمانياً أو يصغره حجماً، بل يستوعبه بوصفه مكوناً من مكوناته.
لقد خلق الله عز وجل هذا الكوكب، كوكب الأرض، وهو جزء بسيط من هذا الكون الفسيح، وخلق عليه كل أشكال الحياة من أبسطها حتى أرقاها وأكثرها تعقيدا (الإنسان) الذي سخر الأرض وما عليها لخدمة متطلبات بقائه، ارتباطاًَ بخاصية العقل التي ميز بها الله الإنسان دون غيره من المخلوقات، استخلفه على هذه الأرض وأمره بألا يفسد فيها وأن يديرها إدارة عقلانية تنسجم والقوانين المحكمة الدقة، المصمم عليها هذا الكون المخلوق الكبير في حجمه المتسم بالتنوع الشديد، والبالغ التعقيد في تكوينه وعلاقاته.
وانسجاماً مع فكرة الخلق واستجابة الكائنات العاقلة لأوامر الخالق، دخل الإنسان في علاقة تفاعل مع الطبيعة بهدف السيطرة عليها وتسخيرها لتلبية احتياجات البقاء. وبمؤازرة تلك العلاقة وامتداداً لها دخل في علاقات مع أمثاله من بني البشر، وهي علاقات اتخذت أشكالاً عدة، تارة أخذت الشكل التحالفي، وتارة أخرى سارت في منحى التنافر والتناحر بحسب الموقف والسباق الذي يجرى بين الجماعات على حيازة الأرض، التي ترى كل جماعة أن في استثمارها ما يكفي لتلبية احتياجاتها واحتياجات تزايد أعدادها. وبحسب علاقات القرابة والجوار، وطبيعة التحديات التي تبرز هنا وهناك، تشكلت التحالفات بين الجماعات البشرية وهي تحالفات كان هدفها في الغالب بلوغ درجة من القوة تستطيع الجماعات المتحالفة من خلالها تأمين حماية ما كسبته من حيازات مكانية، وتأمين ذاتها أكان ذلك من حيث اكتساب المقدرة على مواجهة غزوات الجماعات البشرية الأخرى، أو عن حاجة مثل تلك التحالفات لبلوغ مستوى أفضل من التعاون والتكامل في تحقيق استغلال أوسع وأفضل للحيازات المكانية التي يسيطرون عليها.
هذا الحراك الإنساني في المكان والزمان هو ما نسميه التاريخ، وفي السياق التاريخي تشكلت خرائط التوزع المكاني (الجغرافي) وما عليها من خرائط توزع الكتل السكانية، بمعنى آخر أن التاريخ كان قد أثمر بنيتين: بنية توزع المكان، وبنية مطابقة لها شكلت ملامح توزع المجتمعات الإنسانية.
تلك العمليات التاريخية وما أثمرته من بنى كانت المجتمعات الإنسانية قد أنجزتها في مراحل مبكرة من التاريخ. ولو أن البشرية أدركت ذلك في حينه لتجنبت كل أشكال الشرور والحروب، ولكانت في مستوى غير ما نحن عليه اليوم من التطور والرقي، ولكن يبدو أن في ذلك حكمة، فالنضج لا يأتي إلا متأخراً والتاريخ لا يصير واضحاً إلا بعد اكتماله، وبمعنى آخر أن مسار التاريخ تحركه في الأصل الدوافع المرتبطة بالغرائز والأهواء، ولكنه يسير تدريجياً نحو إخضاع تلك الغرائز والأهواء لسيطرة العقل، وهذا ما نلاحظه لدى الإنسان الفرد في مراحل حياته حين يمر بالطفولة والصبا والمراهقة والشباب والنضج، ويمكن القول إن في ذلك صورة مصغرة لمراحل التاريخ الإنساني برمته.
الأرض وامتلاكها تميزت وتحددت للجماعات البشرية في السياق التاريخي، بل وفي مراحله المبكرة، وكان الإخلال بهذا التميز والتحديد سبباً مباشراً في عدم استقرار المجتمعات والغزوات المتبادلة وحروب الكر والفر فيما بينها حين كان قانون القوة هو القاعدة السائدة في العلاقات بين الجماعات البشرية، وكانت تتحدد في ظل سيادة تلك القاعدة حدود أي جماعة بشرية كبرت أو صغرت بالخط الذي يصله جيشها ويكون قادراً على حمايته، ولأن هذا القانون، قانون القوة والغزو، يتحرك وفق منطق الغرائز والأهواء ولا يمت بصلة إلى العقل، فقد كان سبباً في مآسي الإنسانية، وهو الأمر الذي أدركته المجتمعات البشرية بعد كل هذا التاريخ الطويل، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى التي ألحقت دماراً بالمجتمع الإنساني حين وجد ذلك الإدراك صداه في أول قرارات عصبة الأمم.
في كتابه القيم عن العروبة والإسلام ص 119، كتب الباحث العربي المصري د. عصمت سيف الدولة متناولاً عنصرالأرض وعلاقة الدولة به، قائلا: «إن كل ذلك التاريخ الذي امتد إلى مئات القرون كان يجرى في ظل قاعدة مستقرة، كان ينظر لها بأنها القاعدة الشرعية لعلاقة الدولة بالأرض. تلك القاعدة هي ما يعرف باسم (حق الفتح)، وهو حق لم يتفق المجتمع البشري على إنهاء شرعيته إلا عام 1919م حين وُضع عهد عصبة الأمم على إثر الحرب الأوربية الأولى، أما قبل ذلك وعلى مدى التاريخ كله، فقد كان الاستيلاء بالقوة على أية أرض يكسب القائمين بذلك حق ملكيتها وضمها إلى ممتلكاتهم، وهو حق يعرفه الغالب ويعترف به المغلوب». وبمعنى ما أن السيادة حتى ذلك الوقت لـ (حق القوة) وليس لـ (قوة الحق)، وكان الشعار الدائم لتلك المراحل هو ذلك الشعار المشمول في عبارة القائد التاريخي الشهير الكسندر الأكبر حين سُئل قبل وفاته «لمن يترك ملكه فردد شعار العصر كله: لمن هو أعظمكم قوة» (نفس المرجع ص/122).
ولما كان ذلك المبدأ منافياًَ لمنطق العقل وقيم العدالة، فقد كان سبباً مباشراً في اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار على امتداد التاريخ، ولكنه أفضى إلى حقيقة أن اتساع الكتل السكانية المتحاربة جراء التحالفات مع بعضها البعض في حروب الدفاع عن الذات، قد فرض وجوده على فضاءات جغرافية محددة، وهو الأمر الذي أوجد توازناً بات من الصعب تجاوزه، هذه اللحظة سجلت لحظة انتهاء مرحلة أو دور من أدوار التاريخ كانت ثمرتها بلوغ لحظة القوة التي فرضت توازناً جراء اتساع حجم التحالفات القبلية الكبرى، وهي اللحظة التي تحددت فيها خرائط التوزع المكاني بين التجمعات البشرية (الاقاليم)، وهذه كانت المقدمة التي تأسست عليها فكرة التوازن الداخلي للدول، والذي اعتمدت صيغته السياسية بشكل (الفيدراليات). هذا العامل اتسعت بموجبه ساحة العقل على حساب تراجع واضح لمساحة القوة، وحينها كان لا بد لحق (الفتح) أن يخلي مكانه لحق (تقرير المصير).( المرجع نفسه 26). واتفق منذ ذلك الوقت على أن أي شكل من أشكال التوحد بين الجماعات أو الشعوب والأمم ينبغي له أن يقوم على فكرتي الشراكة والديمقراطية والتوفيق بين مفهومي السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، أو بالأحرى بين وجهي السيادة الداخلي والخارجي، وهذا يعني أن الأطراف الداخلة في الاتحاد يكون كل منها سيداً على أراضي اقليمه، وهذا هو ما يعرف بمبدأ السيادة الداخلية، وهو أمر ثبتته معظم دساتير الدول الديمقراطية ومن بينها الدستور الأمريكي، حيث أدخل كنص دستوري ضمن أولى التعديلات التي أجريت على الدستور في الولايات المتحدة الأمريكية - ربما كان ذلك في عهد رئاسة ابراهام لنكولن. وأصبحت هذه القاعدة ثابتة في العلاقات الداخلية لمعظم دول العالم، وبالذات الديمقراطية منها، وأخذت طابعاً ملزماً حين أصبحت قاعدة منصوصاً عليها في القانون الدولي. ويجرى التعامل بمفهوم سيادة الدولة على أراضيها كمفهوم قانوني أيضاً، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الدول الأخرى، بمعنى آخر أن مفاهيم سيادة الدولة، أراضي الدولة، هي مفاهيم يقصد بها الوجه الخارجي لمعنى السيادة، فسلطة الدولة الموحدة هنا مفوضة بما هي منتخبة من السادة المنضوين تحت لوائها في التحدث مع الغير باسم سيادة الدولة، ومفوضة بحمايتها والدفاع عنها، ولكنها ليست مفوضة بأي حال من الأحوال في حق التصرف بالأرض وملكيتها، فالسادة المحليون (الأقاليم ) من خلال سلطتهم المحلية المنتخبة هم دون غيرهم معنيون بذلك ولا يحق للوكيل (سلطة الدولة) أن يحل محل المالك (الشعب) بمكوناته الإقليمية، وعلينا أن ندرك أن مفهوم السيادة جاء من ساد يسود فهو سيد، والسيد هو المالك والمتصرف وصاحب الحق.
بالنظر إلى تطور وعي المجتمعات البشرية وإدارتها لمثل هذه الحقائق، فقد أجمعت أن أي شكل من أشكال التوحيد بين الأمم والجماعات بعد ذلك ينبغي له أن يقوم على اعتماد مبدأ الشراكة والديمقراطية بديلاً عقلانياً مقبولاً يحل كل طرائق الضم والإلحاق التي كانت سائدة في الماضي. فالمبدآن مختلفان تماماً وينتمى كل منهما إلى عصور تاريخية مختلفة أيضاً، فقد تفرع مبدأ الضم والإلحاق عن ما عرف باسم حق القوة وينتمى إلى عصور ولّى زمانها، في حين تفرع مبدأ الشراكة والديمقراطية عن مبدأ حق تقرير المصير، وينتمى إلى عصرنا الحاضر، عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهنا لا بد أن نشير إلى أن مبدأي الشراكة والديمقراطية لم يجر ابتداعهما عبثاً، فقد جرى تأسيسهما من واقع الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة التي حققتها المجتمعات الإنسانية صغرت أم كبرت، وعلى الأخص حقها في أراضيها. فعلى قاعدة الاعتراف بالبنى المكانية (خارطة توزع الأرض بين الكتل السكانية) التي تحددت وتميزت وعلى مدى قرون طويلة من الزمان بالاعتراف بهذه الحقيقة، تحدد مفهوم الشراكة بين المكونات التي شكلت البنية الاتحادية للدولة وتحددت الديمقراطية وسيلة مثلى أو آلية تتحقق من خلالها فكرة الشراكة، وهنا تبرز أهمية فهم إشكالية الديمقراطية، فهمها كفكرة، فهمها كبنية، فهمها كفعل. فهي بنية مؤسسية تضم في تكوينها كل مكونات الشراكة التي تتألف منها الدولة الموحدة، فالديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تهدف إلى تحقيق غاية الشراكة والتوازن بين مكونات الدولة، ولتتحول الفكرة إلى واقع حقيقي لا بد من الاتفاق على البنية المؤسسية التي ينبغي أن تقوم على الفهم والاعتراف ببنى التوزع المكاني (الجغرافي) وما يقابلها من بنى توزع الكتل السكانية وما أثمرته من علاقات توازن فيما بينها، وتصميم ذلك في هيكلية بنيوية لممارسة ديمقراطية تضمن تحقيق الشراكة الموجودة بين أطراف الاتحاد الذي تتألف منه الدولة. فهذه الكتلة السكانية أو تلك تستمد قوة حقها في الشراكة من واقع امتلاكها للأرض التي تسيطر عليها وتمتلكها منذ آلاف السنين، فقد حدث هنا شبه اندماج بين الجغرافيا والإنسان على هذا الحيز المكاني أو ذاك، حتى أن مسألة الهوية أصبحت تعرف إما بالتسمية المكانية أو بالعرقية القبلية لا فرق بين هذا وذاك بفعل قوة هذا الحق المعترف به. هذه المناقشة توصلنا إلى لحظة تبرز فيها حاجتنا إلى التمييز بين ما هو ثابت وما هو متحول، لنتمكن من التمييز بين الأسس الثابثة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة وبين الفعل السياسي المتحول داخل البنى السياسية الثابتة. وبهذا المعنى فإن الثابت المكاني إلى جانب ثابت الكتل السكانية المتشكلة عبر التاريخ يمثلان الأساس المتين الذي تبنى عليه السياسة، التي عادة ما تبدأ بالاتفاق على تسمية البنية أو الأجزاء المكونة للدولة والذين سيشكلون فيما بعد أطراف الحق أو السادة المقررين للكيفية التي ستسير بها شؤون الدولة التي ارتضوا التوحد تحت لوائها. واتفاق البنية يأخذ بعين الاعتبار ذلك الثابت المكاني والإنساني الذي انتجه التاريخ، وهو عادة ما يسمى باتفاق وحدة الدولة وبنائها، أي أنه بمثابة التصميم الهندسي للساس الذي يقوم عليه البنيان، وفي ذلك تكمن أهميته القصوى، وهو اتفاق ينبغي له أن يشكل فيما بعد روح الدستور، الذي عادة ما يتصف بالثبات ولا يخضع للتغيير إلا في الحالات النادرة جداً ولبعض بنوده وبموافقة أطراف العقد كلها، فهو اتفاق أولاً ودستور ثانياً ترتبط به كل المسائل الكبرى مثل الوطن والانتماء الوطني والهوية بل ووحدة الدولة بمفهومها القانوني وحقيقة وجودها الفعلي، وبالتالي فإن اتفاقاً كهذا من شأنه إعلاء قوة الحق وحمايته، وغايته تكمن فيما يمتلكه من دلالات مطمئنة لكل الأطراف المنضوية تحت لواء الدولة الموحدة، ويجعلها تطمئن لبعضها البعض بأن كلاً منهم يشكل عامل قوة للآخر ولا يستهدفه أو يستهدف أرضه أو يعمل على إلغائه، وهذا المنهج في عمليات التوحد بين الشعوب والجماعات هو وحده دون غيره يستطيع إغلاق الثغرات أمام تدخلات الخارج. إن ثبات وأولوية ما أسميناه (اتفاق وحدة الدولة وبنائها) أو اتفاق البنية والعلاقات الحقوقية بين أجزائها يستمد من ثبات الجغرافيا وما تشكل عليها من تجمعات سكانية نتيجة علاقاتها المتشكلة عبر التاريخ، كما يستمد أولويته من ضرورة وجود تصميم أو تنظيم تخطيطي يمنع حدوث التصادم بين القوى الاجتماعية والسياسية التي ستندفع لممارسة نشاطها داخل المجتمع الموحد.
وإذا كان ذلك هو الثابت وما يتم التأسيس عليه من اتفاقات وبنى تكتسب صفتها الشرعية بعد أن تتحول إلى روح تشكل مضمون الدستور، فإنه بذلك يهيئ الأرضية لظهور المتحول أو المتغير، وهو بعدي ثانوي بالنسبة للأول وفيه يسمح بهامش الاتفاق والاختلاف بعكس الأول الثابت الذي ينبغي له أن يكون محط اتفاق كامل لارتباطه المباشر بوحدة الدولة، وعليه يتوقف وجود الوحدة من عدمها، وعادة ما يكون ذلك الاختلاف المسموح به في إطار التحول مقيداً بالاتفاق الأول الثابت حتى لا يتحول الاختلاف إلى تصادم، وفكرة المتحول أو المتغير وما يترتب عليه من هامش الاتفاق والاختلاف بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية يستمد مشروعيته وضرورة الاعتراف به من حقيقة وجود التنوع الهائل في الوسط الذي يتعامل معه الناس من ناحية، وحقيقة التفاوت في النظر العقلي الذي يتمتع به الناس في تقييمهم للأشياء والظواهو والأحداث من ناحية أخرى، ولأنه لا أحد يستطيع الادعاء بأنه وحده يمتلك الحقيقة فإن الناس تقر في الغالب بأن الاختلاف رحمة لأنه يتضمن في الأصل مساراً أو بحثاً عقلياً يهدف الوصول إلى الحقيقة. يرتبط الشق الأول (الثابت) بوحدة الدولة وبنائها في حين يرتبط الشق الثاني (المتحول) بالنظام السياسي والآليات البنيوية لتنظيم الفعل السياسي والاجتماعي وما يدخل في إطارها من أفكار، أحزاب، منظمات ومؤسسات مجتمع مدني، وهي تكون في الغالب في حالة حراك وتغير مستمر، ولكنها حركة وتغيير عادة ما تكون مقيدة بمضامين الاتفاق الأول (الأم) الذي ينبغي له أن يتحول إلى دستور، فهو المعيار المرجعي للحكم على صواب أو خطأ أي شكل من أشكال الحركة والنشاط السياسي والاجتماعي في البلاد .. إنه أشبه بالنظام المروري الذي ينظم الحركة في المدن الكبرى المزدحمة. ويتوقف نجاح فعل البنى والسياسات المرتبطة بالشق الثاني على درجة دقة وإحكام الاتفاق الأول وعلى مستوى مطابقته أو بالأحرى انسجامه مع حقائق الواقع ومعطياته الجغرافية والتاريخية، فهو يمثل الاتفاق على الأصول ولم يبق الاختلاف إلا في الفروع، وتأخذ الصورة منحىً أكثر وضوحاً عندما يتوفر لنا الإلمام المعرفي ببنية الدولة، أي دولة، فهي تتألف من أرض وسكان وسلطة، والثابت فيها الأرض والإنسان في حين يدخل العنصر الثالث (السلطة) ضمن مفهوم المتحول أو المتغير، فالثابث هو الأساس الذي يتحدد عليه شكل وحركة المتحول مثلما تتحكم الشمس في مدارات الكواكب التي تدخل في إطار المجموعة الشمسية.
وفي الختام نود التأكيد على أن يؤخذ بمبدأ التوازن الحقوقي بين مكونات الدولة، كما شكلها المسار التاريخي السابق لوجودها، واعتماد بنية مؤسسية تهيئ لممارسة ديمقراطية تنتج شراكة فعلية لكل أصحاب الحق .. يعتبر مبدأً صالحاً يمكن تطبيقه داخل أي دولة، وهو كفيل بأن يجعل منها دولة ديمقراطية تؤمن علاقة متوازنة بين عناصر البنية، كما هو قابل أيضاً لأن يشكل مدخلاً مناسباً تقوم عليه الاتحادات الإقليمية الكبرى بل والنظام العالمي برمته، فالإطار الأكبر لا يلغي ما يسبقه زمانياً أو يصغره حجماً، بل يستوعبه بوصفه مكوناً من مكوناته.