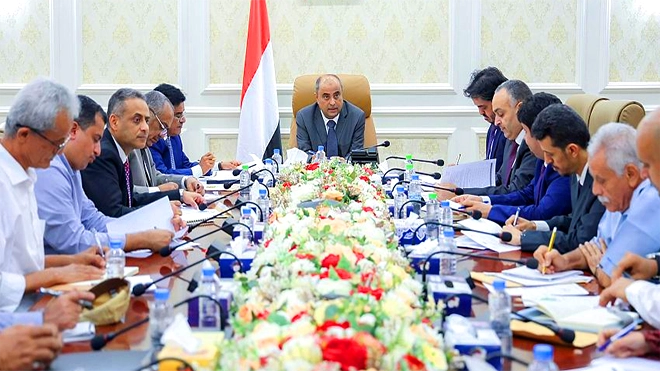> «الأيام» أمذيب صالح احمد:
إذا تأملنا في الروايتين عظمة الفكر السياسي لمفهوم رعاية الدولة لدى هذا الخليفة العظيم لرأينا الأمور التالية: (أ) أن الجوع والبطالة ناشئان عن فساد سياسة الدولة وقياداتها وعليها تقع مسؤولية إزالة البطالة والجوع فوراً، (ب) لا يعاقب مواطن خالف القانون بسبب الجوع أو البطالة وإنما ينزل العقاب بالمسؤولين في الدولة، (ج) أن وظيفة الدولة هي توفير العمل للناس وتوفير حد الكفاية في المعيشة ،(د) أن الدولة ملزمة بوضع قانون يحفظ الحد الأدنى للأجر لدى جميع أصحاب الأعمال بما يضمن حد الكفاية في مستوى معيشي لائق وليس حد الكفاف وعلى هذا الأساس تكون سياسة الأجور، (هـ) أن السرقة لا تستوجب إقامة الحد على السارق إلا بعد توفير حد الكفاية في المعيشة اللائقة للمواطنين حين يقوم مجتمع العدالة الإسلامية، (و) أن الذين يسرقون المال العام أو الخاص من كبار القوم ممن يعيشون فوق حدود الكفاية القصوى هم الذين يستحقون قطع أيديهم أولاً، ولقد رأينا في بلادنا كيف كانت تقطع أيدي الفقراء من صغار اللصوص بأحكام قضائية منحرفة ولم تقطع يد سارق من المسؤولين الشبعانين،(ز) أن العمل حتمي في الإسلام، فالله قد خلق الأيدي لتعمل في النافع من الأعمال فإن تركت للبطالة عملت في المعصية. ونحن نعلم أن الفاروق عمر بن الخطاب ] كان من أكبر قضاة عصره بل وأعظم فقيه للسياسة الشرعية والدستورية في الإسلام، ولذلك فإن أكبر أعداء الدولة الإسلامية الديمقراطية والشوروية من شعوبيين ومتفرنجين تغريبيين ينتقصون من قدره ويحاولون طمس عظمته في استباقه لعباقرة الفكر السياسي في مفهوم دولة العدالة الاجتماعية والحريات العامة التي يتكون منها مفهوم الديمقراطية المعاصرة.
قال تعالى بشأن مكافحة الفقر: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ} ( اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (البقرة/273)، {وَاعْلَم {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (الذاريا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَك أَعْطَى وَاتَّقَى ü وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ü فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} (الليل/5، 6،7)، {الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} (الليل/18).
2) الإنفاق من اجل تحرير الانسان من العبودية
بما أن الفقر يؤدي بالإنسان إلى العبودية وإلى بيع الأعراض فقد قرر الإسلام محاربته واستئصاله لأنه منبع الشرور لحياة الإنسان. إن الفقر يسلب حرية الانسان في جوانب عديدة لكن مذلة الفقر وهَوانِه تجعل بعض الناس من الأقوياء يستعبدون المستضعفين بالفقر بوسائل مختلفة طوال التاريخ، فإذا كان الانسان قديماً يباع ويشترى جسماً وعقلاً بسبب الفقر فإن بيع الانسان لكرامته او لعرضه مازال قائماً حتى اليوم بسبب الفقر وحينما يبيع الانسان نفسه او يبيع او يؤجر أجزاءً محرمة من جسده بدافع الفاقة والحاجة فإنه يكون فاقداً لحريته وشخصيته المستقلة حينما يتعرض كيانه لانتهاك من الآخر وتتحطم كرامته على مطامع ومباذل الغير. وعليه فإن الإنفاق من اجل تحرير الانسان من العبودية بامتلاكه عقلاً وجسداً او بانتهاك جسده تعذيباً او تلذذاً هو فريضة وواجب شرعي. وإذا كانت العبودية تعني الطاعة العمياء للآخر وفقدان الحرية الشخصية وتعذيب الجسد والتمييز والاضطهاد واستلاب حرية الرأي والنقد فإنها اليوم مازالت تمارس بألوان مختلفة مثل: التمييز والاضطهاد العنصري لأسباب اجتماعية مختلفة وتعذيب الأسرى والمعتقلين وتجارة بيع الأعضاء البشرية وتجارة البغاء الدولية للنساء والغلمان واستغلال العمالة المهاجرة وإجراء التجارب اللا إنسانية على الضعفاء والفقراء في السلم والحرب وتسميم الشعوب المختلفة بالمخدرات والكيماويات والنفايات القاتلة، ناهيك عن استعباد العقول وتغريبها عن الحق والخير والعدل بالتضليل الفكري والإعلامي الذي يمارسه أعداء العروبة والإسلام. وقد قررت أحكام الإسلام تحريم عبودية الانسان وأمرت بالإنفاق في سبيل تحريره، ونورد بعضاً من آيات الذكر الحكيم بهذا الشأن وهي: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَا (التوبة/60)، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (النور/33).
3) الإنفاق للجهاد عن المجتمع الإسلامي ودولته
إن فريضة الجهاد في الإسلام هي لبناء وحماية الدولة القوية العادلة والمجتمع الإسلامي الصحيح المتحرر من الفقر والتخلف، فالجهاد هو العمل بشقيه من نفس ومال. فالمال ما هو إلا صورة للعمل المكنوز في ثروة عينية او نقدية ثابتة او منقولة، أما النفس المجاهدة فهي الانسان المسلم حينما يكون كادحاً وعاملاً ومكافحاً ومحارباً. ولذلك فإن فريضة الجهاد مكونة من العمل البنّاء والعمل المسلح للدفاع عن بنيان المجتمع الإسلامي وكيان دولته او بعبارة شائعة «يد تبني ويد تدافع» لأن مفهوم العمل في الإسلام هو مفهوم الجهاد بذاته. ولذلك تميز العرب والمسلمون طوال التاريخ وحتى الآن بالجهاد الدائم ضد «الاستخراب الاستعماري» وضد «الاستكبار الإمبريالي» المعولم. وقد قررت أحكام الذكر الحكيم فريضة الجهاد لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ (التوبة/88)، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (الصف/11).
(ز) جعل العلم والصحة فريضتين على الفرد والدولة
إن الدولة في المجتمع الإسلامي التي تمثل القوى الإنسانية العاملة الخيِّرة من المواطنين ملزمة بتوفير العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل للجميع كحق أساسي حتى يتحول الى سلاح فعّال للتنمية هذه بيد القوى البشرية لتنفيذ أعمالها والقيام بمهامها بطريقة أبسط وأوفر وأرقى بما يزيد في حجم ونوعية العمل الذي تؤديه القوى البشرية العاملة. كما أنها ملزمة بتوفير الصحة العامة للجميع كحق أساسي أيضاً لهذه القوى البشرية كي تعمل بطاقاتها كاملة طوال حياتها في تنمية المجتمع والدولة. وقد أوضحنا في مقال سابق عن القيم الاجتماعية للعمل في الإسلام أن العلم والصحة هما فريضتان على الفرد والدولة لا محيص عنهما تحت أية ذريعة مادية او معنوية، لأنهما حقان أساسيان من الحقوق الأساسية للإنسان في الإسلام. فالطاقة الإنتاجية لقوة العمل البشرية تتعطل بالجهل (نقيض العلم) وتتناقص بالمرض (نقيض الصحة) فلا يتحقق استعمار الأرض الحضاري وتطور الحياة الإنسانية عليها كما أمر به القرآن الكريم.
(3) الإنسان غاية التنمية ووسيلتها:
وإذا كان استعمار الأرض الحضاري بالعمل الإنساني الهادف الى خدمة «القوى البشرية» لا ينهض إلا على اكتاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخططة تخطيطاً سليماً، فإن التنمية الصحيحة الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ان تقوم إلا على سواعد «القوى البشرية» ذاتها، فهي الهدف الأسمى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوسيلة العظمى لها، أي أن هذه القوى البشرية العاملة هي غاية ووسيلة في آن واحد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال الآن هو كيف تكون القوى البشرية غاية ووسيلة للتنمية الاقتصادية في آن واحد؟ يعتبر الفكر الليبرالي في المجتمع الرأسمالي الاستغلالي القوى البشرية وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية بعد تغييب عنصر العمل الإنساني من المال، أما ان تكون غاية فهو أمر غير صحيح لأن الطبقة الرأسمالية الاستغلالية المترفة تكرس كل تنمية اقتصادية مجزأة ومجمعة لخدمة طبقتها مهما ردت للقوى البشرية وتفضلت به من فائض قيمة عملها لتجنب سخطها في شكل خدمات معينة ومحددة واحتكرت لنفسها الاستمتاع بخدمات ومتارف لا حدود لها. أما في المجتمع الإسلامي فإن «القوى البشرية» التي هي كل الشعب العامل بكافة شرائحها الاجتماعية من أثرياء وأغنياء وموسرين وقادرين وفقراء هي وسيلة وغاية في نفس الوقت للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالاستغلال ليس من أهدافها لأن المجتمع الإسلامي الذي تُنميه وتبنيه مؤسس على قوة العمل المبذولة بالتعاون والتضامن والتكافل والتراحم هي من جميع أفراد القوى البشرية العاملة فيه. ومحور المشكلة هنا هو كيف نفهم العلاقة العضوية والجدلية بين الوسيلة والغاية عند التطبيق التنموي للاقتصاد الوطني.
إن عمل القوى البشرية وإنتاجها هو وسيلة، أما انتفاع القوى البشرية بخيرات عملها في صورة ضرورات وخدمات متنوعة فهو غاية. إذن أي جيل تاريخي من القوى البشرية الذي يجب ان تخدمه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدف له. إن الحياة ببشرها وزمانها في ديمومة مستمرة لا تنقطع لحظة واحدة، وهذا يدل على أنه عندما يخطط للاقتصاد الوطني يجب ان تكون القوى البشرية الحاضرة والقادمة في مخيلتنا على الدوام بحيث لا نحمل القوى البشرية القادمة من أحفادنا أعباء القروض والديون التي تدل على عدم اعتمادنا في أيامنا على قوتنا الحقيقية في العمل والإنتاج، بل تدل على حياة طفيلية استمرأها عملاء التواكل والتكاسل من القادة والمخططين في الدولة الذين لا يريدون بناء المجتمع القوي على أسس إسلامية صحيحة. ان نتائج كل عمل حالي تمتد الى العمل اللاحق به، كما ان أعمال ومنافع ومفاسد كل جيل تمتد الى أعمال الجيل اللاحق به، وهكذا دواليك، بحيث يصعب تحديد الحدود بين الأجيال المتلاحقة. وعليه فإن كل جيل يعطي كثيراً للجيل اللاحق به ولكن هذا العطاء يجب ان لا يتحول الى عبء يثقل كاهل الجيل اللاحق. ولذلك فإن خطط التنمية يجب ان تكون أولاً مرحلية من حيث الغاية بحيث تعطي لنفس القوى البشرية التي تنفذها بعض خيرات عملها، وثانياً عليها ان تخطط مواردها وإمكانياتها لتحدث التنمية المباشرة في الحاجات الأساسية لمعيشة القوى البشرية، وثالثاً على القوى البشرية ان تحدث تنمية آجلة للضرورات الثانوية التي تعتبر مكملة لحاجاتها الأساسية حسب ضرورات العصر، ورابعاً على القوى البشرية ان تحدث تنمية طويلة الأمد في مجال المستلزمات الأخرى التي يقتضيها تطور عصرها. غير ان كل مرحلة من مراحل التنمية يجب ان تحقق نفاذاً أفقياً شاملاً لتلبية الحاجات الأساسية للقوى البشرية من السكان بما فيها القضاء على الفقر وتحقق نفاذاً رأسياً وتطوراً نوعياً للخدمات ووسائل الإنتاج على المدى الأطول.
(4) الإنفاق الاستثماري وسيلة التنمية:
إذا سلمنا بأن القوى البشرية هي غاية ووسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، أي ان عمل هذه القوى البشرية هو وسيلة للتنمية واستهلاكها لمنافع أعمالها هو غاية، فكيف يمكننا ان نقيم المعادلة الصعبة بينهما؟ والجواب على هذا هو ان آلية السوق الاقتصادية منذ أقدم العصور قد حلت هذا الإشكال عملياً، غير ان ثمنه كان باهضاً بالنسبة للمجتمع البشري فأوجدت ما سُمي «بالربح» او فيما عُرف فيما بعد «بفائض القيمة» او «بالفائض الاقتصادي» الذي يمثل الفارق بين الخرج والدخل، او بين مدخلات العمل ومخرجاته، او بين ما أُنفق فيه وبين ما استُهلك منه الذي يتحول الى قيمة مالية يعاد استخدامها في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرّف القران الكريم مفهوم «الفائض الأقتصادي» بكلمة«"الفضل» التي وردت في عشرات الآيات مؤكدة بأن خير الله ورزقه يفيض على عباده فالمال هو من الله واليه وليس ملكا لبشر. تقول بعض الآيات الكريمة عن «الفضل»: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ا بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَ (البقريَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (النور/38).
وكلمة «الفضل» تعني ما يزيد عن حاجة الانسان بعد «انفاقه الاستهلاكي» في معيشة كريمة كافية. والانسان حينما يدخر المال بالحفاظ على ما يفضل منه بعد الانفاق الكفائي على معيشته الكريمة وينفق هذا «الفضل» إنفاقاً استثمارياً في صالح المجتمع فانه يعتبر فضلاً من الله مقصده إشاعة الفضيلة بين الناس، أما حينما يساء انفاق المال الزائد عن حاجة الانسان في غير صالح المجتمع فانه يكون مجرد «فضلات» رديئة خاصة بصاحبها ولا تنفع الناس في تطوير معيشتهم، وقد اثبت التاريخ لنا ان بعض الطواغيت ذهبوا ببعض اموالهم الى قبورهم فلم تغن اموالهم عنهم بشيء، وهذا حال لا يختلف عن حال البخلاء الاحياء الذين يحبسون اموالهم عن الانفاق الاستثماري او المترفين الذين يبذرونها في الانفاق الشيطاني بما لاينفع جماعة او مجتمعاً على الارض، مخالفين بذلك مقاصد الشريعة الاسلامية في النماء والحياة.
نستخرج من هذه القاعدة الاقتصادية فكرتين أولهما انه يجب على القوى البشرية العاملة ان لا تستهلك كل قيمة عملها بل تدخر جزءاً من قيمة عملها بحيث تكون القيمة المقدمة لها في شكل أجور نقدية وخدمات عينية بشكل فردي او جماعي او مجتمعي اقل من القيمة الكلية لثمن قوة عملها حتى توجد «الفائض الاقتصادي». وثاني الفكرتين هو ان الفائض الاقتصادي الواجب توفيره دائماً سيتحول الى تراكمات مادية ومالية لإنفاقها في استثمارات جديدة لبناء وتقوية مصادر الثروة القومية ووسائل إنتاجها، إذ ان التطور والتقدم بكافة صوره لا يكون إلا بالمداومة على بناء وتقوية مصادر الثروة القومية ووسائل إنتاجها وليس بالاقتراض المجحف او الاستدانة المرهقة. والسؤال الآن هو كيف يستخدم «الفائض الاقتصادي» في المجتمع الإسلامي؟
إن دخل الفرد والمجتمع والدولة يجب ان يكون في حدود استهلاك كل منهم بما يضمن حد الكفاية للجميع بالوسائل الإنمائية الاقتصادية والوسائل التكافلية الاجتماعية بغير إسراف او ترف وحسب مستوى المعيشة وقوة الاقتصاد الوطني. فالطريق الأمثل الى إحداث الفائض الاقتصادي هو بتقدير فارق مناسب بين «الإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي»، او بين التكاليف من جانب والنفقات من جانب آخر، إذ ان الفارق هو صافي الربح، غير ان الربح ليس فردياً او خاصاً ولكنه ملكية اجتماعية عامة وخاصة يستفاد منها في تحقيق مصلحة خاصة وعامة. فلذلك يعتبر «فائضاً اقتصادياً» في نظر المجتمع الإسلامي لأنه يعبر عن مدى اقتصاد القوى البشرية في نفقاتها. وخلاصة الأمر انه ليس في صالح القوى البشرية ان تستهلك كل قيمة عملها بل يجب ان تدخر جزءاً من قيمة عملها لتستثمره في شكل أموال ومواد حتى تزيد بذلك من قوة عملها وإنتاجها لتطوي بها مراحل التطور والتقدم. والقضية النابعة من هذه الفكرة هي كيف يزاد هذا الفائض الاقتصادي الذي تعتمد عليه مسألة التنمية الشاملة للاقتصاد والمجتمع.
(5) الإنفاق (الاستهلاكي) غاية التنمية :
إن هذه القاعدة الاقتصادية تقودنا الى فهم العلاقة العضوية بين العمل والاستهلاك، وإذا نظرنا الى الاستهلاك لوجدنا ان الإنسان مجبول عليه بفطرته وغرائزه وتحضره لإشباع حاجاته الأساسية التي لا يستطيع الحياة بدونها ولذلك فهو يعمل ليستهلك بأوسع ما يحمله هذا المعنى من استهلاك مادي وروحي ومجتمعي. فالإنسان او في صيغته الجامعة «القوى البشرية» إنسان عامل ومستهلك في آن واحد، كلما زاد من عمله زاد من استهلاكه، ولا يمكن تحديد مستوى الشبع والقناعة عنده حتى في حدود حاجاته الأساسية المتزايدة. وكل من ظن ان تحديد استهلاكه لا يؤثر على عمله سلباً فهو واهم، كما ان من يظن انه يمكن زيادة استهلاكه عن عمله هو أكثر وهماً، لكن الحقيقة الناصعة تبين ان الإنسان يتعاظم عمله ويتزايد كلما كانت فرصة الاستهلاك متاحة له بقدر ما يعمل، وكلما انسدت أمامه فرص الاستهلاك تضاءل عمله وتلاشى. وهذا يقودنا الى القاعدة الاقتصادية وهي ان زيادة الاستهلاك المتاح يؤدي الى زيادة في العمل مما يزيد من فرص الفائض الاقتصادي وإعادة الاستخدام لرأس المال في الإنفاق الاستثماري الذي يوسع دائرة العمل كماً ونوعاً لسد أبواب الفقر في المجتمع.
علينا أولاً ان نحدد معنى الاستهلاك المقصود هنا فهو عبارة عن شيئين اثنين أولهما ما يحصل عليه الفرد من طعام وكساء ولوازم حياتية، وثانيهما ما يستمتع به من خدمات عينية سواء كانت فردية او مجتمعية. والإنسان يسعى دائماً ودون كلل للحصول على اكبر قدر من هذه الحاجات الأساسية وخاصة في المجتمع الإسلامي الذي يستوجب توفير فرص عمل عادلة وظروف تمكنه من إطلاق طاقاته ونشاطاته ولكن في حدود المصلحة العامة واحترام الملكية الاجتماعية الخاصة والعامة بحيث لا يميل او يشتط أي شخص طبيعي او اعتباري في احتكار أو امتلاك ما قد يستخدمه في استغلال الآخرين. ولكن الإنسان لا يستطيع ان يزيد استهلاكه ما لم يزد من عمله، فالعلاقة هنا وثيقة بين العمل والاستهلاك، فإذا رغب الفرد في حصول على أجور مرتفعة ليتأتى له بها الحصول على زيادة في الاستهلاك، فإن السبيل الأوحد المشروع له هو بذل مزيد من العمل والإنتاج. وهنا يكمن السر الأعظم في تحريك الطاقة البشرية، فكل زيادة في الإنتاج والعمل سوف تؤدي الى زيادة في الاستهلاك، وهذا يعني ان الهوة بين الإنتاج والاستهلاك سوف تكبر باستمرار حسب الزيادة في العمل والاستهلاك ذاتها. ولتبسيط هذا الرأي نرمز الى العلاقة بين الاستهلاك والعمل في مرحلة معينة كالعلاقة بين الرقمين (6:4). أما في مرحلة نمو هذه العلاقة فإنها تكون كالعلاقة بين الرقمين (15:10) والفارق النسبي المتزايد هو بطبيعة الحال «الفائض الاقتصادي» الذي يتحول الى رأس مال استثماري لإنفاقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذاتها التي هي محور التطور الحضاري والرقي الاجتماعي.
يوصف النشاط الاجتماعي والاقتصادي للإنسان حينما يعمل بوصفٍ دالٍ على نوعية هذا النشاط. فحينما يعمل الإنسان ليصنع منافعه يوصف عمله بمجال إنتاجي، وحينما يستهلك ثمرة منافعه يوصف عمله بمجال خدماتي. غير إننا في مجال الآلة نصف صيانتها بعمل إنتاجي، أما في مجال العمل فنصف صيانة الانسان بأنه عمل خدماتي، مع ان مجالات الاستهلاك ما هي في حقيقتها إلا وقاية وعلاج وصيانة لحياة الانسان المستعمر للأرض الذي يفعل فعله في المادة فينتج منها خيرات كثيرة، ليستهلك منها نصيبه.
وإذا كانت مستويات صيانة الانسان «القوى البشرية» تكون دائماً في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي وليست أعلى منه، فيجب ان تكون لها أولوية واقعية عند العمل، إذ ان العمل يصنعه الانسان ولا يجيد الانسان صناعة العمل ما لم يكن هو مصوناً بالقدر اللازم الممكن، فإذا كان الإنفاق الاستهلاكي هو من أكبر الحوافز على العمل فعلينا ان ننظر إذن في الوسائل التي يمكن بها تطوير إنتاجية العمل لدى القوى البشرية العاملة، وهذا هو محور القضية الكبرى في تخطيط القوى البشرية وإستراتيجية نشاطها. وهو ما يدل على أهمية قطاع الخدمات وخاصة الجانب الاجتماعي منه الذي يخدم قطاع الإنتاج ودوره في صيانة القوى العاملة وحشد جهودها وتنظيمها وإطلاق طاقاتها وقدراتها او بمعنى أبسط كيف يجعل هذه القوى الإنسانية العاملة تتحفز وتزيد من عملها وإنتاجها كماً ونوعاً.
إن إحداث الزيادة في العمل تعتمد أساساً على قضيتين رئيسيتين هما: (أ)تطور الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية العاملة (ب) تخطيط حاجة العمل من الموارد البشرية في الدولة والمجتمع. وهو ما يستدعي معالجة هاتين القضيتين في مقالين قادمين، بإذن الله.
نيسان/أبريل 2005 [email protected]
قال تعالى بشأن مكافحة الفقر: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ} ( اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (البقرة/273)، {وَاعْلَم {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (الذاريا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَك أَعْطَى وَاتَّقَى ü وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ü فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} (الليل/5، 6،7)، {الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} (الليل/18).
2) الإنفاق من اجل تحرير الانسان من العبودية
بما أن الفقر يؤدي بالإنسان إلى العبودية وإلى بيع الأعراض فقد قرر الإسلام محاربته واستئصاله لأنه منبع الشرور لحياة الإنسان. إن الفقر يسلب حرية الانسان في جوانب عديدة لكن مذلة الفقر وهَوانِه تجعل بعض الناس من الأقوياء يستعبدون المستضعفين بالفقر بوسائل مختلفة طوال التاريخ، فإذا كان الانسان قديماً يباع ويشترى جسماً وعقلاً بسبب الفقر فإن بيع الانسان لكرامته او لعرضه مازال قائماً حتى اليوم بسبب الفقر وحينما يبيع الانسان نفسه او يبيع او يؤجر أجزاءً محرمة من جسده بدافع الفاقة والحاجة فإنه يكون فاقداً لحريته وشخصيته المستقلة حينما يتعرض كيانه لانتهاك من الآخر وتتحطم كرامته على مطامع ومباذل الغير. وعليه فإن الإنفاق من اجل تحرير الانسان من العبودية بامتلاكه عقلاً وجسداً او بانتهاك جسده تعذيباً او تلذذاً هو فريضة وواجب شرعي. وإذا كانت العبودية تعني الطاعة العمياء للآخر وفقدان الحرية الشخصية وتعذيب الجسد والتمييز والاضطهاد واستلاب حرية الرأي والنقد فإنها اليوم مازالت تمارس بألوان مختلفة مثل: التمييز والاضطهاد العنصري لأسباب اجتماعية مختلفة وتعذيب الأسرى والمعتقلين وتجارة بيع الأعضاء البشرية وتجارة البغاء الدولية للنساء والغلمان واستغلال العمالة المهاجرة وإجراء التجارب اللا إنسانية على الضعفاء والفقراء في السلم والحرب وتسميم الشعوب المختلفة بالمخدرات والكيماويات والنفايات القاتلة، ناهيك عن استعباد العقول وتغريبها عن الحق والخير والعدل بالتضليل الفكري والإعلامي الذي يمارسه أعداء العروبة والإسلام. وقد قررت أحكام الإسلام تحريم عبودية الانسان وأمرت بالإنفاق في سبيل تحريره، ونورد بعضاً من آيات الذكر الحكيم بهذا الشأن وهي: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَا (التوبة/60)، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (النور/33).
3) الإنفاق للجهاد عن المجتمع الإسلامي ودولته
إن فريضة الجهاد في الإسلام هي لبناء وحماية الدولة القوية العادلة والمجتمع الإسلامي الصحيح المتحرر من الفقر والتخلف، فالجهاد هو العمل بشقيه من نفس ومال. فالمال ما هو إلا صورة للعمل المكنوز في ثروة عينية او نقدية ثابتة او منقولة، أما النفس المجاهدة فهي الانسان المسلم حينما يكون كادحاً وعاملاً ومكافحاً ومحارباً. ولذلك فإن فريضة الجهاد مكونة من العمل البنّاء والعمل المسلح للدفاع عن بنيان المجتمع الإسلامي وكيان دولته او بعبارة شائعة «يد تبني ويد تدافع» لأن مفهوم العمل في الإسلام هو مفهوم الجهاد بذاته. ولذلك تميز العرب والمسلمون طوال التاريخ وحتى الآن بالجهاد الدائم ضد «الاستخراب الاستعماري» وضد «الاستكبار الإمبريالي» المعولم. وقد قررت أحكام الذكر الحكيم فريضة الجهاد لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ (التوبة/88)، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (الصف/11).
(ز) جعل العلم والصحة فريضتين على الفرد والدولة
إن الدولة في المجتمع الإسلامي التي تمثل القوى الإنسانية العاملة الخيِّرة من المواطنين ملزمة بتوفير العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل للجميع كحق أساسي حتى يتحول الى سلاح فعّال للتنمية هذه بيد القوى البشرية لتنفيذ أعمالها والقيام بمهامها بطريقة أبسط وأوفر وأرقى بما يزيد في حجم ونوعية العمل الذي تؤديه القوى البشرية العاملة. كما أنها ملزمة بتوفير الصحة العامة للجميع كحق أساسي أيضاً لهذه القوى البشرية كي تعمل بطاقاتها كاملة طوال حياتها في تنمية المجتمع والدولة. وقد أوضحنا في مقال سابق عن القيم الاجتماعية للعمل في الإسلام أن العلم والصحة هما فريضتان على الفرد والدولة لا محيص عنهما تحت أية ذريعة مادية او معنوية، لأنهما حقان أساسيان من الحقوق الأساسية للإنسان في الإسلام. فالطاقة الإنتاجية لقوة العمل البشرية تتعطل بالجهل (نقيض العلم) وتتناقص بالمرض (نقيض الصحة) فلا يتحقق استعمار الأرض الحضاري وتطور الحياة الإنسانية عليها كما أمر به القرآن الكريم.
(3) الإنسان غاية التنمية ووسيلتها:
وإذا كان استعمار الأرض الحضاري بالعمل الإنساني الهادف الى خدمة «القوى البشرية» لا ينهض إلا على اكتاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخططة تخطيطاً سليماً، فإن التنمية الصحيحة الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ان تقوم إلا على سواعد «القوى البشرية» ذاتها، فهي الهدف الأسمى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوسيلة العظمى لها، أي أن هذه القوى البشرية العاملة هي غاية ووسيلة في آن واحد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال الآن هو كيف تكون القوى البشرية غاية ووسيلة للتنمية الاقتصادية في آن واحد؟ يعتبر الفكر الليبرالي في المجتمع الرأسمالي الاستغلالي القوى البشرية وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية بعد تغييب عنصر العمل الإنساني من المال، أما ان تكون غاية فهو أمر غير صحيح لأن الطبقة الرأسمالية الاستغلالية المترفة تكرس كل تنمية اقتصادية مجزأة ومجمعة لخدمة طبقتها مهما ردت للقوى البشرية وتفضلت به من فائض قيمة عملها لتجنب سخطها في شكل خدمات معينة ومحددة واحتكرت لنفسها الاستمتاع بخدمات ومتارف لا حدود لها. أما في المجتمع الإسلامي فإن «القوى البشرية» التي هي كل الشعب العامل بكافة شرائحها الاجتماعية من أثرياء وأغنياء وموسرين وقادرين وفقراء هي وسيلة وغاية في نفس الوقت للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالاستغلال ليس من أهدافها لأن المجتمع الإسلامي الذي تُنميه وتبنيه مؤسس على قوة العمل المبذولة بالتعاون والتضامن والتكافل والتراحم هي من جميع أفراد القوى البشرية العاملة فيه. ومحور المشكلة هنا هو كيف نفهم العلاقة العضوية والجدلية بين الوسيلة والغاية عند التطبيق التنموي للاقتصاد الوطني.
إن عمل القوى البشرية وإنتاجها هو وسيلة، أما انتفاع القوى البشرية بخيرات عملها في صورة ضرورات وخدمات متنوعة فهو غاية. إذن أي جيل تاريخي من القوى البشرية الذي يجب ان تخدمه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدف له. إن الحياة ببشرها وزمانها في ديمومة مستمرة لا تنقطع لحظة واحدة، وهذا يدل على أنه عندما يخطط للاقتصاد الوطني يجب ان تكون القوى البشرية الحاضرة والقادمة في مخيلتنا على الدوام بحيث لا نحمل القوى البشرية القادمة من أحفادنا أعباء القروض والديون التي تدل على عدم اعتمادنا في أيامنا على قوتنا الحقيقية في العمل والإنتاج، بل تدل على حياة طفيلية استمرأها عملاء التواكل والتكاسل من القادة والمخططين في الدولة الذين لا يريدون بناء المجتمع القوي على أسس إسلامية صحيحة. ان نتائج كل عمل حالي تمتد الى العمل اللاحق به، كما ان أعمال ومنافع ومفاسد كل جيل تمتد الى أعمال الجيل اللاحق به، وهكذا دواليك، بحيث يصعب تحديد الحدود بين الأجيال المتلاحقة. وعليه فإن كل جيل يعطي كثيراً للجيل اللاحق به ولكن هذا العطاء يجب ان لا يتحول الى عبء يثقل كاهل الجيل اللاحق. ولذلك فإن خطط التنمية يجب ان تكون أولاً مرحلية من حيث الغاية بحيث تعطي لنفس القوى البشرية التي تنفذها بعض خيرات عملها، وثانياً عليها ان تخطط مواردها وإمكانياتها لتحدث التنمية المباشرة في الحاجات الأساسية لمعيشة القوى البشرية، وثالثاً على القوى البشرية ان تحدث تنمية آجلة للضرورات الثانوية التي تعتبر مكملة لحاجاتها الأساسية حسب ضرورات العصر، ورابعاً على القوى البشرية ان تحدث تنمية طويلة الأمد في مجال المستلزمات الأخرى التي يقتضيها تطور عصرها. غير ان كل مرحلة من مراحل التنمية يجب ان تحقق نفاذاً أفقياً شاملاً لتلبية الحاجات الأساسية للقوى البشرية من السكان بما فيها القضاء على الفقر وتحقق نفاذاً رأسياً وتطوراً نوعياً للخدمات ووسائل الإنتاج على المدى الأطول.
(4) الإنفاق الاستثماري وسيلة التنمية:
إذا سلمنا بأن القوى البشرية هي غاية ووسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، أي ان عمل هذه القوى البشرية هو وسيلة للتنمية واستهلاكها لمنافع أعمالها هو غاية، فكيف يمكننا ان نقيم المعادلة الصعبة بينهما؟ والجواب على هذا هو ان آلية السوق الاقتصادية منذ أقدم العصور قد حلت هذا الإشكال عملياً، غير ان ثمنه كان باهضاً بالنسبة للمجتمع البشري فأوجدت ما سُمي «بالربح» او فيما عُرف فيما بعد «بفائض القيمة» او «بالفائض الاقتصادي» الذي يمثل الفارق بين الخرج والدخل، او بين مدخلات العمل ومخرجاته، او بين ما أُنفق فيه وبين ما استُهلك منه الذي يتحول الى قيمة مالية يعاد استخدامها في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرّف القران الكريم مفهوم «الفائض الأقتصادي» بكلمة«"الفضل» التي وردت في عشرات الآيات مؤكدة بأن خير الله ورزقه يفيض على عباده فالمال هو من الله واليه وليس ملكا لبشر. تقول بعض الآيات الكريمة عن «الفضل»: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ا بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَ (البقريَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (النور/38).
وكلمة «الفضل» تعني ما يزيد عن حاجة الانسان بعد «انفاقه الاستهلاكي» في معيشة كريمة كافية. والانسان حينما يدخر المال بالحفاظ على ما يفضل منه بعد الانفاق الكفائي على معيشته الكريمة وينفق هذا «الفضل» إنفاقاً استثمارياً في صالح المجتمع فانه يعتبر فضلاً من الله مقصده إشاعة الفضيلة بين الناس، أما حينما يساء انفاق المال الزائد عن حاجة الانسان في غير صالح المجتمع فانه يكون مجرد «فضلات» رديئة خاصة بصاحبها ولا تنفع الناس في تطوير معيشتهم، وقد اثبت التاريخ لنا ان بعض الطواغيت ذهبوا ببعض اموالهم الى قبورهم فلم تغن اموالهم عنهم بشيء، وهذا حال لا يختلف عن حال البخلاء الاحياء الذين يحبسون اموالهم عن الانفاق الاستثماري او المترفين الذين يبذرونها في الانفاق الشيطاني بما لاينفع جماعة او مجتمعاً على الارض، مخالفين بذلك مقاصد الشريعة الاسلامية في النماء والحياة.
نستخرج من هذه القاعدة الاقتصادية فكرتين أولهما انه يجب على القوى البشرية العاملة ان لا تستهلك كل قيمة عملها بل تدخر جزءاً من قيمة عملها بحيث تكون القيمة المقدمة لها في شكل أجور نقدية وخدمات عينية بشكل فردي او جماعي او مجتمعي اقل من القيمة الكلية لثمن قوة عملها حتى توجد «الفائض الاقتصادي». وثاني الفكرتين هو ان الفائض الاقتصادي الواجب توفيره دائماً سيتحول الى تراكمات مادية ومالية لإنفاقها في استثمارات جديدة لبناء وتقوية مصادر الثروة القومية ووسائل إنتاجها، إذ ان التطور والتقدم بكافة صوره لا يكون إلا بالمداومة على بناء وتقوية مصادر الثروة القومية ووسائل إنتاجها وليس بالاقتراض المجحف او الاستدانة المرهقة. والسؤال الآن هو كيف يستخدم «الفائض الاقتصادي» في المجتمع الإسلامي؟
إن دخل الفرد والمجتمع والدولة يجب ان يكون في حدود استهلاك كل منهم بما يضمن حد الكفاية للجميع بالوسائل الإنمائية الاقتصادية والوسائل التكافلية الاجتماعية بغير إسراف او ترف وحسب مستوى المعيشة وقوة الاقتصاد الوطني. فالطريق الأمثل الى إحداث الفائض الاقتصادي هو بتقدير فارق مناسب بين «الإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي»، او بين التكاليف من جانب والنفقات من جانب آخر، إذ ان الفارق هو صافي الربح، غير ان الربح ليس فردياً او خاصاً ولكنه ملكية اجتماعية عامة وخاصة يستفاد منها في تحقيق مصلحة خاصة وعامة. فلذلك يعتبر «فائضاً اقتصادياً» في نظر المجتمع الإسلامي لأنه يعبر عن مدى اقتصاد القوى البشرية في نفقاتها. وخلاصة الأمر انه ليس في صالح القوى البشرية ان تستهلك كل قيمة عملها بل يجب ان تدخر جزءاً من قيمة عملها لتستثمره في شكل أموال ومواد حتى تزيد بذلك من قوة عملها وإنتاجها لتطوي بها مراحل التطور والتقدم. والقضية النابعة من هذه الفكرة هي كيف يزاد هذا الفائض الاقتصادي الذي تعتمد عليه مسألة التنمية الشاملة للاقتصاد والمجتمع.
(5) الإنفاق (الاستهلاكي) غاية التنمية :
إن هذه القاعدة الاقتصادية تقودنا الى فهم العلاقة العضوية بين العمل والاستهلاك، وإذا نظرنا الى الاستهلاك لوجدنا ان الإنسان مجبول عليه بفطرته وغرائزه وتحضره لإشباع حاجاته الأساسية التي لا يستطيع الحياة بدونها ولذلك فهو يعمل ليستهلك بأوسع ما يحمله هذا المعنى من استهلاك مادي وروحي ومجتمعي. فالإنسان او في صيغته الجامعة «القوى البشرية» إنسان عامل ومستهلك في آن واحد، كلما زاد من عمله زاد من استهلاكه، ولا يمكن تحديد مستوى الشبع والقناعة عنده حتى في حدود حاجاته الأساسية المتزايدة. وكل من ظن ان تحديد استهلاكه لا يؤثر على عمله سلباً فهو واهم، كما ان من يظن انه يمكن زيادة استهلاكه عن عمله هو أكثر وهماً، لكن الحقيقة الناصعة تبين ان الإنسان يتعاظم عمله ويتزايد كلما كانت فرصة الاستهلاك متاحة له بقدر ما يعمل، وكلما انسدت أمامه فرص الاستهلاك تضاءل عمله وتلاشى. وهذا يقودنا الى القاعدة الاقتصادية وهي ان زيادة الاستهلاك المتاح يؤدي الى زيادة في العمل مما يزيد من فرص الفائض الاقتصادي وإعادة الاستخدام لرأس المال في الإنفاق الاستثماري الذي يوسع دائرة العمل كماً ونوعاً لسد أبواب الفقر في المجتمع.
علينا أولاً ان نحدد معنى الاستهلاك المقصود هنا فهو عبارة عن شيئين اثنين أولهما ما يحصل عليه الفرد من طعام وكساء ولوازم حياتية، وثانيهما ما يستمتع به من خدمات عينية سواء كانت فردية او مجتمعية. والإنسان يسعى دائماً ودون كلل للحصول على اكبر قدر من هذه الحاجات الأساسية وخاصة في المجتمع الإسلامي الذي يستوجب توفير فرص عمل عادلة وظروف تمكنه من إطلاق طاقاته ونشاطاته ولكن في حدود المصلحة العامة واحترام الملكية الاجتماعية الخاصة والعامة بحيث لا يميل او يشتط أي شخص طبيعي او اعتباري في احتكار أو امتلاك ما قد يستخدمه في استغلال الآخرين. ولكن الإنسان لا يستطيع ان يزيد استهلاكه ما لم يزد من عمله، فالعلاقة هنا وثيقة بين العمل والاستهلاك، فإذا رغب الفرد في حصول على أجور مرتفعة ليتأتى له بها الحصول على زيادة في الاستهلاك، فإن السبيل الأوحد المشروع له هو بذل مزيد من العمل والإنتاج. وهنا يكمن السر الأعظم في تحريك الطاقة البشرية، فكل زيادة في الإنتاج والعمل سوف تؤدي الى زيادة في الاستهلاك، وهذا يعني ان الهوة بين الإنتاج والاستهلاك سوف تكبر باستمرار حسب الزيادة في العمل والاستهلاك ذاتها. ولتبسيط هذا الرأي نرمز الى العلاقة بين الاستهلاك والعمل في مرحلة معينة كالعلاقة بين الرقمين (6:4). أما في مرحلة نمو هذه العلاقة فإنها تكون كالعلاقة بين الرقمين (15:10) والفارق النسبي المتزايد هو بطبيعة الحال «الفائض الاقتصادي» الذي يتحول الى رأس مال استثماري لإنفاقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذاتها التي هي محور التطور الحضاري والرقي الاجتماعي.
يوصف النشاط الاجتماعي والاقتصادي للإنسان حينما يعمل بوصفٍ دالٍ على نوعية هذا النشاط. فحينما يعمل الإنسان ليصنع منافعه يوصف عمله بمجال إنتاجي، وحينما يستهلك ثمرة منافعه يوصف عمله بمجال خدماتي. غير إننا في مجال الآلة نصف صيانتها بعمل إنتاجي، أما في مجال العمل فنصف صيانة الانسان بأنه عمل خدماتي، مع ان مجالات الاستهلاك ما هي في حقيقتها إلا وقاية وعلاج وصيانة لحياة الانسان المستعمر للأرض الذي يفعل فعله في المادة فينتج منها خيرات كثيرة، ليستهلك منها نصيبه.
وإذا كانت مستويات صيانة الانسان «القوى البشرية» تكون دائماً في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي وليست أعلى منه، فيجب ان تكون لها أولوية واقعية عند العمل، إذ ان العمل يصنعه الانسان ولا يجيد الانسان صناعة العمل ما لم يكن هو مصوناً بالقدر اللازم الممكن، فإذا كان الإنفاق الاستهلاكي هو من أكبر الحوافز على العمل فعلينا ان ننظر إذن في الوسائل التي يمكن بها تطوير إنتاجية العمل لدى القوى البشرية العاملة، وهذا هو محور القضية الكبرى في تخطيط القوى البشرية وإستراتيجية نشاطها. وهو ما يدل على أهمية قطاع الخدمات وخاصة الجانب الاجتماعي منه الذي يخدم قطاع الإنتاج ودوره في صيانة القوى العاملة وحشد جهودها وتنظيمها وإطلاق طاقاتها وقدراتها او بمعنى أبسط كيف يجعل هذه القوى الإنسانية العاملة تتحفز وتزيد من عملها وإنتاجها كماً ونوعاً.
إن إحداث الزيادة في العمل تعتمد أساساً على قضيتين رئيسيتين هما: (أ)تطور الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية العاملة (ب) تخطيط حاجة العمل من الموارد البشرية في الدولة والمجتمع. وهو ما يستدعي معالجة هاتين القضيتين في مقالين قادمين، بإذن الله.
نيسان/أبريل 2005 [email protected]