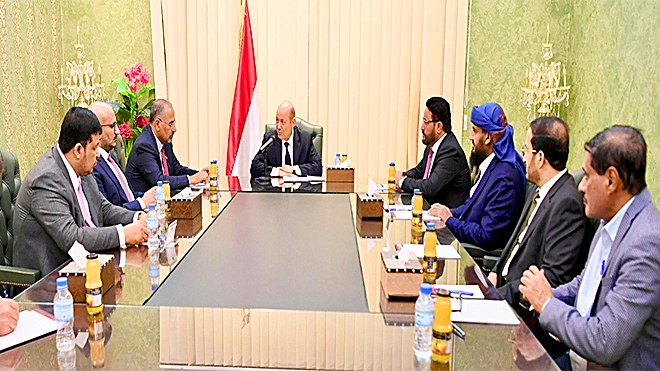> صنعاء «الأيام» محمد الظاهري:
اسمه له وقع يوحي بالقداسة، رجل الاستثناء،«إلا الأستاذ عبدالباري»، عبارة تتردد كلما بدأ الصحافيون مشروع «حشوش» ضد «الحرس القديم». رجل البساطة أبدا، رجل الفكر قطعا، رجل الوداعة دوما، رجل السياسة، التاريخ، ورجل النكتة. قد يسهل اعتبار عبدالباري طاهر رائعا في سطور، غير أن محاولة اختزال حياة مزدحمة بالأحداث هي محاولة جديرة باسم «مهمة صعبة جدا»، تتوه البدايات مع رجل بدأ مشروع فقيه فأعجب بالماركسية. عشق الثورة وانتهى بالبحث عن راتب تقاعدي، سرق المخبرون وثيقته أو أحرقتها زوجة أرعبها وقع أقدامهم، ستفكر ربما بطالب العلم في «كتّاب» تصله منشورات (الأحرار)، أو المعلم في أول صفوف بنتها الثورة. ربما طلائع مجلة الكلمة، أو ستروقك أكثر دهاليز العمل السري، وسائق الأجرة المتخفي قبل أن تخلصه من شؤمه «صومالية»، طالما استعصت عليّ البداية، ومع رجل البدايات فقدت صوابي.
ثمة بداية في حكاية خطأ مطبعي أقاله من «الثورة» حين كان الوطن يعين رئيس التحرير صباحا ويقيله قبل المساء,أيام حين نسمع عنها لا نصدق كيف أمكنهم العيش فيها، وكيف أفسح زحام المخبرين في وطن لم يجف دم ثواره بعد، مكانا لشيء آخر غيرهم.
وبداية أخرى في حكاية انتخابه أول نقيب للصحافيين اليمنيين، سيرة ثورتين بحثتا عن الحرية واختلفتا عليها في النهاية لتكون نقابة الصحافيين آخر ما يمكن الحديث عنه في مشروع مستقبلي للوحدة.
كل بدايات عبدالباري طاهر هكذا، مجرد تواريخ لحدث ما، كلما حاولت إعادة عبدالباري إلى حياته الخاصة انتفض منها كشيء غير مهم، ليروي تاريخ وطن.
يأسرك تواضعه، ويحرجك أيضا، في منزله الصغير يرفض الجلوس بمحاذاتك، يترك وسائده لك ولمصور يرافقك، ويفترش الأرض.
بدلاً من مطاردة البدايات، سأبدأ من هنا، من أول شيء جعلني أحملق في الرجل الذي يصر دائما على سؤالي كلما سارعت لمصافحته: «كيف حال الوالد؟»، رغم أنه لا يعرفني أصلا..
كنا في نقابة الصحافيين، وسط ضوضاء الإعداد لأحد مؤتمراتها العامة، وكنت أعلم أن هذا الرجل حين يتحدث ينصت الجميع، وحين يشير يطيعه قطيع من المتمردين في مجتمع يرفض حتى النصيحة.
كنت أعلم أن مقالتي السياسية أو الأدبية لن تكون أفضل دون رأي هذا الرجل الأشعث، يومها أضاف شيئا جديدا لأعرفه حين سحب أحد الكراسي دون أن يبتعد عن كل الضوضاء حوله وبدأ يكتب.
تعلم عبدالباري طاهر كيف يطارح أفكاره الغرام كيفما اتفق، لا يبالي بشيء حين تومض فكرة، يكتب وسط أعلى ضجيج ممكن وكأنه في أكثر مكان ملهم في العالم.
يفعل ذلك تاركا لك حق الاندهاش ما استطعت، «تأتي الفكرة» فيبدأ بالكتابة غير مكترث لا بالزمان ولا المكان ولا بك أيضا، يلوذ بأوراقه ويبدأ، أحداث وحكايات كثيرة علمته كيف يفعل ذلك.
أمام جنونه هذا للمرة الأولى لم أدر هل أصرخ بأعلى صوتي للتأكد من أنه جاد فيما يقدم عليه، أو أكتفي بمراقبته مبهورا ببريق حروف تولد هكذا، حروف تفضح حمق اعتقادي أن الكتابة طقس أفلاطوني وإن غالبا انتهى بي إلى لا شيء.
أجمل الكلمات تأتي قبل استدعائها، وأجمل الأعمال لا تحتاج أن تقضي عمرك في محاولة جعلها تبدو أنيقة.
مشروع لإنتاج فقيه
في 8 مارس 1941 حصلت «المراوعة»، أحد أجمل مناطق محافظة الحديدة غرب صنعاء، على مولود جديد أطلق عليه اسم «عبدالباري» كعنوان جميل لحلم أسرة علم، أو محاولة للحفاظ على نسل له باع طويل في علوم الدين والتصوف.
وكرس والده الفقيه المتصوف، والمزارع أكثر، محمد بن محمد طاهر الأهدل الكثير من الوقت لتعليمه علوم الدين ليغدو القاضي عبدالباري، وعلوم الزراعة ليعيش، وبدا أن المشروع ينجح.
يكبر الصغير، ويكبر معه شغفه بالقراءة وتدربت ذاكرته على الحفظ وأرشفة كل ما يمر بها، أصبح مشروع فقيه المستقبل أكثر قربا والفتى يظهر تميزا في «الكتّاب» ويظهر ولعا بالكتب.
غير أن مولود «الحوت» ليس الشخص المناسب لوضعه في قالب معد سلفا، قد يكون هادئا لدرجة يصعب التنبؤ بموقفه، وانطوائي إلى حد ما فتصبح القراءة هواية رائعة تبقيه حيث يريد. إلا إنه لا يحبذ القوالب المسبقة، وينفر من كل ما يفرض عليه.
نشأ عبدالباري طاهر في قرية يمنية في الأربعينات والخمسينات، إنها آخر مكان يسمح بالترف، أو حتى يعرف معناه، كان والده «عالم دين ومزارعاً، حظه من الزراعة أكبر»، لذا كان إما في الحقل أو يخضع لدرس تحفيظ، أو يتعلم القراءة ومبادئ الإعراب.
الجزء الثاني من حياته اليومية هو الجزء الذي يبغضه الأطفال أكثر من أي شيء آخر، وهو أيضا غير متوافر لكل أبناء القرية، معظم الآباء مجرد مزارعين لم تتح لهم فرصة التعلم ليعلموا أبناءهم.وقليلون كانوا يهتمون بإلحاق أبنائهم بكتّاب القرية أو بفقيه مقابل اقتطاع جزء من قوتهم الزهيد أصلا لـ«سيدنا»، كانوا يفضلون الاستفادة من الأبناء في العمل.
فذلك أجدى، القراءة في الكتاب لن تحصد كيس قمح نهاية الموسم، على العكس، إنها ستكلفهم لوحا من الخشب ووقتا لجمع «السخام» من جدران المطبخ العتيق وتحويله إلى حبر تتقبله أعواد اليراع، بالإضافة إلى أجر «سيدنا».
وسيدنا لا يتعامل بالدين، إنه يجيد أشياء كثيرة، يجيد توبيخ العائلة المقصرة في خطبة، يجيد إرعاب الطلاب بعصا طويلة لا تكلفه مشقة القيام إلى الطالب الأخير، ويجيد سيدنا النوم فيما يتلو الصبية قصار السور. يجيد أشياء كثيرة، وأحيانا يجيد التعليم.
الخطوة التالية في مشروع «الفقيه المنتظر» عبدالباري كانت نقله إلى الكتّاب ليحصل على وقت أكبر للتعليم من دون مشاغل والده بالزراعة، ولتميزه، أصبح طالبا في الجامع الكبير في المراوعة..الجامع الكبير دائما مرحلة متقدمة بعد كتّاب القرية، وفي «الجامع الكبير» يدرس الطلاب المتفوقون، وفيه أيضا يكون «سيدنا» من النوع الذي يجيد التعليم، بالإضافة إلى المهارات الأخرى طبعا.
ويتذكر عبدالباري طاهر أسماء معلميه في «الجامع الكبير»، الجميع يتذكرون معلميهم في «الكتاتيب» وإن لم يكن للسبب نفسه كل مرة، يتذكرونهم إما لأنهم سيئون جدا أو جيدون جدا، وعبدالباري تحدث عن معلميه باحترام، نطق أسماءهم بشيء من المهابة والإجلال.
رضاعة التغيير
تفاقمت حالة عبدالباري، أصبحت القراءة أكثر من مجرد تفتيش بين دفتي كتاب، فبدأ بغزو مكتبات أساتذته وكل من يعرف أن لديهم مكتبة بعد أن انتهى من مكتبة أبيه، وتغيرت ذائقته في انتقاء الكتب، أصبح يعرف بأن هناك دفتين بينهما شيء غير الفقه وقواعد الإعراب، ومع كل كتاب جديد كان ينسلخ من حلم أبيه.
قرأ عن الانقلاب العثماني وهو في المسجد فعرف لماذا يكره الفلاحون والعمال في قريته المشايخ والإقطاعيين.
بدأت منشورات (الأحرار) تستهويه، وتصل إليه من عدن وصنعاء وتعز: «كانت تصل إلى الحديدة بشكل كبير»، وأول ما حصل عليه منها من بعض معلميه وفقيه قريته محمد بن عبدالباري الذي كان على تواصل مع الأحرار.
المعلمون كانوا غالبا ينتمون إلى طبقة (السادة) المنتسبين إلى آل البيت، و«السادة» هي الطبقة الحاكمة في اليمن، والفقهاء دائما تابعون مطيعون، وبدا غريبا أن تصلهم منشورات من يخططون للثورة، ويقوموا بنقلها إلى طلابهم.
يقول عبدالباري: لم يكن ظهر بعد «الإسلام السياسي»، مفسرا وصول منشورات محرمة تتضمن أفكارا محرمة بالنسبة لفقيه إلى أيدي فقهاء وعلماء يوزعونها ويناقشونها، «كانوا متسامحين ولديهم قبول بالرأي الآخر».
دون تفسيره كنقيض للعقيدة، ربما كان ذلك في الحديدة فقط، فهي محافظة تجنح للسلم، غالبا تفعل ذلك أكثر من اللازم، لذا ما زالت محافظة تسكن القش، وتصدر الكهرباء مبقية لنفسها الظلام والقيظ.
بدأ عبدالباري يتصل أكثر بمؤيدي الأحرار، ويتبنى أفكارهم، وبدأ والده يشعر بالخيبة من ضياع فقيهه المنتظر.
أصبحت علاقته بأسرته «ظاهريا جيدة، لكن في العمق خلاف وخيبة أمل»، كان ذلك حسب عبدالباري حال اليمن كلها، كانت منقسمة بين الثوار والملكية.
أنصار دولة الإمام والخائفون منها يعتبرون الثوار (دستوريين) كفارا يريدون استبدال القرآن بالدستور، أصبح إيقاع الحديث عن الثورة أكثر تأثيرا بعد دخول الراديو وتسرب أنباء الثورات هنا وهناك.
حين اغتيل الإمام يحيى حميد الدين عام 1948 كان عبدالباري ما يزال صغيرا، لكنه يذكر اليوم أن الخلاف والانقسام كان أضعف، كانت الأغلبية غاضبة من الحادث.
يذكر أن بعض مناصري الثوار اعتقلوا، من ضمنهم ابن عمه، وكانوا يسمونهم «الأشرار».
منطقة تهامة مسالمة بالفطرة، وهي مع الثورة في العمق، لكن «كان لدى الكبار بعض التحفظ على حركة الشباب، ونحن كانت أفكارنا فيها الكثير من المراهقة والحدة»، قال ذلك بجدية، ولم يجتهد لتذكر حكاية، لديه ذاكرة يسهل التعامل معها.
سرد نموذجا عن حماس الشباب، بعد مقتل الإمام سارع الأستاذ أحمد جابر عفيف بأخذ البيعة للإمام الجديد الذي نصبه الثوار كإمام دستوري «كان هناك متحمسون، لكن المتحفظين كانوا أكثر».
تغير الأمر مع حركة 1955 التي نفذتها مجموعة من الضباط ضد نظام الإمام أحمد يحيى حميد الدين، وكان الخلاف أكثر حدة، وأنصار الثورة أكثر.
دخل الراديو وبدأت ترد أنباء الثورات هنا وهناك، ثورة مصر وثورة في العراق، قال عبدالباري الذي أصبح يومها أكبر، حدث انقسام وخلاف، لكن التحفظ أقل، أصبح الناس يرون في النظام الجديد شيئا أفضل.
ورغم مسالمة المنطقة التي ينتمي إليها إلا أن «نظام الإمام كان قاسيا، كان الخوف أكثر من الطاعة، والاستسلام أقرب من الحب، هكذا فسر ما واجهه التغيير من حذر وضعف؛ في ما استمر حماس الشباب من دون ترو في كثير من المناطق وليس كلها: «بعضنا انضم إلى الحرس الوطني، كنا نعمل حركات ومهرجانات، وفي تلك الفترة ظهرت أسماء قوية ومؤثرة».
ويتذكر من تلك الأيام عبدالله الصيقل، عبدالله عطية، علي سعيد الحكمي، عبدالله مهدي عبده، وهم إما علماء أو آتون من مدارس دينية .
ومن بين أغلفة الكتب إلى أحداث مرحلة الطفولة كان عبدالباري طاهر يشرب التغيير، ويغير قناعاته، ويبحث عن نفسه في المستقبل، دون أن يتمكن من رسم صورة واضحة.
إلى مكة
لم يعرف عبدالباري والدته، توفيت وهو طفل، فتزوج والده من إحدى شقيقاتها كما درج عليه اليمنيون، ولا يزال الأمر دارجا إلى اليوم.
لم يكن هناك متسع لشقاء آخر يضاف إلى ضنك العيش وتطاول المرض والجهل، فبحث الناس عن أعراف تجنبهم ما استطاعوا أسباب شقاء محتمل، هكذا توالدت الأعراف، وهذا العرف جنب عبدالباري شقاء العيش مع زوجة أب، فخالته كانت أما رءوما.
درس عبدالباري المذهب الشافعي الذي تشربته مدرسة زبيد والمناطق الغربية من اليمن، فيما تشربت مدارس صنعاء المذهب الزيدي، بالنسبة له لم يكن الأمر بهذا التحديد، يصف ما درسه بأنه خليط، دروس الفقه كانت شافعية، وعلم الكلام أشعري بنكهة سنية، هوسه بالقراءة علمه متعة الانتقال من كتاب إلى آخر، ومن فكر إلى غيره، وجد نفسه أكثر ميلا إلى عدم الاعتقاد بمذاق واحد .
ويعتبر نفسه أقرب إلى الأدب منه إلى فتاوى الدين وجنون السياسة، وبدا أن قدره ساعده كثيرا على عدم البقاء في دائرة واحدة، أو حتى مكان واحد.
بعد المراوعة في الحديدة انتقل إلى صنعاء ليدرس على يد العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الذي أصبح فيما بعد مفتيا لليمن، والعلامة محمد بن محمد المنصور وكلاهما من كبار علماء الزيدية في اليمن.
كان انتقاله إلى صنعاء تجاوزا لمرحلة تقليدية تقتضي انتقاله من «الجامع الكبير» في المراوعة إلى مركز مدرسته الشافعية في »زبيد» إحدى أشهر الحوزات الفقهية في اليمن.
كان تنقله خاضعا لخياراته كما يبدو، لم يلتزم منهجا محددا، ولم يسلك ما سلكه غيره من طرق تقليدية، من صنعاء انتقل إلى «مكة» لمواصلة الدراسة، في 1975 التحق بمدرسة الفلاح، كانت تمثل مدرسة ثانوية بالنسبة لنظام الدراسة الأزهرية، ثم التحق بالمدرسة (العارفية) أو الهندية نسبة إلى جهة التمويل من الهند، ثم مدرسة (الصولتية) الممولة من اندونيسيا.
ويتحدث عن تلك الفترة كإحدى محطتين مهمتين غيرتا مسار حياته في ما بعد، المرحلة الأولى تتعلق باقترابه من الثوار وأفكارهم في اليمن، وهنا وجد نفسه في مكتبة الحرم المكي «أمام كنز».
مازالت أخبار الثورات والانقسامات تملأ الأرجاء، وما زال التشبث بذاكرة عبدالباري بعيدا عن السياسة أمراً مستحيلاً.
دائما يفلت منك إلى السياسة، ينسى كوفيته الصغيرة وحلاق القرية وألعاب سرقها الأطفال في غفلة من بؤس يطحن الكبار، ليتحدث عن أسماء وثورات وأفكار، بالإضافة إلى الدراسة في مكة وجد فرصة عمل في المكتبة، لا يدري من اصطاد الآخر، هو أم مسؤول المكتبة؟
كان سعيدا بأي شيء يبقيه في المكتبة، وكان مسؤول المكتبة قادرا على اختيار مساعديه ممن يرى هوسهم برفوفه، كان العمل في المكتبة مقابل أجر رمزي، ويقول:
«كان هذه الأجر آخر ما استرعى اهتمامي أمام عرض العمل في المكتبة»، كان سعيدا بأن لديه فرصة لمطالعة الكثير من العناوين.
يصف عبدالباري المكتبة بالقول: «كانت مهتمة بجمع كل أنواع الكتب من مختلف المشارب والرؤى»، وكانت الأفكار الماركسية والقومية أقرب إليه، وما يتعلق بها يسترعي اهتمامه، فعاد مهووسا بطه حسين والرفاعي، وحاملا للعقاد، وسيد قطب.
قيام ثورة
كان والده قد توفي أثناء دراسته في صنعاء، تاركا وراءه خمسة من الأبناء وستاً من البنات ، كان عبدالباري وفتاة واحدة من الزوجة الأولى ، ربما لهذا كان حلم والده .
مات والده ربما بخيبة أقل ، ففقيهه المنتظر رغم ما يفعله ما زال يسير على الدرب. كان النصيب الأوفر من الخيبة لبقية الأسرة بعد عودة عبدالباري من مكة وانخراطه بشكل كامل مع الرفاق الجدد، وتشربه للفكر الماركسي.
يقول عبدالباري : «كان رد فعل الأسرة على هذا التحول قاسيا ، حدث ما يشبه القطيعة ، كان يطرح عليهم أني شيوعي وماركسي كافر» .
المد القومي حمل معه فكر الاشتراكية، والاشتراكية جرت إلى الشيوعية ومؤلفات ماركس ولينين ، هكذا يفسر عبدالباري وصول الاشتراكية إلى الباحثين عن الحرية : «كانت الاشتراكية كما هي مدونة أقرب إلى أحلام الناس بالحرية والعتق من سطوة البرجوازية وظلم تقسيم المجتمع إلى طبقات ، لم يكن سؤالي مهذبا كوني أعتبر الاشتراكية رديفا لكل الأشياء السيئة في العالم ، وأستغرب أن تكون هي نتيجة البحث عن الحرية ، وليس ذنبي أني أعتقد ذلك بناء على نتائج النظم الاشتراكية، وليس بناء على الأحلام المدونة في أوراق .
هل كان يفترض بي الاعتذار من رجل تشرب الاشتراكية يوما ما؟ ، وإن بدا اليوم متحررا من كل حماقات السياسة؟ ، اكتفيت بملاحقة حكاية فشلت في محاصرتها في نطاق ما تسمح به قدراتي، ومعرفتي ، اكتفيت أيضا بتجرع الشعور بالجهل أمام رجل خلق ليكون ذاكرة.
ردة فعل أسرته على توجه الجديد لم تثنه ، كانت معتقداته مختلفة وراسخة على الأقل بشأن حلم الحرية. ومجددا يفلت عبدالباري من قصته إلى حكاية وطن ، وحين يتحدث عن الثورة يبدي شجنا خاصا ، وحزنا على فقدان الثورة قيمتها من جيل إلى آخر. كل جيل يأتي يصبح أقل تقديرا لأحادث الماضي وللماضي برمته .
ينظر جيل اليوم إلى الآخر فيشعر بالأسى ، عدم الرضا بالحاضر يفقد أحداث وتحولات الماضي قيمتها. ويهدر دماء الثوار. وهذا كفيل بإغاظة عبدالباري وكل من شهد الثورة ويمن ما قبل الثورة.
ليس أن عبدالباري راض عن الحاضر ، بل لأن مشاكل الحاضر لم تكن يوما نتيجة للثورة ، كانت الثورة نتيجة حتمية لتجاوز الألم قدرة الناس على الاحتمال.
يتحدث كثيرا ثم يختصر الأمر برمته قائلا : «من لم يعرف اليمن قبل الثورة لا يمكنه إنصاف الثورة ، ومن لم يعرف اليمن بعد الثورة لن يتمكن من تقدير ما حدث ويحدث» .
يمن ما قبل الثورة كان ظالما ، قال:«المتوكليون ( المملكة المتوكلية ) ظلمت اليمنيين كلهم، كان نظاما قائما على الجباية وكان الناس مزارعين وعمالا وبسطاء بالكاد يحصلون على ما يقيم الأود» . يتذكر أنه في الزيدية ، في الزهرة ، المراوعة ، زبيد ، وكل مناطق الحديدة التي يعرفها أن أسراً معينة تملك كل شيء فيما البقية لا يملكون شيئا ، كان هذا يحدد نوع العلاقات الاجتماعية ، والحديث للأستاذ عبدالباري، كان هناك سادة وعبيد ، مشائخ ورعية .
ويضيف قائلاً : «الحديدة كانت في المركز الثاني تجاريا بعد عدن، رغم هذا كان ناسها فقراء، بساطتهم وجنوحهم للسلم جعلهم فقراء أكثر من غيرهم ، بالنسبة لي ما زالت كذلك ، الفارق تغيرت، المسميات ، مثلا، في الحديدة بالتحديد ، أصبحت عضوية البرلمان ملكية خاصة وإرث عائلي» .ويتابع الأستاذ عبدالباري حديثه عن الحديدة التي يعرفها قبل الثورة : «العلاقات الفلاحية والزراعية كانت الأساس. كان الناس يخضعون لملاك الأراضي من الأسياد والمشائخ والتجار ، وعندما قامت الثورة حدث ما يشبه الانتفاضة ضد الخصوم المباشرين، المزارعين ثاروا على الإقطاعيين الذين يستخدمونهم مقابل لا شيء» .
يتذكر أن : «أنصار الثورة من الشباب في منطقته سارعوا بعد قيام الثورة إلى اعتقال المشايخ والأسياد ، أجمل ما في ذلك أنهم فعلوه كإجراء وقائي بعد أن هدد غضب الناس المذنب والبريء».يتبع
عن «الخليج» الإماراتية
ثمة بداية في حكاية خطأ مطبعي أقاله من «الثورة» حين كان الوطن يعين رئيس التحرير صباحا ويقيله قبل المساء,أيام حين نسمع عنها لا نصدق كيف أمكنهم العيش فيها، وكيف أفسح زحام المخبرين في وطن لم يجف دم ثواره بعد، مكانا لشيء آخر غيرهم.
وبداية أخرى في حكاية انتخابه أول نقيب للصحافيين اليمنيين، سيرة ثورتين بحثتا عن الحرية واختلفتا عليها في النهاية لتكون نقابة الصحافيين آخر ما يمكن الحديث عنه في مشروع مستقبلي للوحدة.
كل بدايات عبدالباري طاهر هكذا، مجرد تواريخ لحدث ما، كلما حاولت إعادة عبدالباري إلى حياته الخاصة انتفض منها كشيء غير مهم، ليروي تاريخ وطن.
يأسرك تواضعه، ويحرجك أيضا، في منزله الصغير يرفض الجلوس بمحاذاتك، يترك وسائده لك ولمصور يرافقك، ويفترش الأرض.
بدلاً من مطاردة البدايات، سأبدأ من هنا، من أول شيء جعلني أحملق في الرجل الذي يصر دائما على سؤالي كلما سارعت لمصافحته: «كيف حال الوالد؟»، رغم أنه لا يعرفني أصلا..
كنا في نقابة الصحافيين، وسط ضوضاء الإعداد لأحد مؤتمراتها العامة، وكنت أعلم أن هذا الرجل حين يتحدث ينصت الجميع، وحين يشير يطيعه قطيع من المتمردين في مجتمع يرفض حتى النصيحة.
كنت أعلم أن مقالتي السياسية أو الأدبية لن تكون أفضل دون رأي هذا الرجل الأشعث، يومها أضاف شيئا جديدا لأعرفه حين سحب أحد الكراسي دون أن يبتعد عن كل الضوضاء حوله وبدأ يكتب.
تعلم عبدالباري طاهر كيف يطارح أفكاره الغرام كيفما اتفق، لا يبالي بشيء حين تومض فكرة، يكتب وسط أعلى ضجيج ممكن وكأنه في أكثر مكان ملهم في العالم.
يفعل ذلك تاركا لك حق الاندهاش ما استطعت، «تأتي الفكرة» فيبدأ بالكتابة غير مكترث لا بالزمان ولا المكان ولا بك أيضا، يلوذ بأوراقه ويبدأ، أحداث وحكايات كثيرة علمته كيف يفعل ذلك.
أمام جنونه هذا للمرة الأولى لم أدر هل أصرخ بأعلى صوتي للتأكد من أنه جاد فيما يقدم عليه، أو أكتفي بمراقبته مبهورا ببريق حروف تولد هكذا، حروف تفضح حمق اعتقادي أن الكتابة طقس أفلاطوني وإن غالبا انتهى بي إلى لا شيء.
أجمل الكلمات تأتي قبل استدعائها، وأجمل الأعمال لا تحتاج أن تقضي عمرك في محاولة جعلها تبدو أنيقة.
مشروع لإنتاج فقيه
في 8 مارس 1941 حصلت «المراوعة»، أحد أجمل مناطق محافظة الحديدة غرب صنعاء، على مولود جديد أطلق عليه اسم «عبدالباري» كعنوان جميل لحلم أسرة علم، أو محاولة للحفاظ على نسل له باع طويل في علوم الدين والتصوف.
وكرس والده الفقيه المتصوف، والمزارع أكثر، محمد بن محمد طاهر الأهدل الكثير من الوقت لتعليمه علوم الدين ليغدو القاضي عبدالباري، وعلوم الزراعة ليعيش، وبدا أن المشروع ينجح.
يكبر الصغير، ويكبر معه شغفه بالقراءة وتدربت ذاكرته على الحفظ وأرشفة كل ما يمر بها، أصبح مشروع فقيه المستقبل أكثر قربا والفتى يظهر تميزا في «الكتّاب» ويظهر ولعا بالكتب.
غير أن مولود «الحوت» ليس الشخص المناسب لوضعه في قالب معد سلفا، قد يكون هادئا لدرجة يصعب التنبؤ بموقفه، وانطوائي إلى حد ما فتصبح القراءة هواية رائعة تبقيه حيث يريد. إلا إنه لا يحبذ القوالب المسبقة، وينفر من كل ما يفرض عليه.
نشأ عبدالباري طاهر في قرية يمنية في الأربعينات والخمسينات، إنها آخر مكان يسمح بالترف، أو حتى يعرف معناه، كان والده «عالم دين ومزارعاً، حظه من الزراعة أكبر»، لذا كان إما في الحقل أو يخضع لدرس تحفيظ، أو يتعلم القراءة ومبادئ الإعراب.
الجزء الثاني من حياته اليومية هو الجزء الذي يبغضه الأطفال أكثر من أي شيء آخر، وهو أيضا غير متوافر لكل أبناء القرية، معظم الآباء مجرد مزارعين لم تتح لهم فرصة التعلم ليعلموا أبناءهم.وقليلون كانوا يهتمون بإلحاق أبنائهم بكتّاب القرية أو بفقيه مقابل اقتطاع جزء من قوتهم الزهيد أصلا لـ«سيدنا»، كانوا يفضلون الاستفادة من الأبناء في العمل.
فذلك أجدى، القراءة في الكتاب لن تحصد كيس قمح نهاية الموسم، على العكس، إنها ستكلفهم لوحا من الخشب ووقتا لجمع «السخام» من جدران المطبخ العتيق وتحويله إلى حبر تتقبله أعواد اليراع، بالإضافة إلى أجر «سيدنا».
وسيدنا لا يتعامل بالدين، إنه يجيد أشياء كثيرة، يجيد توبيخ العائلة المقصرة في خطبة، يجيد إرعاب الطلاب بعصا طويلة لا تكلفه مشقة القيام إلى الطالب الأخير، ويجيد سيدنا النوم فيما يتلو الصبية قصار السور. يجيد أشياء كثيرة، وأحيانا يجيد التعليم.
الخطوة التالية في مشروع «الفقيه المنتظر» عبدالباري كانت نقله إلى الكتّاب ليحصل على وقت أكبر للتعليم من دون مشاغل والده بالزراعة، ولتميزه، أصبح طالبا في الجامع الكبير في المراوعة..الجامع الكبير دائما مرحلة متقدمة بعد كتّاب القرية، وفي «الجامع الكبير» يدرس الطلاب المتفوقون، وفيه أيضا يكون «سيدنا» من النوع الذي يجيد التعليم، بالإضافة إلى المهارات الأخرى طبعا.
ويتذكر عبدالباري طاهر أسماء معلميه في «الجامع الكبير»، الجميع يتذكرون معلميهم في «الكتاتيب» وإن لم يكن للسبب نفسه كل مرة، يتذكرونهم إما لأنهم سيئون جدا أو جيدون جدا، وعبدالباري تحدث عن معلميه باحترام، نطق أسماءهم بشيء من المهابة والإجلال.
رضاعة التغيير
تفاقمت حالة عبدالباري، أصبحت القراءة أكثر من مجرد تفتيش بين دفتي كتاب، فبدأ بغزو مكتبات أساتذته وكل من يعرف أن لديهم مكتبة بعد أن انتهى من مكتبة أبيه، وتغيرت ذائقته في انتقاء الكتب، أصبح يعرف بأن هناك دفتين بينهما شيء غير الفقه وقواعد الإعراب، ومع كل كتاب جديد كان ينسلخ من حلم أبيه.
قرأ عن الانقلاب العثماني وهو في المسجد فعرف لماذا يكره الفلاحون والعمال في قريته المشايخ والإقطاعيين.
بدأت منشورات (الأحرار) تستهويه، وتصل إليه من عدن وصنعاء وتعز: «كانت تصل إلى الحديدة بشكل كبير»، وأول ما حصل عليه منها من بعض معلميه وفقيه قريته محمد بن عبدالباري الذي كان على تواصل مع الأحرار.
المعلمون كانوا غالبا ينتمون إلى طبقة (السادة) المنتسبين إلى آل البيت، و«السادة» هي الطبقة الحاكمة في اليمن، والفقهاء دائما تابعون مطيعون، وبدا غريبا أن تصلهم منشورات من يخططون للثورة، ويقوموا بنقلها إلى طلابهم.
يقول عبدالباري: لم يكن ظهر بعد «الإسلام السياسي»، مفسرا وصول منشورات محرمة تتضمن أفكارا محرمة بالنسبة لفقيه إلى أيدي فقهاء وعلماء يوزعونها ويناقشونها، «كانوا متسامحين ولديهم قبول بالرأي الآخر».
دون تفسيره كنقيض للعقيدة، ربما كان ذلك في الحديدة فقط، فهي محافظة تجنح للسلم، غالبا تفعل ذلك أكثر من اللازم، لذا ما زالت محافظة تسكن القش، وتصدر الكهرباء مبقية لنفسها الظلام والقيظ.
بدأ عبدالباري يتصل أكثر بمؤيدي الأحرار، ويتبنى أفكارهم، وبدأ والده يشعر بالخيبة من ضياع فقيهه المنتظر.
أصبحت علاقته بأسرته «ظاهريا جيدة، لكن في العمق خلاف وخيبة أمل»، كان ذلك حسب عبدالباري حال اليمن كلها، كانت منقسمة بين الثوار والملكية.
أنصار دولة الإمام والخائفون منها يعتبرون الثوار (دستوريين) كفارا يريدون استبدال القرآن بالدستور، أصبح إيقاع الحديث عن الثورة أكثر تأثيرا بعد دخول الراديو وتسرب أنباء الثورات هنا وهناك.
حين اغتيل الإمام يحيى حميد الدين عام 1948 كان عبدالباري ما يزال صغيرا، لكنه يذكر اليوم أن الخلاف والانقسام كان أضعف، كانت الأغلبية غاضبة من الحادث.
يذكر أن بعض مناصري الثوار اعتقلوا، من ضمنهم ابن عمه، وكانوا يسمونهم «الأشرار».
منطقة تهامة مسالمة بالفطرة، وهي مع الثورة في العمق، لكن «كان لدى الكبار بعض التحفظ على حركة الشباب، ونحن كانت أفكارنا فيها الكثير من المراهقة والحدة»، قال ذلك بجدية، ولم يجتهد لتذكر حكاية، لديه ذاكرة يسهل التعامل معها.
سرد نموذجا عن حماس الشباب، بعد مقتل الإمام سارع الأستاذ أحمد جابر عفيف بأخذ البيعة للإمام الجديد الذي نصبه الثوار كإمام دستوري «كان هناك متحمسون، لكن المتحفظين كانوا أكثر».
تغير الأمر مع حركة 1955 التي نفذتها مجموعة من الضباط ضد نظام الإمام أحمد يحيى حميد الدين، وكان الخلاف أكثر حدة، وأنصار الثورة أكثر.
دخل الراديو وبدأت ترد أنباء الثورات هنا وهناك، ثورة مصر وثورة في العراق، قال عبدالباري الذي أصبح يومها أكبر، حدث انقسام وخلاف، لكن التحفظ أقل، أصبح الناس يرون في النظام الجديد شيئا أفضل.
ورغم مسالمة المنطقة التي ينتمي إليها إلا أن «نظام الإمام كان قاسيا، كان الخوف أكثر من الطاعة، والاستسلام أقرب من الحب، هكذا فسر ما واجهه التغيير من حذر وضعف؛ في ما استمر حماس الشباب من دون ترو في كثير من المناطق وليس كلها: «بعضنا انضم إلى الحرس الوطني، كنا نعمل حركات ومهرجانات، وفي تلك الفترة ظهرت أسماء قوية ومؤثرة».
ويتذكر من تلك الأيام عبدالله الصيقل، عبدالله عطية، علي سعيد الحكمي، عبدالله مهدي عبده، وهم إما علماء أو آتون من مدارس دينية .
ومن بين أغلفة الكتب إلى أحداث مرحلة الطفولة كان عبدالباري طاهر يشرب التغيير، ويغير قناعاته، ويبحث عن نفسه في المستقبل، دون أن يتمكن من رسم صورة واضحة.
إلى مكة
لم يعرف عبدالباري والدته، توفيت وهو طفل، فتزوج والده من إحدى شقيقاتها كما درج عليه اليمنيون، ولا يزال الأمر دارجا إلى اليوم.
لم يكن هناك متسع لشقاء آخر يضاف إلى ضنك العيش وتطاول المرض والجهل، فبحث الناس عن أعراف تجنبهم ما استطاعوا أسباب شقاء محتمل، هكذا توالدت الأعراف، وهذا العرف جنب عبدالباري شقاء العيش مع زوجة أب، فخالته كانت أما رءوما.
درس عبدالباري المذهب الشافعي الذي تشربته مدرسة زبيد والمناطق الغربية من اليمن، فيما تشربت مدارس صنعاء المذهب الزيدي، بالنسبة له لم يكن الأمر بهذا التحديد، يصف ما درسه بأنه خليط، دروس الفقه كانت شافعية، وعلم الكلام أشعري بنكهة سنية، هوسه بالقراءة علمه متعة الانتقال من كتاب إلى آخر، ومن فكر إلى غيره، وجد نفسه أكثر ميلا إلى عدم الاعتقاد بمذاق واحد .
ويعتبر نفسه أقرب إلى الأدب منه إلى فتاوى الدين وجنون السياسة، وبدا أن قدره ساعده كثيرا على عدم البقاء في دائرة واحدة، أو حتى مكان واحد.
بعد المراوعة في الحديدة انتقل إلى صنعاء ليدرس على يد العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الذي أصبح فيما بعد مفتيا لليمن، والعلامة محمد بن محمد المنصور وكلاهما من كبار علماء الزيدية في اليمن.
كان انتقاله إلى صنعاء تجاوزا لمرحلة تقليدية تقتضي انتقاله من «الجامع الكبير» في المراوعة إلى مركز مدرسته الشافعية في »زبيد» إحدى أشهر الحوزات الفقهية في اليمن.
كان تنقله خاضعا لخياراته كما يبدو، لم يلتزم منهجا محددا، ولم يسلك ما سلكه غيره من طرق تقليدية، من صنعاء انتقل إلى «مكة» لمواصلة الدراسة، في 1975 التحق بمدرسة الفلاح، كانت تمثل مدرسة ثانوية بالنسبة لنظام الدراسة الأزهرية، ثم التحق بالمدرسة (العارفية) أو الهندية نسبة إلى جهة التمويل من الهند، ثم مدرسة (الصولتية) الممولة من اندونيسيا.
ويتحدث عن تلك الفترة كإحدى محطتين مهمتين غيرتا مسار حياته في ما بعد، المرحلة الأولى تتعلق باقترابه من الثوار وأفكارهم في اليمن، وهنا وجد نفسه في مكتبة الحرم المكي «أمام كنز».
مازالت أخبار الثورات والانقسامات تملأ الأرجاء، وما زال التشبث بذاكرة عبدالباري بعيدا عن السياسة أمراً مستحيلاً.
دائما يفلت منك إلى السياسة، ينسى كوفيته الصغيرة وحلاق القرية وألعاب سرقها الأطفال في غفلة من بؤس يطحن الكبار، ليتحدث عن أسماء وثورات وأفكار، بالإضافة إلى الدراسة في مكة وجد فرصة عمل في المكتبة، لا يدري من اصطاد الآخر، هو أم مسؤول المكتبة؟
كان سعيدا بأي شيء يبقيه في المكتبة، وكان مسؤول المكتبة قادرا على اختيار مساعديه ممن يرى هوسهم برفوفه، كان العمل في المكتبة مقابل أجر رمزي، ويقول:
«كان هذه الأجر آخر ما استرعى اهتمامي أمام عرض العمل في المكتبة»، كان سعيدا بأن لديه فرصة لمطالعة الكثير من العناوين.
يصف عبدالباري المكتبة بالقول: «كانت مهتمة بجمع كل أنواع الكتب من مختلف المشارب والرؤى»، وكانت الأفكار الماركسية والقومية أقرب إليه، وما يتعلق بها يسترعي اهتمامه، فعاد مهووسا بطه حسين والرفاعي، وحاملا للعقاد، وسيد قطب.
قيام ثورة
كان والده قد توفي أثناء دراسته في صنعاء، تاركا وراءه خمسة من الأبناء وستاً من البنات ، كان عبدالباري وفتاة واحدة من الزوجة الأولى ، ربما لهذا كان حلم والده .
مات والده ربما بخيبة أقل ، ففقيهه المنتظر رغم ما يفعله ما زال يسير على الدرب. كان النصيب الأوفر من الخيبة لبقية الأسرة بعد عودة عبدالباري من مكة وانخراطه بشكل كامل مع الرفاق الجدد، وتشربه للفكر الماركسي.
يقول عبدالباري : «كان رد فعل الأسرة على هذا التحول قاسيا ، حدث ما يشبه القطيعة ، كان يطرح عليهم أني شيوعي وماركسي كافر» .
المد القومي حمل معه فكر الاشتراكية، والاشتراكية جرت إلى الشيوعية ومؤلفات ماركس ولينين ، هكذا يفسر عبدالباري وصول الاشتراكية إلى الباحثين عن الحرية : «كانت الاشتراكية كما هي مدونة أقرب إلى أحلام الناس بالحرية والعتق من سطوة البرجوازية وظلم تقسيم المجتمع إلى طبقات ، لم يكن سؤالي مهذبا كوني أعتبر الاشتراكية رديفا لكل الأشياء السيئة في العالم ، وأستغرب أن تكون هي نتيجة البحث عن الحرية ، وليس ذنبي أني أعتقد ذلك بناء على نتائج النظم الاشتراكية، وليس بناء على الأحلام المدونة في أوراق .
هل كان يفترض بي الاعتذار من رجل تشرب الاشتراكية يوما ما؟ ، وإن بدا اليوم متحررا من كل حماقات السياسة؟ ، اكتفيت بملاحقة حكاية فشلت في محاصرتها في نطاق ما تسمح به قدراتي، ومعرفتي ، اكتفيت أيضا بتجرع الشعور بالجهل أمام رجل خلق ليكون ذاكرة.
ردة فعل أسرته على توجه الجديد لم تثنه ، كانت معتقداته مختلفة وراسخة على الأقل بشأن حلم الحرية. ومجددا يفلت عبدالباري من قصته إلى حكاية وطن ، وحين يتحدث عن الثورة يبدي شجنا خاصا ، وحزنا على فقدان الثورة قيمتها من جيل إلى آخر. كل جيل يأتي يصبح أقل تقديرا لأحادث الماضي وللماضي برمته .
ينظر جيل اليوم إلى الآخر فيشعر بالأسى ، عدم الرضا بالحاضر يفقد أحداث وتحولات الماضي قيمتها. ويهدر دماء الثوار. وهذا كفيل بإغاظة عبدالباري وكل من شهد الثورة ويمن ما قبل الثورة.
ليس أن عبدالباري راض عن الحاضر ، بل لأن مشاكل الحاضر لم تكن يوما نتيجة للثورة ، كانت الثورة نتيجة حتمية لتجاوز الألم قدرة الناس على الاحتمال.
يتحدث كثيرا ثم يختصر الأمر برمته قائلا : «من لم يعرف اليمن قبل الثورة لا يمكنه إنصاف الثورة ، ومن لم يعرف اليمن بعد الثورة لن يتمكن من تقدير ما حدث ويحدث» .
يمن ما قبل الثورة كان ظالما ، قال:«المتوكليون ( المملكة المتوكلية ) ظلمت اليمنيين كلهم، كان نظاما قائما على الجباية وكان الناس مزارعين وعمالا وبسطاء بالكاد يحصلون على ما يقيم الأود» . يتذكر أنه في الزيدية ، في الزهرة ، المراوعة ، زبيد ، وكل مناطق الحديدة التي يعرفها أن أسراً معينة تملك كل شيء فيما البقية لا يملكون شيئا ، كان هذا يحدد نوع العلاقات الاجتماعية ، والحديث للأستاذ عبدالباري، كان هناك سادة وعبيد ، مشائخ ورعية .
ويضيف قائلاً : «الحديدة كانت في المركز الثاني تجاريا بعد عدن، رغم هذا كان ناسها فقراء، بساطتهم وجنوحهم للسلم جعلهم فقراء أكثر من غيرهم ، بالنسبة لي ما زالت كذلك ، الفارق تغيرت، المسميات ، مثلا، في الحديدة بالتحديد ، أصبحت عضوية البرلمان ملكية خاصة وإرث عائلي» .ويتابع الأستاذ عبدالباري حديثه عن الحديدة التي يعرفها قبل الثورة : «العلاقات الفلاحية والزراعية كانت الأساس. كان الناس يخضعون لملاك الأراضي من الأسياد والمشائخ والتجار ، وعندما قامت الثورة حدث ما يشبه الانتفاضة ضد الخصوم المباشرين، المزارعين ثاروا على الإقطاعيين الذين يستخدمونهم مقابل لا شيء» .
يتذكر أن : «أنصار الثورة من الشباب في منطقته سارعوا بعد قيام الثورة إلى اعتقال المشايخ والأسياد ، أجمل ما في ذلك أنهم فعلوه كإجراء وقائي بعد أن هدد غضب الناس المذنب والبريء».يتبع
عن «الخليج» الإماراتية