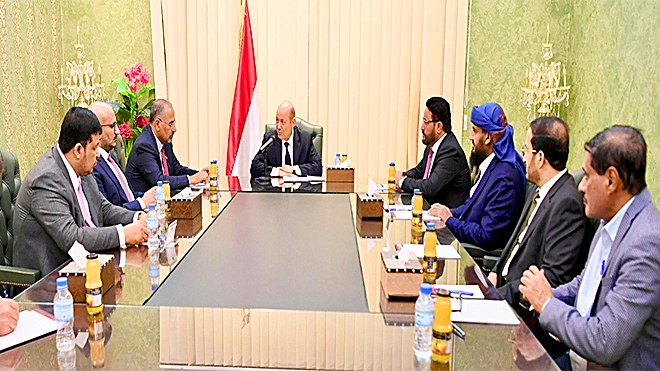> «الأيام» عن «الحياة»:
تحتفل الأوساط الأدبية المصرية والعربية، هذه الايام، بمرور خمسة وسبعين عاماً على رحيل أحمد شوقي «أمير الشعراء» كما لقّب، وكان رحل عام 1932. والواقع أن تقييم شوقي في حياتنا الثقافية تم عبر منظورين مختلفين:
أحدهما: منظور سالب، وثانيهما: منظور موجب. المنظور السالب يرى أن شوقي كان ربيب القصر، وأنه «ولد وفي فمه ملعقة من ذهب» وأنه شاعر الجموع، لا شاعر الفرد، شاعر الخارج لا شاعر الداخل، شاعر الموضوع لا شاعر الذات، ولذلك هو شاعر تقليدي يعيد ترجيع أصداء الشعر العربي القديم، ولم يصنع سوى محاكاة القصيدة العربية في عصورها الزاهرة الغابرة، كما أن الجميع لم ينس له موقفه السلبي من ثورة عرابي (1881) وهو الموقف الذي جعله يستقبل عرابي عند عودته من المنفى بقصيدته سيئة السمعة التي يقول مطلعها: «صغار في الذهاب وفي الإياب / أهذا كل شأنك يا عرابي؟».
أما المنظور الموجب (الذي أميل إلى النظر من خلاله من دون تجاهل المنظور السالب) فيمكن تلخيصه في النقاط الموجزة التالية:
1- كان الشعر العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في حاجة ضاغطة الى نوع من الإيحاء أو البعث، ينتشله من هبوط مرحلة الانحطاط التي غرق فيها طوال القرون السابقة، وقد نهض شعراء هذا البعث والإحياء بمهمتهم خير قيام، بدءاً من محمود سامي البارودي، ومروراً بأحمد شوقي وجميل صدقي الزهاوي وإسماعيل صبري ومعروف الرصافي وحافظ إبراهيم وخليل مردم وخليل مطران وغيرهم.
أعاد هذا الرهط من شعراء الإحياء والبعث إلى القصيدة العربية ديباجتها المتينة ومتانتها الكلاسيكية التي كانت فقدتها طوال فترات الركاكة والضعف (وإن كانت مسألة ركاكة الأدب في عصور الانحطاط تحتاج إلى إعادة نظر جذرية). وعندي أن ذلك الإحياء كان مرحلة ضرورية باعتباره «قنطرة» تاريخية يعبر عليها الشعر إلى التجديد والتطور والتقدم، وهو ما حدث بالفعل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، حينما اندلعت في الحياة الشعرية العربية ثلاث مدارس رومانتيكية كبرى انتقلت بالشعر نقلات جلية معروفة، وهي: مدرسة «الديوان» ومدرسة «المهجر» ومدرسة «ابو للو» (التي رأسها شوقي نفسه في السنة الأولى من قيامها رئاسة شرفية) وواضح أن هذه الأرضية التقليدية التي جهزها هؤلاء الاحيائيون كانت لازمة من أجل أن تنشأ عليها (بها وضدها) التحولات التجديدية اللاحقة.
قد يقول قائل إن الشعر العربي لم يكن محتاجاً لهذه «القنطرة» وكان عليه أن يقفز من مرحلة الانحطاط (العثمانية المملوكية) الى مرحلة التجديد الرومانتيكية مباشرة، على طريقة «حرق المراحل» وربما كان ذلك صحيحاً من الناحية النظرية، لكنه لم يحدث لسببين: الأول هو أن ثقل وطأة الشعر العربي القديم وترسخه في بنية (وذهنية) الثقافة العربية لا يتيح نجاح نظرية «حرق المراحل» أو القفزات الجذرية الواسعة، وإنما يتيح - فحسب- التدرج المتمهل في التطور وفي تسلسل الخطوات، والثاني هو أن بعض «الانحرافات» عن المتن التقليدي الراسخ كانت واقعة بالفعل، لكنها لم تكن ظاهرة في بؤرة المشهد الشعري الرئيسي، واقصد محاولات التمرد الشعري التي مارسها خليل شيبوب ومحمد فريد أبو حديد وجبران ونعيمة وباكثير ودومـط وغيرهم، عـلى أن هـذه الانحرافات ظـلت «هامشاً» للمـتن الرئـيسي للقصيدة العربية التقليدية التي تطورت إلى القصيدة الرومانتيكية العمودية (مع تعديلات طفيفة أجرتها المدارس الثلاث المذكورة).
2- صحيح أن شوقي اتخذ موقفاً سلبياً من ثورة عرابي، لكن ذلك مردود عليه ثلاثة ردود:
الأول: أن الموقف من ثورة عرابي لم يكن المعيار الوحيد للوطنية أو عدمها، فقد اختلف في تقييم ثورة عرابي وطنيون عديدون، منطلقين من ان هذه الثورة لم تحسب بدقة النتائج الفادحة، وهي النتائج التي جرت على مصر الاحتلال الإنكليزي (1882) وتكرر هذا اللبس مع تأميم عبدالناصر لقناة السويس، التأميم الذي نتج عنه العدوان الثلاثي على مصر، ومع اسر حزب الله جنوداً إسرائيليين ما نتج عنه عدوان اسرائيلي وتدمير لبنان.
الثاني: إن سيرة شوقي (على رغم موقفه من عرابي) لم تخلُ من بعض المواقف الوطنية مثل قصيدته عن دنشواي (1906) ومثل تعاطفه مع الخديوي عباس حلمي الثاني (الذي شكل آنذاك بريق أمل لقطاعات من الحركة الوطنية المصرية، بسبب تأييده تركيا ضد الانكليز في الحرب العالمية الثانية (1914 - 1918) وكان من نتيجة هذا التعاطف أن أبعد شوقي إلى اسبانيا منفياً، حيث قال قصيدته الشهيرة التي يعارض فيها سينية البحتري هاتفاً: «اختلاف النهار والليل ينسى / اذكرا لي الصبا وأيام أنسى» وهي التي تحتوي على البيت الذي صار شعاراً من شعارات محبة الوطن:
«وطني لو شغلت في الخلد عنه / نازعتني إليه في الخلد نفسي».
الثالث: أن احياء الشعور «القومي» كان واحداً من إنجازات شوقي السياسية في شعره، إذ تعامل مع الوطن العربي كوحدة سياسية واحدة، في مرحلة حرجة كان فيها العالم العربي يخضع لاحتلالات ثلاثية كبيرة: الإنكليزي والفرنسي والإيطالي، ومثالنا الشهير علي ذلك قصيدته عن «دمشق» التي يقول فيها:
«سلام من صبا بردى أرق
ودمع لا يكفكف يا دمشق
ومعذرة اليراعة والقوافي
جلال الرزء عن وصف يدق».
وهي القصيدة التي احتوت البيت الذي صار- كذلك - شعاراً من شعارات التحرر والاستقلال والتمرد:
«وللحرية الحمراء باب
بكل يد مضرجة يدق».
3- إن شعـــر شوقـــي لم يكن كلــه شعر «خارج» لا شعر «داخل» ولم يكن كله شعر «موضوع» لا شعر «ذات». فأنشأ شوقي العديد من القصائد الذاتية والعاطفية شديدة العذوبة والليونة والرواء.
4- لا يمكن أن ننكر مساهمة شوقي الريادية التحديثية المتمثلة في مسرحياته الشعرية، كتب شوقي عدداً من المسرحيات الشعرية منها: «علي بك الكبير، مصرع كيلوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، عنترة، أميرة الأندلس، الست هدى»، وهي مسرحيات يلاحظ على غالبيتها بعثُ الحس القومي التاريخي التراثي، الذي أظن أن الجماعة المصرية (والعربية) كانت في حاجة الى بعثه في مواجهة الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والإيطالي، وحتى في مواجهة السيادة التركية.
وصحيح أن هذه المسرحيات كانت ذات نزوع تقليدي ولا يعدها نقاد عديدون أكثر من قصائد شعرية مستقلة متفرقة تلقى على خشبة المسرح، لا يربطها درامياً سوى خيط مسرحي طفيف، لكن الصحيح، كذلك، أن إدخال هذا الفن المسرحي الى ثقافتنا العربية كان اجتراءً تجديدياً مرموقاً، تابعه عديدون طوروا ملامح هذا الفن الجديد «المسرح الشعري» مثل صلاح عبدالصبور ومعين بسيسو ونجيب سرور وممدوح عدوان وسميح القاسم وغيرهم من شعراء المسرح.
كان شوقي – إذن - ضرورة، من أكثر من زاوية، فمن زاوية أولى: كان ضرورة لكي يعود المعمار المتين للشعر العربي القديم قبل أن ينحدر في عصور ما يسمى بالانحطاط، ومن زاوية ثانية: كان ضرورة لكي ينشق الثوار اللاحقون على هذا المعمار المتين المكين. فلا بد من أن يوجد ما تريد أن تهدمه.
ومن زاوية ثالثة: كان ضرورة لكي يلقنه العقاد (ومدرسة الديوان) دروساً في أهمية أن يكون «الشعر من الشعور» وفي أن الشاعر الحق «ليس هو من يصفُ لك الشيء كأنك تراه، بل هو الذي يصف اثر الشيء على نفسه»، وهذا هو جوهر المدرسة الرومانتيكية، ومن زاوية رابعة كان ضرورة لكي يتطور المسرح الشعري، بعد أن خلقه شوقي بسيطاً بدائياً، إلى أطوار حديثة على أيدي الشعراء المجددين في العقود التالية، ومن زاوية خامسة: كان ضرورة لكي يتطور مفهوم «الوطن» من المعنى البسيط الذي قدمه شوقي «وطني لو شغلتُ...» الى معنى أكثر عمقاً قدمه السياب بقوله:
«إني لاعجبُ كيف يمكن أن يخون الخائنون/ أيخون إنسان بلاده؟/ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام / حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق»، ثم إلى معنى أكثر تعقيداً وانزياحاً مع شعراء ما بعد الحداثة العربية الراهنة.
إن هذا المنظور الموجب الى مكانة شوقي (من دون تغافل عن بعض حقائق المنظور السالب) هو المنظور الذي ينبغي أن تتبناه الأجيال الشعرية الجديدة، لأنه المنظور الذي يضع شوقي في سياقه التاريخي (في بدايات القرن العشرين) ويرى منجزه على ضوء مرحلته التي ظهر فيها، فلا يطلب منه ما ينبغي أن يطلب من الأجيال الشعرية التالية له. وهو المنظور الذي يقدم نموذجاً صحيحاً وصحياً «لقتل الأب» يبتعد عن المعنى المراهق الذي يسعى الى «القتل لمجرد القتل» نموذج يتأسس على إدراك عمل الأب (معرفته)، ثم تمثله وهمضه، ثم تجاوزه فنياً وإبداعياً الى إضافة شعرية جديدة..
ولعل هذا المغزى هو ما لمحت إليه قصيدة محمود حسن إسماعيل التي أنشأها في رثاء شوقي، ومحمود حسن إسماعيل واحد من أبناء مدرسة «أبوللو» التي ساهمت (مع المهجر والديوان) في نقل الشعر بعد شوقي نقلة كبيرة.. لقد انتحب إسماعيل (بأبيات تعد من البدايات المبكرة للشعر الحر - 1932) قائلاً: «لم يمت شوقي/ وفي الشرق شعاع من سناء/ سائلوا الأيام والأحلام والدنيا/ دولة قامت على عرش الحياة/ من شعور، وجهاد، ودماء/ شاعر في الأرض لم يلق مناه/ فرقى/ يشدو لسكان السماء».
أحدهما: منظور سالب، وثانيهما: منظور موجب. المنظور السالب يرى أن شوقي كان ربيب القصر، وأنه «ولد وفي فمه ملعقة من ذهب» وأنه شاعر الجموع، لا شاعر الفرد، شاعر الخارج لا شاعر الداخل، شاعر الموضوع لا شاعر الذات، ولذلك هو شاعر تقليدي يعيد ترجيع أصداء الشعر العربي القديم، ولم يصنع سوى محاكاة القصيدة العربية في عصورها الزاهرة الغابرة، كما أن الجميع لم ينس له موقفه السلبي من ثورة عرابي (1881) وهو الموقف الذي جعله يستقبل عرابي عند عودته من المنفى بقصيدته سيئة السمعة التي يقول مطلعها: «صغار في الذهاب وفي الإياب / أهذا كل شأنك يا عرابي؟».
أما المنظور الموجب (الذي أميل إلى النظر من خلاله من دون تجاهل المنظور السالب) فيمكن تلخيصه في النقاط الموجزة التالية:
1- كان الشعر العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في حاجة ضاغطة الى نوع من الإيحاء أو البعث، ينتشله من هبوط مرحلة الانحطاط التي غرق فيها طوال القرون السابقة، وقد نهض شعراء هذا البعث والإحياء بمهمتهم خير قيام، بدءاً من محمود سامي البارودي، ومروراً بأحمد شوقي وجميل صدقي الزهاوي وإسماعيل صبري ومعروف الرصافي وحافظ إبراهيم وخليل مردم وخليل مطران وغيرهم.
أعاد هذا الرهط من شعراء الإحياء والبعث إلى القصيدة العربية ديباجتها المتينة ومتانتها الكلاسيكية التي كانت فقدتها طوال فترات الركاكة والضعف (وإن كانت مسألة ركاكة الأدب في عصور الانحطاط تحتاج إلى إعادة نظر جذرية). وعندي أن ذلك الإحياء كان مرحلة ضرورية باعتباره «قنطرة» تاريخية يعبر عليها الشعر إلى التجديد والتطور والتقدم، وهو ما حدث بالفعل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، حينما اندلعت في الحياة الشعرية العربية ثلاث مدارس رومانتيكية كبرى انتقلت بالشعر نقلات جلية معروفة، وهي: مدرسة «الديوان» ومدرسة «المهجر» ومدرسة «ابو للو» (التي رأسها شوقي نفسه في السنة الأولى من قيامها رئاسة شرفية) وواضح أن هذه الأرضية التقليدية التي جهزها هؤلاء الاحيائيون كانت لازمة من أجل أن تنشأ عليها (بها وضدها) التحولات التجديدية اللاحقة.
قد يقول قائل إن الشعر العربي لم يكن محتاجاً لهذه «القنطرة» وكان عليه أن يقفز من مرحلة الانحطاط (العثمانية المملوكية) الى مرحلة التجديد الرومانتيكية مباشرة، على طريقة «حرق المراحل» وربما كان ذلك صحيحاً من الناحية النظرية، لكنه لم يحدث لسببين: الأول هو أن ثقل وطأة الشعر العربي القديم وترسخه في بنية (وذهنية) الثقافة العربية لا يتيح نجاح نظرية «حرق المراحل» أو القفزات الجذرية الواسعة، وإنما يتيح - فحسب- التدرج المتمهل في التطور وفي تسلسل الخطوات، والثاني هو أن بعض «الانحرافات» عن المتن التقليدي الراسخ كانت واقعة بالفعل، لكنها لم تكن ظاهرة في بؤرة المشهد الشعري الرئيسي، واقصد محاولات التمرد الشعري التي مارسها خليل شيبوب ومحمد فريد أبو حديد وجبران ونعيمة وباكثير ودومـط وغيرهم، عـلى أن هـذه الانحرافات ظـلت «هامشاً» للمـتن الرئـيسي للقصيدة العربية التقليدية التي تطورت إلى القصيدة الرومانتيكية العمودية (مع تعديلات طفيفة أجرتها المدارس الثلاث المذكورة).
2- صحيح أن شوقي اتخذ موقفاً سلبياً من ثورة عرابي، لكن ذلك مردود عليه ثلاثة ردود:
الأول: أن الموقف من ثورة عرابي لم يكن المعيار الوحيد للوطنية أو عدمها، فقد اختلف في تقييم ثورة عرابي وطنيون عديدون، منطلقين من ان هذه الثورة لم تحسب بدقة النتائج الفادحة، وهي النتائج التي جرت على مصر الاحتلال الإنكليزي (1882) وتكرر هذا اللبس مع تأميم عبدالناصر لقناة السويس، التأميم الذي نتج عنه العدوان الثلاثي على مصر، ومع اسر حزب الله جنوداً إسرائيليين ما نتج عنه عدوان اسرائيلي وتدمير لبنان.
الثاني: إن سيرة شوقي (على رغم موقفه من عرابي) لم تخلُ من بعض المواقف الوطنية مثل قصيدته عن دنشواي (1906) ومثل تعاطفه مع الخديوي عباس حلمي الثاني (الذي شكل آنذاك بريق أمل لقطاعات من الحركة الوطنية المصرية، بسبب تأييده تركيا ضد الانكليز في الحرب العالمية الثانية (1914 - 1918) وكان من نتيجة هذا التعاطف أن أبعد شوقي إلى اسبانيا منفياً، حيث قال قصيدته الشهيرة التي يعارض فيها سينية البحتري هاتفاً: «اختلاف النهار والليل ينسى / اذكرا لي الصبا وأيام أنسى» وهي التي تحتوي على البيت الذي صار شعاراً من شعارات محبة الوطن:
«وطني لو شغلت في الخلد عنه / نازعتني إليه في الخلد نفسي».
الثالث: أن احياء الشعور «القومي» كان واحداً من إنجازات شوقي السياسية في شعره، إذ تعامل مع الوطن العربي كوحدة سياسية واحدة، في مرحلة حرجة كان فيها العالم العربي يخضع لاحتلالات ثلاثية كبيرة: الإنكليزي والفرنسي والإيطالي، ومثالنا الشهير علي ذلك قصيدته عن «دمشق» التي يقول فيها:
«سلام من صبا بردى أرق
ودمع لا يكفكف يا دمشق
ومعذرة اليراعة والقوافي
جلال الرزء عن وصف يدق».
وهي القصيدة التي احتوت البيت الذي صار- كذلك - شعاراً من شعارات التحرر والاستقلال والتمرد:
«وللحرية الحمراء باب
بكل يد مضرجة يدق».
3- إن شعـــر شوقـــي لم يكن كلــه شعر «خارج» لا شعر «داخل» ولم يكن كله شعر «موضوع» لا شعر «ذات». فأنشأ شوقي العديد من القصائد الذاتية والعاطفية شديدة العذوبة والليونة والرواء.
4- لا يمكن أن ننكر مساهمة شوقي الريادية التحديثية المتمثلة في مسرحياته الشعرية، كتب شوقي عدداً من المسرحيات الشعرية منها: «علي بك الكبير، مصرع كيلوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، عنترة، أميرة الأندلس، الست هدى»، وهي مسرحيات يلاحظ على غالبيتها بعثُ الحس القومي التاريخي التراثي، الذي أظن أن الجماعة المصرية (والعربية) كانت في حاجة الى بعثه في مواجهة الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والإيطالي، وحتى في مواجهة السيادة التركية.
وصحيح أن هذه المسرحيات كانت ذات نزوع تقليدي ولا يعدها نقاد عديدون أكثر من قصائد شعرية مستقلة متفرقة تلقى على خشبة المسرح، لا يربطها درامياً سوى خيط مسرحي طفيف، لكن الصحيح، كذلك، أن إدخال هذا الفن المسرحي الى ثقافتنا العربية كان اجتراءً تجديدياً مرموقاً، تابعه عديدون طوروا ملامح هذا الفن الجديد «المسرح الشعري» مثل صلاح عبدالصبور ومعين بسيسو ونجيب سرور وممدوح عدوان وسميح القاسم وغيرهم من شعراء المسرح.
كان شوقي – إذن - ضرورة، من أكثر من زاوية، فمن زاوية أولى: كان ضرورة لكي يعود المعمار المتين للشعر العربي القديم قبل أن ينحدر في عصور ما يسمى بالانحطاط، ومن زاوية ثانية: كان ضرورة لكي ينشق الثوار اللاحقون على هذا المعمار المتين المكين. فلا بد من أن يوجد ما تريد أن تهدمه.
ومن زاوية ثالثة: كان ضرورة لكي يلقنه العقاد (ومدرسة الديوان) دروساً في أهمية أن يكون «الشعر من الشعور» وفي أن الشاعر الحق «ليس هو من يصفُ لك الشيء كأنك تراه، بل هو الذي يصف اثر الشيء على نفسه»، وهذا هو جوهر المدرسة الرومانتيكية، ومن زاوية رابعة كان ضرورة لكي يتطور المسرح الشعري، بعد أن خلقه شوقي بسيطاً بدائياً، إلى أطوار حديثة على أيدي الشعراء المجددين في العقود التالية، ومن زاوية خامسة: كان ضرورة لكي يتطور مفهوم «الوطن» من المعنى البسيط الذي قدمه شوقي «وطني لو شغلتُ...» الى معنى أكثر عمقاً قدمه السياب بقوله:
«إني لاعجبُ كيف يمكن أن يخون الخائنون/ أيخون إنسان بلاده؟/ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام / حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق»، ثم إلى معنى أكثر تعقيداً وانزياحاً مع شعراء ما بعد الحداثة العربية الراهنة.
إن هذا المنظور الموجب الى مكانة شوقي (من دون تغافل عن بعض حقائق المنظور السالب) هو المنظور الذي ينبغي أن تتبناه الأجيال الشعرية الجديدة، لأنه المنظور الذي يضع شوقي في سياقه التاريخي (في بدايات القرن العشرين) ويرى منجزه على ضوء مرحلته التي ظهر فيها، فلا يطلب منه ما ينبغي أن يطلب من الأجيال الشعرية التالية له. وهو المنظور الذي يقدم نموذجاً صحيحاً وصحياً «لقتل الأب» يبتعد عن المعنى المراهق الذي يسعى الى «القتل لمجرد القتل» نموذج يتأسس على إدراك عمل الأب (معرفته)، ثم تمثله وهمضه، ثم تجاوزه فنياً وإبداعياً الى إضافة شعرية جديدة..
ولعل هذا المغزى هو ما لمحت إليه قصيدة محمود حسن إسماعيل التي أنشأها في رثاء شوقي، ومحمود حسن إسماعيل واحد من أبناء مدرسة «أبوللو» التي ساهمت (مع المهجر والديوان) في نقل الشعر بعد شوقي نقلة كبيرة.. لقد انتحب إسماعيل (بأبيات تعد من البدايات المبكرة للشعر الحر - 1932) قائلاً: «لم يمت شوقي/ وفي الشرق شعاع من سناء/ سائلوا الأيام والأحلام والدنيا/ دولة قامت على عرش الحياة/ من شعور، وجهاد، ودماء/ شاعر في الأرض لم يلق مناه/ فرقى/ يشدو لسكان السماء».