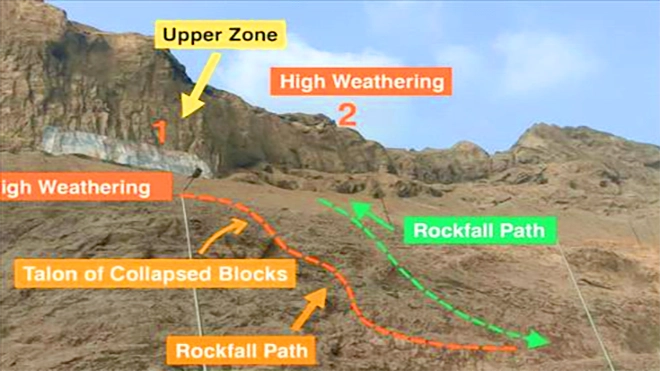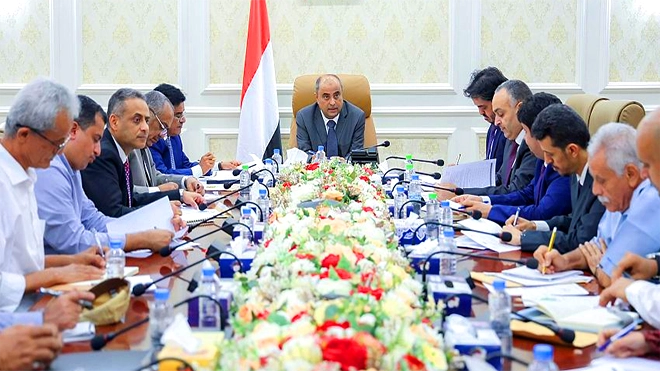> صالح حسين الفردي:
يبدو أن الكثير ممن يحاولون - اليوم- أن يضعوا أنفسهم في خانة الكتاب والمثقفين أصحاب الرأي العميق الباحث عن الحقيقة المجسد لها في واقعنا الوطني المعيش قد توقف وعيهم عند العام تسعين ولم يعودوا قادرين على التجاوز إلى ما بعد هذا التاريخ، بل أن البعض ظل جاثماً على إرثه العتيد من المصطلحات التخوينية والانتقامية التي تفضح النفس المريضة المحركة لمثل هذه الأقلام التي كان عليها أن تختط طرائق وأساليب بعيدة عن (ألاعيب السياسة) التي تجيز استخدام كل الأساليب بما في ذلك اللاإنسانية منها مع المعارضين - الخصوم- وأمثلة التاريخ لا تعد ولا تحصى، لذا كان أولى بحملة الرسالة وضمير الأمة وصوتها الواعي وحراكها الحي أن ينأوا بأنفسهم عن ترديد أحاديث السياسة واجترار الماضي الفاقع كالببغاوات، ذلك أن الثقافي يتجاوز السياسي في الرؤية والغاية والهدف، ولكن ما نجده طافحاً على أسطر الصفحات البيضاء ينم في كثير منه عن أزمة ضمير يعيشها الكثير من هؤلاء الذين يدعون قراءة التاريخ القريب وتوظيفه لمصلحة الأمة والوطن، في حين هم بالأساس بجيرونه لغرض في ذواتهم، فالعاجز عن مجاراة الواقع يرتمي في أحضان الماضي، واللافت أن البعض من هذه (العينة) تناسى زمنه الذي يعيث فيه قدحاً وذماً وقد كان عنوانه وبوقه وصوته الناعق (الباعق) بكل مفردات الزيف والنفاق، ويحاول - هذا البعض- أن يكثر من مقته لذلك الزمن، والبهتان عليه حرصاً منه على طمس بقايا أثر أصابعه ومداد كلماته، معتمداً- خطأ- على نعمة النسيان عند الناس، متناسياً أن ذاكرة الأمة لا تغفو ولا تنام ولا تتناسى، وإن صمتت، إلا أنه صمت السخرية، للسان حال يقول: متى كنتم صادقين بالأمس أو اليوم أو لم يعرف الصدق طريقه إليكم؟!
تلك مزية المجتمع الذي يرصد مثل هذه الحالات المتناقضة في دروب الحياة الثقافية والإعلامية والصحفية، وهو المأزق الذي سقطت فيه أسماء كانت عالية في يوم ما، ولكنها تردت في غياهب الوهم الذي لم يعد يجدي نفعاً عند البطون الخاوية، إلا من حدس إنساني نبيل يرسل ذبذباته الفاحصة لكل قول لا يتغيا- كاتبه- التغيير الحقيقي، ولا يستخدم قواعد وأسس التفكير السليم، ولا يوظف التاريخ في سياق البحث عن فضاءات الضوء وإشعاعاته لرسم خارطة جديدة خالية من الحفر والنتوءات المعيقة لإنعاش الحياة اليومية للمواطن الحقيقي.
يبقى هذا التوقف التسعيني الذي تكلس عنده الكثيرون بقوة وبسلبية من يفرح بالجزء الفاضي من الفنجان ليسكب فيه بعضاً من عقده وأمراضه المصلحية المستعصية على العلاج، ولكنه كمن يجد راحة في خلط الأوراق في حين كان عليه بوصفه مثقفاً أن يفككها ويفندها دون تحيز- طالما عرض لها- فهل ثقافة التعسين وما قبلها قادرة على فهم واقع القرن العشرين وما بعده؟!
تلك مزية المجتمع الذي يرصد مثل هذه الحالات المتناقضة في دروب الحياة الثقافية والإعلامية والصحفية، وهو المأزق الذي سقطت فيه أسماء كانت عالية في يوم ما، ولكنها تردت في غياهب الوهم الذي لم يعد يجدي نفعاً عند البطون الخاوية، إلا من حدس إنساني نبيل يرسل ذبذباته الفاحصة لكل قول لا يتغيا- كاتبه- التغيير الحقيقي، ولا يستخدم قواعد وأسس التفكير السليم، ولا يوظف التاريخ في سياق البحث عن فضاءات الضوء وإشعاعاته لرسم خارطة جديدة خالية من الحفر والنتوءات المعيقة لإنعاش الحياة اليومية للمواطن الحقيقي.
يبقى هذا التوقف التسعيني الذي تكلس عنده الكثيرون بقوة وبسلبية من يفرح بالجزء الفاضي من الفنجان ليسكب فيه بعضاً من عقده وأمراضه المصلحية المستعصية على العلاج، ولكنه كمن يجد راحة في خلط الأوراق في حين كان عليه بوصفه مثقفاً أن يفككها ويفندها دون تحيز- طالما عرض لها- فهل ثقافة التعسين وما قبلها قادرة على فهم واقع القرن العشرين وما بعده؟!