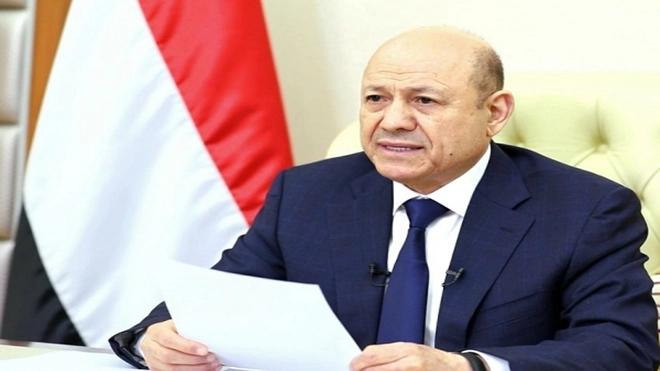> «الأيام» عن «الحياة»:
قبل أن يبلغ الثالثة والأربعين... رحل. كان قد تبقى شهر ويومان، اثنان وثلاثون يوماً، لكن السرطان الذي فاجأه في ظهيرة العمر لم يترك له تلك الأيام القليلة، وترك له عامه الثاني والأربعين بلا اكتمال، مفتوحاً عند النهاية، معلقاً كعلامة استفهام غريبة.
هكذا، ولد أمل دنقل في قرية (القلعة)، في محافظة قنا (الجنوب المصري)، في 23 يونيو 1940. ورحل صباح السبت 21 مايو 1983، وهكذا، أيضاً، مر ربع قرن بالتمام والكمال على رحيله.
كم جرت في النهر العربي من مياه سياسية وشعرية! كم من الأحداث والتحولات الكابوسية التي لم تكن لتخطر بخيال من سمي (شاعر الرفض)، فأصبحت واقعاً مفروضاً، وخريطةً جديدة.
فهل يمكن للمرء أن يقرأ الآن قصيدته الشهيرة سياسياً (لا تصالح)، من دون أن يرى تلك الفجوة الهائلة التي أصبحت تفصلها عن الواقع الراهن، بما يجعلها قصيدة (الماضي) لا الآن؟ وما الذي يفضي إليه تأمل قصائده (السياسية) المشابهة، التي مثلت (شعارات) مرحلة سياسية ماضية؟
فما الذي تبقى منه، بعد 25 سنة من رحيله المبكر؟
لم تكن البدايات الشعرية الأولى لأمل دنقل لتبشر أبداً بالقفزة الكبيرة لديوانه الأول (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) (1969). فقصائد الخمسينات من القرن الماضي- المنشور بعضها في ديوانه الثالث (مقتل القمر) (1974)- تكشف عن شاعر عادي لايلفت الانتباه، يكتب القصيدة التفعيلية السائدة بلا وهج خاص، ولايستطيع إخفاء تأثراته بقصيدة أحمد عبدالمعطي حجازي وصلاح عبدالصبور. فاجأ (مقتل القمر) قراء أمل دنقل من هذه الناحية، فإذ انتظروا- في تلك الحقبة الساخنة سياسياً- ديواناً يتجاوز الديوانين السابقين، ويتجاوب- كعادة أمل الشعرية- مع (السياسي)، إذا به يعود بهم إلى بداياته الرومنطيقية، التي كان تجاوزها بكثير التيار العام للشعر المصري والعربي.
وضعه الديوان الأول- دفعةً واحدة- في قلب الحركة الشعرية العربية، بلا مواربة، كصوت شعري يمتلك خصوصيته الفارقة، الحارقة، بلا تماس- أو تشابه- مع أي من الأصوات الموجودة، خصوصاً الراسخة في التجربة الشعرية الجديدة، لكنه- في الوقت نفسه- الديوان الذي يتماشى مع التوجه السائد في القصيدة العربية، فلا يسعى إلى تجاوزها أو الانفلات إلى أفق مغاير، فهو التميز وسط الجوقة، لا الخروج عليها. (كان ذلك أقصى طموح شعراء الجيل الثاني للتفعيلة، في ظل وجود أصوات شاهقة للجيل الأول من قامة السياب والبياتي وعبدالصبور).
صوتٌ حارق ينكأ الجراح التي يتم التواطؤ على إخفائها، وإغماض العين عينها. ونبرته السياسية ليست تلك المتشفية، أو التشهيرية، أو المستمتعة بجلد الذات بصورة سطحية تستجدي أو تبتز القارئ (ذلك ما سيحدث مع أصوات أخرى تالية، ربما حتى الآن)، بل هي صرخة الضحية الأليمة بعد أن فاض بها الكيل وامتلكت البصر والبصيرة الثاقبة.
هو صوت شاعر القبيلة، العراف، النبي، الشاهد الذي رأى كل شيء، والعبد البصير الحكيم. صوتٌ يستعير صدقيته وجذوره الغائرة من تماهيه مع الأصوات المحفورة الصارخة في التاريخ العربي، منذ حرب البسوس، إلى زرقاء اليمامة، إلى المتنبي، وصولاً إلى فلسطينيي المخيمات الراهنة، مروراً بسبارتاكوس وأسفار العهد القديم. رموزٌ وصرخاتٌ تحتل التاريخ والأسطورة والذاكرة لتتجلى وجوهها المعاصرة داميةً ومعذبةً وصاخبةً بالأسئلة السامة.
لكن هذا الصوت يوجه خطاباً– افتراضاً- إلى جمهور يتلقى النبوءة أو الشهادة أو الحكمة أو الرؤيا، وذلك ما يفرض صياغةً تضبط عملية الإلقاء وحركة المتلقين في آن: فالتفعيلة المنضبطة تخلق وقعاً موسيقياً مباشراً، واضحاً، بسيطاً ومستقيماً، يسوق القارئ– سوقاً- في مجرى القصيدة، بلا تردد، وتوصد التقفية في وجهه أبواب الانفلات من المجرى، إذ توصد نهايات الأبيات بضربة زاعقة، وتضبط خطواته المنتظمة في تقدمه خلال القصيدة. أداتان تقليديتان، تنتميان- في جذورهما- إلى عصر الإنشاد والخطابة، وتمثلان مرتكزين أساسيين في تجربة أمل دنقل الإبداعية، وتضمنان له– مسبقاً- تواصلاً مع السائد في الذوق الشعري، ذلك السائد الذي تخطته قصيدة الرواد نفسها، في بعض حالاتها.
إنها ضرورات الراهن «السياسي» الذي يوجه القصيدة، في صياغة بنيتها، ويشد الذاكرة إلى تلك الواقعة أو الرمز الغابر، بما يمتلكه- أو تمتلكه- من إضاءة فاضحة على الآني، فاكتشاف الآني واستثارته هو الغاية الأولى والأخيرة، والعبرة- القائمة على مشابهةٍ ما، حتى لو كانت رمزية- هي النتيجة (كان اللجوء إلى الرموز الأسطورية والتاريخية سمةً بارزةً، وعموميةً، في شعرية الستينات العربية، للإحالة- غالباً- إلى (السياسي)، فالوجودي). لكن نبرة التعرية العنيفة- بلا مواربة- لدى أمل دنقل، هي ما منحته خصوصيته.
حس عميق مرافق بالتهميش المفروض، أو الانتماء إلى الهامشيين، المهمشين، المهدرين في أنحاء الأرض، الذين لايتذكرهم ذوو السلطان إلا في لحظة الأزمة الفاصلة. هو- هنا- صوت الشاعر الصعلوك، الذي لايملك ما يخسره، ويملك ما لايمكن سلبه منه: صوته وبصيرته النافذة، ولا أو هام أو خداعا ذاتياً إزاء استعراضات القوة والأبهة، فهو يرى ما يتوارى وراء الألوان الصاخبة، ويدرك موقعه من الخريطة: «كنت لا أحمل إلا قلماً بين ضلوعي/ كنت لا أحمل إلا قلمي/ في يدي: خمس مرايا/ تعكس الضوء الذي يسري من دمي/ افتحوا الباب/ فما رد الحرس/ افتحوا الباب.. أنا أطلب ظلا/ قيل: كلا». هو المرفوض الرافض، الذي لايأسى على شيء، والمؤهل- بحكم هذه اللاعلاقة- إلى إشهار قطيعته مع النظام الذي لم يفسح له مكاناً، ولم يفتح أمامه أي باب.
أصبح رفض العالم جوهر القصيدة ووجهها الجلي، فأركان العالم واضحة ومحددة بالأبيض والأسود، لا رمادي، أو ظلال بينية، والتناقضات حدية، لا شبهة فيها، واليقين في سلامة الرؤية مطلق، بلا اهتزاز أو شعرة من الشك والمراوغة، والإجابات جاهزة. عالمٌ منقسم على نفسه إلى طرفين، متقابلين، متناقضين، بصورة قاطعة، ولاتوسط بينهما. تبسيط في الرؤية يسمح باتخاذ موقف قاطع أيضاً، جازم، في الانتماء إلى الهامشي، المقموع، وإدانة الطرف الآخر. وهو الموقف الذي يؤدي مباشرةً إلى الصياغة التقريرية المباشرة، ذات الطبيعة النثرية: «قلت لكم مرارا/ إن الطوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء/ فتهتف النساء في النوافذ انبهارا/ لا تصنع انتصاراً».
وتتكرر هذه الثنائية الحدية في رؤية (المرأة)، (لها حضور واضح، منذ القصائد الأولى)، فهي إما ذات طبيعة ملائكية، تجسد حلم الشاعر الرومانطيقي بالمرأة، وإما عاهرة. وإذا كانت (العاهرة) مستمدة من واقع المدينة الكبيرة، فإن المرأة/ الملاك مستمدة من التصور الخيالي (الذي تجاوزته الشعرية العربية)، لتبدو صورة (العاهرة)- للمفارقة- أكثر حيوية.
وإذ لا سبيل إلى توحد العالم المنقسم، أو وحدة تناقضاته، أو اكتشاف أفقٍ ما لحل تلك التناقضات، فإن العالم- في ذاته- يصبح موصوماً، في جوهره: «كل صباح.../ أفتح الصنبور في إرهاق/ مغتسلاً في مائه الرقراق/ فيسقط الماء على يدي... دما/.../ وعندما.../ أجلس للطعام.. مرغما:/ أبصر في دوائر الأطباق/ جماجما.../ جماجما.../ مفغورة الأفواه والأحداق!!».
أي أن (الرفض) السياسي/ الاجتماعي- في زمن الهزيمة- هو التعبير (العيني) عن رفض العالم الفاسد وجودياً (وما الرموز والإحالات التاريخية والأسطورية إلا شواهد على أن فساد العالم قديم، لا مستحدث، أي كامن في جبلة العالم، وليس عرضاً قابلاً للزوال). وذلك أحد الملامح الجوهرية في قصيدة (أمل دنقل) التي لم ينتبه إليها النقاد، المأخوذون بحدة الرفض السياسي/ الاجتماعي لديه.
قصيدة لحظة تاريخية مأزومة حتى النخاع، قصيدة مثقلة بالأزمة الطاغية، من دون أن تمتلك- القصيدة- القدرة على استيعابها شعرياً، وتجاوزها، فالأزمة/ الهزيمة التاريخية تبدو- بذلك- كأنها قدر العالم، وجوهره الأبدي وشرط الوجود.
لعل ذلك ما وجه (الاستلهام التاريخي) إلى لحظات الانكسار التاريخية (هزيمة سبارتاكوس، وانحطاط عصر كافور في مصر، وخديعة أبي موسى الأشعري، وانكسار الانتفاضة الطالبية المصرية 1972، و (العشاء الأخير) قبل الصلب، وما شابه). كأن الانكسار أو الهزيمة القانون الوجودي الثابت، المدعم بوقائع التاريخ. وجود شامل من الإحباط والآمال المحكومة– حتمياً- بالإجهاض: «فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق/ فسوف تنتهون مثله غداً». وذلك هو جذر (العدمية) الشائع في رحلته الشعرية.
عدمية مؤسسة على يقين بالفساد الجوهري للعالم، ويقين باستحالة إصلاحه، هي عدمية اليأس من العالم، حيث لاتفضي حركته إلا إلى إعادة إنتاج متكررة للفساد، ذلك يعني ثبات فساد العالم وأبديته: «لا تحلموا بعالمٍ سعيد/ فخلف كل قيصرٍ يموت قيصر جديد». ذلك هو القانون الذي اعتمد منذ الخطوات الأولى حتى الأخيرة، هي- في جوهرها- قصيدة اليقين النهائي، الثابت، وهي- في جوهرها- (تعليق على ما حدث) في مرحلة انتقالية حرجة (واضحة المعالم)، وشهادة دامغة عليه.
25/5/2008
هكذا، ولد أمل دنقل في قرية (القلعة)، في محافظة قنا (الجنوب المصري)، في 23 يونيو 1940. ورحل صباح السبت 21 مايو 1983، وهكذا، أيضاً، مر ربع قرن بالتمام والكمال على رحيله.
كم جرت في النهر العربي من مياه سياسية وشعرية! كم من الأحداث والتحولات الكابوسية التي لم تكن لتخطر بخيال من سمي (شاعر الرفض)، فأصبحت واقعاً مفروضاً، وخريطةً جديدة.
فهل يمكن للمرء أن يقرأ الآن قصيدته الشهيرة سياسياً (لا تصالح)، من دون أن يرى تلك الفجوة الهائلة التي أصبحت تفصلها عن الواقع الراهن، بما يجعلها قصيدة (الماضي) لا الآن؟ وما الذي يفضي إليه تأمل قصائده (السياسية) المشابهة، التي مثلت (شعارات) مرحلة سياسية ماضية؟
فما الذي تبقى منه، بعد 25 سنة من رحيله المبكر؟
لم تكن البدايات الشعرية الأولى لأمل دنقل لتبشر أبداً بالقفزة الكبيرة لديوانه الأول (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) (1969). فقصائد الخمسينات من القرن الماضي- المنشور بعضها في ديوانه الثالث (مقتل القمر) (1974)- تكشف عن شاعر عادي لايلفت الانتباه، يكتب القصيدة التفعيلية السائدة بلا وهج خاص، ولايستطيع إخفاء تأثراته بقصيدة أحمد عبدالمعطي حجازي وصلاح عبدالصبور. فاجأ (مقتل القمر) قراء أمل دنقل من هذه الناحية، فإذ انتظروا- في تلك الحقبة الساخنة سياسياً- ديواناً يتجاوز الديوانين السابقين، ويتجاوب- كعادة أمل الشعرية- مع (السياسي)، إذا به يعود بهم إلى بداياته الرومنطيقية، التي كان تجاوزها بكثير التيار العام للشعر المصري والعربي.
وضعه الديوان الأول- دفعةً واحدة- في قلب الحركة الشعرية العربية، بلا مواربة، كصوت شعري يمتلك خصوصيته الفارقة، الحارقة، بلا تماس- أو تشابه- مع أي من الأصوات الموجودة، خصوصاً الراسخة في التجربة الشعرية الجديدة، لكنه- في الوقت نفسه- الديوان الذي يتماشى مع التوجه السائد في القصيدة العربية، فلا يسعى إلى تجاوزها أو الانفلات إلى أفق مغاير، فهو التميز وسط الجوقة، لا الخروج عليها. (كان ذلك أقصى طموح شعراء الجيل الثاني للتفعيلة، في ظل وجود أصوات شاهقة للجيل الأول من قامة السياب والبياتي وعبدالصبور).
صوتٌ حارق ينكأ الجراح التي يتم التواطؤ على إخفائها، وإغماض العين عينها. ونبرته السياسية ليست تلك المتشفية، أو التشهيرية، أو المستمتعة بجلد الذات بصورة سطحية تستجدي أو تبتز القارئ (ذلك ما سيحدث مع أصوات أخرى تالية، ربما حتى الآن)، بل هي صرخة الضحية الأليمة بعد أن فاض بها الكيل وامتلكت البصر والبصيرة الثاقبة.
هو صوت شاعر القبيلة، العراف، النبي، الشاهد الذي رأى كل شيء، والعبد البصير الحكيم. صوتٌ يستعير صدقيته وجذوره الغائرة من تماهيه مع الأصوات المحفورة الصارخة في التاريخ العربي، منذ حرب البسوس، إلى زرقاء اليمامة، إلى المتنبي، وصولاً إلى فلسطينيي المخيمات الراهنة، مروراً بسبارتاكوس وأسفار العهد القديم. رموزٌ وصرخاتٌ تحتل التاريخ والأسطورة والذاكرة لتتجلى وجوهها المعاصرة داميةً ومعذبةً وصاخبةً بالأسئلة السامة.
لكن هذا الصوت يوجه خطاباً– افتراضاً- إلى جمهور يتلقى النبوءة أو الشهادة أو الحكمة أو الرؤيا، وذلك ما يفرض صياغةً تضبط عملية الإلقاء وحركة المتلقين في آن: فالتفعيلة المنضبطة تخلق وقعاً موسيقياً مباشراً، واضحاً، بسيطاً ومستقيماً، يسوق القارئ– سوقاً- في مجرى القصيدة، بلا تردد، وتوصد التقفية في وجهه أبواب الانفلات من المجرى، إذ توصد نهايات الأبيات بضربة زاعقة، وتضبط خطواته المنتظمة في تقدمه خلال القصيدة. أداتان تقليديتان، تنتميان- في جذورهما- إلى عصر الإنشاد والخطابة، وتمثلان مرتكزين أساسيين في تجربة أمل دنقل الإبداعية، وتضمنان له– مسبقاً- تواصلاً مع السائد في الذوق الشعري، ذلك السائد الذي تخطته قصيدة الرواد نفسها، في بعض حالاتها.
إنها ضرورات الراهن «السياسي» الذي يوجه القصيدة، في صياغة بنيتها، ويشد الذاكرة إلى تلك الواقعة أو الرمز الغابر، بما يمتلكه- أو تمتلكه- من إضاءة فاضحة على الآني، فاكتشاف الآني واستثارته هو الغاية الأولى والأخيرة، والعبرة- القائمة على مشابهةٍ ما، حتى لو كانت رمزية- هي النتيجة (كان اللجوء إلى الرموز الأسطورية والتاريخية سمةً بارزةً، وعموميةً، في شعرية الستينات العربية، للإحالة- غالباً- إلى (السياسي)، فالوجودي). لكن نبرة التعرية العنيفة- بلا مواربة- لدى أمل دنقل، هي ما منحته خصوصيته.
حس عميق مرافق بالتهميش المفروض، أو الانتماء إلى الهامشيين، المهمشين، المهدرين في أنحاء الأرض، الذين لايتذكرهم ذوو السلطان إلا في لحظة الأزمة الفاصلة. هو- هنا- صوت الشاعر الصعلوك، الذي لايملك ما يخسره، ويملك ما لايمكن سلبه منه: صوته وبصيرته النافذة، ولا أو هام أو خداعا ذاتياً إزاء استعراضات القوة والأبهة، فهو يرى ما يتوارى وراء الألوان الصاخبة، ويدرك موقعه من الخريطة: «كنت لا أحمل إلا قلماً بين ضلوعي/ كنت لا أحمل إلا قلمي/ في يدي: خمس مرايا/ تعكس الضوء الذي يسري من دمي/ افتحوا الباب/ فما رد الحرس/ افتحوا الباب.. أنا أطلب ظلا/ قيل: كلا». هو المرفوض الرافض، الذي لايأسى على شيء، والمؤهل- بحكم هذه اللاعلاقة- إلى إشهار قطيعته مع النظام الذي لم يفسح له مكاناً، ولم يفتح أمامه أي باب.
أصبح رفض العالم جوهر القصيدة ووجهها الجلي، فأركان العالم واضحة ومحددة بالأبيض والأسود، لا رمادي، أو ظلال بينية، والتناقضات حدية، لا شبهة فيها، واليقين في سلامة الرؤية مطلق، بلا اهتزاز أو شعرة من الشك والمراوغة، والإجابات جاهزة. عالمٌ منقسم على نفسه إلى طرفين، متقابلين، متناقضين، بصورة قاطعة، ولاتوسط بينهما. تبسيط في الرؤية يسمح باتخاذ موقف قاطع أيضاً، جازم، في الانتماء إلى الهامشي، المقموع، وإدانة الطرف الآخر. وهو الموقف الذي يؤدي مباشرةً إلى الصياغة التقريرية المباشرة، ذات الطبيعة النثرية: «قلت لكم مرارا/ إن الطوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء/ فتهتف النساء في النوافذ انبهارا/ لا تصنع انتصاراً».
وتتكرر هذه الثنائية الحدية في رؤية (المرأة)، (لها حضور واضح، منذ القصائد الأولى)، فهي إما ذات طبيعة ملائكية، تجسد حلم الشاعر الرومانطيقي بالمرأة، وإما عاهرة. وإذا كانت (العاهرة) مستمدة من واقع المدينة الكبيرة، فإن المرأة/ الملاك مستمدة من التصور الخيالي (الذي تجاوزته الشعرية العربية)، لتبدو صورة (العاهرة)- للمفارقة- أكثر حيوية.
وإذ لا سبيل إلى توحد العالم المنقسم، أو وحدة تناقضاته، أو اكتشاف أفقٍ ما لحل تلك التناقضات، فإن العالم- في ذاته- يصبح موصوماً، في جوهره: «كل صباح.../ أفتح الصنبور في إرهاق/ مغتسلاً في مائه الرقراق/ فيسقط الماء على يدي... دما/.../ وعندما.../ أجلس للطعام.. مرغما:/ أبصر في دوائر الأطباق/ جماجما.../ جماجما.../ مفغورة الأفواه والأحداق!!».
أي أن (الرفض) السياسي/ الاجتماعي- في زمن الهزيمة- هو التعبير (العيني) عن رفض العالم الفاسد وجودياً (وما الرموز والإحالات التاريخية والأسطورية إلا شواهد على أن فساد العالم قديم، لا مستحدث، أي كامن في جبلة العالم، وليس عرضاً قابلاً للزوال). وذلك أحد الملامح الجوهرية في قصيدة (أمل دنقل) التي لم ينتبه إليها النقاد، المأخوذون بحدة الرفض السياسي/ الاجتماعي لديه.
قصيدة لحظة تاريخية مأزومة حتى النخاع، قصيدة مثقلة بالأزمة الطاغية، من دون أن تمتلك- القصيدة- القدرة على استيعابها شعرياً، وتجاوزها، فالأزمة/ الهزيمة التاريخية تبدو- بذلك- كأنها قدر العالم، وجوهره الأبدي وشرط الوجود.
لعل ذلك ما وجه (الاستلهام التاريخي) إلى لحظات الانكسار التاريخية (هزيمة سبارتاكوس، وانحطاط عصر كافور في مصر، وخديعة أبي موسى الأشعري، وانكسار الانتفاضة الطالبية المصرية 1972، و (العشاء الأخير) قبل الصلب، وما شابه). كأن الانكسار أو الهزيمة القانون الوجودي الثابت، المدعم بوقائع التاريخ. وجود شامل من الإحباط والآمال المحكومة– حتمياً- بالإجهاض: «فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق/ فسوف تنتهون مثله غداً». وذلك هو جذر (العدمية) الشائع في رحلته الشعرية.
عدمية مؤسسة على يقين بالفساد الجوهري للعالم، ويقين باستحالة إصلاحه، هي عدمية اليأس من العالم، حيث لاتفضي حركته إلا إلى إعادة إنتاج متكررة للفساد، ذلك يعني ثبات فساد العالم وأبديته: «لا تحلموا بعالمٍ سعيد/ فخلف كل قيصرٍ يموت قيصر جديد». ذلك هو القانون الذي اعتمد منذ الخطوات الأولى حتى الأخيرة، هي- في جوهرها- قصيدة اليقين النهائي، الثابت، وهي- في جوهرها- (تعليق على ما حدث) في مرحلة انتقالية حرجة (واضحة المعالم)، وشهادة دامغة عليه.
25/5/2008