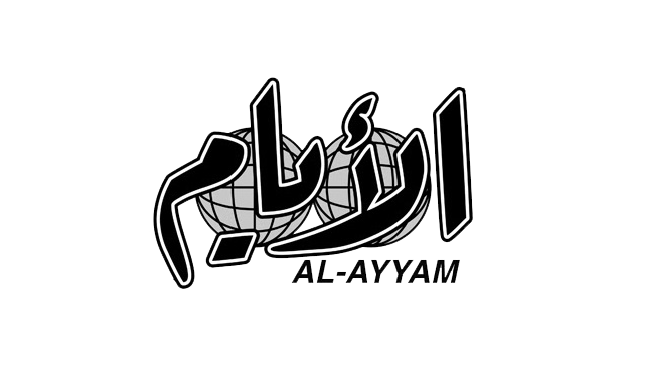> «الأيام» عبده يحيى الدباني:
في ديوان عبدالله البردوني الأول (من أرض بلقيس) نلتقي بقصيدة جليلة جلالة مناسبتها وموضوعها بعنوان (فجر النبوة)، وفضلا عن جلالة الموضوع والمناسبة، فإن البردوني طار بالقصيدة إلى عالم الجمال الشعري الأصيل، الذي لايتكئ أو يتكل على جلال الموضوع أوالمناسبة أو الأفكار (المجردة)، مع أن الجمع بين جلال الموضوع وجمال الشعر يخفق فيه الكثيرون من الشعراء، لاسيما عندما يكون الموضوع متعلقا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإنسانا ورجلا تاريخيا عظيما، لأن عظمة الموضوع تشكل تحديا أمام الشاعر في أن يترجمها شعرا، يرتقي إلى مستوى هذه العظمة، بحيث يستمد جماله من ذاته لا من الموضوع، وقديما قال الأصمعي: «الشعر نكد، بابه الشر، فإذا أدخلته في الخير لان، هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية، فلما دخل في الإسلام ضعف شعره». وليست المسألة مرتبطة بالخير والشر كما أشار الأصمعي، ولكنها تكمن في قوة الموهبة وعبقرية الشعر، وتمثل الشاعر للغة وللموروث الأدبي تمثلا عميقا، وفي خصوبة التجربة الشعرية وغير ذلك.
وأما البردوني هنا، فقد أنشأ قصيدة في المولد النبوي الشريف، فاقت في جمالها وشعريتها ما قاله شعراء الدعوة الإسلامية في عهدها الأول من شعر في مدح الرسول والثناء عليه والإشادة به، ولعل تفوق البردوني يعود إلى قوة عبقريته الشعرية، وإلى تمثله للتراث الثري في هذا الموضوع، أما شعراء العهد الأول فقد كان موضوع النبوة جديدا في شعرهم، وكانوا يسيرون في طريق ليست معبدة فيما يخص هذا الموضوع البكر على عكس البردوني الذي عاش في العصر الحديث. يقول الشاعر في مطلع قصيدته:
صور الجلال وزهوة الأمجاد/ سكبت نمير الوحي في إنشادي/ صور من الأمس البعيد حوافل/ بالذكريات روائح وغوادي/ خطرت تعيد مشاهد الماضي إلى الـ/يوم الجديد إلى الغد المتهادي/ حملت من الميلاد أروع آية/ غمرت متاه الكون بالإرشاد/ زمر من الذكرى تروح وتغتدي/وتشق أبعادا إلى أبعاد/ وتزف وحي المولد الزاهي كما/ زف النسيم شذا الربيع الشادي.
فانظر إلى جلال الألفاظ والتراكيب، وإلى امتداد الإيقاع وانسيابه في انسجام بديع مع الموضوع والمضامين، فالشاعر في هذا المقطع المطلع يصور ما دفعه إلى عالم هذا الموضوع المعجزة، وهو دافع شعري واضح، فليس في الأمر إلزام أو تكلف أو إسقاط واجب فـ (صور الجلال) و(زهوة الأمجاد) هي التي أوحت إلى الشاعر أن يقول ما قال، فهي التي (سكبت نمير الشعر في إنشادي) وغير ذلك صور من الماضي ومشاهد وذكريات انبعث انبعاثا شعريا في روح الشاعر، لأنها ظلت حية متألقة ممتدة عبر الأجيال والآجال، ولا أرى أقدر من الشعراء على تجديدها روحيا، بحيث تكون غضة وطرية وخالية من شوائب الأزمنة والأمكنة. لقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مر بجماعة من أهل اليمن كانوا يسمعون إلى القرآن فيبكون فقال: كنا هكذا في أول الأمر حتى قست القلوب. فالتجديد الروحي مسألة مهمة والشعر أهل لذلك.
ومن ثم ينتقل الشاعر إلى المقطع الثاني من قصيدته مخاطبا (الميلاد النبوي) في ذكراه العطرة، ثم يسترسل في سرد صور من السيرة النبوية سردا شعريا لا تاريخيا، إذ نسج من التاريخ والدين والنبوة كائنا شعريا مستقلا جميلا، يقول في مطلع هذا المقطع:
يافجر ميلاد النبوة هذه
ذكراك فجرٌ دائم الميلاد
فانظر في هذا البيت البديع في وصفه لذكرى المولد النبوي وصفا جديدا طريفا موحيا، لقد اقترن الفجر بالميلاد والميلاد بالنبوة، ثم إن ذكرى هذا الفجر إنما هي فجر، ولكنه دائم الميلاد، لقد تركت لفظة «دائم» في المعنى الشعري أثرا عميقا، فقد أعطت صفة الديمومة المتحركة الخالدة للميلاد النبوي، فهو ليس مجرد مناسبة عابرة كسائر المناسبات، إنها فجر يولد فيولد إلى آخر الدهر.
وأما البردوني هنا، فقد أنشأ قصيدة في المولد النبوي الشريف، فاقت في جمالها وشعريتها ما قاله شعراء الدعوة الإسلامية في عهدها الأول من شعر في مدح الرسول والثناء عليه والإشادة به، ولعل تفوق البردوني يعود إلى قوة عبقريته الشعرية، وإلى تمثله للتراث الثري في هذا الموضوع، أما شعراء العهد الأول فقد كان موضوع النبوة جديدا في شعرهم، وكانوا يسيرون في طريق ليست معبدة فيما يخص هذا الموضوع البكر على عكس البردوني الذي عاش في العصر الحديث. يقول الشاعر في مطلع قصيدته:
صور الجلال وزهوة الأمجاد/ سكبت نمير الوحي في إنشادي/ صور من الأمس البعيد حوافل/ بالذكريات روائح وغوادي/ خطرت تعيد مشاهد الماضي إلى الـ/يوم الجديد إلى الغد المتهادي/ حملت من الميلاد أروع آية/ غمرت متاه الكون بالإرشاد/ زمر من الذكرى تروح وتغتدي/وتشق أبعادا إلى أبعاد/ وتزف وحي المولد الزاهي كما/ زف النسيم شذا الربيع الشادي.
فانظر إلى جلال الألفاظ والتراكيب، وإلى امتداد الإيقاع وانسيابه في انسجام بديع مع الموضوع والمضامين، فالشاعر في هذا المقطع المطلع يصور ما دفعه إلى عالم هذا الموضوع المعجزة، وهو دافع شعري واضح، فليس في الأمر إلزام أو تكلف أو إسقاط واجب فـ (صور الجلال) و(زهوة الأمجاد) هي التي أوحت إلى الشاعر أن يقول ما قال، فهي التي (سكبت نمير الشعر في إنشادي) وغير ذلك صور من الماضي ومشاهد وذكريات انبعث انبعاثا شعريا في روح الشاعر، لأنها ظلت حية متألقة ممتدة عبر الأجيال والآجال، ولا أرى أقدر من الشعراء على تجديدها روحيا، بحيث تكون غضة وطرية وخالية من شوائب الأزمنة والأمكنة. لقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مر بجماعة من أهل اليمن كانوا يسمعون إلى القرآن فيبكون فقال: كنا هكذا في أول الأمر حتى قست القلوب. فالتجديد الروحي مسألة مهمة والشعر أهل لذلك.
ومن ثم ينتقل الشاعر إلى المقطع الثاني من قصيدته مخاطبا (الميلاد النبوي) في ذكراه العطرة، ثم يسترسل في سرد صور من السيرة النبوية سردا شعريا لا تاريخيا، إذ نسج من التاريخ والدين والنبوة كائنا شعريا مستقلا جميلا، يقول في مطلع هذا المقطع:
يافجر ميلاد النبوة هذه
ذكراك فجرٌ دائم الميلاد
فانظر في هذا البيت البديع في وصفه لذكرى المولد النبوي وصفا جديدا طريفا موحيا، لقد اقترن الفجر بالميلاد والميلاد بالنبوة، ثم إن ذكرى هذا الفجر إنما هي فجر، ولكنه دائم الميلاد، لقد تركت لفظة «دائم» في المعنى الشعري أثرا عميقا، فقد أعطت صفة الديمومة المتحركة الخالدة للميلاد النبوي، فهو ليس مجرد مناسبة عابرة كسائر المناسبات، إنها فجر يولد فيولد إلى آخر الدهر.