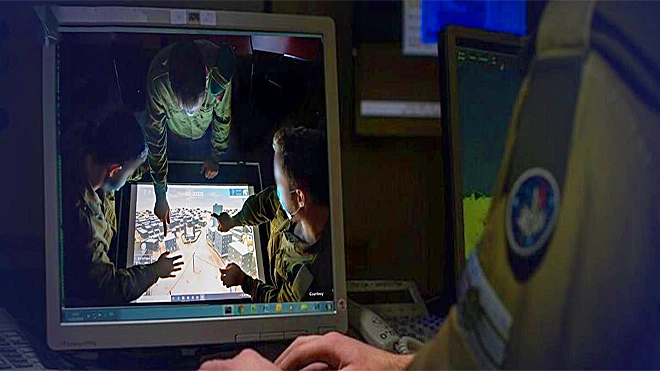> «الأيام» أ.قادري أحمد حيدر:
1. من صيغة وحدة الإمامة بالقبيلة إلى اندماج العسكر بالمشيخة القبلية:
لا يمكن إنكار دور ومكانة البنية الاجتماعية التقليدية، بعد الثورة، في إضعاف التطور الاقتصادي الرأسمالي، وفي تنامي وتشكل الطبقة البرجوازية. والحقيقة أن هذا التكوين والكبح لتطور البرجوازية، والتشكل الرأسمالي له جذور عميقة في التاريخ الحديث والمعاصر في اليمن في المرحلة الإمامية ترك إشارة على ما بعد الثورة حتى اليوم.
ومن دون العودة للمراجع التاريخية، وتقليب صفحات التاريخ الاجتماعي في هذه المرحلة وصولاً إلى قيام الثورة، يمكن القول إن الصيغة التاريخية، الاجتماعية، والسياسية، والفكرية لوحدة الإمامة بالمشيخة القبلية المسلحة منذ أواخر القرن الثالث الهجري 294هـ كانت هي البداية لميلاد صيغة الوحدة التاريخية بين الإمامة كسلطة ونظام حكم وشكل لإدارة المجتمع، والدولة، وبين القبيلة، أو النخبة المشيخية القبلية المسلحة، حيث وجدت الإمامة في البنية المشيخية القبلية (اجتماعياً، وعسكرياً) وجهها الغائب أو رداءها العسكري المسلح، (ذراعها الحربي، أو جيشها)، ووجدت البنية الاجتماعية المشيخية القبلية في الإمامة غطاءها الروحي، أو بعدها العقيدي الديني المذهبي الغائب. وبذلك تواءمت الإمامة، والمشيخية القبلية وتوحدت تاريخياً كصيغة حكم وإدارة للبلد، موكول للإمامة، وظيفة إدارة اجتماعية لمناطقها القبلية في حدود عدم الاقتراب من بنية الحكم والنظام.
وفي تقديري أن هذه الوحدة الاجتماعية السياسية التاريخية لمعادلة الحكم، وفي تنظيم إدارة المجتمع، هي الصيغة الاجتماعية، والسياسية، والفكرية التاريخية التي حكمت العلاقة بين الإمامة الدينية المذهبية (الزيدية) والبنية الاجتماعية المشيخية القبلية، وبقدر ما شكلت هذه المعادلة أو الصيغة السياسية، والاجتماعية، والفكرية عامل ثبات واستقرار لزمن طويل للحكم، والبنية الاجتماعية، إلا أن هذه الصيغة الاجتماعية السياسية نفسها، كانت تاريخياً هي عامل كبح وتعويق لتطور القوى الإنتاجية، وعلاقات الإنتاج، وفي تقديري أن الحالة اليمنية الإمامية في إدارة الحكم والنظام السياسي (السلطة/ الدولة) ما تزال بحاجة إلى دراسة، بل دراسات معمقة سوسيو-اقتصادية، ثقافية، تاريخية وهي حالة فريدة يكاد يكون لا شبيه لها في التاريخ الحديث والمعاصر، وما يزال البحث الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي في هذه المرحلة والتاريخ من نظام الحكم، وفي إدارة الدولة والمجتمع غائباً عن الدراسات الأكاديمية، بمختلف مستوياتها بسبب غياب القراءات التأسيسية من هذه الزاوية، ومن هنا كانت الصعوبة في تقديري، وهو مجال مفتوح للبحث العلمي الجاد للغوص في عمق هذه المرحلة اجتماعياً، واقتصادياً. حتى نصل لدراسة البنية الاجتماعية التقليدية الراهنة (السائدة) وعلاقتها بالسلطة والدولة، يجب الإقرار أن ثورة 26 سبتمبر لم تستطع أن تحدث تغييراً عميقاً وحقيقياً في البنية الاجتماعية التقليدية الإمامية التاريخية، بعد قيام الثورة والأسباب هنا عديدة.
أولاً: الجمود التاريخي لعلاقات الإنتاج وتحجرها، وبقاء البلاد في واقع «فوات تاريخي»، بقي خلالها اليمن الإمامي لقرون سحيقة حبيس قوى إنتاج وعلاقات إنتاج قبل رأسمالية، بل قبل إقطاعية (إن شئت شبه إقطاعية) تهيمن عليه اجتماعياً وسياسياً، ثقافة أبوية (دينية، مذهبية)، غطاء فكري، وبرداء قبلي، عشائري، طائفي وهي منظومة ثقافة وقيم لا علاقة لها بالحياة والعصر.
ثانياً: عزلة اليمن الداخلية عن بعضها البعض اجتماعياً وثقافياً، (تشتتها الاجتماعي والثقافي والسيكلوجي)، ناهيك عن عزلتها عن العالم العربي، والخارجي (وهي عزلة تقرأ بالدلالة النسبية، قياساً لواقع المجتمعات العربية الأخرى)، وهي عزلة وانكفاء تمت باسم «الاستقلال الوطني» عن الاحتلال العثماني، وهو الاستقلال الذي تحول إلى نقمة ونكبة اجتماعية وثقافية، وسياسية على مستوى الداخل، وأصبح معها الآخر أو الأجنبي عدواً، غدا معها الاستقلال الزائف قيداً ومعوقاً للتقدم الاجتماعي، وهي عزلة قاسية ليس لها من تسمية إلا أنها «عزلة حضارية».
ثالثاً: هيمنة البنية الاجتماعية التقليدية في ثقافتها الأبوية (المذهبية الدينية) لقرون طويلة، وحصر الحكم في سلالة مذهبية «البطنين»، وخلق تراتبية اجتماعية قوية وصارمة، كانت واحدة من المعضلات الحقيقية التي واجهها مجتمع الثورة، وثقافة الثورة.
رابعاً: طبيعة البنية الاجتماعية القبلية العسكرية المحيطة بعاصمة الثورة (صنعاء) كانت من العوامل التي أطالت أمد حصار الثورة، اجتماعياً ووضعها كعاصمة تحت الطوق العسكري لأكثر من سبع سنوات، وما يزال قدر ذلك الحصار -القبلي المسلح- يلاحق عاصمة الثورة والوحدة حتى اليوم، والسبب هو تعثر بناء الدولة الحديثة المؤسسية، وتراجع فكرة المواطنة حتى عن مستواها الفعلي الذي كان قائماً قبل عقد ونصف العقد من الزمن.
خامساً: لجملة تلك العوامل والشروط بقيت إجراءات الثورة السبتمبرية، وما بعدها (التنموية والاقتصادية والاجتماعية) حبيسة تلك الضغوط والشروط، وجاءت الإجراءات التنفيذية للثورة على مستوى التنمية الاقتصادية الاجتماعية -في واقع اقتصاد الحرب- بطيئة ولا تلبي الحاجات الفعلية لطموحات المجتمع ورغباته وأحلامه الكامنة في عمق الوعي، واللاوعي الاجتماعي.. فقد وجدت قوى الثورة الاجتماعية والسياسية الجديدة نفسها بين فكي كماشة الحصار الاقتصادي والسياسي، والهجوم العسكري، الأجنبي من جانب، ومعه القوى الملكية والإمامية بكل عتادها القبلي والعسكري، وفي جانب آخر هناك واقع بنية اجتماعية تقليدية (قبلية عسكرية) ما تزال مهيمنة على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في هذه المناطق المحيطة بالثورة مباشرة، (جمهوري قبلي معتدل، جمهوري قبلي إسلامي، جمهوري قبلي بين بين ومع كل الأطراف) وهي بصورة أو أخرى استمرار للإرث التاريخي القروسطي في صيغة وحدة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية المسلحة، تركت آثارها السلبية على واقع تطور الثورة والجمهورية واستمرارها. وهي واحدة من مشكلات ومعوقات الثورة، وهي كذلك من مشكلات ومعوقات بناء الدولة الحديثة المدنية المؤسسية حتى اليوم واللحظة. وما لم يُفك ذلك الاشتباك لصالح دولة المؤسسات والمواطنة، والنظام والقانون فلا أمل مرتجى للحديث عن التعددية، والتنمية، والتداول السلمي للسلطة، ففي واقع ازدواجية السلطة، بين الدولة، والقبيلة، فلا معنى للحديث عن إمكانية وجود دولة مدنية حديثة، ولا سلطة نظام وقانون.
وأستطيع القول إن جوهر إشكالية وجود دولة مدنية حديثة، دولة مؤسسات ما يزال هو السؤال الجوهري الغائب منذ قيام ثورة 26 سبتمبر حتى اللحظة.
لقد وجدت قوى الثورة نفسها في حالة تحالف سياسي عسكري مع زعماء البنية المشيخية القبلية التي أعلنت أقسام منها ولاءها للثورة لأسباب عديدة موضوعية وذاتية، خاصة، وعامة، في مواجهة الهجوم العسكري الاستعماري والرجعي العربي والملكي، وهو تاريخياً أمر مفهوم، أن يقف قطاع من البنية الاجتماعية المشيخية القبلية إلى جانب الثورة مدافعاً عنها، ويكتل قبائله للدفاع عنها لاعتبارات ذاتية/ خاصة/ وموضوعية عامة. على أن كسر الصيغة التأريخية لوحدة الإمامة، بالبنية المشيخية القبلية، لصالح إزالة حكم السلالة (البطنين) لم ينتج عنه في الواقع تفكك وانحلال تلك العلاقة والبنية، لتكريس بناء مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وتفكيك البنية الاجتماعية التقليدية، وتحلل بنى الإنتاج والعلاقات ما قبل الرأسمالية وشبه الإقطاعية والقبلية، بل ترسخ مكانة البنية المشيخية القبلية أكثر، وتحولها تدريجياً ليس إلى قوة عسكرية تقف في مؤازاة إمكانات بناء مشروع الدولة الوطنية الحديثة بل وتحولها إلى قوة اقتصادية ومالية وتجارية كبيرة، فهي وظفت تحالفها السياسي والعسكري مع قوى الثورة والجمهورية لتفرض نفسها كبنية سياسية مشيخية قبلية مسلحة، وطرفاً شريكاً وأساسياً في بنية السلطة والدولة. جرى معها تدريجياً مأسسة وجودها في قمة السلطة الجمهورية، والدولة، حتى تحولت في مرحلة معينة إلى الطرف الشريك النافذ والأساسي في معادلة السلطة والدولة، والحكم، والثروة.
حقيقة لقد كانت البنية المشيخية القبلية في سياق التحول الجمهوري، والدفاع عن الثورة هي الطرف الأساسي المستفيد من الثورة والجمهورية، فإذا كانت الإمامة لم تسمح لرموز البنية المشيخية القبلية أن تكون شريكاً في سلطة الحكم محتفظة بدورها كذراع عسكري لحماية الصيغة التاريخية لوحدة الإمامة بالقبلية، فإنه مع الثورة ومع أول قرار جمهوري بعد الثورة مباشرة جرى مأسسة حضور الزعامة المشيخية القبلية في قمة السلطة والدولة، وهو أول تمييز في المواطنة بين فئات الشعب وشرائحه المختلفة لصالح تكريس تميز استثنائي للبنية الاجتماعية المشيخية القبلية، أو القبيلة التي لم تكن تشكل أكثر من %25-20 من السكان على الأكثر، فقد نصت المادة العاشرة من الإعلان الدستوري باسم مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 1962/10/31م على «أنه يتألف من شيوخ الضمان مجلس الدفاع الأعلى، أعطى خلالها لشيخ الضمان درجة وزير».
إن القراءة النقدية الموضوعية التاريخية تؤكد ليس على صعوبة ، بل واستحالة إحداث تغيير جذري، في التركيبة الاجتماعية التقليدية التي هيمنت لقرون طويلة على المجتمع، وعلى الثقافة، والقيم، (ثقافة السلطة المهيمنة)، وأن الأمر كان بحاجة إلى إجراءات حقيقية على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي تفوق بكثير الإجراءات التي اتخذتها الثورة، وبعبارة أخرى أن اليمن الإمامي القروسطي، كان بحاجة إلى أكثر من ثورة واحدة، وقد أشار ثوار سبتمبر إلى أن طموحهم لم يتجاوز تغيير شكل نظام الحكم وأنهم لم يكونوا يحملون مشروعاً سياسياً متكاملاً لما بعد الثورة، ولقضية التغيير الاجتماعي، ولذلك جرى قمع محاولات القيام بعملية إصلاحية اجتماعية سياسية خاصة في محافظتي إب، وتعز، حيث بادر الناس بالقيام بإجراءات ثورية فيما يتعلق بالأرض والموقف من المشايخ والإقطاع، وتم قمعها وإيقافها، فالمساس بالتركيبة الاجتماعية التقليدية والبنى الاجتماعية القبلية العشائرية، كان أمراً يتجاوز سقف الثورة في ظل تحالف القوى الاجتماعية السياسية الجديدة للثورة، مع رموز المؤسسة المشيخية القبلية. وفي واقع استمرار دور لرموز النخبة المشيخية القبلية في الثورة والدفاع عنها، وهي عملية موضوعية تاريخية معقدة، ولذلك أضيف إلى المادة العاشرة في الإعلان الدستوري 1962/10/31م الذي يكرس مكانة البنية الاجتماعية السياسية لمشايخ القبائل، صدور القرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجالس شيوخ القبائل في 26 إبريل 1963م، حيث ينشأ في كل قبيلة مجلس يسمى مجلس شيوخ القبيلة، وفي كل لواء مجلس شيوخ اللواء، ثم إنشاء المجلس الأعلى لشيوخ القبائل، يكون مقره العاصمة صنعاء، وفتحت هذه المجالس صلاحيات اجتماعية وسياسية ودستورية عديدة. وفي مجلس الرئاسة المشكل في إبريل 1963م، دخل ثلاثة عشر شيخاً قبلياً في عضوية المجلس المكون من اثنين وثلاثين عضواً، ما نسبته %41 من المجلس.
ولم تبدأ محاولة تقليص نفوذ وسلطات رموز النخبة المشيخية القبلية إلا مع قيام حركة 13 يونيو 1974م، وفي إطار عملية سياسية إصلاحية جزئية فوقية، ومن دون مشروع سياسي، ولا رؤية اقتصادية اجتماعية تنموية فعلية لتقليص نفوذ وسلطات رموز المؤسسة المشيخية القبلية المسلحة، التي كانت قد أصبحت ومنذ انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، هي القوة الفعلية المهيمنة على مفاصل الدولة (الجيش والأمن) ومواقع السلطة العليا، والتجارة، والمال) ولذلك بقيت إجراءات 13 يونيو الإصلاحية فوقية ومحدودة، ولم تتجاوز عملياً حدود الشعار والخطاب، ولذلك جرى الانقضاض عليها، واستعيد معها تأكيد تاريخ الذاكرة الاجتماعية القبلية كجزء فاعل، ومكون أساسي من مكونات السلطة والدولة، والمجتمع، والبعض منا ما يزال يتذكر أنه وبعد قيام حركة 13 يونيو 1974م مباشرة تم تشكيل المجلس الأعلى للقبائل اليمنية في 1974/6/18م. وهو ما يعني أن حركة يونيو لم يكن لديها مشروع سياسي اجتماعي من شأنه إحداث تغيير في تركيبية وهرمية البنية الاجتماعية التقليدية التي بقيت محافظة على جوهرها الداخلي العميق لقرون طويلة، ولم تمثل الثورة وإجراءاتها سوى إحداث تعديلات على البنية الخارجية للتركيبة الاجتماعية التقليدية.
وأستطيع القول : إن ما حدث بعد الثورة مباشرة على مستوى البنية الاجتماعية التقليدية، والصيغة التاريخية لعلاقة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية ليس أكثر من تعديلات وتحويرات في بنية الشكل الخارجي، ولصالح تكريس وجود ومأسسة الزعامة المشيخية القبلية في قمة السلطة والدولة، وبالنتيجة إعادة إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية وفق شروط جديدة معاصرة ، وهي واحدة من أخطر معوقات تبلور وحضور دور ومكانة الدولة الوطنية الحديثة، فالمؤسسة القبلية، والبنى الاجتماعية التقليدية، وغياب الدولة الوطنية الحديثة وجهان لعملية سياسية اجتماعية تاريخية واحدة. وهو مالم يتنبه له الاتجاه الثوري في النظام الجمهوري الجديد، ولذلك فإن المادة العاشرة من الإعلان الدستوري بتاريخ 1962/10/31م، وبعدها صدور القرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجلس شيوخ القبائل في 26 إبريل 1963م، ومن ثم إنشاء وزارة مخصصة باسم وزارة شؤون القبائل، وهو أول تشكيل وزاري يضم وزارة بهذه التسمية بتاريخ 1963/4/25م توزرها رجل من أصول قبلية ولكنه حداثي بامتياز هو مطيع دماج -وهو من رموز الأحرار اليمنيين- في وزارة العميد عبداللطيف ضيف الله.
ولا أجد في المادة العاشرة من الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجلس شيوخ القبائل وكذا المؤتمرات السياسية القبلية المعارضة الأولى، مؤتمرات، عمران، خمر، الطائف، الجند، وحرض، وغيرها من المؤتمرات القبلية، سوى محاولات أولى ومتوالية سياسية لإعادة إنتاج صيغة أو معادلة وحدة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية، التي فجرتها ثورة 26 سبتمبر 1962م ولم تتمكن من إعادة صياغة وإنتاج المعادلة بصورة جديدة تكرس وجود وحضور القوى السياسية الاجتماعية الجديدة، وجاء القراران، والمؤتمرات السياسية القبلية المسلحة لمواجهة البعد السياسي والاجتماعي والوطني للثورة، ومحاولة في اتجاه إعادة إنتاج الصيغة التقليدية بما يكرس إعادة إنتاج البنية الاجتماعية المشيخية القبلية في السلطة والدولة والجمهورية الجديدة على حساب حضور ومكانة القوى السياسية الاجتماعية الحديثة. ومن حينه وتحديداً مع انقلاب 5 نوفمبر 1967م بدأت الخطوات الأولى لمأسسة وجود وحضور الجماعة المشيخية القبلية، ليس كمركز ضغط اجتماعي سياسي في قلب السلطة الجمهورية، بل كطرف أساسي ومقرر في قلب النظام الجمهوري، وجاء القراران، والمؤتمرات السياسية القبلية من 1967-1962م بمثابة قوى ضغط سياسية على القوى الاجتماعية والسياسية الحديثة في النظام الجمهوري والثوري، وإصرار على إضعاف قدرة النظام على إحداث تغيير جوهري في النظام الاجتماعي، والبنية الاجتماعية التقليدية.
في تقديري أن 5 نوفمبر 1967م، هي اللحظة السياسية التأسيسية لعودة الحياة بقوة إلى البنية الاجتماعية التقليدية مع أن البعض يتحدث عن 5 نوفمبر 1967م على أنها النظام المدني الذي جيء به على أنقاض حكم فردي، عسكري طغياني -المقصود السلال- أسلم البلاد للأجانب ( المصريين) كما كان يقول الخطاب السياسي القبلي في بعض مؤتمراته السياسية القبلية المعارضة ، على أن الحقيقة هي أن جمهورية نوفمبر أو «الجمهورية الثانية» حسب تعبير البردوني، هي انقلاب جذري على المشروع السياسي الوطني، الذي أفرغ دولة ثورة سبتمبر من طابعها الوطني الاستقلالي، ومن مضمونها السياسي الاجتماعي التحرري، وتحويلها إلى أداة لخدمة النظام القبلي العسكري.
ومع هذا الانقلاب تم إقصاء القوى الاجتماعية والسياسية الحديثة، من السلطة، والدولة، ومن الجيش والأمن، ومن الإدارة، ومع هذا الموقف وتلك الإرادات المتصارعة في الجمهورية، أو النظام الجمهوري، أجدني متفقاً مع قول المفكر السوسيولوجي (هشام شرابي) حين أشار قائلاً: «علينا أن لا ننسى أننا ما زلنا مجتمعاً متخلفاً لا يمكنه الخروج من حالة الجهل والضعف، بمجرد (الثورة) أو انقلاب، بل علينا العمل المستمر لفترة طويلة قد تمتد إلى جيل أو جيلين أو أكثر!!
إن وعياً زمنياً كهذا يحررنا من عبودية الأحلام الطوباوية وأماني المستقبل البعيد، ويدفعنا إلى الانصراف إلى الحاضر القائم والمستقبل الآتي القريب، فلا نعود نتحدث عن التراث والمستقبل في معميات الماضي السحيق، وأبعاد المستقبل المجهول، بل نركز قوانا على الواقع التاريخي المعاش بدءاً بهذه اللحظة العفنة». وبحكم طبيعة القوى المفجرة للثورة والمحركة لها، وقصور رؤيتها لما بعد الثورة، فإن ذلك سهل استيلاء القوى السياسية والاجتماعية التقليدية- بقايا الأحرار اليمنيين- على المفاصل الأساسية في بنية السلطة والدولة الجمهورية الوليدة ، وتحديداً منذ أواخر عام 1963م.
لا يمكن إنكار دور ومكانة البنية الاجتماعية التقليدية، بعد الثورة، في إضعاف التطور الاقتصادي الرأسمالي، وفي تنامي وتشكل الطبقة البرجوازية. والحقيقة أن هذا التكوين والكبح لتطور البرجوازية، والتشكل الرأسمالي له جذور عميقة في التاريخ الحديث والمعاصر في اليمن في المرحلة الإمامية ترك إشارة على ما بعد الثورة حتى اليوم.
ومن دون العودة للمراجع التاريخية، وتقليب صفحات التاريخ الاجتماعي في هذه المرحلة وصولاً إلى قيام الثورة، يمكن القول إن الصيغة التاريخية، الاجتماعية، والسياسية، والفكرية لوحدة الإمامة بالمشيخة القبلية المسلحة منذ أواخر القرن الثالث الهجري 294هـ كانت هي البداية لميلاد صيغة الوحدة التاريخية بين الإمامة كسلطة ونظام حكم وشكل لإدارة المجتمع، والدولة، وبين القبيلة، أو النخبة المشيخية القبلية المسلحة، حيث وجدت الإمامة في البنية المشيخية القبلية (اجتماعياً، وعسكرياً) وجهها الغائب أو رداءها العسكري المسلح، (ذراعها الحربي، أو جيشها)، ووجدت البنية الاجتماعية المشيخية القبلية في الإمامة غطاءها الروحي، أو بعدها العقيدي الديني المذهبي الغائب. وبذلك تواءمت الإمامة، والمشيخية القبلية وتوحدت تاريخياً كصيغة حكم وإدارة للبلد، موكول للإمامة، وظيفة إدارة اجتماعية لمناطقها القبلية في حدود عدم الاقتراب من بنية الحكم والنظام.
وفي تقديري أن هذه الوحدة الاجتماعية السياسية التاريخية لمعادلة الحكم، وفي تنظيم إدارة المجتمع، هي الصيغة الاجتماعية، والسياسية، والفكرية التاريخية التي حكمت العلاقة بين الإمامة الدينية المذهبية (الزيدية) والبنية الاجتماعية المشيخية القبلية، وبقدر ما شكلت هذه المعادلة أو الصيغة السياسية، والاجتماعية، والفكرية عامل ثبات واستقرار لزمن طويل للحكم، والبنية الاجتماعية، إلا أن هذه الصيغة الاجتماعية السياسية نفسها، كانت تاريخياً هي عامل كبح وتعويق لتطور القوى الإنتاجية، وعلاقات الإنتاج، وفي تقديري أن الحالة اليمنية الإمامية في إدارة الحكم والنظام السياسي (السلطة/ الدولة) ما تزال بحاجة إلى دراسة، بل دراسات معمقة سوسيو-اقتصادية، ثقافية، تاريخية وهي حالة فريدة يكاد يكون لا شبيه لها في التاريخ الحديث والمعاصر، وما يزال البحث الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي في هذه المرحلة والتاريخ من نظام الحكم، وفي إدارة الدولة والمجتمع غائباً عن الدراسات الأكاديمية، بمختلف مستوياتها بسبب غياب القراءات التأسيسية من هذه الزاوية، ومن هنا كانت الصعوبة في تقديري، وهو مجال مفتوح للبحث العلمي الجاد للغوص في عمق هذه المرحلة اجتماعياً، واقتصادياً. حتى نصل لدراسة البنية الاجتماعية التقليدية الراهنة (السائدة) وعلاقتها بالسلطة والدولة، يجب الإقرار أن ثورة 26 سبتمبر لم تستطع أن تحدث تغييراً عميقاً وحقيقياً في البنية الاجتماعية التقليدية الإمامية التاريخية، بعد قيام الثورة والأسباب هنا عديدة.
أولاً: الجمود التاريخي لعلاقات الإنتاج وتحجرها، وبقاء البلاد في واقع «فوات تاريخي»، بقي خلالها اليمن الإمامي لقرون سحيقة حبيس قوى إنتاج وعلاقات إنتاج قبل رأسمالية، بل قبل إقطاعية (إن شئت شبه إقطاعية) تهيمن عليه اجتماعياً وسياسياً، ثقافة أبوية (دينية، مذهبية)، غطاء فكري، وبرداء قبلي، عشائري، طائفي وهي منظومة ثقافة وقيم لا علاقة لها بالحياة والعصر.
ثانياً: عزلة اليمن الداخلية عن بعضها البعض اجتماعياً وثقافياً، (تشتتها الاجتماعي والثقافي والسيكلوجي)، ناهيك عن عزلتها عن العالم العربي، والخارجي (وهي عزلة تقرأ بالدلالة النسبية، قياساً لواقع المجتمعات العربية الأخرى)، وهي عزلة وانكفاء تمت باسم «الاستقلال الوطني» عن الاحتلال العثماني، وهو الاستقلال الذي تحول إلى نقمة ونكبة اجتماعية وثقافية، وسياسية على مستوى الداخل، وأصبح معها الآخر أو الأجنبي عدواً، غدا معها الاستقلال الزائف قيداً ومعوقاً للتقدم الاجتماعي، وهي عزلة قاسية ليس لها من تسمية إلا أنها «عزلة حضارية».
ثالثاً: هيمنة البنية الاجتماعية التقليدية في ثقافتها الأبوية (المذهبية الدينية) لقرون طويلة، وحصر الحكم في سلالة مذهبية «البطنين»، وخلق تراتبية اجتماعية قوية وصارمة، كانت واحدة من المعضلات الحقيقية التي واجهها مجتمع الثورة، وثقافة الثورة.
رابعاً: طبيعة البنية الاجتماعية القبلية العسكرية المحيطة بعاصمة الثورة (صنعاء) كانت من العوامل التي أطالت أمد حصار الثورة، اجتماعياً ووضعها كعاصمة تحت الطوق العسكري لأكثر من سبع سنوات، وما يزال قدر ذلك الحصار -القبلي المسلح- يلاحق عاصمة الثورة والوحدة حتى اليوم، والسبب هو تعثر بناء الدولة الحديثة المؤسسية، وتراجع فكرة المواطنة حتى عن مستواها الفعلي الذي كان قائماً قبل عقد ونصف العقد من الزمن.
خامساً: لجملة تلك العوامل والشروط بقيت إجراءات الثورة السبتمبرية، وما بعدها (التنموية والاقتصادية والاجتماعية) حبيسة تلك الضغوط والشروط، وجاءت الإجراءات التنفيذية للثورة على مستوى التنمية الاقتصادية الاجتماعية -في واقع اقتصاد الحرب- بطيئة ولا تلبي الحاجات الفعلية لطموحات المجتمع ورغباته وأحلامه الكامنة في عمق الوعي، واللاوعي الاجتماعي.. فقد وجدت قوى الثورة الاجتماعية والسياسية الجديدة نفسها بين فكي كماشة الحصار الاقتصادي والسياسي، والهجوم العسكري، الأجنبي من جانب، ومعه القوى الملكية والإمامية بكل عتادها القبلي والعسكري، وفي جانب آخر هناك واقع بنية اجتماعية تقليدية (قبلية عسكرية) ما تزال مهيمنة على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في هذه المناطق المحيطة بالثورة مباشرة، (جمهوري قبلي معتدل، جمهوري قبلي إسلامي، جمهوري قبلي بين بين ومع كل الأطراف) وهي بصورة أو أخرى استمرار للإرث التاريخي القروسطي في صيغة وحدة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية المسلحة، تركت آثارها السلبية على واقع تطور الثورة والجمهورية واستمرارها. وهي واحدة من مشكلات ومعوقات الثورة، وهي كذلك من مشكلات ومعوقات بناء الدولة الحديثة المدنية المؤسسية حتى اليوم واللحظة. وما لم يُفك ذلك الاشتباك لصالح دولة المؤسسات والمواطنة، والنظام والقانون فلا أمل مرتجى للحديث عن التعددية، والتنمية، والتداول السلمي للسلطة، ففي واقع ازدواجية السلطة، بين الدولة، والقبيلة، فلا معنى للحديث عن إمكانية وجود دولة مدنية حديثة، ولا سلطة نظام وقانون.
وأستطيع القول إن جوهر إشكالية وجود دولة مدنية حديثة، دولة مؤسسات ما يزال هو السؤال الجوهري الغائب منذ قيام ثورة 26 سبتمبر حتى اللحظة.
لقد وجدت قوى الثورة نفسها في حالة تحالف سياسي عسكري مع زعماء البنية المشيخية القبلية التي أعلنت أقسام منها ولاءها للثورة لأسباب عديدة موضوعية وذاتية، خاصة، وعامة، في مواجهة الهجوم العسكري الاستعماري والرجعي العربي والملكي، وهو تاريخياً أمر مفهوم، أن يقف قطاع من البنية الاجتماعية المشيخية القبلية إلى جانب الثورة مدافعاً عنها، ويكتل قبائله للدفاع عنها لاعتبارات ذاتية/ خاصة/ وموضوعية عامة. على أن كسر الصيغة التأريخية لوحدة الإمامة، بالبنية المشيخية القبلية، لصالح إزالة حكم السلالة (البطنين) لم ينتج عنه في الواقع تفكك وانحلال تلك العلاقة والبنية، لتكريس بناء مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وتفكيك البنية الاجتماعية التقليدية، وتحلل بنى الإنتاج والعلاقات ما قبل الرأسمالية وشبه الإقطاعية والقبلية، بل ترسخ مكانة البنية المشيخية القبلية أكثر، وتحولها تدريجياً ليس إلى قوة عسكرية تقف في مؤازاة إمكانات بناء مشروع الدولة الوطنية الحديثة بل وتحولها إلى قوة اقتصادية ومالية وتجارية كبيرة، فهي وظفت تحالفها السياسي والعسكري مع قوى الثورة والجمهورية لتفرض نفسها كبنية سياسية مشيخية قبلية مسلحة، وطرفاً شريكاً وأساسياً في بنية السلطة والدولة. جرى معها تدريجياً مأسسة وجودها في قمة السلطة الجمهورية، والدولة، حتى تحولت في مرحلة معينة إلى الطرف الشريك النافذ والأساسي في معادلة السلطة والدولة، والحكم، والثروة.
حقيقة لقد كانت البنية المشيخية القبلية في سياق التحول الجمهوري، والدفاع عن الثورة هي الطرف الأساسي المستفيد من الثورة والجمهورية، فإذا كانت الإمامة لم تسمح لرموز البنية المشيخية القبلية أن تكون شريكاً في سلطة الحكم محتفظة بدورها كذراع عسكري لحماية الصيغة التاريخية لوحدة الإمامة بالقبلية، فإنه مع الثورة ومع أول قرار جمهوري بعد الثورة مباشرة جرى مأسسة حضور الزعامة المشيخية القبلية في قمة السلطة والدولة، وهو أول تمييز في المواطنة بين فئات الشعب وشرائحه المختلفة لصالح تكريس تميز استثنائي للبنية الاجتماعية المشيخية القبلية، أو القبيلة التي لم تكن تشكل أكثر من %25-20 من السكان على الأكثر، فقد نصت المادة العاشرة من الإعلان الدستوري باسم مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 1962/10/31م على «أنه يتألف من شيوخ الضمان مجلس الدفاع الأعلى، أعطى خلالها لشيخ الضمان درجة وزير».
إن القراءة النقدية الموضوعية التاريخية تؤكد ليس على صعوبة ، بل واستحالة إحداث تغيير جذري، في التركيبة الاجتماعية التقليدية التي هيمنت لقرون طويلة على المجتمع، وعلى الثقافة، والقيم، (ثقافة السلطة المهيمنة)، وأن الأمر كان بحاجة إلى إجراءات حقيقية على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي تفوق بكثير الإجراءات التي اتخذتها الثورة، وبعبارة أخرى أن اليمن الإمامي القروسطي، كان بحاجة إلى أكثر من ثورة واحدة، وقد أشار ثوار سبتمبر إلى أن طموحهم لم يتجاوز تغيير شكل نظام الحكم وأنهم لم يكونوا يحملون مشروعاً سياسياً متكاملاً لما بعد الثورة، ولقضية التغيير الاجتماعي، ولذلك جرى قمع محاولات القيام بعملية إصلاحية اجتماعية سياسية خاصة في محافظتي إب، وتعز، حيث بادر الناس بالقيام بإجراءات ثورية فيما يتعلق بالأرض والموقف من المشايخ والإقطاع، وتم قمعها وإيقافها، فالمساس بالتركيبة الاجتماعية التقليدية والبنى الاجتماعية القبلية العشائرية، كان أمراً يتجاوز سقف الثورة في ظل تحالف القوى الاجتماعية السياسية الجديدة للثورة، مع رموز المؤسسة المشيخية القبلية. وفي واقع استمرار دور لرموز النخبة المشيخية القبلية في الثورة والدفاع عنها، وهي عملية موضوعية تاريخية معقدة، ولذلك أضيف إلى المادة العاشرة في الإعلان الدستوري 1962/10/31م الذي يكرس مكانة البنية الاجتماعية السياسية لمشايخ القبائل، صدور القرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجالس شيوخ القبائل في 26 إبريل 1963م، حيث ينشأ في كل قبيلة مجلس يسمى مجلس شيوخ القبيلة، وفي كل لواء مجلس شيوخ اللواء، ثم إنشاء المجلس الأعلى لشيوخ القبائل، يكون مقره العاصمة صنعاء، وفتحت هذه المجالس صلاحيات اجتماعية وسياسية ودستورية عديدة. وفي مجلس الرئاسة المشكل في إبريل 1963م، دخل ثلاثة عشر شيخاً قبلياً في عضوية المجلس المكون من اثنين وثلاثين عضواً، ما نسبته %41 من المجلس.
ولم تبدأ محاولة تقليص نفوذ وسلطات رموز النخبة المشيخية القبلية إلا مع قيام حركة 13 يونيو 1974م، وفي إطار عملية سياسية إصلاحية جزئية فوقية، ومن دون مشروع سياسي، ولا رؤية اقتصادية اجتماعية تنموية فعلية لتقليص نفوذ وسلطات رموز المؤسسة المشيخية القبلية المسلحة، التي كانت قد أصبحت ومنذ انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، هي القوة الفعلية المهيمنة على مفاصل الدولة (الجيش والأمن) ومواقع السلطة العليا، والتجارة، والمال) ولذلك بقيت إجراءات 13 يونيو الإصلاحية فوقية ومحدودة، ولم تتجاوز عملياً حدود الشعار والخطاب، ولذلك جرى الانقضاض عليها، واستعيد معها تأكيد تاريخ الذاكرة الاجتماعية القبلية كجزء فاعل، ومكون أساسي من مكونات السلطة والدولة، والمجتمع، والبعض منا ما يزال يتذكر أنه وبعد قيام حركة 13 يونيو 1974م مباشرة تم تشكيل المجلس الأعلى للقبائل اليمنية في 1974/6/18م. وهو ما يعني أن حركة يونيو لم يكن لديها مشروع سياسي اجتماعي من شأنه إحداث تغيير في تركيبية وهرمية البنية الاجتماعية التقليدية التي بقيت محافظة على جوهرها الداخلي العميق لقرون طويلة، ولم تمثل الثورة وإجراءاتها سوى إحداث تعديلات على البنية الخارجية للتركيبة الاجتماعية التقليدية.
وأستطيع القول : إن ما حدث بعد الثورة مباشرة على مستوى البنية الاجتماعية التقليدية، والصيغة التاريخية لعلاقة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية ليس أكثر من تعديلات وتحويرات في بنية الشكل الخارجي، ولصالح تكريس وجود ومأسسة الزعامة المشيخية القبلية في قمة السلطة والدولة، وبالنتيجة إعادة إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية وفق شروط جديدة معاصرة ، وهي واحدة من أخطر معوقات تبلور وحضور دور ومكانة الدولة الوطنية الحديثة، فالمؤسسة القبلية، والبنى الاجتماعية التقليدية، وغياب الدولة الوطنية الحديثة وجهان لعملية سياسية اجتماعية تاريخية واحدة. وهو مالم يتنبه له الاتجاه الثوري في النظام الجمهوري الجديد، ولذلك فإن المادة العاشرة من الإعلان الدستوري بتاريخ 1962/10/31م، وبعدها صدور القرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجلس شيوخ القبائل في 26 إبريل 1963م، ومن ثم إنشاء وزارة مخصصة باسم وزارة شؤون القبائل، وهو أول تشكيل وزاري يضم وزارة بهذه التسمية بتاريخ 1963/4/25م توزرها رجل من أصول قبلية ولكنه حداثي بامتياز هو مطيع دماج -وهو من رموز الأحرار اليمنيين- في وزارة العميد عبداللطيف ضيف الله.
ولا أجد في المادة العاشرة من الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري بقانون بإنشاء مجلس شيوخ القبائل وكذا المؤتمرات السياسية القبلية المعارضة الأولى، مؤتمرات، عمران، خمر، الطائف، الجند، وحرض، وغيرها من المؤتمرات القبلية، سوى محاولات أولى ومتوالية سياسية لإعادة إنتاج صيغة أو معادلة وحدة الإمامة بالبنية المشيخية القبلية، التي فجرتها ثورة 26 سبتمبر 1962م ولم تتمكن من إعادة صياغة وإنتاج المعادلة بصورة جديدة تكرس وجود وحضور القوى السياسية الاجتماعية الجديدة، وجاء القراران، والمؤتمرات السياسية القبلية المسلحة لمواجهة البعد السياسي والاجتماعي والوطني للثورة، ومحاولة في اتجاه إعادة إنتاج الصيغة التقليدية بما يكرس إعادة إنتاج البنية الاجتماعية المشيخية القبلية في السلطة والدولة والجمهورية الجديدة على حساب حضور ومكانة القوى السياسية الاجتماعية الحديثة. ومن حينه وتحديداً مع انقلاب 5 نوفمبر 1967م بدأت الخطوات الأولى لمأسسة وجود وحضور الجماعة المشيخية القبلية، ليس كمركز ضغط اجتماعي سياسي في قلب السلطة الجمهورية، بل كطرف أساسي ومقرر في قلب النظام الجمهوري، وجاء القراران، والمؤتمرات السياسية القبلية من 1967-1962م بمثابة قوى ضغط سياسية على القوى الاجتماعية والسياسية الحديثة في النظام الجمهوري والثوري، وإصرار على إضعاف قدرة النظام على إحداث تغيير جوهري في النظام الاجتماعي، والبنية الاجتماعية التقليدية.
في تقديري أن 5 نوفمبر 1967م، هي اللحظة السياسية التأسيسية لعودة الحياة بقوة إلى البنية الاجتماعية التقليدية مع أن البعض يتحدث عن 5 نوفمبر 1967م على أنها النظام المدني الذي جيء به على أنقاض حكم فردي، عسكري طغياني -المقصود السلال- أسلم البلاد للأجانب ( المصريين) كما كان يقول الخطاب السياسي القبلي في بعض مؤتمراته السياسية القبلية المعارضة ، على أن الحقيقة هي أن جمهورية نوفمبر أو «الجمهورية الثانية» حسب تعبير البردوني، هي انقلاب جذري على المشروع السياسي الوطني، الذي أفرغ دولة ثورة سبتمبر من طابعها الوطني الاستقلالي، ومن مضمونها السياسي الاجتماعي التحرري، وتحويلها إلى أداة لخدمة النظام القبلي العسكري.
ومع هذا الانقلاب تم إقصاء القوى الاجتماعية والسياسية الحديثة، من السلطة، والدولة، ومن الجيش والأمن، ومن الإدارة، ومع هذا الموقف وتلك الإرادات المتصارعة في الجمهورية، أو النظام الجمهوري، أجدني متفقاً مع قول المفكر السوسيولوجي (هشام شرابي) حين أشار قائلاً: «علينا أن لا ننسى أننا ما زلنا مجتمعاً متخلفاً لا يمكنه الخروج من حالة الجهل والضعف، بمجرد (الثورة) أو انقلاب، بل علينا العمل المستمر لفترة طويلة قد تمتد إلى جيل أو جيلين أو أكثر!!
إن وعياً زمنياً كهذا يحررنا من عبودية الأحلام الطوباوية وأماني المستقبل البعيد، ويدفعنا إلى الانصراف إلى الحاضر القائم والمستقبل الآتي القريب، فلا نعود نتحدث عن التراث والمستقبل في معميات الماضي السحيق، وأبعاد المستقبل المجهول، بل نركز قوانا على الواقع التاريخي المعاش بدءاً بهذه اللحظة العفنة». وبحكم طبيعة القوى المفجرة للثورة والمحركة لها، وقصور رؤيتها لما بعد الثورة، فإن ذلك سهل استيلاء القوى السياسية والاجتماعية التقليدية- بقايا الأحرار اليمنيين- على المفاصل الأساسية في بنية السلطة والدولة الجمهورية الوليدة ، وتحديداً منذ أواخر عام 1963م.