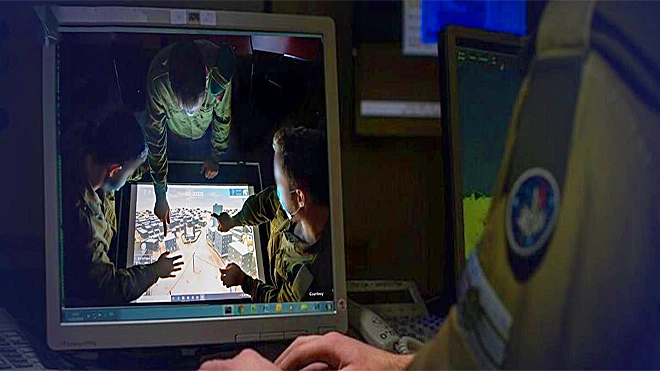> «الأيام» أ.قادري أحمد حيدر:
2. خدمة الحداثة للتقليد .. في واقع البنية الاجتماعية التقليدية/ الجديدة (الملقحة):إن الصراع السياسي الذي برز بعد الثورة، أتاح فرصة كبيرة لتحويل القبيلة، وتحديداً المشيخة القبلية، من قوة اجتماعية بدرجة أساسية إلى قوة سياسية نافذة بصورة لم تكنه يوماً في تاريخ اليمن منذ دخول الإمامة في أواخر القرن الثالث الهجري، وحتى قبيل قيام الثورة.
وكان لواقع غياب الدولة، وأجهزتها، ومؤسساتها، وهيئاتها الإدارية والقانونية، فضلاً عن حالة ضعف حضور القوى الاجتماعية السياسية الحديثة، تأثيره الفاعل إذ وجدت نفسها بعيد الثورة مباشرة أمام مهمات وتحديات أكبر من قدرتها على احتماله وعلى مواجهته بنفسها، ولذلك وجدت نفسها في سياق العملية الاجتماعية، والسياسية الثورية تعقد صفقات غير متكافئة مع رموز القوى السياسية التقليدية (الأحرار)، ومع زعماء المؤسسة القبلية العشائرية، التي وقفت بصلابة أمام الضرورة الوطنية لبناء الدولة الوطنية الحديثة، حيث لم يكن لمعنى الدولة أي وجود في حياة اليمنيين في ظل الإمامة، وهي واحدة من المشكلات الكبرى التي واجهتها ثورة 26 سبتمبر 1962م، وفي هذا السياق جرى مأسسة وجود القبيلة، في صورة شيخ القبيلة في قمة السلطة والدولة الجمهوريين. وفي تقديري أن انقلاب 5 نوفمبر 1967م، هو أحد الانعطافات السياسية والاجتماعية التاريخية الشاملة في حياة اليمنيين بعد ثورة سبتمبر 1962م. وهو الانقلاب الذي طال كل شيء وأسس لتصفية قوى الحداثة السياسية، والاجتماعية، ورموز المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات، تعمق خلالها الحضور القوي للبنية الاجتماعية التقليدية، وكان دستور 1970م تعبيرها السياسي والقانوني، وما صاحب ذلك من هجوم للثقافة العصبوية، والفكر السلفي الوهابي الذي استحوذ على التعليم، وغزا الفكر السياسي الديني الأصولي (المتأسلم) حياة اليمنيين الاجتماعية، والثقافية، وجرى مواءمة مناهج التعليم والمدرسة والجامعة على أساس من ذلك الفكر السلفي المتحجر، والتكفيري، وغدت منظومة الثقافة التقليدية العصبوية بشقيها (الديني، والثقافي الاجتماعي) أبز مظاهر الحياة السائدة منذ السبعينيات مروراً بالثمانينيات إلى اليوم -بهذه الدرجة أو تلك- وكانت المعاهد العلمية الدينية هي الوجه الفكري والثقافي والمذهبي البارز لتلك الهيمنة الثقافية السلفية. فقد جرى حصار قوى الحداثة، والمجتمع المدني، في أضيق نطاق بعد حظر العمل السياسي والحزبي دستورياً، ومطاردة قوى الحداثة الاجتماعية والسياسية، والثقافية، وظيفياً وأمنياً، وجعلهم تحت مجهر المراقبة اليومية، وفرض وثيقة حسن السيرة والسلوك عليهم من أجهزة الأمن لإثبات طهارتهم الوطنية، وأصبح كل ما هو حديث وتقدمي، ومعاصر مقموعاً ومحاصراً، إلاَّ من تخلى عن هويته السياسية والإيديولوجية وتمكن من مواءمة نفسه مع الواقع القائم، وقبل أن يكون موظفاً لخدمة القديم، ولتأكيد استمرارية الوضع القائم. وهي مرحلة هيمن خلالها النص التقليدي في الفكر والثقافة والسياسة، والاجتماع، ترسخ معها مكانة ودور البنية الاجتماعية التقليدية، انحصر فيها صراع القديم والحديث من أواخر الستينيات إلى بداية السبعينيات في الصراع الأدبي والثقافي (الشكل والمضمون في الأدب والثقافة) ولم يتمكن الفكر السياسي الحديث، والفكر الاجتماعي بمضامينه التقدمية المعاصرة التعبير عن نفسه سوى بصورة مواربة، وغير مباشرة، بحكم حالة الحصار والقمع لكل ما هو حديث، ويستعصي على الهضم والتوظيف لصالح البنية الاجتماعية والفكرية التقليدية، بعد أن استحوذت القوى السياسية والاجتماعية التقليدية على جميع مفاصل الدولة، والسلطة، والمجتمع، والتعليم، والثقافة، والاقتصاد، والتجارة، والمال، والمقاولات، وكل شيء يمر عبرها ومن خلالها.
وهنا أتفق مع حديث أو فكرة أشار إليها الباحث الدكتور فؤاد الصلاحي، حول أن الشيخ في بلادنا صار مثل الإقطاعي في أوروبا في علاقته بالأقنان، حيث أشار قائلاً: «نحن في اليمن أمام واقع موضوعي تستطيع أن تقول أن الدولة لها شكل مؤسسات رسمية حديثة، هناك برلمان، وهناك دولة وحكومة حديثة على الأقل من حيث الشكل، لكننا لو نأتي إلى البنية الداخلية في البرلمان، أو مجلس الشورى.. إلخ، أو الحكومة، وهي من الكوادر الحديثة، فالعلاقات القبلية هي التي تنظم هذا النسيج وهي التي تحكم مضمون الإدارة ومفاهيمها في هذه المؤسسات (البرلمان، الشورى، الحكومة، المجالس المحلية)، وهي في الغالب مؤسسات ذات شكل حداثي خارجي، محكومة بسلطة شيخ القبيلة، ومن بعده أبناؤه، ولا تزال الثقافة العصبوية، والعلاقات والمفاهيم التقليدية (قبل الوطنية، وقبل الرأسمالية) هي الفاعلة والمحددة للعلاقات بين الأفراد، بل أن أكبر محدد للعمل السياسي وللعملية الانتخابية (البرلمان، المجالس المحلية، انتخابات الحزب الحاكم)، هي العلاقات الاجتماعية التقليدية، وعلاقات القرابة، وليس انتخاب المرشح على أساس من برنامجه السياسي الانتخابي، أو موقفه الطبقي، فهذه مسائل ما تزال غائبة» وما تزال ثقافة الجماعة التقليدية وليس ثقافة الفرد الحر هي المسيطرة على حياتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي القلب منها ثقافة الطاعة بالمعنيين، الديني، والاجتماعي القبلي، فلا حوار، ولا نقد، ولا تسامح، ولا مصالحات، بل هجوم أوامري كاسح من الأعلى إلى الأسفل، وفق منظومة قيم وأحكام القبيلة وأعرافها، باعتبارها العقد الداخلي الذي يحكم العلاقة في المجتمعات التقليدية، وحتى المجتمعات التقليدية الملقحة بالحداثة كحالنا في اليمن اليوم، فالتسامح، والحوار، والنقد، والقبول بالآخر، هي قيم ومفاهيم غريبة على مجتمع القبيلة، التي تعتمد القوة أساس حل خلافاتها، ولا تستطيع أن تبني في داخلها -مجتمعها- حالة ألفة جامعة، ولا كذلك مع الخارج عنها.
«إن البنى الاجتماعية التقليدية في اليمن، تمتلك رصيداً تاريخياً في ميدان السياسة استطاعت أن تتعايش بمرونة مع البناء المؤسسي الهش (للدولة) وأن تحتفظ لنفسها بمواطن القوة فيه، من خلال التسلل إلى جميع مفاصل المؤسسة الرسمية، أو العمل تحت غطائها، وكان من نتيجة ذلك أن المؤسسات والسلطات تستند إلى شرعية الدستور شكلياً، فيما الإدارة والحكم في الواقع تتم ممارستها استناداً إلى شرعيات تقليدية ماضوية، وهو الأمر الذي ضمن استمرار إعادة انتاج البنى التقليدية والمحافظة على مواقعها ونفوذها في المجتمع، احتفظ المشايخ لأنفسهم بحوالي 70% وأكثر من مقاعد السلطة التشريعية -البرلمان الحالي- موزعة على صفة الشيخ المباشرة، والشيخ التاجر، والشيخ العسكري، -وبذلك فرضوا رقابتهم على التشريع، وضمنوا أن تخرج القوانين وعليها بصماتهم فيما السلطة الدينية حاضرة في القضاء، وفي الحياة السياسية، رغم ما قيل عن تقنين الشريعة، وهيئة علماء المسلمين حاضرة، اليوم في كل الأحداث فيما يخرس الدستور... وبصراحة أكثر أستطيع القول إن الدستور الحالي لا يشجعنا أن نرفعه حتى نداً للشرعيات التقليدية». إن مقاربة سريعة لواقع تركيبة السلطة التشريعية (مجلس النواب) بعد الوحدة 22 مايو 1990م، ومجلس النواب المنتخب في 27 إبريل 1993م، توضح الفارق النوعي بينهما وبين تركيبة المجلس الحالي اجتماعياً وسياسياً ، حيث تهيمن التركيبة الاجتماعية التقليدية (المشيخية القبلية) على مجمل تركيبة المجلس الحالي، ففي مجلس نواب دولة الوحدة أقر قانون التعليم الموحد القاضي بإلغاء حالة ازدواجية التعليم، كان ذلك في قمة الصراع السياسي في البلد، واليوم يبقى قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته لسنوات معلقاً في دهاليز إدارة المجلس، وغيرها من القوانين والتشريعات، وتتسع في المجتمع ظاهرة الثأر، والحروب الأهلية الداخلية والقبلية، وتسود الأحكام العرفية، والقبلية، ضداً على أحكام الدستور والقانون بل إن السلطة ورموزها يفضلون الحلول والأحكام العرفية القبلية، على اللجوء إلى أحكام الدستور والقانون والقضاء، وتمارس السلطة ورموز الدولة العليا (التهجير) القبلي، والعودة للأعراف والأحكام القبلية على اللجوء للدستور والقانون، والقضاء، ووصل الأمر أن رموزاً في النظام يُحَكِّمُون قبيلة -كما حدث مع قبيلة الكبس- على الدولة. ويمكنني القول إنه ولأسباب عديدة موضوعية وذاتية، لم ينكسر النموذج التقليدي في الاجتماع والسياسة، ولم يفرض الحداثي النقدي نفسه، إلا من خلال فعل سلطة الزمن، وبفعل حتمية التغيير الطبيعية التي يفرضها الزمن، والسبب العميق هو غياب الإرادة السياسية الوطنية لذلك التغيير وخشية من تبعاته، لذلك انحصر التغيير والتحول في البنى الاجتماعية التقليدية في أضيق نطاق. ويصدق على هذه اللحظة اليمنية الاجتماعية التاريخية قول المفكر علي حرب «إن انكسار النموذج التقليدي والأحادي في البلدان العربية لم يفض إلى ابتكار نماذج جديدة، ولا إلى اكتساب القيم والفضائل الحديثة، على ما جرى في المجتمعات الغربية، وعلى نحو يؤدي إلى المشاركة الغنية والفعالة في صناعة الحياة الحديثة والمعاصرة، وإنما الذي جعل أن الفرد العربي بات على الصعيد الخلقي، والفكري معلقاً أو مشطوراً أو ممزقاً بين القديم والحديث، فلا هو محافظ، ولا هو حديث، لا هو رجعي ولا هو تقدمي، لا هو متخلف ولا هو متقدم» ولا أفهم الفكرة السابقة التي قدمها المفكر علي حرب إلا بدلالتها النسبية، ما يعني أن العملية والقضية صراعية وكفاحية بين التقليدي والحديث، بين التقدمي والرجعي، تبقى القضية محصورة في إطار مشروعين أحدهما يرى ضرورة الإصلاح والتغيير في البنى الاجتماعية التقليدية والمفاهيم الثقافية العصبوية، والعلاقات الإنتاجية، والقيم ما قبل الرأسمالية، وآخر يسعى لتكريس وترسيخ البنى الاجتماعية التقليدية، مع توظيفه جميع أشكال الحداثة والمدنية (المادية، والمفاهيمة، والمعنوية) بعد إفراغها من مضامينها لخدمة البنى الاجتماعية السائدة، أحدهما يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة وصناعة القرار، وتوسيع حضور المجتمع المدني كفاعل أساسي إلى جانب القوى السياسية والتنظيمية الأخرى، وآخر يحاول تكريس صورة الهيمنة التقليدية على السلطة والثروة، وعدم الفصل بينهما، لاستمرار الهيمنة على المجال السياسي ورفض أي محاولة لإعادة بناء المجال السياسي بصورة جديدة وحديثة، ونعني هنا بإعادة بناء المجال السياسي، تجاوز وضعية البنية البطركية، من خلال تفعيل دور دولة المؤسسات، وسلطة القانون والنظام، لأنه لا نظام من دون قانون، والعمل الجدي لإعادة بناء الاجتماع السياسي على أساس من تعميق فكرة المواطنة، والتعددية الحقيقية، والحرية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والتداول السلمي للسلطة، كما أشار إليها برنامج الرئيس الانتخابي 20 سبتمبر 2006م، وكما هي في نص الدستور.إن أكثر ما تخشاه القوى السياسية والاجتماعية التقليدية، إنما هو الدستور، والقانون، والتعددية، وقوة حضور فكرة المواطنة، وتكافؤ الفرص، والعدالة، وتداول السلطة سلمياً، من السلطة داخل الأطر الصغيرة اجتماعياً، إلى السلطة المحلية، إلى البرلمان، إلى الرئاسة. فجميع المفردات السابقة مناقضة لمعنى وجودها.
إن تحول الممثل في السلطة المحلية والنائب في البرلمان، إلى كائن فردي مستقل عن سلطة الجماعة القبلية، وتحوله ممثلاً للشعب عموماً هي بداية الوعي بفكرة المواطنة، وتحول هذه الأشكال والأطر إلى وسائط مدنية اجتماعية سياسية تساهم في إذابة الجميع في إطار سلطة دولة لكل مواطنيها، ولذلك يرفض رموز المؤسسة المشيخية القبلية تحولهم إلى جزء من المجتمع والدولة. فقد اعتاد الشيخ رمز القبيلة -قبل الثورة وبعدها وحتى اليوم- إنه جامع الضرائب أو مساهم في جمعها، ويعمل لتجميع المواطنين للتجنيد، يحل مشاكل مجتمع القرية، بل والحارة حتى في المدينة، (صنعاء، تعز، الحديدة... إلخ) وتعممت ظاهرة شيخ الحارة على كل المدن الرئيسة من بعد حرب 1994م وبما فيها عدن.
وإذا كان الشيخ وعاقل الحارة، كان يكتفي بأن يقوم بدور القاضي، ومساعد قسم الشرطة، والمخبر الأمني، فهو اليوم رئيس لحزب سياسي، ورئيس للبرلمان، وفق معادلة «شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ»، وتأكيدا لهذا المعنى ولهذه الفكرة أشار نصر طه مصطفي أنه «عند إجراء انتخابات مجلس الشورى مرة أخرى في عهد الرئيس علي عبدالله صالح عام 1988م حرص الشيخ الأحمر على أن يرشح نفسه إلا أن الرئيس صالح طلب منه بشكل ودي عدم ترشيح نفسه لحسابات سياسية، كانت بصيرة في حينها لكنه عاد فشجع الشيخ للترشيح لعضوية مجلس النواب في أول انتخابات نيابية تجري عقب وحدة الشطرين عام 1993م ، وأدرك الجميع حينها أن رجلاً بحجم الشيخ الأحمر لا يمكن أن يترشح مالم يكن هو رئيس البرلمان القادم وهذا ما حدث» وخلال الفترتين اللتين تم فيهما انتخاب الشيخ عبدالله لرئاسة البرلمان، لم يحقق حزبه(الإصلاح) العدد الذي يؤهله لانتخابه وإعادة انتخابه، وهي في الحقيقة استمرار للمعادلة والصيغة التاريخية في صورتها الجديدة، شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ، صيغة وحدة القبيلة بالدولة. ولا أمل لمشروع الدولة المدنية الحديثة من دون فك ذلك الارتباط بين الدولة والقبلية، في صورة رمزها السياسي الشيخ. لذلك تقف رموز الارستقراطية المشيخية القبلية ضد مشروع الدولة الوطنية الحديثة، كما ليس في مصلحتهم -المشايخ- إحداث تنمية وتحديث وتمدين حقيقي في مجتمعاتها فذلك يعني إذابة وتفكيك سلطتها، لصالح سلطة أعلى، هي الدولة المركزية، دولة لكل مواطنيها، لذلك يعتمد رموز المشيخة القبلية إبقاء مجتمعاتهم في حالة من التخلف والجهل ومن دون مدرسة ولا تعليم، وفقاً للقاعدة الإمامية «الشعب الجاهل أسلس قيادة من الشعب العارف أو المتعلم، وعند هذه النقطة تتفق وتلتقي أجزاء أو أجنحة في النظام السياسي القائم مع رموز المشروع التقليدي للمشايخ ورموز القبلية المسلحة، وجميعهم ليس لهم مصلحة في اندماج البنية القبلية في مشروع الدولة الحديثة، وفي بنية المجتمع الوطني ككل، وإلا فكيف نفسر استمرار وجود ظاهرة مؤسسة أو مصلحة شؤون القبائل بعد أكثر من خمسة وأربعين عاماً على قيام ثورة 26 سبتمبر وتعميمها بعد الوحدة 22 مايو 1990م على كل الوطن وكيف نفهم أن ميزانية شؤون القبائل تصل إلى أكثر من أربعة مليار ريال سنوياً، ومدرجة في الموازنة العامة للدولة وتتزايد عاماً بعد آخر، أكبر من جمع ميزانيات مراكز البحوث والدراسات في اليمن عدة مرات، وكأننا ما نزال عند لحظة إصدار القرار الجمهوري بقانون لإنشاء مجلس شيوخ القبائل في إبريل 1963م، وعند حدود المادة العاشرة من الإعلان الدستوري الذي أصدر بتاريخ 31/10/1962م».
إن ما لا يدركه البعض اليوم هو أن هذه الوحدة الظاهرية الشكلية التي تنسم بها البنية الاجتماعية التقليدية، وفي زمن العولمة، والتحولات الديمقراطية الكونية، وثورة الاتصالات والمعلومات التي قلصت المكان ووحدت الزمان، هو أن هذه الوحدة في البنية الاجتماعية التقليدية في أساسها العميق هي وحدة ظاهرية سطحية خارجية، هي وحدة تعيش حالة اضطراب وعدم تماسك، وتفكك داخلي، والحروب القبلية الداخلية الصغيرة والكبيرة، وتوسع ظاهرة الثأر والقتل داخل القبيلة والعائلة الواحدة في القبيلة ذاتها هو مظهر من مظاهر التحلل والتفكك في قلب هذه البنية، كما تلعب حالة الرسملة الاقتصادية للزراعة، والهجرة الواسعة من الريف إلى المدن الرئيسة، إلى جانب طبيعة الدولة الريعية، والاقتصاد الريعي، ونسبة الفقر الكبيرة، والبطالة، دوراً مساعداً في تفكيك اللحمة الاجتماعية التقليدية، وهو عموماً تفكك داخلي تاريخي حكم طبيعة ومحتوى هذه الوحدة (الأبوية) لأن ما يضبط وينظم هذه الوحدة الداخلية، إنما هو عامل القوة بمعناها المجرد والمطلق، وعامل العصبية، ثانياً، هي وحدة قائمة بفعل دور مباشر وأساسي للسلطة أو الدولة البطركية التي تعيد إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية باستمرار، وخاصة مع كل منعطف سياسي تاريخي حاد قد يقود إلى إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي ككل.
ثالثاً: هناك تطورات مادية، اقتصادية إنتاجية رأسمالية، وتحولات سياسية واجتماعية شهدتها البلاد طيلة أربعة عقود ونيف منصرمة، أحدثت - قطعاً- خلخلة عميقة في بنية وتركيبة المجتمع التقليدي، وفي الفكر، والثقافة السياسية عامة، على أن أثرها مكبوت، وفعلها محاصر ومقموع، ومسكوت عنه، بفعل دور أيديولوجي، وسياسي، وإعلامي مباشر من بعض أجنحة الحكم، وبفعل عدم فك الاشتباك بين رموز الجمهورية القبلية التقليدية، و(الدولة) وهي الأزمة السياسية التاريخية نفسها التي بدأت مع قيام الثورة والدفاع عنها، وبدء التأسيس الجدي لها مع انقلاب 5 نوفمبر 1967م.
فإذا كانت 5 نوفمبر 1967م، أسست تاريخياً لإعادة إنتاج البنية المشيخية القبلية، والبنية السياسية التقليدية في صورة (المجلس الجمهوري) بعد 5 نوفمبر، وعززت مكانة وموقع البنية الاجتماعية التقليدية، فإن أحداث 13 يناير 1986م ساهمت بدور كبير في إضعاف تيار الحداثة والتقدم، لصالح قوى التقليد، ومثلت نكسة سياسية واجتماعية وثقافية ووطنية. وجاءت حرب 1994م لتعيد إنتاج وصياغة وترسيم البنية الاجتماعية التقليدية، على مستوى الوطن الموحد ، وتعظيم دورها ومكانتها في جميع مفاصل السلطة والدولة، والمجتمع والثقافة، تراجع معها بصورة واضحة دور ومكانة المرأة الاجتماعي، ومضمونها الحداثي، تحققت معه انتكاسة سياسية واجتماعية وثقافية ووطنية شاملة، طالت آثارها السلبية كافة قطاعات وشرائح وطبقات المجتمع، كان حظ الثقافة والمثقفين منها كبيراً، حيث رأينا قطاعاً من المثقفين ينكفئ على ذاته وينعزل، ويعود للاحتماء بالقبيلة، أو يتسولها للنجاة، ويتوسل القيم والمفاهيم والأفكار المتخلفة وكأنه يتبرأ من تاريخ آثم، ويعود قطاع من المثقفين والسياسيين إلى أحفوراتهم الأصولية العرقية، السلالية، المذهبية، القبلية، العشائرية، والجغرافية، ومشجر أنسابهم، وكأنهم يصحون فجأة على غلطة أو جريمة تاريخية كبرى لا تبرأ إلا بالتطهر عما كانوا عليه ، وهي في تقديري ردة اجتماعية وثقافية وسياسية ووطنية شاملة. هي انعكاس لحالة سياسية عامة. وإلا فكيف نفسر أن يتحول النظام الاجتماعي التقليدي (الأبوي) مصدراً لنيل الشرعية، يذهب معها المثقف الوطني والقومي، والتقدمي للبحث عن خريطة أصوله العرقية والسلالية والجغرافية، والقبلية، والمذهبية في أحفورات التاريخ الاجتماعي، بل الانثربولوجي، حيث المطلوب منه إعادة تسجيل اسمه وأصله الأحفوري، على بطاقة الهوية الشخصية الجديدة، وهو قمة التعبير عن لحظة انحطاط الوعي، وتراجع دور الثقافة والمثقف، والعقل والعقلانية الاجتماعية النقدية، بل وكل شكل من أشكال العقل النقدي!!.
وكان لواقع غياب الدولة، وأجهزتها، ومؤسساتها، وهيئاتها الإدارية والقانونية، فضلاً عن حالة ضعف حضور القوى الاجتماعية السياسية الحديثة، تأثيره الفاعل إذ وجدت نفسها بعيد الثورة مباشرة أمام مهمات وتحديات أكبر من قدرتها على احتماله وعلى مواجهته بنفسها، ولذلك وجدت نفسها في سياق العملية الاجتماعية، والسياسية الثورية تعقد صفقات غير متكافئة مع رموز القوى السياسية التقليدية (الأحرار)، ومع زعماء المؤسسة القبلية العشائرية، التي وقفت بصلابة أمام الضرورة الوطنية لبناء الدولة الوطنية الحديثة، حيث لم يكن لمعنى الدولة أي وجود في حياة اليمنيين في ظل الإمامة، وهي واحدة من المشكلات الكبرى التي واجهتها ثورة 26 سبتمبر 1962م، وفي هذا السياق جرى مأسسة وجود القبيلة، في صورة شيخ القبيلة في قمة السلطة والدولة الجمهوريين. وفي تقديري أن انقلاب 5 نوفمبر 1967م، هو أحد الانعطافات السياسية والاجتماعية التاريخية الشاملة في حياة اليمنيين بعد ثورة سبتمبر 1962م. وهو الانقلاب الذي طال كل شيء وأسس لتصفية قوى الحداثة السياسية، والاجتماعية، ورموز المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات، تعمق خلالها الحضور القوي للبنية الاجتماعية التقليدية، وكان دستور 1970م تعبيرها السياسي والقانوني، وما صاحب ذلك من هجوم للثقافة العصبوية، والفكر السلفي الوهابي الذي استحوذ على التعليم، وغزا الفكر السياسي الديني الأصولي (المتأسلم) حياة اليمنيين الاجتماعية، والثقافية، وجرى مواءمة مناهج التعليم والمدرسة والجامعة على أساس من ذلك الفكر السلفي المتحجر، والتكفيري، وغدت منظومة الثقافة التقليدية العصبوية بشقيها (الديني، والثقافي الاجتماعي) أبز مظاهر الحياة السائدة منذ السبعينيات مروراً بالثمانينيات إلى اليوم -بهذه الدرجة أو تلك- وكانت المعاهد العلمية الدينية هي الوجه الفكري والثقافي والمذهبي البارز لتلك الهيمنة الثقافية السلفية. فقد جرى حصار قوى الحداثة، والمجتمع المدني، في أضيق نطاق بعد حظر العمل السياسي والحزبي دستورياً، ومطاردة قوى الحداثة الاجتماعية والسياسية، والثقافية، وظيفياً وأمنياً، وجعلهم تحت مجهر المراقبة اليومية، وفرض وثيقة حسن السيرة والسلوك عليهم من أجهزة الأمن لإثبات طهارتهم الوطنية، وأصبح كل ما هو حديث وتقدمي، ومعاصر مقموعاً ومحاصراً، إلاَّ من تخلى عن هويته السياسية والإيديولوجية وتمكن من مواءمة نفسه مع الواقع القائم، وقبل أن يكون موظفاً لخدمة القديم، ولتأكيد استمرارية الوضع القائم. وهي مرحلة هيمن خلالها النص التقليدي في الفكر والثقافة والسياسة، والاجتماع، ترسخ معها مكانة ودور البنية الاجتماعية التقليدية، انحصر فيها صراع القديم والحديث من أواخر الستينيات إلى بداية السبعينيات في الصراع الأدبي والثقافي (الشكل والمضمون في الأدب والثقافة) ولم يتمكن الفكر السياسي الحديث، والفكر الاجتماعي بمضامينه التقدمية المعاصرة التعبير عن نفسه سوى بصورة مواربة، وغير مباشرة، بحكم حالة الحصار والقمع لكل ما هو حديث، ويستعصي على الهضم والتوظيف لصالح البنية الاجتماعية والفكرية التقليدية، بعد أن استحوذت القوى السياسية والاجتماعية التقليدية على جميع مفاصل الدولة، والسلطة، والمجتمع، والتعليم، والثقافة، والاقتصاد، والتجارة، والمال، والمقاولات، وكل شيء يمر عبرها ومن خلالها.
وهنا أتفق مع حديث أو فكرة أشار إليها الباحث الدكتور فؤاد الصلاحي، حول أن الشيخ في بلادنا صار مثل الإقطاعي في أوروبا في علاقته بالأقنان، حيث أشار قائلاً: «نحن في اليمن أمام واقع موضوعي تستطيع أن تقول أن الدولة لها شكل مؤسسات رسمية حديثة، هناك برلمان، وهناك دولة وحكومة حديثة على الأقل من حيث الشكل، لكننا لو نأتي إلى البنية الداخلية في البرلمان، أو مجلس الشورى.. إلخ، أو الحكومة، وهي من الكوادر الحديثة، فالعلاقات القبلية هي التي تنظم هذا النسيج وهي التي تحكم مضمون الإدارة ومفاهيمها في هذه المؤسسات (البرلمان، الشورى، الحكومة، المجالس المحلية)، وهي في الغالب مؤسسات ذات شكل حداثي خارجي، محكومة بسلطة شيخ القبيلة، ومن بعده أبناؤه، ولا تزال الثقافة العصبوية، والعلاقات والمفاهيم التقليدية (قبل الوطنية، وقبل الرأسمالية) هي الفاعلة والمحددة للعلاقات بين الأفراد، بل أن أكبر محدد للعمل السياسي وللعملية الانتخابية (البرلمان، المجالس المحلية، انتخابات الحزب الحاكم)، هي العلاقات الاجتماعية التقليدية، وعلاقات القرابة، وليس انتخاب المرشح على أساس من برنامجه السياسي الانتخابي، أو موقفه الطبقي، فهذه مسائل ما تزال غائبة» وما تزال ثقافة الجماعة التقليدية وليس ثقافة الفرد الحر هي المسيطرة على حياتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي القلب منها ثقافة الطاعة بالمعنيين، الديني، والاجتماعي القبلي، فلا حوار، ولا نقد، ولا تسامح، ولا مصالحات، بل هجوم أوامري كاسح من الأعلى إلى الأسفل، وفق منظومة قيم وأحكام القبيلة وأعرافها، باعتبارها العقد الداخلي الذي يحكم العلاقة في المجتمعات التقليدية، وحتى المجتمعات التقليدية الملقحة بالحداثة كحالنا في اليمن اليوم، فالتسامح، والحوار، والنقد، والقبول بالآخر، هي قيم ومفاهيم غريبة على مجتمع القبيلة، التي تعتمد القوة أساس حل خلافاتها، ولا تستطيع أن تبني في داخلها -مجتمعها- حالة ألفة جامعة، ولا كذلك مع الخارج عنها.
«إن البنى الاجتماعية التقليدية في اليمن، تمتلك رصيداً تاريخياً في ميدان السياسة استطاعت أن تتعايش بمرونة مع البناء المؤسسي الهش (للدولة) وأن تحتفظ لنفسها بمواطن القوة فيه، من خلال التسلل إلى جميع مفاصل المؤسسة الرسمية، أو العمل تحت غطائها، وكان من نتيجة ذلك أن المؤسسات والسلطات تستند إلى شرعية الدستور شكلياً، فيما الإدارة والحكم في الواقع تتم ممارستها استناداً إلى شرعيات تقليدية ماضوية، وهو الأمر الذي ضمن استمرار إعادة انتاج البنى التقليدية والمحافظة على مواقعها ونفوذها في المجتمع، احتفظ المشايخ لأنفسهم بحوالي 70% وأكثر من مقاعد السلطة التشريعية -البرلمان الحالي- موزعة على صفة الشيخ المباشرة، والشيخ التاجر، والشيخ العسكري، -وبذلك فرضوا رقابتهم على التشريع، وضمنوا أن تخرج القوانين وعليها بصماتهم فيما السلطة الدينية حاضرة في القضاء، وفي الحياة السياسية، رغم ما قيل عن تقنين الشريعة، وهيئة علماء المسلمين حاضرة، اليوم في كل الأحداث فيما يخرس الدستور... وبصراحة أكثر أستطيع القول إن الدستور الحالي لا يشجعنا أن نرفعه حتى نداً للشرعيات التقليدية». إن مقاربة سريعة لواقع تركيبة السلطة التشريعية (مجلس النواب) بعد الوحدة 22 مايو 1990م، ومجلس النواب المنتخب في 27 إبريل 1993م، توضح الفارق النوعي بينهما وبين تركيبة المجلس الحالي اجتماعياً وسياسياً ، حيث تهيمن التركيبة الاجتماعية التقليدية (المشيخية القبلية) على مجمل تركيبة المجلس الحالي، ففي مجلس نواب دولة الوحدة أقر قانون التعليم الموحد القاضي بإلغاء حالة ازدواجية التعليم، كان ذلك في قمة الصراع السياسي في البلد، واليوم يبقى قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته لسنوات معلقاً في دهاليز إدارة المجلس، وغيرها من القوانين والتشريعات، وتتسع في المجتمع ظاهرة الثأر، والحروب الأهلية الداخلية والقبلية، وتسود الأحكام العرفية، والقبلية، ضداً على أحكام الدستور والقانون بل إن السلطة ورموزها يفضلون الحلول والأحكام العرفية القبلية، على اللجوء إلى أحكام الدستور والقانون والقضاء، وتمارس السلطة ورموز الدولة العليا (التهجير) القبلي، والعودة للأعراف والأحكام القبلية على اللجوء للدستور والقانون، والقضاء، ووصل الأمر أن رموزاً في النظام يُحَكِّمُون قبيلة -كما حدث مع قبيلة الكبس- على الدولة. ويمكنني القول إنه ولأسباب عديدة موضوعية وذاتية، لم ينكسر النموذج التقليدي في الاجتماع والسياسة، ولم يفرض الحداثي النقدي نفسه، إلا من خلال فعل سلطة الزمن، وبفعل حتمية التغيير الطبيعية التي يفرضها الزمن، والسبب العميق هو غياب الإرادة السياسية الوطنية لذلك التغيير وخشية من تبعاته، لذلك انحصر التغيير والتحول في البنى الاجتماعية التقليدية في أضيق نطاق. ويصدق على هذه اللحظة اليمنية الاجتماعية التاريخية قول المفكر علي حرب «إن انكسار النموذج التقليدي والأحادي في البلدان العربية لم يفض إلى ابتكار نماذج جديدة، ولا إلى اكتساب القيم والفضائل الحديثة، على ما جرى في المجتمعات الغربية، وعلى نحو يؤدي إلى المشاركة الغنية والفعالة في صناعة الحياة الحديثة والمعاصرة، وإنما الذي جعل أن الفرد العربي بات على الصعيد الخلقي، والفكري معلقاً أو مشطوراً أو ممزقاً بين القديم والحديث، فلا هو محافظ، ولا هو حديث، لا هو رجعي ولا هو تقدمي، لا هو متخلف ولا هو متقدم» ولا أفهم الفكرة السابقة التي قدمها المفكر علي حرب إلا بدلالتها النسبية، ما يعني أن العملية والقضية صراعية وكفاحية بين التقليدي والحديث، بين التقدمي والرجعي، تبقى القضية محصورة في إطار مشروعين أحدهما يرى ضرورة الإصلاح والتغيير في البنى الاجتماعية التقليدية والمفاهيم الثقافية العصبوية، والعلاقات الإنتاجية، والقيم ما قبل الرأسمالية، وآخر يسعى لتكريس وترسيخ البنى الاجتماعية التقليدية، مع توظيفه جميع أشكال الحداثة والمدنية (المادية، والمفاهيمة، والمعنوية) بعد إفراغها من مضامينها لخدمة البنى الاجتماعية السائدة، أحدهما يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة وصناعة القرار، وتوسيع حضور المجتمع المدني كفاعل أساسي إلى جانب القوى السياسية والتنظيمية الأخرى، وآخر يحاول تكريس صورة الهيمنة التقليدية على السلطة والثروة، وعدم الفصل بينهما، لاستمرار الهيمنة على المجال السياسي ورفض أي محاولة لإعادة بناء المجال السياسي بصورة جديدة وحديثة، ونعني هنا بإعادة بناء المجال السياسي، تجاوز وضعية البنية البطركية، من خلال تفعيل دور دولة المؤسسات، وسلطة القانون والنظام، لأنه لا نظام من دون قانون، والعمل الجدي لإعادة بناء الاجتماع السياسي على أساس من تعميق فكرة المواطنة، والتعددية الحقيقية، والحرية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والتداول السلمي للسلطة، كما أشار إليها برنامج الرئيس الانتخابي 20 سبتمبر 2006م، وكما هي في نص الدستور.إن أكثر ما تخشاه القوى السياسية والاجتماعية التقليدية، إنما هو الدستور، والقانون، والتعددية، وقوة حضور فكرة المواطنة، وتكافؤ الفرص، والعدالة، وتداول السلطة سلمياً، من السلطة داخل الأطر الصغيرة اجتماعياً، إلى السلطة المحلية، إلى البرلمان، إلى الرئاسة. فجميع المفردات السابقة مناقضة لمعنى وجودها.
إن تحول الممثل في السلطة المحلية والنائب في البرلمان، إلى كائن فردي مستقل عن سلطة الجماعة القبلية، وتحوله ممثلاً للشعب عموماً هي بداية الوعي بفكرة المواطنة، وتحول هذه الأشكال والأطر إلى وسائط مدنية اجتماعية سياسية تساهم في إذابة الجميع في إطار سلطة دولة لكل مواطنيها، ولذلك يرفض رموز المؤسسة المشيخية القبلية تحولهم إلى جزء من المجتمع والدولة. فقد اعتاد الشيخ رمز القبيلة -قبل الثورة وبعدها وحتى اليوم- إنه جامع الضرائب أو مساهم في جمعها، ويعمل لتجميع المواطنين للتجنيد، يحل مشاكل مجتمع القرية، بل والحارة حتى في المدينة، (صنعاء، تعز، الحديدة... إلخ) وتعممت ظاهرة شيخ الحارة على كل المدن الرئيسة من بعد حرب 1994م وبما فيها عدن.
وإذا كان الشيخ وعاقل الحارة، كان يكتفي بأن يقوم بدور القاضي، ومساعد قسم الشرطة، والمخبر الأمني، فهو اليوم رئيس لحزب سياسي، ورئيس للبرلمان، وفق معادلة «شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ»، وتأكيدا لهذا المعنى ولهذه الفكرة أشار نصر طه مصطفي أنه «عند إجراء انتخابات مجلس الشورى مرة أخرى في عهد الرئيس علي عبدالله صالح عام 1988م حرص الشيخ الأحمر على أن يرشح نفسه إلا أن الرئيس صالح طلب منه بشكل ودي عدم ترشيح نفسه لحسابات سياسية، كانت بصيرة في حينها لكنه عاد فشجع الشيخ للترشيح لعضوية مجلس النواب في أول انتخابات نيابية تجري عقب وحدة الشطرين عام 1993م ، وأدرك الجميع حينها أن رجلاً بحجم الشيخ الأحمر لا يمكن أن يترشح مالم يكن هو رئيس البرلمان القادم وهذا ما حدث» وخلال الفترتين اللتين تم فيهما انتخاب الشيخ عبدالله لرئاسة البرلمان، لم يحقق حزبه(الإصلاح) العدد الذي يؤهله لانتخابه وإعادة انتخابه، وهي في الحقيقة استمرار للمعادلة والصيغة التاريخية في صورتها الجديدة، شيخ الرئيس، ورئيس الشيخ، صيغة وحدة القبيلة بالدولة. ولا أمل لمشروع الدولة المدنية الحديثة من دون فك ذلك الارتباط بين الدولة والقبلية، في صورة رمزها السياسي الشيخ. لذلك تقف رموز الارستقراطية المشيخية القبلية ضد مشروع الدولة الوطنية الحديثة، كما ليس في مصلحتهم -المشايخ- إحداث تنمية وتحديث وتمدين حقيقي في مجتمعاتها فذلك يعني إذابة وتفكيك سلطتها، لصالح سلطة أعلى، هي الدولة المركزية، دولة لكل مواطنيها، لذلك يعتمد رموز المشيخة القبلية إبقاء مجتمعاتهم في حالة من التخلف والجهل ومن دون مدرسة ولا تعليم، وفقاً للقاعدة الإمامية «الشعب الجاهل أسلس قيادة من الشعب العارف أو المتعلم، وعند هذه النقطة تتفق وتلتقي أجزاء أو أجنحة في النظام السياسي القائم مع رموز المشروع التقليدي للمشايخ ورموز القبلية المسلحة، وجميعهم ليس لهم مصلحة في اندماج البنية القبلية في مشروع الدولة الحديثة، وفي بنية المجتمع الوطني ككل، وإلا فكيف نفسر استمرار وجود ظاهرة مؤسسة أو مصلحة شؤون القبائل بعد أكثر من خمسة وأربعين عاماً على قيام ثورة 26 سبتمبر وتعميمها بعد الوحدة 22 مايو 1990م على كل الوطن وكيف نفهم أن ميزانية شؤون القبائل تصل إلى أكثر من أربعة مليار ريال سنوياً، ومدرجة في الموازنة العامة للدولة وتتزايد عاماً بعد آخر، أكبر من جمع ميزانيات مراكز البحوث والدراسات في اليمن عدة مرات، وكأننا ما نزال عند لحظة إصدار القرار الجمهوري بقانون لإنشاء مجلس شيوخ القبائل في إبريل 1963م، وعند حدود المادة العاشرة من الإعلان الدستوري الذي أصدر بتاريخ 31/10/1962م».
إن ما لا يدركه البعض اليوم هو أن هذه الوحدة الظاهرية الشكلية التي تنسم بها البنية الاجتماعية التقليدية، وفي زمن العولمة، والتحولات الديمقراطية الكونية، وثورة الاتصالات والمعلومات التي قلصت المكان ووحدت الزمان، هو أن هذه الوحدة في البنية الاجتماعية التقليدية في أساسها العميق هي وحدة ظاهرية سطحية خارجية، هي وحدة تعيش حالة اضطراب وعدم تماسك، وتفكك داخلي، والحروب القبلية الداخلية الصغيرة والكبيرة، وتوسع ظاهرة الثأر والقتل داخل القبيلة والعائلة الواحدة في القبيلة ذاتها هو مظهر من مظاهر التحلل والتفكك في قلب هذه البنية، كما تلعب حالة الرسملة الاقتصادية للزراعة، والهجرة الواسعة من الريف إلى المدن الرئيسة، إلى جانب طبيعة الدولة الريعية، والاقتصاد الريعي، ونسبة الفقر الكبيرة، والبطالة، دوراً مساعداً في تفكيك اللحمة الاجتماعية التقليدية، وهو عموماً تفكك داخلي تاريخي حكم طبيعة ومحتوى هذه الوحدة (الأبوية) لأن ما يضبط وينظم هذه الوحدة الداخلية، إنما هو عامل القوة بمعناها المجرد والمطلق، وعامل العصبية، ثانياً، هي وحدة قائمة بفعل دور مباشر وأساسي للسلطة أو الدولة البطركية التي تعيد إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية باستمرار، وخاصة مع كل منعطف سياسي تاريخي حاد قد يقود إلى إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي ككل.
ثالثاً: هناك تطورات مادية، اقتصادية إنتاجية رأسمالية، وتحولات سياسية واجتماعية شهدتها البلاد طيلة أربعة عقود ونيف منصرمة، أحدثت - قطعاً- خلخلة عميقة في بنية وتركيبة المجتمع التقليدي، وفي الفكر، والثقافة السياسية عامة، على أن أثرها مكبوت، وفعلها محاصر ومقموع، ومسكوت عنه، بفعل دور أيديولوجي، وسياسي، وإعلامي مباشر من بعض أجنحة الحكم، وبفعل عدم فك الاشتباك بين رموز الجمهورية القبلية التقليدية، و(الدولة) وهي الأزمة السياسية التاريخية نفسها التي بدأت مع قيام الثورة والدفاع عنها، وبدء التأسيس الجدي لها مع انقلاب 5 نوفمبر 1967م.
فإذا كانت 5 نوفمبر 1967م، أسست تاريخياً لإعادة إنتاج البنية المشيخية القبلية، والبنية السياسية التقليدية في صورة (المجلس الجمهوري) بعد 5 نوفمبر، وعززت مكانة وموقع البنية الاجتماعية التقليدية، فإن أحداث 13 يناير 1986م ساهمت بدور كبير في إضعاف تيار الحداثة والتقدم، لصالح قوى التقليد، ومثلت نكسة سياسية واجتماعية وثقافية ووطنية. وجاءت حرب 1994م لتعيد إنتاج وصياغة وترسيم البنية الاجتماعية التقليدية، على مستوى الوطن الموحد ، وتعظيم دورها ومكانتها في جميع مفاصل السلطة والدولة، والمجتمع والثقافة، تراجع معها بصورة واضحة دور ومكانة المرأة الاجتماعي، ومضمونها الحداثي، تحققت معه انتكاسة سياسية واجتماعية وثقافية ووطنية شاملة، طالت آثارها السلبية كافة قطاعات وشرائح وطبقات المجتمع، كان حظ الثقافة والمثقفين منها كبيراً، حيث رأينا قطاعاً من المثقفين ينكفئ على ذاته وينعزل، ويعود للاحتماء بالقبيلة، أو يتسولها للنجاة، ويتوسل القيم والمفاهيم والأفكار المتخلفة وكأنه يتبرأ من تاريخ آثم، ويعود قطاع من المثقفين والسياسيين إلى أحفوراتهم الأصولية العرقية، السلالية، المذهبية، القبلية، العشائرية، والجغرافية، ومشجر أنسابهم، وكأنهم يصحون فجأة على غلطة أو جريمة تاريخية كبرى لا تبرأ إلا بالتطهر عما كانوا عليه ، وهي في تقديري ردة اجتماعية وثقافية وسياسية ووطنية شاملة. هي انعكاس لحالة سياسية عامة. وإلا فكيف نفسر أن يتحول النظام الاجتماعي التقليدي (الأبوي) مصدراً لنيل الشرعية، يذهب معها المثقف الوطني والقومي، والتقدمي للبحث عن خريطة أصوله العرقية والسلالية والجغرافية، والقبلية، والمذهبية في أحفورات التاريخ الاجتماعي، بل الانثربولوجي، حيث المطلوب منه إعادة تسجيل اسمه وأصله الأحفوري، على بطاقة الهوية الشخصية الجديدة، وهو قمة التعبير عن لحظة انحطاط الوعي، وتراجع دور الثقافة والمثقف، والعقل والعقلانية الاجتماعية النقدية، بل وكل شكل من أشكال العقل النقدي!!.