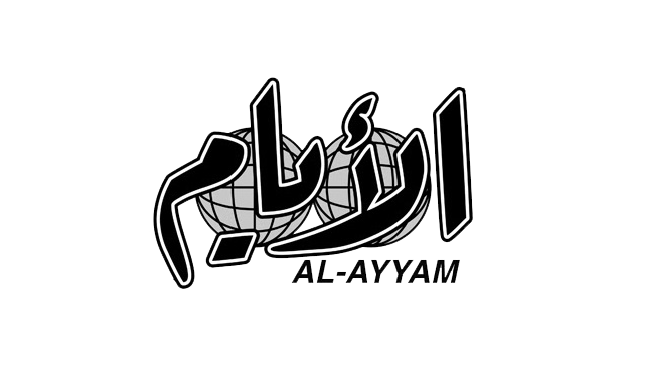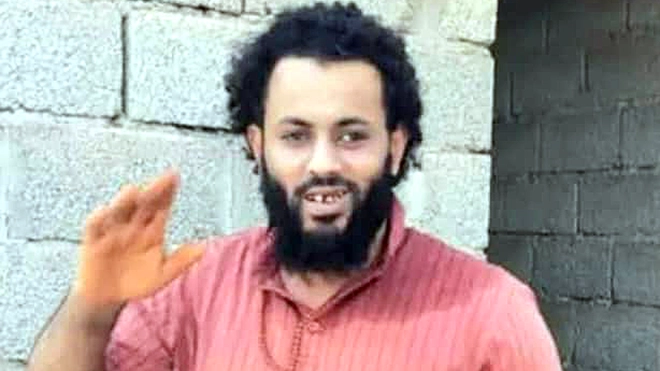> قادري أحمد حيدر:
إن سؤال التحديث يستدعي بالضرورة الحفر في أسئلة الثقافة، والسياسة، والتنمية الاقتصادية الإنتاجية، فما بالنا والسؤال يتحدد في المداخل لتحديث ثقافة المجتمع ودورها في التنمية، وهو سؤال كبير يستعصي الإمساك بمفرداته جميعاً، أو متابعتها بدقة.
وسيبقى همنا في هذه الورقة منحصراً في تحديد الخطوط العريضة لهذه المداخل التي نجدها الأساس في تحديث ثقافة المجتمع وفي تنميته. ولا معنى هنا لسؤال تحديث ثقافة المجتمع بعيداً عن سؤال التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والأهم هو سؤال إعادة بناء المجال السياسي، سؤال الدولة المدنية المؤسسية، دولة الحق، وسلطة القانون والمساواة أمام القانون، وهو السؤال المركزي كما أراه الذي سيتخلل معظم مفردات الفقرات التي تحتويها الورقة بصورة مركزة وفي خطوطها العريضة والعامة.
إن التحديث مشروع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي تاريخي كبير، ومن الخطل تصور أن عملية التحديث، وتحديث ثقافة المجتمع بصورة خاصة ممكن استحضارها أو تحققها من خلال إحداث بعض الإصلاحات، أو التحولات السياسية الشكلية في البنى التقليدية القائمة، كما أن تحديث ثقافة المجتمع مشروع تاريخي يتطلب توافر إرادة سياسية واعية لما نريد من تحديث وتنمية وتقدم اجتماعي .. تضع في اعتبارها قضية التحديث في ارتباط مع إحداث تحولات اقتصادية اجتماعية، غير منفصلة عن الشروع في إحداث إصلاحات سياسية وديمقراطية وقانونية، ودستورية، إصلاحات تطال مجمل البنية المؤسسية للدولة والسلطة، باتجاه تأسيسي وترسيخ سلطة دولة المؤسسات.. السؤال الكبير الغائب عن حياتنا كلها، لذلك نجد أن من المستحيل الدخول إلى إحداث تغيير جذري بنيوي في البنية الاجتماعية التقليدية، في غياب :
أولاً : إرادة سياسية وطنية واعية ومدركة معنى ضرورة الإصلاح والتغيير للخروج من عنق الأزمة السياسية والوطنية التاريخية.
ثانياً : الإقرار بالإصلاح والتغيير يجب أن يكون ذا مضامين وأبعاد وأهداف تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، بعيداً عن سياسات الترقيعات الإصلاحية الجزئية هنا أو هناك وبدون رؤية للإصلاح، وغالباً ما تأتي الإصلاحات الجزئية والكمية بناءً لمطالب وشروط الجهات المانحة، وتنفيذاً لسياساتها الخارجية - الصندوق والبنك الدوليين - ولذلك نرى أن تحديث ثقافة المجتمع ليست إشكالية معرفية ونظرية، أو هي مسألة فكرية وثقافية وسياسية، بقدر ما هي عملية تنموية استراتيجية شاملة، وهي في الوقت نفسه إشكالية أو قضية صراعية كفاحية بين دعاة التنمية وتحديث ثقافة المجتمع، وبين قوى المحافظة والتقليد؛ وبدون تأهيل قطاعات واسعة في المجتمع للمساهمة والمشاركة الجدية في صياغة القرار، وفي عملية التنمية، كما تشير إلى ذلك جميع تقارير البرامج الإنمائية للأمم المتحدة، فإنه يصبح من المتعذر بل من المستحيل الشروع في تحقيق أي تنمية أو تحديث جدي في المجتمع، وفي البنى التقليدية المهيمنة. فالمشاركة الجدية الواسعة لفئات وشرائح وطبقات المجتمع المختلفة في التنمية، وفي المشاركة في صياغة القرار السياسي، وفي الإسهام في بناء المجتمع من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المختلفة، وكافة أشكال المنظمات غير الحكومية والأهلية التعاونية ذات الصلة الحقيقية ببنية المجتمع التقليدي والخارجة من صلبه مثل الجمعيات التعاونية الخيرية والإصلاحية التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع وإن كان البعض لا يعدها ضمن منظمات المجتمع المدني، وجميع هذه الإرادات والإجراءات في حال توافر الإرادة السياسية الوطنية قد تؤدي إلى إعادة بناء مجال القوة، وتحديداً إعادة بناء المجال السياسي العام، مجال تأسيس وبناء مشروع الدولة المؤسسية المدنية الحديثة.
ونعني بإعادة بناء المجال السياسي هنا تجاوز وضعية البنية - البطريكية - الاجتماعية التقليدية، الملقحة، من خلال تفعيل دور دولة المؤسسات، وسلطة القانون والنظام/ لأنه لا نظام بدون قانون.
وفي الوقت نفسه العمل الجدي لإعادة صياغة بناء الاجتماع السياسي على أساس يغوص في جذر فكرة المواطنة، والتعددية، والحرية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والتداول السلمي للسلطة التي أشار إليها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لمرتين مضيفاً إلى ذلك في برنامجه اختصار مدة بقاء رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بدلاً عن سبع سنوات ؛ وهو وعد مطلوب تحقيقه، بل تحقيق كافة الوعود التي طرحها في برنامجه الرئاسي الانتخابي بما فيها وعده بالقضاء على الفقر.
وتحديداً التأكيد المتكرر على ضرورة قيام واستكمال بناء دولة المؤسسات - كما جاء في برنامجه الانتخابي - إلى جانب تأكيده على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وبناء المجتمع المدني، وترسيخ التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والبدء الجدي في التوجه نحو تنفيذ هذه الوعود البرنامجية الانتخابية ، وللدخول إلى تحديث ثقافة المجتمع وتنميته إنما يكون من خلال تجاوز الواقع البائس والمأزوم لاستمرار حالة ثنائية الدولة والسلطة، وثنائية الثروة والسلطة، وثنائية الحاكم الشخصي، والمؤسسة، وثنائية الدين والسياسة، وثنائية العمل والسياسة. وهي القضايا التي حاولت الورقة التطرق إلى مفرداتها في خطوطها العامة والعريضة.
إن واحداً من أسباب أزمة التحديث وثقافة الحداثة في اليمن في التاريخ المعاصر -بشطريه- هو أن مشاريع التنمية سارعت خطاها بساق واحدة، أو أنها كانت تنمية مشوهة وأحادية البعد، وكانت تجري في سياق تحولات جزئية لم تلامس صلب البنية الاجتماعية التقليدية بشكل جذري، والأمر هنا ينطبق على المرحلتين في تطور التجربة السياسية والاجتماعية والوطنية اليمنية - في الشطرين بدرجات متفاوتة- والمقصود هنا بالمرحلتين مرحلة الثورة في الشمال، وتحقيق الاستقلال الوطني الكامل والناجز في الجنوب، حيث اقتصر التحول على إجراءات جزئية وكمية، ولم تمس إجراءات الثورة البعد السياسي، وقضايا الحريات، وحقوق الإنسان، وفرضت أنظمة شمولية، أنظمة الحزب الواحد، أو النظام العسكري المشائخي القبلي، رحَّلَ كلا النظامين العمل السياسي الديمقراطي، والتعددية، على مشجب حل المسألة الاجتماعية والوطنية، والقومية، وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وصوت الحزب الواحد، فلاهما حققا تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، ولا دخلا المعركة وساهما في حل المسألة القومية، ولا أنهما أنجزا مهمات التحول السياسي المؤسسي الديمقراطي على صعيد الدولة ونظام الحكم السياسي، وهو ما شكل - بعد ذلك - عقبة جدية أمام مسار تطور العملية السياسية الوطنية الوحدوية.
والمرحلة الثانية وهي مرحلة الوحدة - لم تتطرق الورقة لأي منهما في عناوين مباشرة - وهي من حيث الجوهر لم تختلف جذرياً عن الأولى سوى في أنها أنجزت مهمات إعلان دولة الوحدة، وربطت الوحدة بالديمقراطية، وأقر دستور الوحدة.
إن جوهر النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وهو في تقديري إنجاز سياسي ووطني وديمقراطي هائل قياساً بما كان معمولاً به في الشطرين وفي هذه المرحلة أنجزت سلطة الوحدة جملة من المشاريع السياسية الديمقراطية؛ إصدار قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، قانون الانتخابات، الاستفتاء على دستور دولة الوحدة على معارضة شديدة من القوى الاجتماعية السياسية التقليدية، والجماعات الدينية الأصولية، ليس بسبب عدائها للدستور فحسب، وإنما لخوفها الشديد من أي توجه جدي للتحديث والتنمية السياسية الشاملة، ففي ذلك زعزعة للبنية الاجتماعية التقليدية التي ترتكز عليها قوتها، ويتحدد من خلال استمرارها وثباتها دورها السياسي الكبير ومكانتها الاجتماعية والثقافية الراسخة التي لم تتمكن الثورة وإجراءاتها من زحزحتها عنها إلا قليلاً ولمرحلة قصيرة خاصة في شمال الوطن، حيث بقيت الأشكال التقليدية هي التي تتحكم بمسار الأمور في البلاد، وهي التي بيدها تحديد مستقبل البلاد، وبرز تفرد ومكانة القوى الاجتماعية السياسية التقليدية المشيخية والقبلية والعسكرية بقوة ووضوح بعد حرب 1994م حيث وسعت الحرب من مساحة مشاركة القوى المشيخية القبلية فيها ورفعت من أسهمها السياسية ومن رصيدها في قمة السلطة أكثر مما كان عليه الحال قبل إعلان الوحدة ؛ وهي بمثابة استحقاقات سياسية واقتصادية، أو ريع سياسي، وثمن مشاركتها في الحرب «المقدسة»، كما كان يسميها رموز الأرستقراطية المشيخية القبلية والعسكرية ؛ ومعها - أي بعد الحرب - توقفت المساعي الجدية لدولة الوحدة لاستكمال مشروع إحداث إصلاحات حقيقية في الواقع السياسي والاقتصادي والتنموي، توقف بعدها الإصلاح عند حالات جزئية بعد أن جرى عرقلة وتعويق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وكبح عملية التطور الاقتصادي الرأسمالي من قبل مراكز القوى التقليدية في قمة السلطة ، ولم تؤد الإصلاحات الجزئية والكمية المفصولة عن أي رؤية إستراتيجية للإصلاح الشامل إلى إحداث أي تغيير في البنية الاجتماعية التقليدية أو في الهرم الاجتماعي السائد تاريخياً، بل أنه جرى تعميمه على كل الوطن، تم بعدها تعديل بل تغيير - دستور دولة الوحدة، الذي قلص كثيراً من إمكانية الحد من نفوذ وسلطة وهيمنة البنية الاجتماعية التقليدية والعصبوية ، وقلص من إمكانية توجه اليمن نحو المستقبل، وتمثل ذلك في الموقف من مفهوم المواطنة خاصة تعديل المواد الدستورية المؤكدة على ذلك ... المادة (...)، وفي الموقف من المرأة، وفي الإصلاح السياسي التعددي الذي كانت البلاد قد شرعت في التوجه نحوه.
وعموماً أستطيع القول إن سؤال الدولة المركزية - أو دولة المؤسسات - هو سؤال عمره أكثر من ستة عقود أعلنته وثائق الأحرار الدستوريين بوضوح وأشارت إليه العديد من وثائق وكتابات الأحرار وبرامجهم السياسية.
وسؤال الأحرار حول الدولة، والمواطنة والعمل المؤسسي، ونقض جذر فكرة الراعي والرعية، جميعها أسئلة ما تزال تكتسب مصداقيتها، وواقعيتها، وتاريخيتها حتى اليوم.
وسيبقى همنا في هذه الورقة منحصراً في تحديد الخطوط العريضة لهذه المداخل التي نجدها الأساس في تحديث ثقافة المجتمع وفي تنميته. ولا معنى هنا لسؤال تحديث ثقافة المجتمع بعيداً عن سؤال التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والأهم هو سؤال إعادة بناء المجال السياسي، سؤال الدولة المدنية المؤسسية، دولة الحق، وسلطة القانون والمساواة أمام القانون، وهو السؤال المركزي كما أراه الذي سيتخلل معظم مفردات الفقرات التي تحتويها الورقة بصورة مركزة وفي خطوطها العريضة والعامة.
إن التحديث مشروع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي تاريخي كبير، ومن الخطل تصور أن عملية التحديث، وتحديث ثقافة المجتمع بصورة خاصة ممكن استحضارها أو تحققها من خلال إحداث بعض الإصلاحات، أو التحولات السياسية الشكلية في البنى التقليدية القائمة، كما أن تحديث ثقافة المجتمع مشروع تاريخي يتطلب توافر إرادة سياسية واعية لما نريد من تحديث وتنمية وتقدم اجتماعي .. تضع في اعتبارها قضية التحديث في ارتباط مع إحداث تحولات اقتصادية اجتماعية، غير منفصلة عن الشروع في إحداث إصلاحات سياسية وديمقراطية وقانونية، ودستورية، إصلاحات تطال مجمل البنية المؤسسية للدولة والسلطة، باتجاه تأسيسي وترسيخ سلطة دولة المؤسسات.. السؤال الكبير الغائب عن حياتنا كلها، لذلك نجد أن من المستحيل الدخول إلى إحداث تغيير جذري بنيوي في البنية الاجتماعية التقليدية، في غياب :
أولاً : إرادة سياسية وطنية واعية ومدركة معنى ضرورة الإصلاح والتغيير للخروج من عنق الأزمة السياسية والوطنية التاريخية.
ثانياً : الإقرار بالإصلاح والتغيير يجب أن يكون ذا مضامين وأبعاد وأهداف تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، بعيداً عن سياسات الترقيعات الإصلاحية الجزئية هنا أو هناك وبدون رؤية للإصلاح، وغالباً ما تأتي الإصلاحات الجزئية والكمية بناءً لمطالب وشروط الجهات المانحة، وتنفيذاً لسياساتها الخارجية - الصندوق والبنك الدوليين - ولذلك نرى أن تحديث ثقافة المجتمع ليست إشكالية معرفية ونظرية، أو هي مسألة فكرية وثقافية وسياسية، بقدر ما هي عملية تنموية استراتيجية شاملة، وهي في الوقت نفسه إشكالية أو قضية صراعية كفاحية بين دعاة التنمية وتحديث ثقافة المجتمع، وبين قوى المحافظة والتقليد؛ وبدون تأهيل قطاعات واسعة في المجتمع للمساهمة والمشاركة الجدية في صياغة القرار، وفي عملية التنمية، كما تشير إلى ذلك جميع تقارير البرامج الإنمائية للأمم المتحدة، فإنه يصبح من المتعذر بل من المستحيل الشروع في تحقيق أي تنمية أو تحديث جدي في المجتمع، وفي البنى التقليدية المهيمنة. فالمشاركة الجدية الواسعة لفئات وشرائح وطبقات المجتمع المختلفة في التنمية، وفي المشاركة في صياغة القرار السياسي، وفي الإسهام في بناء المجتمع من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المختلفة، وكافة أشكال المنظمات غير الحكومية والأهلية التعاونية ذات الصلة الحقيقية ببنية المجتمع التقليدي والخارجة من صلبه مثل الجمعيات التعاونية الخيرية والإصلاحية التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع وإن كان البعض لا يعدها ضمن منظمات المجتمع المدني، وجميع هذه الإرادات والإجراءات في حال توافر الإرادة السياسية الوطنية قد تؤدي إلى إعادة بناء مجال القوة، وتحديداً إعادة بناء المجال السياسي العام، مجال تأسيس وبناء مشروع الدولة المؤسسية المدنية الحديثة.
ونعني بإعادة بناء المجال السياسي هنا تجاوز وضعية البنية - البطريكية - الاجتماعية التقليدية، الملقحة، من خلال تفعيل دور دولة المؤسسات، وسلطة القانون والنظام/ لأنه لا نظام بدون قانون.
وفي الوقت نفسه العمل الجدي لإعادة صياغة بناء الاجتماع السياسي على أساس يغوص في جذر فكرة المواطنة، والتعددية، والحرية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والتداول السلمي للسلطة التي أشار إليها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لمرتين مضيفاً إلى ذلك في برنامجه اختصار مدة بقاء رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بدلاً عن سبع سنوات ؛ وهو وعد مطلوب تحقيقه، بل تحقيق كافة الوعود التي طرحها في برنامجه الرئاسي الانتخابي بما فيها وعده بالقضاء على الفقر.
وتحديداً التأكيد المتكرر على ضرورة قيام واستكمال بناء دولة المؤسسات - كما جاء في برنامجه الانتخابي - إلى جانب تأكيده على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وبناء المجتمع المدني، وترسيخ التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والبدء الجدي في التوجه نحو تنفيذ هذه الوعود البرنامجية الانتخابية ، وللدخول إلى تحديث ثقافة المجتمع وتنميته إنما يكون من خلال تجاوز الواقع البائس والمأزوم لاستمرار حالة ثنائية الدولة والسلطة، وثنائية الثروة والسلطة، وثنائية الحاكم الشخصي، والمؤسسة، وثنائية الدين والسياسة، وثنائية العمل والسياسة. وهي القضايا التي حاولت الورقة التطرق إلى مفرداتها في خطوطها العامة والعريضة.
إن واحداً من أسباب أزمة التحديث وثقافة الحداثة في اليمن في التاريخ المعاصر -بشطريه- هو أن مشاريع التنمية سارعت خطاها بساق واحدة، أو أنها كانت تنمية مشوهة وأحادية البعد، وكانت تجري في سياق تحولات جزئية لم تلامس صلب البنية الاجتماعية التقليدية بشكل جذري، والأمر هنا ينطبق على المرحلتين في تطور التجربة السياسية والاجتماعية والوطنية اليمنية - في الشطرين بدرجات متفاوتة- والمقصود هنا بالمرحلتين مرحلة الثورة في الشمال، وتحقيق الاستقلال الوطني الكامل والناجز في الجنوب، حيث اقتصر التحول على إجراءات جزئية وكمية، ولم تمس إجراءات الثورة البعد السياسي، وقضايا الحريات، وحقوق الإنسان، وفرضت أنظمة شمولية، أنظمة الحزب الواحد، أو النظام العسكري المشائخي القبلي، رحَّلَ كلا النظامين العمل السياسي الديمقراطي، والتعددية، على مشجب حل المسألة الاجتماعية والوطنية، والقومية، وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وصوت الحزب الواحد، فلاهما حققا تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، ولا دخلا المعركة وساهما في حل المسألة القومية، ولا أنهما أنجزا مهمات التحول السياسي المؤسسي الديمقراطي على صعيد الدولة ونظام الحكم السياسي، وهو ما شكل - بعد ذلك - عقبة جدية أمام مسار تطور العملية السياسية الوطنية الوحدوية.
والمرحلة الثانية وهي مرحلة الوحدة - لم تتطرق الورقة لأي منهما في عناوين مباشرة - وهي من حيث الجوهر لم تختلف جذرياً عن الأولى سوى في أنها أنجزت مهمات إعلان دولة الوحدة، وربطت الوحدة بالديمقراطية، وأقر دستور الوحدة.
إن جوهر النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وهو في تقديري إنجاز سياسي ووطني وديمقراطي هائل قياساً بما كان معمولاً به في الشطرين وفي هذه المرحلة أنجزت سلطة الوحدة جملة من المشاريع السياسية الديمقراطية؛ إصدار قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، قانون الانتخابات، الاستفتاء على دستور دولة الوحدة على معارضة شديدة من القوى الاجتماعية السياسية التقليدية، والجماعات الدينية الأصولية، ليس بسبب عدائها للدستور فحسب، وإنما لخوفها الشديد من أي توجه جدي للتحديث والتنمية السياسية الشاملة، ففي ذلك زعزعة للبنية الاجتماعية التقليدية التي ترتكز عليها قوتها، ويتحدد من خلال استمرارها وثباتها دورها السياسي الكبير ومكانتها الاجتماعية والثقافية الراسخة التي لم تتمكن الثورة وإجراءاتها من زحزحتها عنها إلا قليلاً ولمرحلة قصيرة خاصة في شمال الوطن، حيث بقيت الأشكال التقليدية هي التي تتحكم بمسار الأمور في البلاد، وهي التي بيدها تحديد مستقبل البلاد، وبرز تفرد ومكانة القوى الاجتماعية السياسية التقليدية المشيخية والقبلية والعسكرية بقوة ووضوح بعد حرب 1994م حيث وسعت الحرب من مساحة مشاركة القوى المشيخية القبلية فيها ورفعت من أسهمها السياسية ومن رصيدها في قمة السلطة أكثر مما كان عليه الحال قبل إعلان الوحدة ؛ وهي بمثابة استحقاقات سياسية واقتصادية، أو ريع سياسي، وثمن مشاركتها في الحرب «المقدسة»، كما كان يسميها رموز الأرستقراطية المشيخية القبلية والعسكرية ؛ ومعها - أي بعد الحرب - توقفت المساعي الجدية لدولة الوحدة لاستكمال مشروع إحداث إصلاحات حقيقية في الواقع السياسي والاقتصادي والتنموي، توقف بعدها الإصلاح عند حالات جزئية بعد أن جرى عرقلة وتعويق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وكبح عملية التطور الاقتصادي الرأسمالي من قبل مراكز القوى التقليدية في قمة السلطة ، ولم تؤد الإصلاحات الجزئية والكمية المفصولة عن أي رؤية إستراتيجية للإصلاح الشامل إلى إحداث أي تغيير في البنية الاجتماعية التقليدية أو في الهرم الاجتماعي السائد تاريخياً، بل أنه جرى تعميمه على كل الوطن، تم بعدها تعديل بل تغيير - دستور دولة الوحدة، الذي قلص كثيراً من إمكانية الحد من نفوذ وسلطة وهيمنة البنية الاجتماعية التقليدية والعصبوية ، وقلص من إمكانية توجه اليمن نحو المستقبل، وتمثل ذلك في الموقف من مفهوم المواطنة خاصة تعديل المواد الدستورية المؤكدة على ذلك ... المادة (...)، وفي الموقف من المرأة، وفي الإصلاح السياسي التعددي الذي كانت البلاد قد شرعت في التوجه نحوه.
وعموماً أستطيع القول إن سؤال الدولة المركزية - أو دولة المؤسسات - هو سؤال عمره أكثر من ستة عقود أعلنته وثائق الأحرار الدستوريين بوضوح وأشارت إليه العديد من وثائق وكتابات الأحرار وبرامجهم السياسية.
وسؤال الأحرار حول الدولة، والمواطنة والعمل المؤسسي، ونقض جذر فكرة الراعي والرعية، جميعها أسئلة ما تزال تكتسب مصداقيتها، وواقعيتها، وتاريخيتها حتى اليوم.