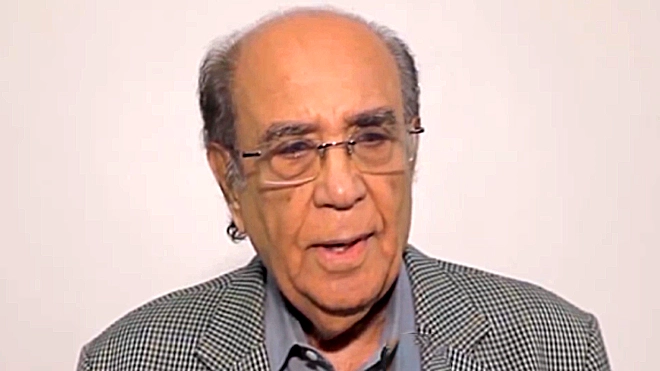> عبدالله أحمد غانم:
تنشر «الأيام» القراءة القانونية لمشروع«الاصلاح السياسي الوطني» تزامنا مع نشرها في الزميلة صحيفة «26 سبتمبر» .
بعد قراءة فاحصة لمشروع الإصلاح المقترح من قبل ممثلي ستة أحزاب من أحزاب المعارضة والمعروفة بأحزاب اللقاء المشترك (ثلاثة منها لديها ممثلون في مجلس النواب) وجدت أن هذه الوثيقة التي أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي عقد الاسبوع قبل الماضي بدون ممانعة السلطة الرسمية قد تعرضت لجملة من المسائل الدستورية والقانونية الى جانب مسائل أخرى عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
فيما يتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية المثارة في هذه الوثيقة، وإزاء الأسلوب الذي اتبعه واضعو الوثيقة في تناول هذه المسائل الهامة وجدت نفسي مدفوعاً الى كتابة تعقيب قانوني عليها، ليس رداً على ماجاء بالوثيقة بقدر ماهو حرص على تبصير القراء الكرام والمواطنين عموماً بالمسائل الدستورية والقانونية وبمفاهيمها الصحيحة وكيفية تعامل النظام السياسي اليمني معها ومكانتها في هذا النظام القائم على مبادئ السيادة الشعبية والمشروعية الدستورية.
ولا أشك لحظة واحدة أن ما لفت نظري إزاء المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الوثيقة قد لفت ايضاً نظر العديد من المشتغلين بالقضايا القانونية وخاصة بالنظر الى ما اتسمت به الوثيقة في هذا الجانب من تسرع وخفة، وعدم إلمام كافٍ بالمفاهيم الدستورية والقانونية وهي سمات ما كان متصوراً أن تتسم بها وثيقة تتصدى لمهام جسيمة ويدعي أصحابها أنهم إنما يعبرون عما يدور في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم كما جاء في مقدمة الوثيقة.
بعد هذه التوطئة التي أراها ضرورية تمهيداً للانتقال الى عرض قراءتي القانونية للوثيقة بدءاً من مقدمتها الطويلة وانتهاء بمفردات المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الكثير من فصولها في مقدمة مشروع اللقاء المشترك الذي أسموه مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني- دون تحديد لما هو وطني هنا- حاول واضعو المشروع تحليل وتشخيص الواقع الراهن للبلاد بأسوأ ما يكون التحليل والتشخيص وخاصة على الصعيد السياسي حيث تصوروا وجود أزمة سياسية خانقة تتجلى مظاهرها في: - غياب دولة القانون والمؤسسات- انعدام المساواة أمام القانون- تركيز السلطة في يد رئيس الدولة - انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات - وذلك الى جانب العديد من المظاهر العامة مما ليس له صلة مباشرة بالجوانب الدستورية والقانونية..فيما يلي نورد تعقيباً موجزاً على النقاط أعلاه:
- إن الحديث عن غياب دولة القانون والمؤسسات يمكن أن يكون مقبولاً اذا كان القصد منه وصف الحالة في اليمن قبل سنوات عدة قبل تحقيق الوحدة اليمنية، أما أن يكون القصد هو وصف الحالة القائمة اليوم فهو أبعد مايكون عن الصواب إذ إن القانون اليوم هو الذي ينظم كافة مناحي حياة الدولة والمجتمع، واستناداً اليه تتم عملية تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية المنتخبة والمعينة مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الدولة ومجلس الشورى وكذلك بقية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والاداري. كذلك فإن القوانين هي التي تنظم علاقات المواطنين فيما بينهم وكذلك فيما بينهم وبين هيئات وأجهزة الدولة سواء المحلية منها أو المركزية، واستناداً اليه يمارس المواطنون حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. بل وأصبح القانون اليوم يلعب دوراً متزايداً في حياة الناس وفي مجرى العلاقات اليومية بين كافة مكونات الجهاز الإداري للدولة وكذلك بين هذه الهيئات والأجهزة وبين كافة الفعاليات الخاصة والمجتمعية الاقتصادية والسياسية وغير ذلك من الفعاليات والمكونات التي تتكاثر مع اتساع المصالح الخاصة والعامة التي يوفرها ويحميها القانون. ومن ناحية أخرى هل كان ممكناً اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب لدورات ثلاث حتى الآن بدون وجود مؤسسة انتخابية مستقلة ومحايدة؟ وهل كان ممكناً إصدار هذا الكم المعروف من القوانين في جميع المجالات بدون وجود مؤسسة تشريعية منتخبة بما في ذلك العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية؟ وهل كان ممكناً ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وإلزامها بإلغاء بعض العقود التي سبق أن وقعّت عليها بدون وجود السلطة التشريعية المنتخبة؟ وهل كان ممكناً الفصل في مئات بل آلاف من المنازعات المدنية والتجارية وغيرها بدون وجود مؤسسة قضائية مستقلة؟ وهل كان ممكناً حماية أمن واستقرار البلاد بدون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية ذات كفاءة في أداء مهامها الدستورية؟ وهل كان ممكناً تأمين حدود البلاد بإجراءات واتفاقيات دولية بدون وجود مؤسسة رئاسية منتخبة تتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية بحكمة واقتدار؟ هذه مجرد أمثلة فقط للدلالة على مدى الخطل والبعد عن الصواب الذي أصاب رؤية واضعي هذا المشروع.
نحن لا ننكر وجود نقص هنا أو خلل هناك ولكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في إصلاح ما يثبت أنه خطأ دون أن يؤدي بنا الى هذا الحد من انعدام البصيرة أو أن تتملكنا الروح العدمية عند محاولة تحليل وتشخيص الوضع الراهن خاصة اذا ما علمنا بالحجم الهائل للمعوقات والصعوبات التي كانت - وبعضها لايزال قائماً- في سبيل الوصول الى هذا المستوى الذي وصلته عملية بناء دولة القانون والمؤسسات.
ادعاءات باطلة
وأما ما ذكر بشأن انعدام المساواة أمام القانون كإحدى مظاهر ماسمي بالأزمة السياسية فإن هذا المبدأ (المساواة بين المواطنين أمام القانون) قد اعتمده الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة المنبثقة عنه في أكثر من نص وفي أكثر من صورة، مثل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا في تحمل الواجبات العامة مع اشتراط العدالة في التطبيق. واستند الدستور في النص على هذا الحق في المساواة الى الشريعة الاسلامية السمحاء والى المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان. ولم يكتف الدستور بتقرير الحق في المساواة للأفراد فقط وانما نص أيضاً على المساواة بين الشخصيات الاعتبارية وأورد في الأسس الاقتصادية (المادة 7 فقرة ب) مايلي:- (التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات) أما بالنسبة لمساواة المواطنين أمام القانون وهو أهم مقاييس احترام الدول لحقوق الإنسان فقد نص الدستور على هذا المبدأ في مواد عدة أهمها مايلي:-
مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
مادة (25): يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
مادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة
مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
مادة (58): للمواطنين في عموم الجمهورية- بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً.. الخ المادة.
وبذلك يتبين أن الادعاء بانعدام المساواة أمام القانون بعد الادعاء السابق بغياب دولة القانون في مقدمة المشروع ليس أكثر من محاولة وضع أساس باطل لما يزمع اقامته من بناء على هذا الأساس، وهنا ينبغي أن نتذكر القاعدة الشهيرة بأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
بعيداً عن الحقيقة
- وبالنسبة لموضوع تركيز السلطة بيد رئيس الدولة والذي ذكر في مقدمة المشروع بوصفه إحدى تجليات الأزمة السياسية فهو إنما يشير وكأن رئيس الدولة يمارس مهام وصلاحيات خارجة عن نطاق الدستور وهو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة وعن واقع الحال. فالدستور حدد إجمالاً وتفصيلاً مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للسيادة في داخل الدولة وخارجها وهو يمارس السلطة التنفيذية الى جانب مجلس الوزراء نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وذلك وفقاً لما جاء في المادة (105) من الدستور.
- ونصت المادة (110) من الدستور على أن (يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور).
ومع ذلك فإن مما يحسب لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أنه الأكثر حرصاً على الحد من صلاحيات رئيس الدولة لمصلحة تعزيز وتكريس النهج الديمقراطي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مايلي:-
أ- الدفع باتجاه أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً من الشعب في انتخابات حرة ومباشرة وتنافسية بعد أن كان الرئيس حسب الدستور الأسبق منتخباً فقط من مجلس النواب وهي طريقة أسهل لمن يريد تركيز السلطة بيده أو النأي عن الاختيار الشعبي الحر.
ب- الإصرار على أن تكون مدة ولاية الرئيس دورتين فقط ولم يكن ذلك نتيجة لأية مطالبات أو ضغوط وإنما قناعة منه بإرساء أسس ديمقراطية حقيقية تحسباً للمستقبل وحرصاً على تجنيب البلاد ويلات الصراع العنيف على كرسي السلطة.
ج- الإعلان الصادر مؤخراً عن الرئيس شخصياً بشأن الترتيب لانتخاب مجلس الشورى بدلاً عن التعيين.
د- وكذلك الإعلان عن الانتقال الى انتخاب المحافظين بدلاً عن التعيين.
هـ- الدفع باتجاه إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور السابق بإصدار قرارات لها قوة القانون بين فترات انعقاد مجلس النواب التزاماً منه بحصر التشريع بالسلطة التشريعية وحدها، وبذلك يتبين أن الادعاء بتركيز السلطة في يد رئيس الدولة ليس أكثر من محاولة بائسة لافتعال أزمة سياسية ليس لها وجود في الواقع.
نتائج غير صحيحة
- وأما مايدّعون بخصوص انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات كمبدأ في ذهن واضعه يحاول أن يؤسس عليه نتائج غير صحيحة، فإن واقع الحال يشهد بغير ذلك، فالنظام السياسي اليمني يفخر بتجربته الانتخابية التي تديرها لجنة عليا مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب الدستور تحضر للعملية الفنية الانتخابية، أما لجان الانتخابات فإنها تشكل من كافة القوى السياسية في المجتمع وهي التي تشرف وتدير عملية القيد والتسجيل وكذلك عملية الاقتراع والفرز كضمانة رئيسية لمشاركة كافة القوى السياسية لإدارة عملية الانتخابات وأضف الى ذلك أن القانون قد جعل المرشح حاضراً بنفسه أو من يمثله في مراقبة عملية الاقتراع والفرز سواء أكان مرشحاً حزبياً أم مرشحاً مستقلاً وكذلك أجاز للأحزاب السياسية تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات بالرغم كما سبق أن وضحنا أن مرشحيها لهم حق الرقابة فهناك رقابة المرشح ورقابة الحزب وأضاف القانون أيضاً رقابة الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية.
- ناهيك عما تضمنه القانون من أحكام تتعلق بالمساواة في الدعاية وتضمين الرموز الانتخابية والحق في التظلم أمام القضاء كلها تصب في تأمين سلامة ونزاهة الانتخابات وفي جعل جميع المتنافسين أمام الصندوق سواء، فضلاً عن أن الدستور في المادة (5) قد منع تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
ثنائية السلطة
- أما فيما يتعلق بما توصل اليها ما سمي بمشروع اللقاء المشترك في مقدمته بأن النظام البرلماني كبديل للنظام القائم التي صورته بأنه نظام فردي هي النتيجة الخاطئة التي توصلوا اليها بعد مقدمات وأسباب خاطئة أيضاً ويتمثل خطأها في مايلي:-
أولاً:- أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب أحكام الدستور يحمل من سمات وملامح النظام البرلماني أكثر مما يحمل من سمات وملامح النظام الرئاسي بل يذهب البعض الى انه نظام برلماني أصلاً وليس نظاماً فردياً على الإطلاق، فنظامنا السياسي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية رئاسة الدولة والحكومة وأن الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة وأن السلطة التشريعية تمتلك أدوات الرقابة والمحاسبة بموجب الدستور على السلطة التنفيذية مثل حق الاستيضاح وحق السؤال وحق الاستجواب وحق التحقيق وحق سحب الثقة سواء من وزير بعينه أم من الحكومة بكاملها.
وهي الأدوات الموجودة في النظام الفرنسي على سبيل المثال.
ثانياً:- أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على قاعدة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والشوروية والمحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وعلى التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر، ولو كان قائماً على النظام الفردي كما يحاول أن يصوره من صاغ هذا المشروع ما كان هناك رأي آخر.
تحوير وإيهام
هذا فيما يتعلق بالمقدمة كما سبق الإيضاح أما قراءتنا القانونية لما تبقى من فصول المشروع فهي على النحو التالي:-
إن ماجاء بشأن التنظيم الدستوري لسلطات الدولة والادعاء بتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة بما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني ما هو إلا تحوير في الصياغة لما يتبناه الدستور والنظام السياسي اليمني الحالي. إن هذا الادعاء ليس أكثر من محاولة للإيهام بأن نظامنا السياسي غير ديمقراطي ويرفض التعددية الحزبية والفصل بين السلطات ولا يتضمن الدستور ما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة.
فالمادة (5) من الدستور تنص على أن (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين).
فمن صاغ الفقرة (أ) تحت بند مايسمى بتطوير التنظيم الدستوري هو في الواقع قد حوّر النص الدستوري في المادة (5) التي سبق الإشارة اليها ليضلل القارئ أو المستمع بأنها ليست جزءاً من النظام.
إذا لم تكن التعددية جزءاً من النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب المادة (5) من الدستور فبماذا نفسر وجود الأحزاب السياسية المختلفة في الحياة السياسية اليمنية فنص المادة (5) من الدستور كفيل بالرد، كما أن واقع وجود ممثلين لعدد من أحزاب المعارضة في مجلس النواب جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة ما هو إلا دليل لا يقبل الدحض على عدم الإلمام الكافي بالمسائل الدستورية والقانونية لدى واضعي هذا المشروع.
أما الادعاء بأن النظام البرلماني هو وحده الذي يضمن الفصل بين السلطات فهو ليس أكثر من ادعاء متعمد يراد به التأثير على القارئ أو المستمع، أما من الناحية الدستورية والقانونية فالنظام البرلماني سواء في فرنسا أو بريطانيا لا يقوم على الفصل المطلق بين السلطات، فنظام الفصل المطلق بين السلطات موجود في النظام الرئاسي وإن كان حتى النظام الرئاسي اليوم حسب فقهاء القانون أصبح يقوم على الفصل المتوازن بين السلطات أما في النظام البرلماني فإن الفصل بين السلطات هو فصل مرن ومتداخل وعلى وجه الخصوص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك لأن حزب الأغلبية في البرلمان هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة ويسمح فيها لعضو مجلس النواب أن يكون عضواً في الحكومة وتعود الحكومة لحزبها صاحب الأغلبية في كثير من المسائل بل وأن الحكومة هي التي تضع جدول أعمال السلطة التشريعية كما تملك كل سلطة وسائل رقابة في مواجهة السلطة الأخرى فإذا كان من حق السلطة التشريعية سحب الثقة من الحكومة فمن حق السلطة التنفيذية حل البرلمان.
أما من ناحية الوظيفة التي تؤديها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن كل واحدة منهما خصص لها الدستور (العقد الاجتماعي) مهام في ادارة الشؤون العامة للدولة.
في الفقرة (ا) من البند (أ) اعترف من صاغ المشروع أن النظام البرلماني موجود وإنما المقصود وحسب ادعائه استكمال مقومات النظام البرلماني، ومعروف حسب فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية أن النظام البرلماني يقوم على الأسس التالية:-
أ- برلمان منتخب من الشعب لممارسة السلطة التشريعية، وهذا موجود في الدستور اليمني في المادة (62) التي تنص على أن (مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور)، ومعروف أن مجلس النواب ينتخب من الشعب بانتخابات تنافسية وفق ضمانات قانونية على أعلى درجة من النزاهة والشفافية.
ب- ثنائية السلطة التنفيذية، فيوجد رئيس دولة وبجانبه يوجد رئيس مجلس الوزراء وهذا منصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية حسب ما سبق أن بينا في المقدمة.
ج- وجود حكومة مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان، ومعروف أن النظام الدستوري اليمني قد كفل في الدستور كافة أوجه الرقابة على السلطة التنفيذية.
د- قيام علاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها التعاون فيما بينهما مع وجود رقابة متبادلة وذلك وفقاً لأحكام الدستور على النحو التالي:-
1- تستطيع السلطة التنفيذية المساهمة في الوظيفة التشريعية وذلك بما لها من حق اقتراح القوانين.
2- للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان قبل نهاية المدة القانونية المقررة بموجب الشروط الواردة في الدستور.
3- يملك البرلمان حق طرح موضوع هام للمناقشة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لأعضاء الحكومة كما يملك حق استجواب الوزراء وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وحق سحب الثقة.
تلك هي أهم مقومات النظام البرلماني المعروفة وهي بكل وضوح وشفافية متوافرة في الدستور اليمني وتؤكدها كذلك وقائع الممارسة العملية للعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية.
أفكار متداخلة
أما ما ورد بعد ذلك فهو مجرد أفكار متداخلة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وأحياناً اجتهاد غير مؤصل سياسياً أو دستورياً ونفندها على النحو التالي:
- تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية هو تحصيل حاصل فالنظام السياسي للجمهورية اليمنية قد طبق هذا المبدأ منذ أول انتخابات نيابية في دولة الوحدة المباركة عام (93)م ثم بعد انتخابات (97) ثم بعد انتخابات (2003)م.
- خضوع الحكومة بشكل مباشر أو مستمر للمساءلة البرلمانية وهذا مكفول بموجب نصوص الدستور. فالحكومة تخضع للمساءلة أمام البرلمان بحسب نص المادة (96) التي تؤكد على أن (مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة).
- منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
إن الدستور في أي نظام سياسي في العالم هو الإطار المنظم للحياة السياسية وسلطات الدولة وبموجبه يتم منح الصلاحيات للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية لممارسة وظيفتها، ورئيس الجمهورية اليمنية يمارس مهامه وصلاحياته بموجب الدستور المعبر عن إرادة الشعب من خلال الاستفتاء الذي تم عليه. فالرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله يمارس صلاحياته بموجب نصوص دستور الجمهورية اليمنية مثلما يمارس الرئيس في أي دولة صلاحياته بموجب دستور دولته.
- ثنائية السلطة التشريعية: بشأن هذه المسألة فإننا نتفق مع ما جاء في المشروع حيث إنه قد أصبح ضرورياً إحداث إصلاح وتطوير برلماني جديد تصبح بموجبه السلطة التشريعية مكونة من غرفتين أو مجلسين: مجلس نواب ومجلس شورى، وذلك لتحقيق أهداف عدة أهمها ضمان أن تكون عملية التشريع أكثر دقة واكتمالاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة تقع في صدارة أجندة الإصلاحات السياسية التي يجري حالياً وضع اللمسات النهائية عليها.
- تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.
إن وظيفة الجهاز المركزي هي رقابة إدارية ومالية على وحدات الجهاز الإداري بينما وظيفة مجلس النواب هي رقابة على الأداء الكلي للحكومة بما في ذلك الأداء السياسي وكلا المهتمين مختلفتان. ومع ذلك فإن الدستور قد أجاز لمجلس النواب حق طلب تقارير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصرف النظر عن التبعية الإدارية للجهاز.
تنص المادة (91) من الدستور على أن (يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى) ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع من مواصلة البحث في هذا الموضوع والاستفادة من تجارب الآخرين.
- تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.
هذا مستوعب في الدستور، والموازنة تصدر بقانون بعد موافقة مجلس النواب، وهنا تجدر الملاحظة بضرورة بذل اهتمام وعناية أكبر بالموارد وليس فقط بالنفقات.
- تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي وللسفراء ولكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.
هذا الطلب ليس من سمات النظم البرلمانية وإنما من سمات النظم الرئاسية، ومع ذلك نشير هنا أن هذه المسألة مثلها مثل غيرها من المسائل الفرعية يمكن تنظيمها وإعادة تنظيمها بين وقت وآخر تبعاً لحدود العلاقة التي تنظمها النصوص الدستورية الناظمة لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية.
- ما يتعلق بتخويل السلطة التشريعية وعبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية.. الخ.
هذا الطرح جاء مرتبكاً ويدل مجدداً على مدى خفة وسطحية تناول المسائل الدستورية والقانونية في المشروع. إذ لا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية من ممارسة هذا النوع من الرقابة. ولكن من الضروري معرفة أن الرقابة القضائية في هذا المجال هي الأكثر فعالية.
- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط.
إن قصر المدة أو تطويلها راجع إلى نصوص الدستور ومن لم يرغب بهذه المدة رغم أنه قد تم الاستفتاء عليها فما عليه إلاَّ التقدم بطلب تعديل دستوري حسب الإجراءات المتبعة في الدستور وإذا حاز التعديل على الأغلبية وفق الإجراءات المتبعة في الدستور أصبح معمولاً به. وسبق أن بينا أن مدة رئيس الجمهورية هي لدورتين متتاليتين فقط حسب الدستور النافذ.
دهشة وريبة
أما فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وبحسب ما يدعيه المشروع من أنه سيعمل على تعزيز دوره من خلال الاستقلال المالي والإداري والفني ومن خلال استقلال القضاء في حكمه، فهذا ليس إلا ترديداً لحكم المادة (149) من الدستور بل إن النص الدستوري يعد أقوى من ذلك حيث تنص المادة (149) على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
- أما ما وصفوه في المشروع بعد تلك المقدمة المتعلقة بالسلطة القضائية من إجراءات الاستقلال فهي تدعو إلى العجب والدهشة والريبة.
- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى.. الخ.
فهذه الجزئية ليست أولاً من معالم النظام البرلماني ولا حتى الرئاسي. وثانياً تجعل تشكيل مجلس القضاء خاضعاً للتركيبة السياسية في مجلس الشورى وبالتالي تسييس السلطة القضائية وعدم استقلاليتها.
أما ما يدعونه من اختيار المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بعد أن كانوا قد أشاروا إلى أن من مهام مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة، هو كلام متناقض مع الفقرة التي تعلوها وسيخضع تشكيل المحكمة العليا للأهواء السياسية داخل البرلمان وسيجعلهم خاضعين لسلطة المجلس وبالتالي لم يعد هناك استقلالية للقضاء وأصبحوا تابعين حزبيين وسياسيين وهذا يتنافى مع الأصول المتعارف عليها في بناء وتنظيم السلطات القضائية وخاصة في البلدان العربية.
- وفيما يتعلق بضمان الحصانة القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية فهذا مستوعب في نظامنا الدستوري والقانوني حيث تنص المادة (150) من الدستور على أن (القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال).
- أما ما يتعلق بإنشاء محكمة دستورية وقضاء إداري فإن الأمر لا يعدو كونه تطبيقاً للنظام القضائي الفرنسي الذي يبنى على تجزئة القضاء وليس على النظام الإنجليزي الذي يبنى على أساس وحدة القضاء ولا يعني أن الأخذ بأحدهما هو غاية المراد فالأمر قابل للتطور حسب الواقع واحتياجاته.
- أما ما يتعلق ببقية الجزئيات التي تناولها المشروع تحت بند إصلاح القضاء فإن الكثير منها مستوعب في استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، كما أن منظومة الإصلاح التي تعدها الحكومة تشمل جوانب هامة من تكوين ونظام السلطة القضائية في إطار منهجية علمية ومنظمة تشمل كافة حلقات النظام العدلي.
لا يحقق العدالة
- أما ما يدعون من إصلاح النظام الانتخابي من خلال:
1- الأخذ بنظام القائمة النسبية.
2- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات.
3- المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية في اللجنة العليا ولجانها الانتخابية، يمكن التعقيب على تلك الجزئيات على النحو التالي:-
- بشأن الأخذ بنظام القائمة النسبية وإن كان من الناحية النظرية سهل فإنه من الناحية العملية يتسم بكثير من التعقيدات والحسابات المتوالية مما يجعله غير صالح في المجتمع اليمني، كما أن هذا النظام لا يحقق العدالة كما يدعون فتظل هناك أعداد كبيرة من أصوات الناخبين لا قيمة لها ولا يعد هذا النظام هو النظام الانتخابي الأمثل في العالم حيث إن معظم الدول الديمقراطية لا تأخذ به وإن أخذت به تشترط لتمثيل الحزب حصوله على 7% من نسبة الناخبين على مستوى الدولة.
كما أن دولاً عديدة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا واليابان والهند وباكستان والدول العربية تأخذ بالنظام الفردي المعمول به في النظام اليمني ومع ذلك لا تتهم بأن نظامها الانتخابي غير عادل.
- أما فيما يتعلق بحيادية اللجنة العليا فإن تشكيلها من قبل مجلس النواب من الأحزاب السياسية الفاعلة والممثلة في المجلس فهي أكبر ضمان ثم إن عملها ذو طابع إداري فني بحت ليس له علاقة بالتنافس بين الأحزاب، أما الطلب بأن تشكل من جميع الأحزاب فهو نوع من المبالغة غير الواقعية وغير المقبولة والمهم أن تشكل من الحاكم والمعارض وهذه هي المساواة.
أما المشاركة في اللجان الإشرافية ولجان إدارة القيد والتسجيل والاقتراع والفرز فهي تشكل تقريباً من كافة الأحزاب السياسية كضمان لوجود الحزب الحاكم والحزب المعارض في إدارة العملية. هذا بالإضافة إلى إشراف المرشح وإشراف لجان الأحزاب وإشراف اللجان الوطنية وإشراف اللجان الأجنبية إضافة إلى ما يجعل الانتخاب سرياً وهذا هو الضمانة الأكيدة.
- أما فيما يتعلق بإصلاح السلطة المحلية فلم يأتوا بجديد وإنما تناولوا نقاطاً من خطاب فخامة الأخ الرئيس في تعز في 25 سبتمبر الماضي.
- وتحت ما سمي بضمان الحقوق والحريات العامة. العجيب أن المشروع بدأ الحديث في هذه الجزئية بالاستناد إلى أحكام الدستور رغم أنه في المقدمة قد بنى مشروعه على أساس غياب دولة القانون.
ومع ذلك فإن ما ترتب على هذه الجزئية من نتائج أوردها المشروع لا تعدو كونها نصوصاً دستورية كفلها النظام السياسي اليمني لكافة المواطنين.
خطاب موجه للخارج
- أما ما يحاولون تصويره من أن هناك عوائق وقيوداً لممارسة المواطنين لحقهم الدستوري فليس أكثر من خطاب موجّه للخارج أكثر منه للداخل.
- والشيء نفسه ينطبق على عدد من النقاط الواردة في المشروع مثل تعديل قانون الأحزاب وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب وما يتعلق بنشاط الهيئات والمنظمات المدنية. وكذلك ما جاء بشأن إصدار أو تعديل عدد من القوانين (والغريب هنا ذكر القانون الإداري بين القوانين المطلوب إصدارها أو تعديلها ومصدر الغرابة هو أنه لا يوجد أصلاً قانون واحد بذاته يسمى القانون الإداري وإنما يقصد بذلك في الفقه القانوني مجموعة القوانين واللوائح المنظمة لكامل الأجهزة والعلاقات في الجهاز الإداري للدولة).
- وفيما يتعلق بحيادية واستقلالية الإدارة وضماناتها وعلى الأخص في التنافس السياسي.
إن حيادية الإدارة وضمانات هذه الحيادية مكفولة في جميع المجالات ليس فقط في النصوص الدستورية بل كذلك في الكثير من القوانين، وفي حال أن يتبين وجود نقص أو خلل في أي من هذه القوانين يتم تلافي مثل هذا النقص أو الخلل من خلال العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب وهي عملية مستمرة طوال الوقت.
ولا شك أن أخطر ما يمكن أن يوجد من اختلالات في هذا الجانب هو ما يتعلق بالتنافس في الانتخابات، بهذا الشأن أكد قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م في المادة (40) منه (يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية) ونصت المادة (52) تأكيداً لما سبق على أن (يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية)، كما نصت المادة (129) على أن(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته)، كما تنص المادة (143) بأنه (لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون) كل تلك النصوص هي ضمانات لحيادية أجهزة الدولة والمال العام.
القوات المسلحة ملك الشعب
- أما فيما يتعلق بما سمي ببناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، وكأنها الآن مبنية على أسس غير وطنية ولا ندري كيف تبنى على أسس وطنية لأنهم لم يدللوا بشيء، نؤكد أن الدستور قد عمل على صيانة القوات المسلحة والأمن واعتبرهما ملك الشعب ولحماية الجمهورية حيث تنص المادة (36) من الدستور (الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى..).
كما نصت المادة (39) على أن (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون) ونصت المادة (40) من الدستور على أن (يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون).
- كل هذه النصوص الدستورية والقانونية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما ورد في المشروع بهذا الصدد ليس أكثر من محاولة لإيهام الآخرين بأن خللاً كبيراً قد أصاب المؤسسة العسكرية والأمنية ومتجاهلاً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية من أجل أن تصل هذه المؤسسة إلى هذا المستوى المشرف.وإذ نكتفي بهذا القدر من القراءة القانونية للمشروع مع إمكانية العودة لمزيد من الإيضاح إن اقتضى الحال، فإنني أختتم قراءتي بملاحظات عامة كما يلي:-
أولاً: أن ما يسمى بمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني قد بدأ بتصور خاطئ تماما ليصل إلى نتائج خاطئة بعد ذلك، ويبدو أنه قد فعل ذلك بصورة متعمدة غرضها مخاطبة الخارج قبل الداخل.
ثانياً: أن المشروع قد أورد عبارات غاية في العمومية ولا تستند إلى أدلة أو حجج وحمل النظام السياسي كل ماسماه إخفاقات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية بل وحتى فشل أحزاب المعارضة التي تدير نفسها، وهذا كلام غير مسئول لا من الناحية العلمية ولا من الناحية السياسية ولا من أي ناحية أخرى.
ثالثاً: أن الانطلاق من أن النظام البرلماني حسب ما يدعونه سيعمل على إزالة كافة المعوقات والتشوهات التي صوروها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو طرح عقيم لا يستند إلى أسس علمية أو موضوعية. ولا يعقل في أي مجتمع أنه بمجرد تحويل شكل النظام السياسي من حال إلى آخر سيحدث نقلة نوعية فهذا طرح غير دقيق من الناحية العلمية، لأن النظام السياسي لأي مجتمع إنما ينطلق من الواقع وتغيير النظام من حال إلى حال لا يغير في الواقع شيئاً فالنظم السياسية تتطور مع تطور الواقع المطبق فيه هذا النظام.
إن تغيير نظام المرور مثلاً من النظام المعمول به حالياً في اليمن إلى النظام المعمول به في بريطانيا أي جعل "المقود" يمين وتغيير خط الذاهب عن خط الراجع من الشمال إلى اليمين لن يجعل نظام المرور لدينا مثالياً كما في بريطانيا، لأننا نطبق هذا النظام على الواقع اليمني بثقافاته وسلوكياته وفهمه لحركة المرور.
وأخيراً أرجو أن تكون مساهماتنا في أي إصلاحات سياسية في مستوى أهمية وخطورة هذه الإصلاحات وأحسب أن هذه مسئولية الجميع في الحكم وفي المعارضة فنحن جميعاً شركاء في هذا الوطن..
والله من وراء القصد.
عضو مجلس الشورى
بعد قراءة فاحصة لمشروع الإصلاح المقترح من قبل ممثلي ستة أحزاب من أحزاب المعارضة والمعروفة بأحزاب اللقاء المشترك (ثلاثة منها لديها ممثلون في مجلس النواب) وجدت أن هذه الوثيقة التي أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي عقد الاسبوع قبل الماضي بدون ممانعة السلطة الرسمية قد تعرضت لجملة من المسائل الدستورية والقانونية الى جانب مسائل أخرى عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
فيما يتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية المثارة في هذه الوثيقة، وإزاء الأسلوب الذي اتبعه واضعو الوثيقة في تناول هذه المسائل الهامة وجدت نفسي مدفوعاً الى كتابة تعقيب قانوني عليها، ليس رداً على ماجاء بالوثيقة بقدر ماهو حرص على تبصير القراء الكرام والمواطنين عموماً بالمسائل الدستورية والقانونية وبمفاهيمها الصحيحة وكيفية تعامل النظام السياسي اليمني معها ومكانتها في هذا النظام القائم على مبادئ السيادة الشعبية والمشروعية الدستورية.
ولا أشك لحظة واحدة أن ما لفت نظري إزاء المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الوثيقة قد لفت ايضاً نظر العديد من المشتغلين بالقضايا القانونية وخاصة بالنظر الى ما اتسمت به الوثيقة في هذا الجانب من تسرع وخفة، وعدم إلمام كافٍ بالمفاهيم الدستورية والقانونية وهي سمات ما كان متصوراً أن تتسم بها وثيقة تتصدى لمهام جسيمة ويدعي أصحابها أنهم إنما يعبرون عما يدور في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم كما جاء في مقدمة الوثيقة.
بعد هذه التوطئة التي أراها ضرورية تمهيداً للانتقال الى عرض قراءتي القانونية للوثيقة بدءاً من مقدمتها الطويلة وانتهاء بمفردات المسائل الدستورية والقانونية الواردة في الكثير من فصولها في مقدمة مشروع اللقاء المشترك الذي أسموه مشروعاً للإصلاح السياسي والوطني- دون تحديد لما هو وطني هنا- حاول واضعو المشروع تحليل وتشخيص الواقع الراهن للبلاد بأسوأ ما يكون التحليل والتشخيص وخاصة على الصعيد السياسي حيث تصوروا وجود أزمة سياسية خانقة تتجلى مظاهرها في: - غياب دولة القانون والمؤسسات- انعدام المساواة أمام القانون- تركيز السلطة في يد رئيس الدولة - انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات - وذلك الى جانب العديد من المظاهر العامة مما ليس له صلة مباشرة بالجوانب الدستورية والقانونية..فيما يلي نورد تعقيباً موجزاً على النقاط أعلاه:
- إن الحديث عن غياب دولة القانون والمؤسسات يمكن أن يكون مقبولاً اذا كان القصد منه وصف الحالة في اليمن قبل سنوات عدة قبل تحقيق الوحدة اليمنية، أما أن يكون القصد هو وصف الحالة القائمة اليوم فهو أبعد مايكون عن الصواب إذ إن القانون اليوم هو الذي ينظم كافة مناحي حياة الدولة والمجتمع، واستناداً اليه تتم عملية تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية المنتخبة والمعينة مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الدولة ومجلس الشورى وكذلك بقية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والاداري. كذلك فإن القوانين هي التي تنظم علاقات المواطنين فيما بينهم وكذلك فيما بينهم وبين هيئات وأجهزة الدولة سواء المحلية منها أو المركزية، واستناداً اليه يمارس المواطنون حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. بل وأصبح القانون اليوم يلعب دوراً متزايداً في حياة الناس وفي مجرى العلاقات اليومية بين كافة مكونات الجهاز الإداري للدولة وكذلك بين هذه الهيئات والأجهزة وبين كافة الفعاليات الخاصة والمجتمعية الاقتصادية والسياسية وغير ذلك من الفعاليات والمكونات التي تتكاثر مع اتساع المصالح الخاصة والعامة التي يوفرها ويحميها القانون. ومن ناحية أخرى هل كان ممكناً اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب لدورات ثلاث حتى الآن بدون وجود مؤسسة انتخابية مستقلة ومحايدة؟ وهل كان ممكناً إصدار هذا الكم المعروف من القوانين في جميع المجالات بدون وجود مؤسسة تشريعية منتخبة بما في ذلك العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية؟ وهل كان ممكناً ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وإلزامها بإلغاء بعض العقود التي سبق أن وقعّت عليها بدون وجود السلطة التشريعية المنتخبة؟ وهل كان ممكناً الفصل في مئات بل آلاف من المنازعات المدنية والتجارية وغيرها بدون وجود مؤسسة قضائية مستقلة؟ وهل كان ممكناً حماية أمن واستقرار البلاد بدون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية ذات كفاءة في أداء مهامها الدستورية؟ وهل كان ممكناً تأمين حدود البلاد بإجراءات واتفاقيات دولية بدون وجود مؤسسة رئاسية منتخبة تتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية بحكمة واقتدار؟ هذه مجرد أمثلة فقط للدلالة على مدى الخطل والبعد عن الصواب الذي أصاب رؤية واضعي هذا المشروع.
نحن لا ننكر وجود نقص هنا أو خلل هناك ولكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في إصلاح ما يثبت أنه خطأ دون أن يؤدي بنا الى هذا الحد من انعدام البصيرة أو أن تتملكنا الروح العدمية عند محاولة تحليل وتشخيص الوضع الراهن خاصة اذا ما علمنا بالحجم الهائل للمعوقات والصعوبات التي كانت - وبعضها لايزال قائماً- في سبيل الوصول الى هذا المستوى الذي وصلته عملية بناء دولة القانون والمؤسسات.
ادعاءات باطلة
وأما ما ذكر بشأن انعدام المساواة أمام القانون كإحدى مظاهر ماسمي بالأزمة السياسية فإن هذا المبدأ (المساواة بين المواطنين أمام القانون) قد اعتمده الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة المنبثقة عنه في أكثر من نص وفي أكثر من صورة، مثل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا في تحمل الواجبات العامة مع اشتراط العدالة في التطبيق. واستند الدستور في النص على هذا الحق في المساواة الى الشريعة الاسلامية السمحاء والى المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان. ولم يكتف الدستور بتقرير الحق في المساواة للأفراد فقط وانما نص أيضاً على المساواة بين الشخصيات الاعتبارية وأورد في الأسس الاقتصادية (المادة 7 فقرة ب) مايلي:- (التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات) أما بالنسبة لمساواة المواطنين أمام القانون وهو أهم مقاييس احترام الدول لحقوق الإنسان فقد نص الدستور على هذا المبدأ في مواد عدة أهمها مايلي:-
مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
مادة (25): يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
مادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة
مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
مادة (58): للمواطنين في عموم الجمهورية- بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً.. الخ المادة.
وبذلك يتبين أن الادعاء بانعدام المساواة أمام القانون بعد الادعاء السابق بغياب دولة القانون في مقدمة المشروع ليس أكثر من محاولة وضع أساس باطل لما يزمع اقامته من بناء على هذا الأساس، وهنا ينبغي أن نتذكر القاعدة الشهيرة بأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
بعيداً عن الحقيقة
- وبالنسبة لموضوع تركيز السلطة بيد رئيس الدولة والذي ذكر في مقدمة المشروع بوصفه إحدى تجليات الأزمة السياسية فهو إنما يشير وكأن رئيس الدولة يمارس مهام وصلاحيات خارجة عن نطاق الدستور وهو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة وعن واقع الحال. فالدستور حدد إجمالاً وتفصيلاً مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للسيادة في داخل الدولة وخارجها وهو يمارس السلطة التنفيذية الى جانب مجلس الوزراء نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وذلك وفقاً لما جاء في المادة (105) من الدستور.
- ونصت المادة (110) من الدستور على أن (يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور).
ومع ذلك فإن مما يحسب لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أنه الأكثر حرصاً على الحد من صلاحيات رئيس الدولة لمصلحة تعزيز وتكريس النهج الديمقراطي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مايلي:-
أ- الدفع باتجاه أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً من الشعب في انتخابات حرة ومباشرة وتنافسية بعد أن كان الرئيس حسب الدستور الأسبق منتخباً فقط من مجلس النواب وهي طريقة أسهل لمن يريد تركيز السلطة بيده أو النأي عن الاختيار الشعبي الحر.
ب- الإصرار على أن تكون مدة ولاية الرئيس دورتين فقط ولم يكن ذلك نتيجة لأية مطالبات أو ضغوط وإنما قناعة منه بإرساء أسس ديمقراطية حقيقية تحسباً للمستقبل وحرصاً على تجنيب البلاد ويلات الصراع العنيف على كرسي السلطة.
ج- الإعلان الصادر مؤخراً عن الرئيس شخصياً بشأن الترتيب لانتخاب مجلس الشورى بدلاً عن التعيين.
د- وكذلك الإعلان عن الانتقال الى انتخاب المحافظين بدلاً عن التعيين.
هـ- الدفع باتجاه إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور السابق بإصدار قرارات لها قوة القانون بين فترات انعقاد مجلس النواب التزاماً منه بحصر التشريع بالسلطة التشريعية وحدها، وبذلك يتبين أن الادعاء بتركيز السلطة في يد رئيس الدولة ليس أكثر من محاولة بائسة لافتعال أزمة سياسية ليس لها وجود في الواقع.
نتائج غير صحيحة
- وأما مايدّعون بخصوص انعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات كمبدأ في ذهن واضعه يحاول أن يؤسس عليه نتائج غير صحيحة، فإن واقع الحال يشهد بغير ذلك، فالنظام السياسي اليمني يفخر بتجربته الانتخابية التي تديرها لجنة عليا مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب الدستور تحضر للعملية الفنية الانتخابية، أما لجان الانتخابات فإنها تشكل من كافة القوى السياسية في المجتمع وهي التي تشرف وتدير عملية القيد والتسجيل وكذلك عملية الاقتراع والفرز كضمانة رئيسية لمشاركة كافة القوى السياسية لإدارة عملية الانتخابات وأضف الى ذلك أن القانون قد جعل المرشح حاضراً بنفسه أو من يمثله في مراقبة عملية الاقتراع والفرز سواء أكان مرشحاً حزبياً أم مرشحاً مستقلاً وكذلك أجاز للأحزاب السياسية تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات بالرغم كما سبق أن وضحنا أن مرشحيها لهم حق الرقابة فهناك رقابة المرشح ورقابة الحزب وأضاف القانون أيضاً رقابة الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية.
- ناهيك عما تضمنه القانون من أحكام تتعلق بالمساواة في الدعاية وتضمين الرموز الانتخابية والحق في التظلم أمام القضاء كلها تصب في تأمين سلامة ونزاهة الانتخابات وفي جعل جميع المتنافسين أمام الصندوق سواء، فضلاً عن أن الدستور في المادة (5) قد منع تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
ثنائية السلطة
- أما فيما يتعلق بما توصل اليها ما سمي بمشروع اللقاء المشترك في مقدمته بأن النظام البرلماني كبديل للنظام القائم التي صورته بأنه نظام فردي هي النتيجة الخاطئة التي توصلوا اليها بعد مقدمات وأسباب خاطئة أيضاً ويتمثل خطأها في مايلي:-
أولاً:- أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب أحكام الدستور يحمل من سمات وملامح النظام البرلماني أكثر مما يحمل من سمات وملامح النظام الرئاسي بل يذهب البعض الى انه نظام برلماني أصلاً وليس نظاماً فردياً على الإطلاق، فنظامنا السياسي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية رئاسة الدولة والحكومة وأن الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة وأن السلطة التشريعية تمتلك أدوات الرقابة والمحاسبة بموجب الدستور على السلطة التنفيذية مثل حق الاستيضاح وحق السؤال وحق الاستجواب وحق التحقيق وحق سحب الثقة سواء من وزير بعينه أم من الحكومة بكاملها.
وهي الأدوات الموجودة في النظام الفرنسي على سبيل المثال.
ثانياً:- أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على قاعدة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والشوروية والمحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وعلى التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر، ولو كان قائماً على النظام الفردي كما يحاول أن يصوره من صاغ هذا المشروع ما كان هناك رأي آخر.
تحوير وإيهام
هذا فيما يتعلق بالمقدمة كما سبق الإيضاح أما قراءتنا القانونية لما تبقى من فصول المشروع فهي على النحو التالي:-
إن ماجاء بشأن التنظيم الدستوري لسلطات الدولة والادعاء بتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة بما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني ما هو إلا تحوير في الصياغة لما يتبناه الدستور والنظام السياسي اليمني الحالي. إن هذا الادعاء ليس أكثر من محاولة للإيهام بأن نظامنا السياسي غير ديمقراطي ويرفض التعددية الحزبية والفصل بين السلطات ولا يتضمن الدستور ما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة.
فالمادة (5) من الدستور تنص على أن (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين).
فمن صاغ الفقرة (أ) تحت بند مايسمى بتطوير التنظيم الدستوري هو في الواقع قد حوّر النص الدستوري في المادة (5) التي سبق الإشارة اليها ليضلل القارئ أو المستمع بأنها ليست جزءاً من النظام.
إذا لم تكن التعددية جزءاً من النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بموجب المادة (5) من الدستور فبماذا نفسر وجود الأحزاب السياسية المختلفة في الحياة السياسية اليمنية فنص المادة (5) من الدستور كفيل بالرد، كما أن واقع وجود ممثلين لعدد من أحزاب المعارضة في مجلس النواب جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة ما هو إلا دليل لا يقبل الدحض على عدم الإلمام الكافي بالمسائل الدستورية والقانونية لدى واضعي هذا المشروع.
أما الادعاء بأن النظام البرلماني هو وحده الذي يضمن الفصل بين السلطات فهو ليس أكثر من ادعاء متعمد يراد به التأثير على القارئ أو المستمع، أما من الناحية الدستورية والقانونية فالنظام البرلماني سواء في فرنسا أو بريطانيا لا يقوم على الفصل المطلق بين السلطات، فنظام الفصل المطلق بين السلطات موجود في النظام الرئاسي وإن كان حتى النظام الرئاسي اليوم حسب فقهاء القانون أصبح يقوم على الفصل المتوازن بين السلطات أما في النظام البرلماني فإن الفصل بين السلطات هو فصل مرن ومتداخل وعلى وجه الخصوص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك لأن حزب الأغلبية في البرلمان هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة ويسمح فيها لعضو مجلس النواب أن يكون عضواً في الحكومة وتعود الحكومة لحزبها صاحب الأغلبية في كثير من المسائل بل وأن الحكومة هي التي تضع جدول أعمال السلطة التشريعية كما تملك كل سلطة وسائل رقابة في مواجهة السلطة الأخرى فإذا كان من حق السلطة التشريعية سحب الثقة من الحكومة فمن حق السلطة التنفيذية حل البرلمان.
أما من ناحية الوظيفة التي تؤديها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن كل واحدة منهما خصص لها الدستور (العقد الاجتماعي) مهام في ادارة الشؤون العامة للدولة.
في الفقرة (ا) من البند (أ) اعترف من صاغ المشروع أن النظام البرلماني موجود وإنما المقصود وحسب ادعائه استكمال مقومات النظام البرلماني، ومعروف حسب فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية أن النظام البرلماني يقوم على الأسس التالية:-
أ- برلمان منتخب من الشعب لممارسة السلطة التشريعية، وهذا موجود في الدستور اليمني في المادة (62) التي تنص على أن (مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور)، ومعروف أن مجلس النواب ينتخب من الشعب بانتخابات تنافسية وفق ضمانات قانونية على أعلى درجة من النزاهة والشفافية.
ب- ثنائية السلطة التنفيذية، فيوجد رئيس دولة وبجانبه يوجد رئيس مجلس الوزراء وهذا منصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية حسب ما سبق أن بينا في المقدمة.
ج- وجود حكومة مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان، ومعروف أن النظام الدستوري اليمني قد كفل في الدستور كافة أوجه الرقابة على السلطة التنفيذية.
د- قيام علاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها التعاون فيما بينهما مع وجود رقابة متبادلة وذلك وفقاً لأحكام الدستور على النحو التالي:-
1- تستطيع السلطة التنفيذية المساهمة في الوظيفة التشريعية وذلك بما لها من حق اقتراح القوانين.
2- للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان قبل نهاية المدة القانونية المقررة بموجب الشروط الواردة في الدستور.
3- يملك البرلمان حق طرح موضوع هام للمناقشة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لأعضاء الحكومة كما يملك حق استجواب الوزراء وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وحق سحب الثقة.
تلك هي أهم مقومات النظام البرلماني المعروفة وهي بكل وضوح وشفافية متوافرة في الدستور اليمني وتؤكدها كذلك وقائع الممارسة العملية للعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية.
أفكار متداخلة
أما ما ورد بعد ذلك فهو مجرد أفكار متداخلة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وأحياناً اجتهاد غير مؤصل سياسياً أو دستورياً ونفندها على النحو التالي:
- تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية هو تحصيل حاصل فالنظام السياسي للجمهورية اليمنية قد طبق هذا المبدأ منذ أول انتخابات نيابية في دولة الوحدة المباركة عام (93)م ثم بعد انتخابات (97) ثم بعد انتخابات (2003)م.
- خضوع الحكومة بشكل مباشر أو مستمر للمساءلة البرلمانية وهذا مكفول بموجب نصوص الدستور. فالحكومة تخضع للمساءلة أمام البرلمان بحسب نص المادة (96) التي تؤكد على أن (مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة).
- منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
إن الدستور في أي نظام سياسي في العالم هو الإطار المنظم للحياة السياسية وسلطات الدولة وبموجبه يتم منح الصلاحيات للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية لممارسة وظيفتها، ورئيس الجمهورية اليمنية يمارس مهامه وصلاحياته بموجب الدستور المعبر عن إرادة الشعب من خلال الاستفتاء الذي تم عليه. فالرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله يمارس صلاحياته بموجب نصوص دستور الجمهورية اليمنية مثلما يمارس الرئيس في أي دولة صلاحياته بموجب دستور دولته.
- ثنائية السلطة التشريعية: بشأن هذه المسألة فإننا نتفق مع ما جاء في المشروع حيث إنه قد أصبح ضرورياً إحداث إصلاح وتطوير برلماني جديد تصبح بموجبه السلطة التشريعية مكونة من غرفتين أو مجلسين: مجلس نواب ومجلس شورى، وذلك لتحقيق أهداف عدة أهمها ضمان أن تكون عملية التشريع أكثر دقة واكتمالاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة تقع في صدارة أجندة الإصلاحات السياسية التي يجري حالياً وضع اللمسات النهائية عليها.
- تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.
إن وظيفة الجهاز المركزي هي رقابة إدارية ومالية على وحدات الجهاز الإداري بينما وظيفة مجلس النواب هي رقابة على الأداء الكلي للحكومة بما في ذلك الأداء السياسي وكلا المهتمين مختلفتان. ومع ذلك فإن الدستور قد أجاز لمجلس النواب حق طلب تقارير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصرف النظر عن التبعية الإدارية للجهاز.
تنص المادة (91) من الدستور على أن (يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى) ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع من مواصلة البحث في هذا الموضوع والاستفادة من تجارب الآخرين.
- تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.
هذا مستوعب في الدستور، والموازنة تصدر بقانون بعد موافقة مجلس النواب، وهنا تجدر الملاحظة بضرورة بذل اهتمام وعناية أكبر بالموارد وليس فقط بالنفقات.
- تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي وللسفراء ولكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.
هذا الطلب ليس من سمات النظم البرلمانية وإنما من سمات النظم الرئاسية، ومع ذلك نشير هنا أن هذه المسألة مثلها مثل غيرها من المسائل الفرعية يمكن تنظيمها وإعادة تنظيمها بين وقت وآخر تبعاً لحدود العلاقة التي تنظمها النصوص الدستورية الناظمة لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية.
- ما يتعلق بتخويل السلطة التشريعية وعبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية.. الخ.
هذا الطرح جاء مرتبكاً ويدل مجدداً على مدى خفة وسطحية تناول المسائل الدستورية والقانونية في المشروع. إذ لا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية من ممارسة هذا النوع من الرقابة. ولكن من الضروري معرفة أن الرقابة القضائية في هذا المجال هي الأكثر فعالية.
- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط.
إن قصر المدة أو تطويلها راجع إلى نصوص الدستور ومن لم يرغب بهذه المدة رغم أنه قد تم الاستفتاء عليها فما عليه إلاَّ التقدم بطلب تعديل دستوري حسب الإجراءات المتبعة في الدستور وإذا حاز التعديل على الأغلبية وفق الإجراءات المتبعة في الدستور أصبح معمولاً به. وسبق أن بينا أن مدة رئيس الجمهورية هي لدورتين متتاليتين فقط حسب الدستور النافذ.
دهشة وريبة
أما فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وبحسب ما يدعيه المشروع من أنه سيعمل على تعزيز دوره من خلال الاستقلال المالي والإداري والفني ومن خلال استقلال القضاء في حكمه، فهذا ليس إلا ترديداً لحكم المادة (149) من الدستور بل إن النص الدستوري يعد أقوى من ذلك حيث تنص المادة (149) على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
- أما ما وصفوه في المشروع بعد تلك المقدمة المتعلقة بالسلطة القضائية من إجراءات الاستقلال فهي تدعو إلى العجب والدهشة والريبة.
- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى.. الخ.
فهذه الجزئية ليست أولاً من معالم النظام البرلماني ولا حتى الرئاسي. وثانياً تجعل تشكيل مجلس القضاء خاضعاً للتركيبة السياسية في مجلس الشورى وبالتالي تسييس السلطة القضائية وعدم استقلاليتها.
أما ما يدعونه من اختيار المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بعد أن كانوا قد أشاروا إلى أن من مهام مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة، هو كلام متناقض مع الفقرة التي تعلوها وسيخضع تشكيل المحكمة العليا للأهواء السياسية داخل البرلمان وسيجعلهم خاضعين لسلطة المجلس وبالتالي لم يعد هناك استقلالية للقضاء وأصبحوا تابعين حزبيين وسياسيين وهذا يتنافى مع الأصول المتعارف عليها في بناء وتنظيم السلطات القضائية وخاصة في البلدان العربية.
- وفيما يتعلق بضمان الحصانة القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية فهذا مستوعب في نظامنا الدستوري والقانوني حيث تنص المادة (150) من الدستور على أن (القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال).
- أما ما يتعلق بإنشاء محكمة دستورية وقضاء إداري فإن الأمر لا يعدو كونه تطبيقاً للنظام القضائي الفرنسي الذي يبنى على تجزئة القضاء وليس على النظام الإنجليزي الذي يبنى على أساس وحدة القضاء ولا يعني أن الأخذ بأحدهما هو غاية المراد فالأمر قابل للتطور حسب الواقع واحتياجاته.
- أما ما يتعلق ببقية الجزئيات التي تناولها المشروع تحت بند إصلاح القضاء فإن الكثير منها مستوعب في استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، كما أن منظومة الإصلاح التي تعدها الحكومة تشمل جوانب هامة من تكوين ونظام السلطة القضائية في إطار منهجية علمية ومنظمة تشمل كافة حلقات النظام العدلي.
لا يحقق العدالة
- أما ما يدعون من إصلاح النظام الانتخابي من خلال:
1- الأخذ بنظام القائمة النسبية.
2- ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات.
3- المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية في اللجنة العليا ولجانها الانتخابية، يمكن التعقيب على تلك الجزئيات على النحو التالي:-
- بشأن الأخذ بنظام القائمة النسبية وإن كان من الناحية النظرية سهل فإنه من الناحية العملية يتسم بكثير من التعقيدات والحسابات المتوالية مما يجعله غير صالح في المجتمع اليمني، كما أن هذا النظام لا يحقق العدالة كما يدعون فتظل هناك أعداد كبيرة من أصوات الناخبين لا قيمة لها ولا يعد هذا النظام هو النظام الانتخابي الأمثل في العالم حيث إن معظم الدول الديمقراطية لا تأخذ به وإن أخذت به تشترط لتمثيل الحزب حصوله على 7% من نسبة الناخبين على مستوى الدولة.
كما أن دولاً عديدة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا واليابان والهند وباكستان والدول العربية تأخذ بالنظام الفردي المعمول به في النظام اليمني ومع ذلك لا تتهم بأن نظامها الانتخابي غير عادل.
- أما فيما يتعلق بحيادية اللجنة العليا فإن تشكيلها من قبل مجلس النواب من الأحزاب السياسية الفاعلة والممثلة في المجلس فهي أكبر ضمان ثم إن عملها ذو طابع إداري فني بحت ليس له علاقة بالتنافس بين الأحزاب، أما الطلب بأن تشكل من جميع الأحزاب فهو نوع من المبالغة غير الواقعية وغير المقبولة والمهم أن تشكل من الحاكم والمعارض وهذه هي المساواة.
أما المشاركة في اللجان الإشرافية ولجان إدارة القيد والتسجيل والاقتراع والفرز فهي تشكل تقريباً من كافة الأحزاب السياسية كضمان لوجود الحزب الحاكم والحزب المعارض في إدارة العملية. هذا بالإضافة إلى إشراف المرشح وإشراف لجان الأحزاب وإشراف اللجان الوطنية وإشراف اللجان الأجنبية إضافة إلى ما يجعل الانتخاب سرياً وهذا هو الضمانة الأكيدة.
- أما فيما يتعلق بإصلاح السلطة المحلية فلم يأتوا بجديد وإنما تناولوا نقاطاً من خطاب فخامة الأخ الرئيس في تعز في 25 سبتمبر الماضي.
- وتحت ما سمي بضمان الحقوق والحريات العامة. العجيب أن المشروع بدأ الحديث في هذه الجزئية بالاستناد إلى أحكام الدستور رغم أنه في المقدمة قد بنى مشروعه على أساس غياب دولة القانون.
ومع ذلك فإن ما ترتب على هذه الجزئية من نتائج أوردها المشروع لا تعدو كونها نصوصاً دستورية كفلها النظام السياسي اليمني لكافة المواطنين.
خطاب موجه للخارج
- أما ما يحاولون تصويره من أن هناك عوائق وقيوداً لممارسة المواطنين لحقهم الدستوري فليس أكثر من خطاب موجّه للخارج أكثر منه للداخل.
- والشيء نفسه ينطبق على عدد من النقاط الواردة في المشروع مثل تعديل قانون الأحزاب وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب وما يتعلق بنشاط الهيئات والمنظمات المدنية. وكذلك ما جاء بشأن إصدار أو تعديل عدد من القوانين (والغريب هنا ذكر القانون الإداري بين القوانين المطلوب إصدارها أو تعديلها ومصدر الغرابة هو أنه لا يوجد أصلاً قانون واحد بذاته يسمى القانون الإداري وإنما يقصد بذلك في الفقه القانوني مجموعة القوانين واللوائح المنظمة لكامل الأجهزة والعلاقات في الجهاز الإداري للدولة).
- وفيما يتعلق بحيادية واستقلالية الإدارة وضماناتها وعلى الأخص في التنافس السياسي.
إن حيادية الإدارة وضمانات هذه الحيادية مكفولة في جميع المجالات ليس فقط في النصوص الدستورية بل كذلك في الكثير من القوانين، وفي حال أن يتبين وجود نقص أو خلل في أي من هذه القوانين يتم تلافي مثل هذا النقص أو الخلل من خلال العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب وهي عملية مستمرة طوال الوقت.
ولا شك أن أخطر ما يمكن أن يوجد من اختلالات في هذا الجانب هو ما يتعلق بالتنافس في الانتخابات، بهذا الشأن أكد قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م في المادة (40) منه (يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية) ونصت المادة (52) تأكيداً لما سبق على أن (يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية)، كما نصت المادة (129) على أن(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته)، كما تنص المادة (143) بأنه (لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون) كل تلك النصوص هي ضمانات لحيادية أجهزة الدولة والمال العام.
القوات المسلحة ملك الشعب
- أما فيما يتعلق بما سمي ببناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، وكأنها الآن مبنية على أسس غير وطنية ولا ندري كيف تبنى على أسس وطنية لأنهم لم يدللوا بشيء، نؤكد أن الدستور قد عمل على صيانة القوات المسلحة والأمن واعتبرهما ملك الشعب ولحماية الجمهورية حيث تنص المادة (36) من الدستور (الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى..).
كما نصت المادة (39) على أن (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون) ونصت المادة (40) من الدستور على أن (يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون).
- كل هذه النصوص الدستورية والقانونية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما ورد في المشروع بهذا الصدد ليس أكثر من محاولة لإيهام الآخرين بأن خللاً كبيراً قد أصاب المؤسسة العسكرية والأمنية ومتجاهلاً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية من أجل أن تصل هذه المؤسسة إلى هذا المستوى المشرف.وإذ نكتفي بهذا القدر من القراءة القانونية للمشروع مع إمكانية العودة لمزيد من الإيضاح إن اقتضى الحال، فإنني أختتم قراءتي بملاحظات عامة كما يلي:-
أولاً: أن ما يسمى بمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني قد بدأ بتصور خاطئ تماما ليصل إلى نتائج خاطئة بعد ذلك، ويبدو أنه قد فعل ذلك بصورة متعمدة غرضها مخاطبة الخارج قبل الداخل.
ثانياً: أن المشروع قد أورد عبارات غاية في العمومية ولا تستند إلى أدلة أو حجج وحمل النظام السياسي كل ماسماه إخفاقات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية بل وحتى فشل أحزاب المعارضة التي تدير نفسها، وهذا كلام غير مسئول لا من الناحية العلمية ولا من الناحية السياسية ولا من أي ناحية أخرى.
ثالثاً: أن الانطلاق من أن النظام البرلماني حسب ما يدعونه سيعمل على إزالة كافة المعوقات والتشوهات التي صوروها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو طرح عقيم لا يستند إلى أسس علمية أو موضوعية. ولا يعقل في أي مجتمع أنه بمجرد تحويل شكل النظام السياسي من حال إلى آخر سيحدث نقلة نوعية فهذا طرح غير دقيق من الناحية العلمية، لأن النظام السياسي لأي مجتمع إنما ينطلق من الواقع وتغيير النظام من حال إلى حال لا يغير في الواقع شيئاً فالنظم السياسية تتطور مع تطور الواقع المطبق فيه هذا النظام.
إن تغيير نظام المرور مثلاً من النظام المعمول به حالياً في اليمن إلى النظام المعمول به في بريطانيا أي جعل "المقود" يمين وتغيير خط الذاهب عن خط الراجع من الشمال إلى اليمين لن يجعل نظام المرور لدينا مثالياً كما في بريطانيا، لأننا نطبق هذا النظام على الواقع اليمني بثقافاته وسلوكياته وفهمه لحركة المرور.
وأخيراً أرجو أن تكون مساهماتنا في أي إصلاحات سياسية في مستوى أهمية وخطورة هذه الإصلاحات وأحسب أن هذه مسئولية الجميع في الحكم وفي المعارضة فنحن جميعاً شركاء في هذا الوطن..
والله من وراء القصد.
عضو مجلس الشورى