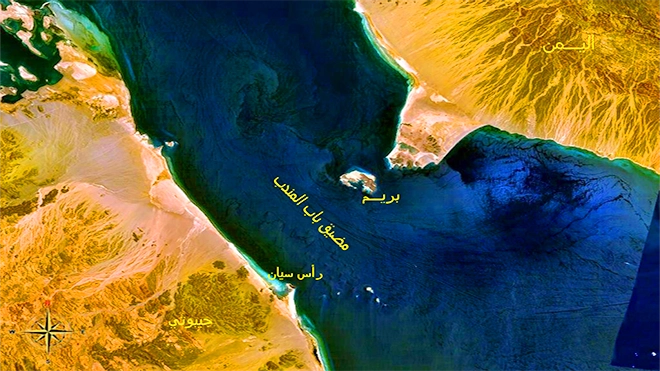> أبوبكر السقاف:
-1 ضلت باكستان طريقها نحو الدولة المدنية العصرية منذ عام الاستقلال، لأنها قامت على أساس ديني سياسي يميزها عن دولة الهند التي استقلت في العام نفسه 1947م، ومن هنا يمكن فهم قول المودودي بالحاكمية لتكون مبرر وجودها الحقيقي، معارضا بذلك ما يمكن تسميته بالإسلام الهندي الدستوري الذي يشترك مع حركة الإصلاح الإسلامية التي حاولت إيجاد صلة بين نهج الدولة الوطنية والفكر السياسي الحديث القائم على أن الأمة مصدر السلطات والسيادة وعلى الفصل بين السلطات، كما جاء عند خيرالدين التونسي وجمال الدين الأفغاني وغيرهما على تفاوت في ذلك. فالحاكمية تمثل قطيعة مع الدولة الوطنية ومع الأفكار الحديثة في الأمة والدستور والسيادة...إلخ، فهي تقوم على مبدأي الاستخلاف والوحدانية، ووفقا للأول على الإنسان عمارة الارض، وعلى الثاني تقوم وحدانية أقيمت على التشريع والسياسة فكرة «انتزاع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر، منفردين ومجتمعين، ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفُذ أمره في بشر مثله فيطيعوه، أو ليسن قانونا لهم فينقادون له ويتبعونه، فإن ذلك أمر مختص بالله وحده». (نظرية الإسلام السياسية، محاضرة ألقيت في لاهور 1939م).
وأساس هذه الفكرة قائم في ضرورة أن يكون الإسلام لا المواطنة والقومية هوية جماعية لمسلمي الهند، بينما كان أبو الكلام ازاد (1958-1888م) بين الذين يمثلون الإسلام الهندي الدستوري، فقد كان من الذين اتصلوا بحركة المشروطية (الدستورية) في ايران 1906م ومن المؤيدين لإصلاحات مدحت باشا في تركيا، وشارك في تأسيس (جمعية الحداثة) بعد الحرب العالمية الأولى التي هزمت فيها تركيا، وكان يرى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوساطة العمل السياسي السلمي، ووسع مفهوم (السياسة الشرعية) حتى شمل الأنظمة العلمانية الدنيوية، التي اعتبرها شرعية مادامت توافق مقاصد الإسلام، وهو رأي قديم قال به كثيرون منهم ابن الجوزي الذي اعتبر كل ما يحسن مصلحة المسلمين حتى وإن لم يرد في القرآن أو الحديث شرعيا، و(موافقات) الشاطبي صريحة في هذا الأمر، وكان محمد عبده يدرس (الموافقات).
2- هذا الأساس الذي أقيمت عليه الدولة عقد صلتها بالدولة المدنية، فشهدت عددا من الانقلابات العسكرية(1) كان آخرها انقلاب برويز مشرف، وظلت المعارضة الإسلامية بعد كل انقلاب تعود إلى مبرر أو علة وجود الدولة، أي الإسلام، بينما تطالب المعارضة الدستورية المدنية بالعودة إلى الدستورية وترفض جمع رئيس الدولة بين قيادة الجيش ورئاسة الدولة(2). ولكن هذا الاختلاف بين التيارين لم يحل هذه المرة بين جموع المعارضة والاتفاق على ضرورة تثبيت مدنية السلطة الذي أصبح مطلب المطالب وأساس الإجماع الوطني، فلا تحرر من الهيمنة الخارجية ولا ديمقراطية إلا بإرساء الدولة المدنية، فقد ثبت أن حكم الجيش يدمر السياسة من الأساس لأنه يقوم على مبدأ القوة، ولا تعايش بين الاستبداد والسياسة، ولذا يصبح الحيز العام كله وحتى القضاء مهددا بنزوات الحاكم العسكري المستبد بالتعريف.
وهذا ما حدث مع قاضي القضاة افتخار شودري الذي عزله مشرف من منصبه في أذار الماضي بتهمة استغلال المنصب، وحكمت المحكمة العليا بالأمس 2007/7/20م بعودته إلى منصبه (3)، فكان يوم فرح وطني شامل، فقد تلقى الديكتاتور ضربة قوية في ظرف سياسي شديد التعقيد، ورغم ذلك فإن مشرف يبدو أعقل وأكثر ثقافة من الرؤساء العرب والعسكر كافة باستثناء أعلى ولد فال الموريتاني، فقد قبل حكم المحكمة العليا.
واليوم يعيد سؤال الدولة المدنية طرح نفسه على الباكستانيين، الذين أجمعوا في مؤتمر أحزابهم في لندن على إسقاط الحكم العسكري، باستثناء حزب بانظير بوتو.
إن الدولة العسكرية في كل العالم الثالث تبدو استمرارا للقبيلة أو الجهة الجغرافية أو أقلية انكشارية رسخت امتيازاتها لطول بقائها في السلطة، وهي تؤسس دائما سلطة مضادة لكل أشكال الحكم المدني والعقلانية السياسية، تفترض أساس وحدة المجتمعين المدني والسياسي، وهما عمادا الدولة. وقد اتخذ حكم العسكر في الباكستان صورة تجمع انكشاري، فهو مؤسسة اقتصادية تدير المليارات وتملك أجهزة استخبارات مستقلة، ولعل صورته تكون قريبة إلى الأذهان بذكر المؤسسة الاقتصادية العسكرية التي كان حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة في مصر يرأسها، وتقليدها في الشمال اليمني كان المؤسسة الاقتصادية العسكرية، والمشترك بين كل هذه المؤسسات الاقتصادية العسكرية هو شمول سيطرة الجيش على المجتمع بوساطة جهاز القمع الأول في الدولة واستهلاك فائض الانتاج الوطني بانتظام يوفر إمكان قيام مجتمع إنتاجي عصري.
تتسم مجتمعات الاستبداد العسكري ليس بالقمع والفساد والانحلال الخلقي بل وبعقم في كل ما له علاقة بالإنتاج والعلم والتطور، لأن أساسها استهلاكي، وبنيتها تراتبية هرمية، تذكر في أوجه منها بدولة افلاطون التي أقامها على تحديد صارم للطبقات ومكرس لإشباع حاجات الاستهلاك داخل الهرم الاجتماعي وفقا للمرتبة. ولذا ظلت عشرات الدول في امريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا تدور في دوامة الفقر والجوع والظلم، حتى انتشلت نفسها بدحى الحكم العسكري وبناء دولة مدنية دستورية.
وإذا لم نتعلم في اليمن وفي غيره من الأقطار العربية هذا الدرس فإننا سنظل في هذه الدوامة، التي تقودنا في طرق شديدة الدموية كما نرى في العراق والسودان، وهي طرق لا تحرمنا من التقدم من أهدافنا التاريخية بل تعيدنا القهقرى إلى مكونات وجودنا الاولية والوشائج الاصلية الطبيعية، أي الانحلال والتحول المستمر نحو اللا وجود، وبذلك نغدو مع كل يوم يطيل عمر هذه الأنظمة العسكرية شاهدين وصانعين لحركة مضادة لسير التاريخ الحديث والمعاصر نحو الهمجية ودرجة الصفر.
إذاً ليست القضية أننا لا نتقدم أو أننا نزداد تخلفا، بل في أننا ننحط ونتحلل في بؤرة تنضح قتلا ودما وانحلالا على كل الصعد.
إن نقطة البداية ليست في الاجتهادات التي تدور على الفرق بين النظام الجمهوري والنظام الرئاسي، فهذه في بلادنا تمرينات نظرية أكثر مما هي معالجة لحال سياسة يمنية جذرها حكم الفرد العسكري المستبد، ولا في نقد الدستور المفصل على قد فرد ولا قانون الأحزاب ...إلخ، بل إن القضية المركزية المحورية هي مدنية الدولة.. مدنية السياسة. فهذا المبدأ موجه ضدا على عسكريتها وقبيلتها ومصدر السلطات فيها، ومبدأ السيادة العليا، وبعد حل هذه العقدة التاريخية تعالج قضايا الدستور والقوانين الظالمة.
لم يبدأ مجتمع في العصر الحديث من خارج هذه القضية، بل إن الفرق بين الحديث والقرون الوسطى هو الدولة المدنية والسياسة المدنية العقلانية السياسية، التي جاءت بحقوق المواطن والإنسان.
وليس مصادفة أن المدنية كانت الهدف الأول منذ بداية حركة الإصلاح الديني ومطلع حركة التحرر الوطني.. وعند كل الأطراف وتتحدث عنوانات الكتب عن هذا الإسلام والمدنية (محمد عبده)، تاريخ التمدن الإسلامي (جورجي زيدان) وغيرها كثير.
أحدث الانقلاب العسكري قطيعة معرفية ونفسية مع المدني، لأنه بحكم التعريف والنشأة والتاريخ مضاد له. وما القطيعة السياسية مع الحديث والعصري إلا ثمرة هذه القطيعة الشاملة.
(1) كان كل انقلاب يوظف قضية الإسلام- الهوية توظيفا ماكيافيليا صريحا، وأشدها تمثل في عهد ضياء الحق الذي بالغ في ذلك وفي القمع وأغرق التشريع بما سماه قوانين إسلامية.
(2) (3) أصبح شودري على رأس حركة وطنية عامة، شد إزرها بجولاته في أرجاء البلاد، وهي تطالب بحكم مدني وحاكم مدني وترفض إعادة انتخاب مشرف بوساطة البرلمان دون انتخابات جديدة، وتصر على عودة الجيش إلى ثكناته. وتذكر بأحداث العام 1954م في مصر ومطالبة اللواء محمد نجيب وخالد محي الدين بعودة الأحزاب وعودة الجيش إلى الثكنات.
ومن المصادفات أنني سمعت اسم افتخار شودري لأول مرة في ألمانيا، وكان ذلك في اليوم الأخير لبرنامج تعريف بالنظام القانوني والدستوري لألمانيا، لا سيما حقوق الإنسان، استمر أسبوعين ونظم لمجموعة من آسيا تضم سياسيين ومفكرين وصحافيين من الرجال والنساء المعنيين بحقوق الانسان في العام 1992م. كنا في المحكمة الدستورية العليا في ضواحي فرانكفورت وهي أعلى سلطة قضائية فيدرالية وتأتي في النظام الدستوري مرجعا لكل المحاكم الفدرالية، وكان رئيسها يودعنا بعد قضاء يوم كامل في المحكمة.. وفجأة سال زميلة باكستانية عن القاضي شودري وأراد معرفة تفاصيل عنه، وكان من الواضح أنه يثني على شودري وعمله في مجال القضاء في باكستان. علمنا في ذلك اللقاء الأخير أن مرتب القاضي الألماني رئيس المحكمة العليا لحقوق الإنسان أعلى من مرتب رئيس الجمهورية.
2007/7/21
وأساس هذه الفكرة قائم في ضرورة أن يكون الإسلام لا المواطنة والقومية هوية جماعية لمسلمي الهند، بينما كان أبو الكلام ازاد (1958-1888م) بين الذين يمثلون الإسلام الهندي الدستوري، فقد كان من الذين اتصلوا بحركة المشروطية (الدستورية) في ايران 1906م ومن المؤيدين لإصلاحات مدحت باشا في تركيا، وشارك في تأسيس (جمعية الحداثة) بعد الحرب العالمية الأولى التي هزمت فيها تركيا، وكان يرى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوساطة العمل السياسي السلمي، ووسع مفهوم (السياسة الشرعية) حتى شمل الأنظمة العلمانية الدنيوية، التي اعتبرها شرعية مادامت توافق مقاصد الإسلام، وهو رأي قديم قال به كثيرون منهم ابن الجوزي الذي اعتبر كل ما يحسن مصلحة المسلمين حتى وإن لم يرد في القرآن أو الحديث شرعيا، و(موافقات) الشاطبي صريحة في هذا الأمر، وكان محمد عبده يدرس (الموافقات).
2- هذا الأساس الذي أقيمت عليه الدولة عقد صلتها بالدولة المدنية، فشهدت عددا من الانقلابات العسكرية(1) كان آخرها انقلاب برويز مشرف، وظلت المعارضة الإسلامية بعد كل انقلاب تعود إلى مبرر أو علة وجود الدولة، أي الإسلام، بينما تطالب المعارضة الدستورية المدنية بالعودة إلى الدستورية وترفض جمع رئيس الدولة بين قيادة الجيش ورئاسة الدولة(2). ولكن هذا الاختلاف بين التيارين لم يحل هذه المرة بين جموع المعارضة والاتفاق على ضرورة تثبيت مدنية السلطة الذي أصبح مطلب المطالب وأساس الإجماع الوطني، فلا تحرر من الهيمنة الخارجية ولا ديمقراطية إلا بإرساء الدولة المدنية، فقد ثبت أن حكم الجيش يدمر السياسة من الأساس لأنه يقوم على مبدأ القوة، ولا تعايش بين الاستبداد والسياسة، ولذا يصبح الحيز العام كله وحتى القضاء مهددا بنزوات الحاكم العسكري المستبد بالتعريف.
وهذا ما حدث مع قاضي القضاة افتخار شودري الذي عزله مشرف من منصبه في أذار الماضي بتهمة استغلال المنصب، وحكمت المحكمة العليا بالأمس 2007/7/20م بعودته إلى منصبه (3)، فكان يوم فرح وطني شامل، فقد تلقى الديكتاتور ضربة قوية في ظرف سياسي شديد التعقيد، ورغم ذلك فإن مشرف يبدو أعقل وأكثر ثقافة من الرؤساء العرب والعسكر كافة باستثناء أعلى ولد فال الموريتاني، فقد قبل حكم المحكمة العليا.
واليوم يعيد سؤال الدولة المدنية طرح نفسه على الباكستانيين، الذين أجمعوا في مؤتمر أحزابهم في لندن على إسقاط الحكم العسكري، باستثناء حزب بانظير بوتو.
إن الدولة العسكرية في كل العالم الثالث تبدو استمرارا للقبيلة أو الجهة الجغرافية أو أقلية انكشارية رسخت امتيازاتها لطول بقائها في السلطة، وهي تؤسس دائما سلطة مضادة لكل أشكال الحكم المدني والعقلانية السياسية، تفترض أساس وحدة المجتمعين المدني والسياسي، وهما عمادا الدولة. وقد اتخذ حكم العسكر في الباكستان صورة تجمع انكشاري، فهو مؤسسة اقتصادية تدير المليارات وتملك أجهزة استخبارات مستقلة، ولعل صورته تكون قريبة إلى الأذهان بذكر المؤسسة الاقتصادية العسكرية التي كان حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة في مصر يرأسها، وتقليدها في الشمال اليمني كان المؤسسة الاقتصادية العسكرية، والمشترك بين كل هذه المؤسسات الاقتصادية العسكرية هو شمول سيطرة الجيش على المجتمع بوساطة جهاز القمع الأول في الدولة واستهلاك فائض الانتاج الوطني بانتظام يوفر إمكان قيام مجتمع إنتاجي عصري.
تتسم مجتمعات الاستبداد العسكري ليس بالقمع والفساد والانحلال الخلقي بل وبعقم في كل ما له علاقة بالإنتاج والعلم والتطور، لأن أساسها استهلاكي، وبنيتها تراتبية هرمية، تذكر في أوجه منها بدولة افلاطون التي أقامها على تحديد صارم للطبقات ومكرس لإشباع حاجات الاستهلاك داخل الهرم الاجتماعي وفقا للمرتبة. ولذا ظلت عشرات الدول في امريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا تدور في دوامة الفقر والجوع والظلم، حتى انتشلت نفسها بدحى الحكم العسكري وبناء دولة مدنية دستورية.
وإذا لم نتعلم في اليمن وفي غيره من الأقطار العربية هذا الدرس فإننا سنظل في هذه الدوامة، التي تقودنا في طرق شديدة الدموية كما نرى في العراق والسودان، وهي طرق لا تحرمنا من التقدم من أهدافنا التاريخية بل تعيدنا القهقرى إلى مكونات وجودنا الاولية والوشائج الاصلية الطبيعية، أي الانحلال والتحول المستمر نحو اللا وجود، وبذلك نغدو مع كل يوم يطيل عمر هذه الأنظمة العسكرية شاهدين وصانعين لحركة مضادة لسير التاريخ الحديث والمعاصر نحو الهمجية ودرجة الصفر.
إذاً ليست القضية أننا لا نتقدم أو أننا نزداد تخلفا، بل في أننا ننحط ونتحلل في بؤرة تنضح قتلا ودما وانحلالا على كل الصعد.
إن نقطة البداية ليست في الاجتهادات التي تدور على الفرق بين النظام الجمهوري والنظام الرئاسي، فهذه في بلادنا تمرينات نظرية أكثر مما هي معالجة لحال سياسة يمنية جذرها حكم الفرد العسكري المستبد، ولا في نقد الدستور المفصل على قد فرد ولا قانون الأحزاب ...إلخ، بل إن القضية المركزية المحورية هي مدنية الدولة.. مدنية السياسة. فهذا المبدأ موجه ضدا على عسكريتها وقبيلتها ومصدر السلطات فيها، ومبدأ السيادة العليا، وبعد حل هذه العقدة التاريخية تعالج قضايا الدستور والقوانين الظالمة.
لم يبدأ مجتمع في العصر الحديث من خارج هذه القضية، بل إن الفرق بين الحديث والقرون الوسطى هو الدولة المدنية والسياسة المدنية العقلانية السياسية، التي جاءت بحقوق المواطن والإنسان.
وليس مصادفة أن المدنية كانت الهدف الأول منذ بداية حركة الإصلاح الديني ومطلع حركة التحرر الوطني.. وعند كل الأطراف وتتحدث عنوانات الكتب عن هذا الإسلام والمدنية (محمد عبده)، تاريخ التمدن الإسلامي (جورجي زيدان) وغيرها كثير.
أحدث الانقلاب العسكري قطيعة معرفية ونفسية مع المدني، لأنه بحكم التعريف والنشأة والتاريخ مضاد له. وما القطيعة السياسية مع الحديث والعصري إلا ثمرة هذه القطيعة الشاملة.
(1) كان كل انقلاب يوظف قضية الإسلام- الهوية توظيفا ماكيافيليا صريحا، وأشدها تمثل في عهد ضياء الحق الذي بالغ في ذلك وفي القمع وأغرق التشريع بما سماه قوانين إسلامية.
(2) (3) أصبح شودري على رأس حركة وطنية عامة، شد إزرها بجولاته في أرجاء البلاد، وهي تطالب بحكم مدني وحاكم مدني وترفض إعادة انتخاب مشرف بوساطة البرلمان دون انتخابات جديدة، وتصر على عودة الجيش إلى ثكناته. وتذكر بأحداث العام 1954م في مصر ومطالبة اللواء محمد نجيب وخالد محي الدين بعودة الأحزاب وعودة الجيش إلى الثكنات.
ومن المصادفات أنني سمعت اسم افتخار شودري لأول مرة في ألمانيا، وكان ذلك في اليوم الأخير لبرنامج تعريف بالنظام القانوني والدستوري لألمانيا، لا سيما حقوق الإنسان، استمر أسبوعين ونظم لمجموعة من آسيا تضم سياسيين ومفكرين وصحافيين من الرجال والنساء المعنيين بحقوق الانسان في العام 1992م. كنا في المحكمة الدستورية العليا في ضواحي فرانكفورت وهي أعلى سلطة قضائية فيدرالية وتأتي في النظام الدستوري مرجعا لكل المحاكم الفدرالية، وكان رئيسها يودعنا بعد قضاء يوم كامل في المحكمة.. وفجأة سال زميلة باكستانية عن القاضي شودري وأراد معرفة تفاصيل عنه، وكان من الواضح أنه يثني على شودري وعمله في مجال القضاء في باكستان. علمنا في ذلك اللقاء الأخير أن مرتب القاضي الألماني رئيس المحكمة العليا لحقوق الإنسان أعلى من مرتب رئيس الجمهورية.
2007/7/21