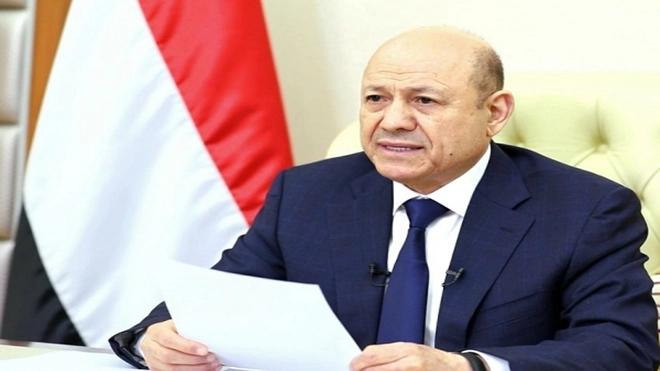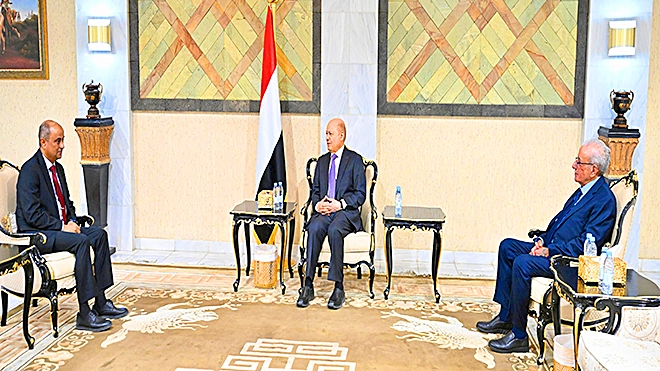> «الأيام» أديب قاسم:
ظاهر فريدة في الأدب، بسطت ظلها على مختلف جوانب الحياة الثقافية في اليمن.
إنسان أوتي ملكة في الأدب، وقد انبعثت بداياته ولم تذهب بعيدا.. إذ كان في الوقت نفسه قد ارتاد حقلا (فنيا) آخر شغف به كل الشغف، وتأسست عليه قناعاته منذ عقد الطفولة.. فتحددت به إمكاناته ليختار طريقه في الحياة.. ذلك هو حقل التكوين (أو التشكيل) فازدهرت لوحاته- من بعد- في المعارض ليزدهي بها سوق الفن، وتتنعم بها الحياة.
وتجيء (الوظيفة) فتنتزعه من هذا الحقل أو الوسط الفني زمنا خلته دهرا.
وحيث أن الفن لايمكن أن يكون مهنة! غير أنه يظل وفيا لفنه، ويرى فيه قوة انبعاثه.. يحس في دخيلته أنه قد خلق له، وأنه لايصلح لغيره، وإن أغرته لقمة العيش الكبيرة.
وتمضي الحياة تتجاذبه في وظيفته (لجهة أعمال إدارية فنية أو إشرافية حكومية) فتكاد تأتي على تلك الموهبة الخلاقة والمبدعة غير التقليدية، التي كان يميل بها إلى المدرسة الانطباعية.. وهي قريبة من الأدب.
وبما أنني عميق الصلة (بروح) الفنان، وقد خلصت إلى الأدب خلال حياة رافقته فيها منذ البداية، فقد عشت أرقبه عن كثب في مخاضات تلك التجربة الحية إلى أن دخلنا معا في كهف الذكريات، ثم وفي هذا الوقت، وعلى غير انتظار، وبعد أن سار صاحبي (رفيق العمر) على درب تلك الموهبة ليقيم عليها وجوده ويصنع لنفسه شهرة، يتكشف له أن نفسه ظلت تنطوي على شيء آخر.. أبعد مما هيأته له الظروف، وإذا به ينشر مقالات عدة في الصحف فتدفعه إلى مقام الأدباء والنقاد.
وأعرف- تماما- أنه عندما شرع يكتب وينشر كتاباته، وقد أوفى على التقاعد، لم يكن يريد منها سوى تسلية نفسه، أو قل ليفرغ ما في نفسه ولاشيء وراء هذا.. حتى أنه ما كان بحاجة إلى الأجر الذي تدفعه الصحف لقاء ما يكتب- هذا إن كانت في الأصل تدفع، وتلتزم بحقوق الإنتاج الفكري!- مكتفيا بمعاشه الطيب، غير أنه وقد لقي إقبالا من القراء لاسيما في الوسط الثقافي، الفني، والأدبي، لم يلبث أن انتقل إلى الكتابة التي يريد لها أن تشيع بين القراء.
فنرى أنه قد مر بمرحلة تحول كلي عندما بدأ الكتابة ليبث القارئ أفكاره ويفوز بحبه.
ومعنى هذا أنه عندما اكتشف (الأديب) في نفسه لم يعد يقدر على التوقف.. فأدرك أنه قد انتصر لتلك الموهبة القابعة في أعماقه، وأمام التهيب من الأدب، ومن كل ممارسة فكرية، وهذا ما صار إليه. كاتب بالغ الثراء والتنوع، كتب- ومايزال- في مختلف جوانب الثقافة.. واستطاع أن يثبت قدميه في حقل الأدب.
تحدث هذه الظاهرة، وهي تظهر في حالات كثيرة من الكتابة التي تأتي متأخرة بشكل انقلابي دراماتيكي، وإذا بها تفاجئك ببلوغها حدا كبيرا من النضج الفكري والفني والأدبي، إذ تنبعث من مخزون كبير يقف على قاعدة واسعة متينة من القراءة والاطلاع والطواف في مختلف جوانب الثقافة من فنون وآداب وغيرها من أنماط المعرفة.. حتى فاض بها الأديب الكاتب والفنان (علي محمد يحيى) إلى الصحف، وقد سهل عليه هذا (الكثير) من خلال تنوع ثقافاته وموسوعية فكرة وسعة اطلاعه أن يسكب روحه بين مختلف الاتجاهات في الفن والأدب، مثلما في معالجة الأنماط الأخرى عن طريق مقالاته الفنية والنقدية، أو عرضه ومراجعاته للإصدارات.
على أن الأدب- بالذات- ليس بالشيء السهل الذي يمكن أن تقطفه من فوق الأشجار دون أن تعد نفسك للغوص في الأعماق.. حتى يتبين لك أنك تمسك بشجرة المعرفة من جذورها وبذرها وأزهارها، ومنها تكون ثمار الأدب!.. الأدب الذي وقف عليه (علي محمد يحيى) قبل أن يدلف إلى ميدان الكتابة.. ويتعلم من الصحافة اختصار الوقت في أسلوب وموضوع المقالة دون التهيب الذي يلازم المبتدئ في كل صناعة!.
ومع التدقيق والعناية بالموضوع ظهرت تجلياته في الأدب، وقد تشبعت بذلك الأسلوب الموضوعي الاستقصائي الممتلئ المغري بالقراءة، والذي لا يتأتى إلا بطول ممارسة وإغراق في البحث والقراءة.. ومع التمعن بأسرار البلاغة في الصوغ الأدبي و(فنية) الأدب.
وكان أول نتاج نثري له قيمة للأديب (علي محمد يحيى) هو (حكاية المساء)، عنوان لسلسلة من الحكايات أو الأحداث التي تمر بها الحياة.. كانت قد قدمتها إذاعة البرنامج الثاني (عدن) في فترات المساء طيلة 180 ليلة من عام 1998.
وفي هذه الحكايات برزت فيه موهبة الأديب، حيث يروي لنا بصدق وشاعرية تجارب من الحياة، غير أن أبرز ما في الموضوع ومع تغلغله في ظواهر الحياة هو (الأسلوب)، أسلوب العرض الذي ازدانت به تلك الحكايات، والتي كنت كلما استمعت إليها أحسست فيها طراوة المساء، وانتابني إحساس بالحكايات التي تبث في الليالي المقمرة، مع فارق رئيسي، هو أن مادتها (حية) مستقاة من واقع الحياة، متضمنة نقدا لظواهر اجتماعية وإنسانية.
وكان أسلوبها الرائع ببنيته الأدبية يحقق من الاستمتاع ما يبدد الفراغ في النفس، ويحيلك إلى أجواء المساء الهادئ، المزدهي بأضواء تلوح بعيدا عند الأفق.. وخير عبارة أشبه بها تلك الحكايات هي عبارة (ت. س اليوت): «هنالك من يعزف تلك المقطوعة الموسيقية الحالمة الرائعة عن الليل، وبها نستطيع أن نستجلي الليل وضوء القمر.. إنها موسيقى نلجأ إليها لننفث فراغ نفوسنا، وتلك هي الحكايات التي تأتي عند المساء».
هذا غير ما كان من شعره المتقدم الذي برز في مطلع السبعينات من القرن الماضي بتكثيف ورهافة حس، أوفى إلى دلالات شعرية تجردت عن الصور الذهنية في شكل من أشكال الحداثة، هي ما انتهى إليه الشعر في عصرنا!.. لكن هذه التجربة، المبكرة نسبيا، وئدت في وقتها.. فلم تمتد فصولا يتعمق من أبعادها في رؤيتها واستبصارها لآماد التحورات من تبدل أشكال القصيدة الحداثية وانعكاساتها عن المشاكل الاجتماعية والسياسية، إبان فوران الشكل المعماري وتحطيم شجرة اللغة العتيقة.
غير أن القصيدة بتعدد مستوياتها الفنية قد دخلت في تراكيب لغته الأدبية بجزالة مفرداتها وخاصيتها الدسمة.. وهذا ما سوف نكتشفه من خلال تكثيفه (للصور) في أعماله الأدبية والنقدية عبر الصحف.
وننتهي إلى نهجه في الكتابة بوجه عام، وهي كتابات اقتصرت على الصحف، حيث تدل على سعة اطلاع وإبحار في المدى البعيد للرؤية من خلال تأملاته وإسقاطاته ملقيا نظرات في الفن والأدب والحياة.
أما عن كشفه لظواهر الإبداع الثقافي والفني، فلا مندوحة لنا من القول إنه يقف منها موقف النقد (الانطباعي - التأثري) بأدوات نقدية فيها جزالة الوصف خلال تناوله لها كلما عرض له مصنف، وإن أردت الحقيقة، تجد أن من الصعب في وسطنا الثقافي إحراز الرضى القلبي عند النقد - نقد الصحة، إن عمدت إلى قول الحقيقة على قواعد من المنطق ودقة المعرفة.. إلا أن ترفه عن المصنف.. فتقول:«أحسنت، وقد جئت بالبيان المعجز!».
فكيف توفق بين أن تقول كلمة طيبة، وبين أن تخلص للحقيقة؟ وأنت تعلم أنك إن تكلمت بما في جوهرك من الصدق تكون قد وفقت فيما تطرح من أحكام نقدية، تزجي بها خدمة جمالية في ظرف من ظروف الجمال التي تطمح إليها الحياة.
هذه الحقيقة، كان قد أدركها (علي محمد يحيى) فتوقف عندها لينقطع إلى النقد الجمالي الوصفي من طريق تأملاته وإسقاطاته على العمل الفني، لاسيما في محيط الأدب، وعلى هذا الأساس من الإدراك جرى نهجه في الكتابة، فلم يشأ أن يحفر عميقا في أخاديد العمل الشعري أو النثري أو غيره، أكان أثرا فنيا أم نصا من نصوص الأدب، ولكن أن يجلي الصورة فيبرز مفاتن العمل بكل ما يتسم به من ثراء وحكمة.
وكثيرا ما كان يقترب من التحليل النفسي للإبداع الفني تبعا لقوة أثره البلاغي في النفس، وهو غالبا مما يتصل بملكة التذوق إذ يتناول الصور وخاصيتها المعبرة.. حيث تسيطر الصور على جمال التعبير بما لها من قوة عاطفية، ودون أن يعشم نفسه التوغل بأدوات التحليل ووسائله التي تمكن من الكشف عن قوانين تكوين النص بما يبين الخصائص النوعية الفارقة لظواهر الإبداع الثقافي والفني خاصة، ففي كثير مما يكتبه عن وعي وإدراك كاملين، شيء من الحقيقة، إلى درجة كبيرة، والباقي لايخلو من الفبركة والقفز على الحقيقة (وهو ما يستدعيه الموقف الدقيق للحساسية النقدية).
ومع ذلك فإن الصورة التي يرسمها عن (الموضوع) فيها كثير من دقة التصوير مما يتسم به النقد الوصفي، ومن خلال ذخيرته التي لاتنفذ بما فيها من إمكانات كثيرة للتعبير عن جماليات النص في شكله وموضوعه وتداخلاته مع الحياة.
وبهذا كان يكسب معركته مع النقد بما يقربه من الآخرين في الوسط الاجتماعي على صعيد الثقافة والفن والأدب، وكل نص مفتوح على الحياة بتعدد أوجه الكتابة من دراسات وأبحاث وغيرها. وبهذا ترسخت مكانته في الأدب، وحقق لنفسه الشهرة.
إنسان أوتي ملكة في الأدب، وقد انبعثت بداياته ولم تذهب بعيدا.. إذ كان في الوقت نفسه قد ارتاد حقلا (فنيا) آخر شغف به كل الشغف، وتأسست عليه قناعاته منذ عقد الطفولة.. فتحددت به إمكاناته ليختار طريقه في الحياة.. ذلك هو حقل التكوين (أو التشكيل) فازدهرت لوحاته- من بعد- في المعارض ليزدهي بها سوق الفن، وتتنعم بها الحياة.
وتجيء (الوظيفة) فتنتزعه من هذا الحقل أو الوسط الفني زمنا خلته دهرا.
وحيث أن الفن لايمكن أن يكون مهنة! غير أنه يظل وفيا لفنه، ويرى فيه قوة انبعاثه.. يحس في دخيلته أنه قد خلق له، وأنه لايصلح لغيره، وإن أغرته لقمة العيش الكبيرة.
وتمضي الحياة تتجاذبه في وظيفته (لجهة أعمال إدارية فنية أو إشرافية حكومية) فتكاد تأتي على تلك الموهبة الخلاقة والمبدعة غير التقليدية، التي كان يميل بها إلى المدرسة الانطباعية.. وهي قريبة من الأدب.
وبما أنني عميق الصلة (بروح) الفنان، وقد خلصت إلى الأدب خلال حياة رافقته فيها منذ البداية، فقد عشت أرقبه عن كثب في مخاضات تلك التجربة الحية إلى أن دخلنا معا في كهف الذكريات، ثم وفي هذا الوقت، وعلى غير انتظار، وبعد أن سار صاحبي (رفيق العمر) على درب تلك الموهبة ليقيم عليها وجوده ويصنع لنفسه شهرة، يتكشف له أن نفسه ظلت تنطوي على شيء آخر.. أبعد مما هيأته له الظروف، وإذا به ينشر مقالات عدة في الصحف فتدفعه إلى مقام الأدباء والنقاد.
وأعرف- تماما- أنه عندما شرع يكتب وينشر كتاباته، وقد أوفى على التقاعد، لم يكن يريد منها سوى تسلية نفسه، أو قل ليفرغ ما في نفسه ولاشيء وراء هذا.. حتى أنه ما كان بحاجة إلى الأجر الذي تدفعه الصحف لقاء ما يكتب- هذا إن كانت في الأصل تدفع، وتلتزم بحقوق الإنتاج الفكري!- مكتفيا بمعاشه الطيب، غير أنه وقد لقي إقبالا من القراء لاسيما في الوسط الثقافي، الفني، والأدبي، لم يلبث أن انتقل إلى الكتابة التي يريد لها أن تشيع بين القراء.
فنرى أنه قد مر بمرحلة تحول كلي عندما بدأ الكتابة ليبث القارئ أفكاره ويفوز بحبه.
ومعنى هذا أنه عندما اكتشف (الأديب) في نفسه لم يعد يقدر على التوقف.. فأدرك أنه قد انتصر لتلك الموهبة القابعة في أعماقه، وأمام التهيب من الأدب، ومن كل ممارسة فكرية، وهذا ما صار إليه. كاتب بالغ الثراء والتنوع، كتب- ومايزال- في مختلف جوانب الثقافة.. واستطاع أن يثبت قدميه في حقل الأدب.
تحدث هذه الظاهرة، وهي تظهر في حالات كثيرة من الكتابة التي تأتي متأخرة بشكل انقلابي دراماتيكي، وإذا بها تفاجئك ببلوغها حدا كبيرا من النضج الفكري والفني والأدبي، إذ تنبعث من مخزون كبير يقف على قاعدة واسعة متينة من القراءة والاطلاع والطواف في مختلف جوانب الثقافة من فنون وآداب وغيرها من أنماط المعرفة.. حتى فاض بها الأديب الكاتب والفنان (علي محمد يحيى) إلى الصحف، وقد سهل عليه هذا (الكثير) من خلال تنوع ثقافاته وموسوعية فكرة وسعة اطلاعه أن يسكب روحه بين مختلف الاتجاهات في الفن والأدب، مثلما في معالجة الأنماط الأخرى عن طريق مقالاته الفنية والنقدية، أو عرضه ومراجعاته للإصدارات.
على أن الأدب- بالذات- ليس بالشيء السهل الذي يمكن أن تقطفه من فوق الأشجار دون أن تعد نفسك للغوص في الأعماق.. حتى يتبين لك أنك تمسك بشجرة المعرفة من جذورها وبذرها وأزهارها، ومنها تكون ثمار الأدب!.. الأدب الذي وقف عليه (علي محمد يحيى) قبل أن يدلف إلى ميدان الكتابة.. ويتعلم من الصحافة اختصار الوقت في أسلوب وموضوع المقالة دون التهيب الذي يلازم المبتدئ في كل صناعة!.
ومع التدقيق والعناية بالموضوع ظهرت تجلياته في الأدب، وقد تشبعت بذلك الأسلوب الموضوعي الاستقصائي الممتلئ المغري بالقراءة، والذي لا يتأتى إلا بطول ممارسة وإغراق في البحث والقراءة.. ومع التمعن بأسرار البلاغة في الصوغ الأدبي و(فنية) الأدب.
وكان أول نتاج نثري له قيمة للأديب (علي محمد يحيى) هو (حكاية المساء)، عنوان لسلسلة من الحكايات أو الأحداث التي تمر بها الحياة.. كانت قد قدمتها إذاعة البرنامج الثاني (عدن) في فترات المساء طيلة 180 ليلة من عام 1998.
وفي هذه الحكايات برزت فيه موهبة الأديب، حيث يروي لنا بصدق وشاعرية تجارب من الحياة، غير أن أبرز ما في الموضوع ومع تغلغله في ظواهر الحياة هو (الأسلوب)، أسلوب العرض الذي ازدانت به تلك الحكايات، والتي كنت كلما استمعت إليها أحسست فيها طراوة المساء، وانتابني إحساس بالحكايات التي تبث في الليالي المقمرة، مع فارق رئيسي، هو أن مادتها (حية) مستقاة من واقع الحياة، متضمنة نقدا لظواهر اجتماعية وإنسانية.
وكان أسلوبها الرائع ببنيته الأدبية يحقق من الاستمتاع ما يبدد الفراغ في النفس، ويحيلك إلى أجواء المساء الهادئ، المزدهي بأضواء تلوح بعيدا عند الأفق.. وخير عبارة أشبه بها تلك الحكايات هي عبارة (ت. س اليوت): «هنالك من يعزف تلك المقطوعة الموسيقية الحالمة الرائعة عن الليل، وبها نستطيع أن نستجلي الليل وضوء القمر.. إنها موسيقى نلجأ إليها لننفث فراغ نفوسنا، وتلك هي الحكايات التي تأتي عند المساء».
هذا غير ما كان من شعره المتقدم الذي برز في مطلع السبعينات من القرن الماضي بتكثيف ورهافة حس، أوفى إلى دلالات شعرية تجردت عن الصور الذهنية في شكل من أشكال الحداثة، هي ما انتهى إليه الشعر في عصرنا!.. لكن هذه التجربة، المبكرة نسبيا، وئدت في وقتها.. فلم تمتد فصولا يتعمق من أبعادها في رؤيتها واستبصارها لآماد التحورات من تبدل أشكال القصيدة الحداثية وانعكاساتها عن المشاكل الاجتماعية والسياسية، إبان فوران الشكل المعماري وتحطيم شجرة اللغة العتيقة.
غير أن القصيدة بتعدد مستوياتها الفنية قد دخلت في تراكيب لغته الأدبية بجزالة مفرداتها وخاصيتها الدسمة.. وهذا ما سوف نكتشفه من خلال تكثيفه (للصور) في أعماله الأدبية والنقدية عبر الصحف.
وننتهي إلى نهجه في الكتابة بوجه عام، وهي كتابات اقتصرت على الصحف، حيث تدل على سعة اطلاع وإبحار في المدى البعيد للرؤية من خلال تأملاته وإسقاطاته ملقيا نظرات في الفن والأدب والحياة.
أما عن كشفه لظواهر الإبداع الثقافي والفني، فلا مندوحة لنا من القول إنه يقف منها موقف النقد (الانطباعي - التأثري) بأدوات نقدية فيها جزالة الوصف خلال تناوله لها كلما عرض له مصنف، وإن أردت الحقيقة، تجد أن من الصعب في وسطنا الثقافي إحراز الرضى القلبي عند النقد - نقد الصحة، إن عمدت إلى قول الحقيقة على قواعد من المنطق ودقة المعرفة.. إلا أن ترفه عن المصنف.. فتقول:«أحسنت، وقد جئت بالبيان المعجز!».
فكيف توفق بين أن تقول كلمة طيبة، وبين أن تخلص للحقيقة؟ وأنت تعلم أنك إن تكلمت بما في جوهرك من الصدق تكون قد وفقت فيما تطرح من أحكام نقدية، تزجي بها خدمة جمالية في ظرف من ظروف الجمال التي تطمح إليها الحياة.
هذه الحقيقة، كان قد أدركها (علي محمد يحيى) فتوقف عندها لينقطع إلى النقد الجمالي الوصفي من طريق تأملاته وإسقاطاته على العمل الفني، لاسيما في محيط الأدب، وعلى هذا الأساس من الإدراك جرى نهجه في الكتابة، فلم يشأ أن يحفر عميقا في أخاديد العمل الشعري أو النثري أو غيره، أكان أثرا فنيا أم نصا من نصوص الأدب، ولكن أن يجلي الصورة فيبرز مفاتن العمل بكل ما يتسم به من ثراء وحكمة.
وكثيرا ما كان يقترب من التحليل النفسي للإبداع الفني تبعا لقوة أثره البلاغي في النفس، وهو غالبا مما يتصل بملكة التذوق إذ يتناول الصور وخاصيتها المعبرة.. حيث تسيطر الصور على جمال التعبير بما لها من قوة عاطفية، ودون أن يعشم نفسه التوغل بأدوات التحليل ووسائله التي تمكن من الكشف عن قوانين تكوين النص بما يبين الخصائص النوعية الفارقة لظواهر الإبداع الثقافي والفني خاصة، ففي كثير مما يكتبه عن وعي وإدراك كاملين، شيء من الحقيقة، إلى درجة كبيرة، والباقي لايخلو من الفبركة والقفز على الحقيقة (وهو ما يستدعيه الموقف الدقيق للحساسية النقدية).
ومع ذلك فإن الصورة التي يرسمها عن (الموضوع) فيها كثير من دقة التصوير مما يتسم به النقد الوصفي، ومن خلال ذخيرته التي لاتنفذ بما فيها من إمكانات كثيرة للتعبير عن جماليات النص في شكله وموضوعه وتداخلاته مع الحياة.
وبهذا كان يكسب معركته مع النقد بما يقربه من الآخرين في الوسط الاجتماعي على صعيد الثقافة والفن والأدب، وكل نص مفتوح على الحياة بتعدد أوجه الكتابة من دراسات وأبحاث وغيرها. وبهذا ترسخت مكانته في الأدب، وحقق لنفسه الشهرة.