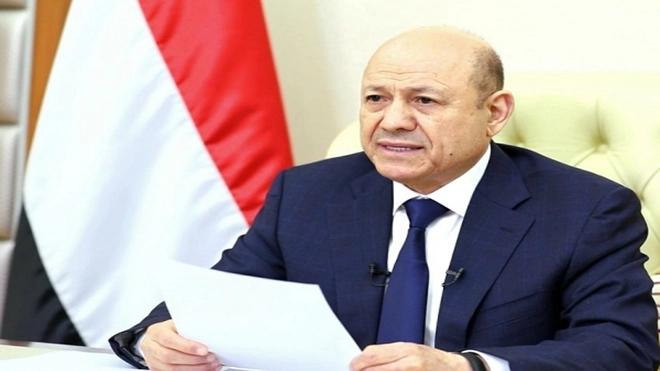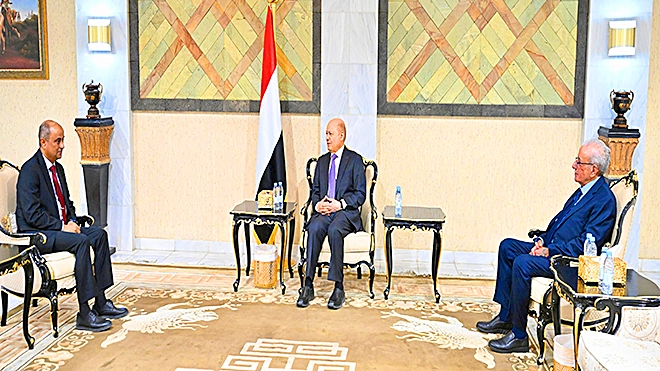> «الأيام» محمد عمر بحاح:
إشارة واحدة من العسكري، أوقفت سيارتهم في نقطة التفتيش المؤدية إلى المدينة.
كان جنود النقطة منهمكين في تفتيش السيارات، والركاب المنتظرين بفارغ الصبر.
لبس العسكري وجهه الصارم، كانت بندقيته الرشاش تتدلى من كتفه، ويرتدي بذلة كتلك التي لجنود الصاعقة، وينتعل حذاءين ثقيلين، ويعتمر خوذة حديدية لا تناسب صيف عدن الحارق.
يلتهم وجوههم بعينين شرستين. كانوا ستة بما في ذلك صديقهم السائق، متشابهين في الوداعة، وسماع الموسيقى والأغاني، ويتشاركون الاهتمامات والأحلام والوجع!
بالصرامة التي لبسها يسألهم إن كانوا يحملون سلاحاً؟
يجيبون بالنفي.
يلفت انتباهه «العود» النائم في حضن أحد الركاب الثلاثة في المقعد الخلفي.
بالصرامة نفسها يسألهم:
- ماهذا ؟
كان الراكب وهو فنان معروف، يحتضن عودة بحنان ملحوظ، لم يقرأ في عيني العسكري، وسؤاله، سوى نوع من الغباء المستحكم، أو الاستفزاز المتعمد!
يكبت ضحكة كادت تفلت منه، ويكتم غضباً كاد ينفجر به.
يجيبه:
- عود!!!
وضمه إلى صدره بحنان من يحتضن فلذته.
وهذه المرة لم ينس أن يستبدل الضحكة بابتسامة ساخرة، لم يلحظها العسكري، أو أنه تجاهلها حتى لا يتهم بالغباء!
يستبد السؤال عن السلاح والعود، بالسؤال عن المكان الذي قدموا منه؟ ويفشل في إخفاء نظرة عدائية تنهمر من عينيه بغزارة.
- من لحج.
هكذا أخبروه.
ولن يخبروه، أنهم قضوا عدة ساعات رائعة، في «بستان» بدعوة من صديقهم المخرج التلفزيوني. خشوا أن يسألهم عن اسمه، وموقع البستان، فلم يجدوا ضرورة لإعلامه.
لم يقولوا له أنهم قضوا أجمل ساعات العمر يغنون، ويضحكون، ويصافحون بأرواحهم قبل عيونهم أشجار الفواكه، وخضرة الأشجار، وزقزقة العصافير، وفي تجاذب الأحاديث عن لحج الخضيرة وروائع القمندان، وتتغلغل فيهم روائحها.
ولم يقولوا له أنهم خلال ذلك، دفنوا كآبة الجدران، وحزن السنين، وقتامة الحاضر، دون أن يشعروا بمرور الوقت، أو ينسوا الحلم بالمستقبل. وكانوا سيكونون بحال أفضل لولا إشارته الغبية بالتوقف، وأفضل كثيراً لو لم تكن هذه النقطة موجودة، ليدخلوا إلى مدينتهم دون توقيف، أو تفتيش!
يحشر العسكري رأسه ، ونصف جسمه الأعلى في فتحة النافذة الأمامية ، حيث يجلس السائق.
يلتهم بعينيه أرجاءها، ويتفحص بنهم السائق والراكبين إلى جانبه، لكنه لم يسألهم عن هوياتهم، بل يدس يده في أكياسهم بحثاً عن سلاح، لايجد فيها سوى بقايا القات، وقناني ماء، ومشروبات غازية... شربوا أكثر من نصفها!
بنفس التجهم والوجه العابس الذي ارتداه، يحشر رأسه في النافذة الخلفية وفي وجوه الركاب في المقعد الخلفي..
يأمرهم بالنزول من السيارة.
ينزل الفنان محتضناً عوده!
وينزل الراكبان الآخران حاملين أكياسهما (النايلون)..
يفتشها العسكري فلا يجد فيها أيضاً سوى بقايا القات، وقناني الماء والمشروبات الغازية..
تزداد خيبة أمله، يفتش «الكابينة»، المقاعد حيث كانوا يجلسون، ولا ينسى أن يفتش مواقع أقدامهم.. والبحث في أي مكان قد تكون فيها ثغرة، يمكن تخبئة سلاح فيها ..
يقرأون في عينيه، وطريقة تصرفه نظرة عدائية لم يكونوا يعرفون سببها، فقد كانوا مواطنين مسالمين، لا علاقة لهم بالسلاح ولا بالإرهاب! وكان في نشوة البزة العسكرية، والبندقية المتدلية من كتفه، والسلطة الممنوحة له، والتعبئة الخاطئة بأن كل من لا يرتدي «الميري» عدو حتى يثبت العكس!
يأمر الراكبين في الأمام بالنزول.. لاتزال له نفس النبرة العنجهية، والنظر العدائية المستفزة، ويعيد تفتيشهما مجدداً..
يحشر رأسه ونصف جدعه الأعلى من جديد، ويعيد تفتيش ما سبق أن فتشه قبل قليل.
يعيد فتح «الخانة» أسفل الطبلون، وحيث دس أنفه وعينيه تنهمر عليه وجوه ضاحكة، مشهورة، مألوفة، وهادئة للمرشدي، وأحمد قاسم، ومحمد سعد عبدالله، واسكندر ثابت، وفيصل علوي، وفيروز، وعبدالوهاب، والزيدي. لم يكن أحدهم بلحية أو يحمل سلاحاً، أو له وجه إرهابي، فأصيب ما يشبه بخيبة الأمل!
لم يسألهم من هؤلاء، ولا ماذا يفعلون، ولا عن سبب وجودهم في سيارتهم، لكن مزاجه تحول إلى مزاج عكر أكثر من السابق، فألبس وجهه صرامة جديدة، وازدادت عصبيته، كالذين يشعرون بالفشل عندما لا يجدون ما يبحثون عنه.
يزيده غيظاً صوت أحمد قاسم، رأى صورته قبل قليل دون أن يعرف من يكون.. ولا ماذا يفعل في خانة السيارة مع أولئك الرجال والبنات!
لكن صوت غنائه كان يغيظه..
كان ينساب من المسجلة التي تركها صديقهم السائق في وضع التشغيل، ويغني أغنية عذبة، ويهديها إلى أرواحهم - ويهدونها بدورهم إلى روحه.
مات، أو قتل قبل (15 عاماً) في حادث مروري عندما كان عائداً من صنعاء إلى عدن! وشكل موته حزناً خاصاً في كل قلب، وبكته المدينة كما تبكي الأم ابنها، بمشهد وداع حزين ودموع، لكنها لم تنسه. لا يزال حياً بفنه، وموسيقاه، وأغانيه، في قلبها، وقلوب الناس.
غني للحرية والحب والوطن كما غنى لها محمد سعد عبدالله والزيدي واسكندر ثاب وسواهم، عاشوا وماتوا فظفر الناس بالحرية والاستقلال، ونسوا أسماء المقاتلين، والعديد من الشهداء، وحتى أسماء الزعماء الذين حكموهم، لكنهم لم ينسوا شعراءهم وفنانيهم.. بقي أثرهم في مشاعرهم الوطنية بنفس القدر في مشاعرهم العاطفية ووجدانهم الإنساني، وسيبقى.
العسكري لا يتقن سوى الصرامة، ووجهه العابس الذي ارتداه والتفتيش في أي مكان.. عن سلاح جريمة..
يتلمس طبلون السيارة، يزيح قطعة القماش المزركشة ذات اللون البني التي تغطيه، والتي وضعت لحماية مقدمة السيارة من صيف عدن الحارق.
تصطدم أصابعه بصلابة الحديد!
ينظرون إليه في دهشة:«ماذا كان يتوقع أن يجد هنا غير حديد السيارة؟..» يتململون، يحاولون الحفاظ على هدوئهم، حتى لا يستفزوا العسكري أكثر مما هو مستفز.
وما دهشوا له أجاب عنه «الزبيري» قبل أكثر من نصف قرن، وكانوا يعرفون ويحفظون بيته الشهير:«العسكري بليدٌ، للأذى فطنٌ، كأن إبليس للطغيان رباه»! ذهب الإمام ومات.. واستشهد الزبيري، وبقي العُكفي! كانوا يرونه أمامهم في تلك اللحظة بشحمه، ولحمه، ودمه!
بطريقة ما تسكن كهرباء العسكري.
يأمرهم بنفس الصرامة والشراسة، العودة إلى سيارتهم.. يعطي إشارة التحرك للسائق.
تنطلق بهم..
يرسل أحمد قاسم صوته العذب المكبوت، هادراً قوياً بعد أن رفع صديقهم مؤشر الصوت عالياً.
يستعيدون بعض النشوة، وبعض الحرية التي افتقدوها في نقطة التفتيش..
كانت عدن تفتح صدرها لهم بحرارتها المعهودة، يستنشقون هواءها بعمق .. واستقبلوا أضواءها الحانية، وإشاراتها العذبة المنهمرة نحوهم بغزارة. كانت مزيجاً من حب جميل، عاطفة متأججة، وحزن نبيل على أحلام مغتالة، وأخرى لا تتوقف.. وتحلم مثلهم بالأجمل، وهي حتماً تستحقه..وهُم.
تتدفق من مكان ما من ذاكرتهم، أو ذاكرة المدينة، بصوت ينساب عذوبة كعذوبة البحر في أضواء الليل، أغنية المطرب الشهير «رالف ماكتل»:
«دعني أمسك بيديك
وأريك لندن في الليل
ولا تقل إنك تشعر بالوحدة!»
صنعاء 19 أكتوبر 2008م
كان جنود النقطة منهمكين في تفتيش السيارات، والركاب المنتظرين بفارغ الصبر.
لبس العسكري وجهه الصارم، كانت بندقيته الرشاش تتدلى من كتفه، ويرتدي بذلة كتلك التي لجنود الصاعقة، وينتعل حذاءين ثقيلين، ويعتمر خوذة حديدية لا تناسب صيف عدن الحارق.
يلتهم وجوههم بعينين شرستين. كانوا ستة بما في ذلك صديقهم السائق، متشابهين في الوداعة، وسماع الموسيقى والأغاني، ويتشاركون الاهتمامات والأحلام والوجع!
بالصرامة التي لبسها يسألهم إن كانوا يحملون سلاحاً؟
يجيبون بالنفي.
يلفت انتباهه «العود» النائم في حضن أحد الركاب الثلاثة في المقعد الخلفي.
بالصرامة نفسها يسألهم:
- ماهذا ؟
كان الراكب وهو فنان معروف، يحتضن عودة بحنان ملحوظ، لم يقرأ في عيني العسكري، وسؤاله، سوى نوع من الغباء المستحكم، أو الاستفزاز المتعمد!
يكبت ضحكة كادت تفلت منه، ويكتم غضباً كاد ينفجر به.
يجيبه:
- عود!!!
وضمه إلى صدره بحنان من يحتضن فلذته.
وهذه المرة لم ينس أن يستبدل الضحكة بابتسامة ساخرة، لم يلحظها العسكري، أو أنه تجاهلها حتى لا يتهم بالغباء!
يستبد السؤال عن السلاح والعود، بالسؤال عن المكان الذي قدموا منه؟ ويفشل في إخفاء نظرة عدائية تنهمر من عينيه بغزارة.
- من لحج.
هكذا أخبروه.
ولن يخبروه، أنهم قضوا عدة ساعات رائعة، في «بستان» بدعوة من صديقهم المخرج التلفزيوني. خشوا أن يسألهم عن اسمه، وموقع البستان، فلم يجدوا ضرورة لإعلامه.
لم يقولوا له أنهم قضوا أجمل ساعات العمر يغنون، ويضحكون، ويصافحون بأرواحهم قبل عيونهم أشجار الفواكه، وخضرة الأشجار، وزقزقة العصافير، وفي تجاذب الأحاديث عن لحج الخضيرة وروائع القمندان، وتتغلغل فيهم روائحها.
ولم يقولوا له أنهم خلال ذلك، دفنوا كآبة الجدران، وحزن السنين، وقتامة الحاضر، دون أن يشعروا بمرور الوقت، أو ينسوا الحلم بالمستقبل. وكانوا سيكونون بحال أفضل لولا إشارته الغبية بالتوقف، وأفضل كثيراً لو لم تكن هذه النقطة موجودة، ليدخلوا إلى مدينتهم دون توقيف، أو تفتيش!
يحشر العسكري رأسه ، ونصف جسمه الأعلى في فتحة النافذة الأمامية ، حيث يجلس السائق.
يلتهم بعينيه أرجاءها، ويتفحص بنهم السائق والراكبين إلى جانبه، لكنه لم يسألهم عن هوياتهم، بل يدس يده في أكياسهم بحثاً عن سلاح، لايجد فيها سوى بقايا القات، وقناني ماء، ومشروبات غازية... شربوا أكثر من نصفها!
بنفس التجهم والوجه العابس الذي ارتداه، يحشر رأسه في النافذة الخلفية وفي وجوه الركاب في المقعد الخلفي..
يأمرهم بالنزول من السيارة.
ينزل الفنان محتضناً عوده!
وينزل الراكبان الآخران حاملين أكياسهما (النايلون)..
يفتشها العسكري فلا يجد فيها أيضاً سوى بقايا القات، وقناني الماء والمشروبات الغازية..
تزداد خيبة أمله، يفتش «الكابينة»، المقاعد حيث كانوا يجلسون، ولا ينسى أن يفتش مواقع أقدامهم.. والبحث في أي مكان قد تكون فيها ثغرة، يمكن تخبئة سلاح فيها ..
يقرأون في عينيه، وطريقة تصرفه نظرة عدائية لم يكونوا يعرفون سببها، فقد كانوا مواطنين مسالمين، لا علاقة لهم بالسلاح ولا بالإرهاب! وكان في نشوة البزة العسكرية، والبندقية المتدلية من كتفه، والسلطة الممنوحة له، والتعبئة الخاطئة بأن كل من لا يرتدي «الميري» عدو حتى يثبت العكس!
يأمر الراكبين في الأمام بالنزول.. لاتزال له نفس النبرة العنجهية، والنظر العدائية المستفزة، ويعيد تفتيشهما مجدداً..
يحشر رأسه ونصف جدعه الأعلى من جديد، ويعيد تفتيش ما سبق أن فتشه قبل قليل.
يعيد فتح «الخانة» أسفل الطبلون، وحيث دس أنفه وعينيه تنهمر عليه وجوه ضاحكة، مشهورة، مألوفة، وهادئة للمرشدي، وأحمد قاسم، ومحمد سعد عبدالله، واسكندر ثابت، وفيصل علوي، وفيروز، وعبدالوهاب، والزيدي. لم يكن أحدهم بلحية أو يحمل سلاحاً، أو له وجه إرهابي، فأصيب ما يشبه بخيبة الأمل!
لم يسألهم من هؤلاء، ولا ماذا يفعلون، ولا عن سبب وجودهم في سيارتهم، لكن مزاجه تحول إلى مزاج عكر أكثر من السابق، فألبس وجهه صرامة جديدة، وازدادت عصبيته، كالذين يشعرون بالفشل عندما لا يجدون ما يبحثون عنه.
يزيده غيظاً صوت أحمد قاسم، رأى صورته قبل قليل دون أن يعرف من يكون.. ولا ماذا يفعل في خانة السيارة مع أولئك الرجال والبنات!
لكن صوت غنائه كان يغيظه..
كان ينساب من المسجلة التي تركها صديقهم السائق في وضع التشغيل، ويغني أغنية عذبة، ويهديها إلى أرواحهم - ويهدونها بدورهم إلى روحه.
مات، أو قتل قبل (15 عاماً) في حادث مروري عندما كان عائداً من صنعاء إلى عدن! وشكل موته حزناً خاصاً في كل قلب، وبكته المدينة كما تبكي الأم ابنها، بمشهد وداع حزين ودموع، لكنها لم تنسه. لا يزال حياً بفنه، وموسيقاه، وأغانيه، في قلبها، وقلوب الناس.
غني للحرية والحب والوطن كما غنى لها محمد سعد عبدالله والزيدي واسكندر ثاب وسواهم، عاشوا وماتوا فظفر الناس بالحرية والاستقلال، ونسوا أسماء المقاتلين، والعديد من الشهداء، وحتى أسماء الزعماء الذين حكموهم، لكنهم لم ينسوا شعراءهم وفنانيهم.. بقي أثرهم في مشاعرهم الوطنية بنفس القدر في مشاعرهم العاطفية ووجدانهم الإنساني، وسيبقى.
العسكري لا يتقن سوى الصرامة، ووجهه العابس الذي ارتداه والتفتيش في أي مكان.. عن سلاح جريمة..
يتلمس طبلون السيارة، يزيح قطعة القماش المزركشة ذات اللون البني التي تغطيه، والتي وضعت لحماية مقدمة السيارة من صيف عدن الحارق.
تصطدم أصابعه بصلابة الحديد!
ينظرون إليه في دهشة:«ماذا كان يتوقع أن يجد هنا غير حديد السيارة؟..» يتململون، يحاولون الحفاظ على هدوئهم، حتى لا يستفزوا العسكري أكثر مما هو مستفز.
وما دهشوا له أجاب عنه «الزبيري» قبل أكثر من نصف قرن، وكانوا يعرفون ويحفظون بيته الشهير:«العسكري بليدٌ، للأذى فطنٌ، كأن إبليس للطغيان رباه»! ذهب الإمام ومات.. واستشهد الزبيري، وبقي العُكفي! كانوا يرونه أمامهم في تلك اللحظة بشحمه، ولحمه، ودمه!
بطريقة ما تسكن كهرباء العسكري.
يأمرهم بنفس الصرامة والشراسة، العودة إلى سيارتهم.. يعطي إشارة التحرك للسائق.
تنطلق بهم..
يرسل أحمد قاسم صوته العذب المكبوت، هادراً قوياً بعد أن رفع صديقهم مؤشر الصوت عالياً.
يستعيدون بعض النشوة، وبعض الحرية التي افتقدوها في نقطة التفتيش..
كانت عدن تفتح صدرها لهم بحرارتها المعهودة، يستنشقون هواءها بعمق .. واستقبلوا أضواءها الحانية، وإشاراتها العذبة المنهمرة نحوهم بغزارة. كانت مزيجاً من حب جميل، عاطفة متأججة، وحزن نبيل على أحلام مغتالة، وأخرى لا تتوقف.. وتحلم مثلهم بالأجمل، وهي حتماً تستحقه..وهُم.
تتدفق من مكان ما من ذاكرتهم، أو ذاكرة المدينة، بصوت ينساب عذوبة كعذوبة البحر في أضواء الليل، أغنية المطرب الشهير «رالف ماكتل»:
«دعني أمسك بيديك
وأريك لندن في الليل
ولا تقل إنك تشعر بالوحدة!»
صنعاء 19 أكتوبر 2008م