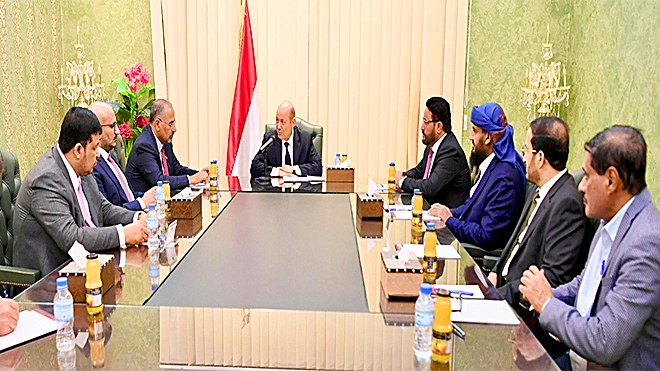كان اختراق الهواتف هو القاعدة لا الاستثناء. عرفت الشرطة ذلك في وقته، لكنها لم تفعل شيئاً حيال الأمر. لكن أحد الضحايا الآخرين للاختراق، وهو جوردون تايلور، المدير التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم، التجأ للقضاء، وكان يحاول اكتشاف من عرف بذلك الأمر، ومتى عرف به. ما عدد الضحايا الذين نتكلم عنهم هنا؟ التقى نِك شخصية بارزة في الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد). وكان الجواب: العدد يقدر بالآلاف. لذا، فلم يكن غودمان مجرد ثمرة فاسدة.
عرضت الصحيفة التي هزها هذا الإجراء القانوني، أن تدفع لتايلور مبلغاً ضخماً هو 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 520 ألف دولار أميركي) بالإضافة إلى النفقات التي بلغت 300 ألف يورو (حوالي 390 ألف دولار أميركي). وهكذا فإنَّ الشركة بهذا المبلغ بالإضافة إلى دفع المال لزملاء تايلور كانت تعرض ما لا يقل عن مليون جنيه إسترليني (حوالي مليون و300 ألف دولار أميركي) لدفع هذا الإجراء القانوني. وقد أُخبر نِك أنَّ ضحايا الاختراق تضمنوا نائب رئيس الوزراء، جون بريسكوت. وتورط في هذا الأمر عشرات من صحفيي نيوز أوف ذا وورلد وموظفيها. وكان لدى نِك إمكانية الوصول إلى رسائل إلكترونية تفيد بأنَّ صحفيين ومحررين (مذكورين بالاسم) في نيوز أوف ذا وورلد ناقشوا ما ورد في 35 رسالة صوتية تم اختراقها.
وهكذا فقد مُزقت حجة «الصحفي المارق» إرباً. وبحسب مصادر نِك، فقد وافق على هذه الصفقة جيمس موردوخ، ابن روبرت ورئيس شركة نيوز إنترناشيونال، على دفع ثمن الإسكات، وأغلقت وثائق المحكمة. لو كان نِك على صواب، فإنَّ أكبر المديرين التنفيذيين لمردوخ في المملكة المتحدة قد وافق على دفع مليون جنيه إسترليني (حوالي مليون و300 ألف دولار أميركي) للتستر على سلوك إجرامي في شركته.
كانت هذه قصة رهيبة. وكانت عملية مردوخ، بشكل إجمالي، قاسية. لو جرحت الشركة فحسب، فسوف تسعى للقضاء عليك. كنا نعرف بالفعل أنَّ الشرطة، لأسباب معروفة لهم وحدهم، لن يريدوا التورط في هذا الأمر. لن يكون لنا الكثير من الأصدقاء من السياسيين أو بقية الصحافة. سوف نكون بمفردنا. بدأت قصتنا في منتصف يوم الأربعاء الـ8 من شهر يوليو 2009. فصلت القصة مؤامرة التستر على سلوك إجرامي. وورطت المتحدث الرسمي باسم زعيم المحافظين. واتهمت المديرين التنفيذيين لمردوخ بتضليل البرلمان. وأشارت بأصابع الاتهام إلى مراقب الصحافة وتساءلت عن سبب تجاهل الشرطة لهذا الأمر. أظهرت الصحافة البريطانية اهتماماً خفيفاً فحسب بهذه القصة. أصدرت نيوز إنترناشونال بياناً من ثلاث صفحات انتقدت فيه عملنا بشدة وبرأت فيه نفسها. كان قسم العلاقات العامة للشركة يعمل وقتاً إضافياً في وستمنسر.
قالوا إنَّ جميع هذه الادعاءات كاذبة. كتبت ريبيكا بروكس إلى رئيس اللجنة المختارة قائلة إنّنا قد ضللنا الرأي العام البريطاني عامدين. ونشرت التايمز مقالاً لضابط سابق في الشرطة البريطانية (يعمل الآن لدى مردوخ) صب فيه الماء البارد على قصة الغارديان. وأعيد طبع هذه القصة في الصحيفة الشقيقة، ذا نيوز أوف ذا وورلد، في صفحة تحريرية كاملة تهاجمنا. كان هذا درساً في «كيف ترد منظمة مردوخ». وقد وعد مدير تنفيذي كبير في صحيفة ذا صن، لاحقاً، باستخدام صفحات الصنداي تايمز ليظهر كيف أنني «أكبر منافق لعين في العالم».
بدا لو أنَّ عناوين هذه الصحف الشقيقة يمكن أن تستبدل لاستخدامها في استهداف أي شخص يمتلك جرأة الهجوم على المنظمة. بدا كما لو أنَّ منظمة صحف مردوخ في المملكة المتحدة بأكملها قد جرى حشدها لتكذيب الخبر والترويج للأخبار الكاذبة على أنها الحقيقة. وخلال العامين التاليين، جرى الدفاع عن تقاريرنا بالتدريج وبشكل مؤلم. وفي الـ15 من شهر يوليو 2011، استقالت بروكس من نيوز إنترناشيونال.
كانت هاتان السنتان اللتان تطلبهما الأمر لرد غضب صحافة مردوخ ولإثبات أنَّ نِك كان على صواب، سنتين من الوحدة. حين يعيش المرء في ديمقراطية فإنه يفترض أنَّ ثمة العديد من الضوابط والموازين لمنع أصحاب النفوذ من ارتكاب أفعال ملتوية.
وللمرة الأولى في حياتي الراشدة، شككت في أن هذا الأمر ينطبق على بريطانيا. كنا قد عرضنا دليلاً قوياً على وجود مؤامرة إجرامية في واحدة من أقوى شركات الإعلام في العالم، لكن لم يرد أحد أن يعرف. لا البوليس. ولا المراقب. ولا البرلمان، على الأقل في البداية. ولا الصحافة البريطانية. في نهاية المطاف، وجدت الشركة نفسها في المحاكمة- أو على الأقل، تحت الوهج القاسي للتحقيق القضائي- وبدأ تحقيق ليفنسون في ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة البريطانية، التحقيق الذي مثّل استجابة الحكومة البريطانية لتقرير نك ديفيز، وقد بدأ التحقيق في الـ14 من شهر نوفمبر2011.
كان التحقيق المكون من جزأين قد بدأه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في أعقاب اكتشافات القرصنة على الهاتف. وحتى هذه اللحظة، كانت الصحافة البريطانية تمول جهازها التنظيمي الذاتي بنفسها، وهو «لجنة الشكاوى الصحفية». وقد دافعت الصحافة البريطانية عن هذه المنظمة معتبرين إياها صارمة ودقيقة، حتى شهر يوليو2011، عندما اعترف قدامى المحررين أنَّ المنظمة بلا سلطات في النهاية، وأنه ينبغي استبدالها بشيء أقوى وأكثر صرامة. لكن كان ثمة قضية ينبغي الإجابة عنها. فالإجرام غير المُراقب داخل غرف الأخبار كان كارثة أخلاقية للصحافة البريطانية ودورها في ديمقراطيتنا. كانت مثل فضائح EnronوVolkswagonوDeepwater، كانت بمثابة أزمة رهن عقاري الخاصة بنا. كان من المحزن أن نشاهد بعض الزملاء ينسحبون إلى المخابئ ويستخدمون صفحات التنمر خاصتهم لإنهاء جدل من خلال الهجوم العنيف على أي شخص يعرض حتى المساعدة البناءة لإعادة بناء الثقة في الصحافة. كرهتُ التهديدات والإساءة الموجهة إلى أي شخص كان يجرؤ على الاعتراض. كانت الاستجابة الأولية لليفنسون، في الحقيقة، مدروسة. وبدا عموماً، أنَّ ثمة شعوراً بالارتياح أننا قد نجحنا في الإفلات نسبياً.
لكنَّ بعض التبعات جرى التعامل معها بسوء كامل، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للصحافة البريطانية لكي تتحد وتهاجم، فرفضت بمرارة حتى المحاولات الأصدق نية والرامية إلى شكل أكثر مصداقية من التنظيم المستقل. إنَّ ازدرائهم الشديد للـ»نخبة اللبرالية» أو مفهومهم المفترض للـ»مصلحة العامة» كان الجانب المر لحروب ثقافية أعمق. لكن ليفنسون وتداعياتها قد أوضحت كيف أنَّ معظم الارتباك، أو بشكل أكثر دقة الخلاف المباشر، موجود الآن حول طبيعة وغرض ما فعلناه. لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أنه لم يكن ثمة اتفاق واضح حول دور الصحافة في المصلحة العامة. وظفت صحيفة The Daily Mail الكثير من الصحفيين البارزين، لكنَّ الروح التحريرية القاسية والمؤلمة أحياناً لتلك الصحيفة لم يكن لديها الكثير من القواسم المشتركة مع هيئة BBC أو صحيفة The Financial Times، مثلها في ذلك مثل Fox News التي لا تجمعها قواسمٌ مشتركة مع New York Times أو Washington Post. حتى بين أوساط ما يسمى بمنظمات تراث الصحافة، كان ثمة تباين حاد في الموقف حول ما ينبغي للصحافة أن تكونه أو ما يمكن لها أن تكونه. وقلما يمر أسبوع دون هجوم شديد من صحيفة The Daily Mail على المعايير أو الروح التحريرية لـBBC. ودورياً، يوبخ مُحرِّر The Daily Mail صحيفة The Guardian أو القناة الرابعة أو Financial Times، إما بشكل شخصي، أو دون ذكر أسماء أو عبر وكلاء.
لم يكن ثمة وميض من السخرية او التواضع في نظر الصحيفة الأكثر تعرّضاً للشكوى (1214 شكوى للجنة شكاوى الصحافة عام 2013) وهي تزدري أكثر المنظمات الإخبارية ثقة في البلاد (حظيت Financial Times على 7 شكاوى للجنة شكاوى الصحافة عام 2013).
إنَّ غضب الكبار من تحقيق ليفنسون تخفى في دعوات كوبيت أو سويفت لكن بدا أنه ليس ثمة الكثير مما يقترحه ليفنسون نفسه في ذلك الوقت- في مقابل التشاحن السقيم الذي تلاه- والذي قيّد أي تعليق قوي أو تحقيق في أمور ذات أهمية أصيلة للجمهور.
فما الذي كانوا يخشون منه إذن؟ إنَّ الغضب الحقيقي، وهو أيضاً ظاهر في شجب اختصاص المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالخصوصية، كان الغضب الحقيق منصباً على القضاة الذين وقفوا في طريق هذه الصحف في سعيها للربح جراء نشر الفضائح الجنسية. لدى الصحافة الصفراء نموذج تجاري ينطوي، جزئياً، على التدخل في خصوصية الناس في نظر العامة.
ومقارنة بنماذج تجارية أخرى، فإنَّ هذا لا يعد نموذجاً سيئاً. ذلك أنَّ شهية الجمهور للفضائح تفوق شهيته لتغطية أخبار السياسة. إن لم تنشر عن الفساد والجنس فلن يقرأ أحد عن ويستمينستر. هذه هي حجتهم. لكن كان من الصعب ألا نتعجَّب من كل هذا الغضب المُثار. هل كان الفريق التحريري لصحيفة The Sun خالياً من «الغسيل القذر» أو «السلوكيات الرخيصة» أكثر من أي غرفة أخبار أخرى؟ إنَّ الصحفيين- وحتى بعض المُلَّاك- لم يكونوا معروفين بعيش حياة القديسين، أكثر من لاعبي كرة القدم. هل كان الأمر مهماً؟ يمكن لصحيفتيّ The Sun وThe Daily Mail بالطبع أن يكون لهما أولوياتهما الاقتصادية وأخلاقياتهما، ويمكن للنيويورك تايمز والفاينانشيال تايمز أن يكون لهما ذلك أيضاً. وكذا فوكس نيوز وبي بي سي.
فالأمر كله «صحافة». يمكننا تدبير أمورنا في تعايش سلمي. كانت هذه هي الطريقة التي اعتادت بها الأمور أن تسير، في زمن ألطف قبل أن تبدأ الصحف باستخدام تقنيات الشرطة السرية للتجسس على أهدافها. لكنَّ الصحافة الآن تواجه خطراً اقتصادياً وجودياً في صورة إعادة تقييم غاضبة لمكاننا في العالم. وعلى كلا الجانبين من الجدل الذي يزداد خشونة حول الإعلام والسياسة والديمقراطية، ثمة تردد حول ما إذا كانت لا تزال ثمة فكرة مشتركة لما تعنيه الصحافة، وسبب أهميتها. في الثالث من شهر ديسمبر 2013، قدمت إلى قاعة لجان برلمانية في وستمنستر للدفاع عن الصحافة.
لم يكن ذلك محاكمة، لكنها بدت كما لو كانت كذلك. في الغرفة المجاورة كان اثنان من أبرز ضباط الشرطة في البلاد ينتظران، وكانا يحققان فيما إذا كان ينبغي محاكمتي. كان بعض الأعضاء المحافظين في اللجنة عازمين على سحب اعترافات مني وكنت متأكداً أنهم سوف يحبون رؤيتي في السجن. نظرياً، كانت لجنة الشؤون الداخلية تنظر في مكافحة الإرهاب.
لكنهم في ذلك اليوم كانوا يريدون أن يعرفوا عن إدوارد سنودن، العميل السابق بوكالة الأمن القومية الأميركية الذي سرّب للغارديان وصحفٍ أخرى وثائق فائقة السرية من وكالة الأمن القومي الأميركية ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، تكشف عن مدى أنشطة مراقبة الدولة للمواطنين. لم يحدث مثل هذا التسريب من قبل قط. كان رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية، الدبلوماسي اللبق السابق السير جون ساورز قد أخبر أعضاء البرلمان أنَّ خصوم بريطانيا كانوا «يفركون أيديهم سعادة. والقاعدة على وشك الفوز».
بل كانت بعض الصحف معادية لنشرها بشكل علني. وكتب مُحرِّر سابق في إحدى الصحف الكبرى أنَّ الصحف ليس لها الحق في تحديد المصلحة العامة عندما يتعلق الأمر بالأمن. وقال أحد كتاب الإيكونوميست إنه كان سيسلم سنودن للشرطة لو كان قد أحضر هذه القصة له.
مرة أخرى، لم تتفق الصحافة البريطانية على معنى المصلحة العامة. لم يبدُ أعضاء البرلمان الجالسون أمامي على شكل نصف دائرة، في المجمل، ودودين. كنت وحدي. افتتح رئيس اللجنة، عضو البرلمان المُتمرِّد عن حزب العمال، كيث فاز، الأسئلة. كان «فاز» سليل عائلة من غوان وقد استقر في إنكلترا عندما كان بعمر السادسة بعد فترة قضاها في عدن. لم يمض وقت طويل قبل أن يلقي فاز ما بدا كأنه قذيفة في اتجاهي. قال: «ولد كلانا خارج هذا البلد، لكنني أحب هذا البلد. هل تحبها أنت؟».
لجزء من الثانية كنت عاجزاً عن الكلام. أفقت لأقول إنَّ وطنيتي متجذرة في فكرة أنَّ بريطانيا تسمح بصحافة حرة يمكنها الكتابة عن هذه الأمور. كانت هناك بلدان تخبر الأجهزة الأمنية فيها المُحرِّرين بما يمكنهم الكتابة عنه وما لا يمكنهم. هذه الدول ليست ديمقراطيات. كنت فخوراً لأنني أعيش في دولة لم يكن هذا سلوكها. إذا لم يكن بإمكان الصحفيين الاتفاق على فكرة مشتركة للمصلحة العامة- عن الخدمة العامة التي نزعم أننا نقدمها- فإنَّ ذلك يعقد الدفاع عما نفعله. وفي عصر الإعلام الجماهيري الحر الأفقي، من الأكثر أهمية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تحديد قيمنا، وغايتنا واستقلالنا وإعلانها. وهو ما يشمل الاستقلال عن الدولة.
لكن بعد خمس سنوات من اكتشافات سنودن، من الواضح الآن أنَّ الدول أنفسها تعاني من الاضطراب الرقمي الذي مزق في البداية وسائل الإعلام الراسخة وهو يعيد الآن صياغة السياسة.
إنَّ الشركات الرقمية العملاقة لم تطلق العنان لفوضى المعلومات فحسب، بل إنها أصبحت، في غمضة عين، أقوى المنظمات التي شهدها العالم على الإطلاق. إنَّ كلمة «العامة» بالنسبة لبعض الناس في القرن الـ21، كلمة صعبة. إننا نقدر الخدمات العامة، والمساحة العامة والسلع العامة لكننا أحياناً ما نكافح لمعرفة كيفية مناقشتها، أو إنشائها، أو إدارتها أو تمويلها أو تنظيمها أو دعمها أو قياسها. نتكلَّم عن المنافع العامة و«المصلحة العامة» دون أن نعرفها قط تعريفاً مُرضياً.
لكن كيف يمكن أن نقيس أو نقيم مثل هذه البضاعة العامة في وقت «أصبحت فيه الأسواق، وقيم السوق، تحكم حياتنا كما لم يحدث قط من قبل … تترك الأسواق أثرها.
أحياناً، تدفع قيمُ السوق قيماً غير سوقية جديرة بالاهتمام»، وذلك بحسب الفيلسوف السياسي مايكل ساندل. قبل عقد من الزمان، كان هذا الكلام عن الأخبار بهذه الطريقة من شأنه أن يُرفض بصفته شكوى الليبراليين- الـ«تابعون» المحتقرون الذين لم يكونوا تجاريين بما يكفي لإنتاج صحافة مناسبة يريد الجمهور قراءتها (كما زعم جيمس مردوخ عام 2009 «إنَّ الضامن الوحيد المعتمد والمستمر والدائم للاستقلالية هو الربح»). لكن الآن، في مواجهة النطاق الواسع والشعبية والقوة التجارية الهائلة لجبابرة وادي السليكون، ثمة صرخة عبر الإعلام ضد الفوضى التي ألحقتها الأسواق الحرة بالصحافة التقليدية.
لكن التحديات لم تكن قط بمثل هذا الإلحاح: فنحن بحاجة إلى العمل الصحفي الأساسي، أن تكون الصحافة صرخة ينبغي لها أن تُفرِّق، بأعلى صوت، بين الحقائق والأكاذيب.
*صحفي بريطاني ورئيس صحيفة The Guardian البريطانية في الفترة من 1995 إلى 2015.