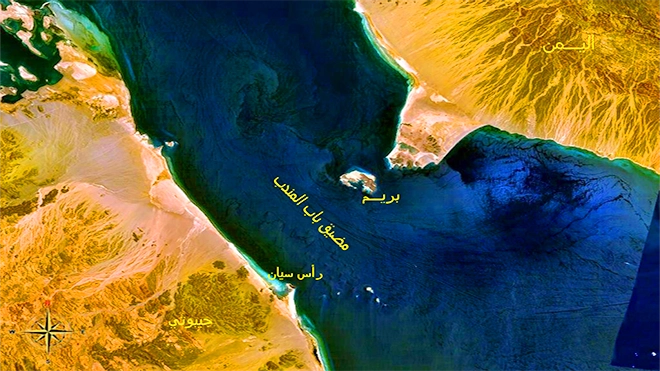> نبيل عودة
دأب السلطان دائماً على استئجار قرائح الشعراء، وكيف لا؟ والشعر هو الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارا في عالم العرب في وقت قلَّ من يعرف القراءة والكتابة، ولم تتغير الحال في وقتنا، ازداد عدد من يعرفون القراءة والكتابة، ولكن القراءة صارت من أقل الكماليات ضرورة لحياة العرب، أي لم يتغير الحال وظل الرواة والمحدثون من مروجي الحكايات الشعرية والغيبيات والخرافات والخوارق هم وسائل إعلام المجتمع.
حمل الشعر في وقته، الحكايات والأحداث، حسب مفاهيم ذلك العصر، وكان إما شعراً هجائياً أو مديحاً إما إذلالاً أو تكريماً، أما حباً أو كراهية.. أو بطولات أسطورية، ومازلنا في نفس الساحة لم يتغير فينا إلا وسائل تنقلنا ونوع مساكننا، وأنواع أكلنا.
بالطبع السلاطين العرب ازدادوا عدداً وأشكالاً وتعددت مناصبهم طولاً وعرضاً، وارتفاعاً وانخفاضاً، وكثر الطلب على الدلالين والمداحين ومنظمي الكلام. وبما أن الشعر والشعراء هما أشهر ما تبقى في الذاكرة من موروثات تاريخ "الأمجاد العربية"، لذا طمع السلاطين بحشد الشعراء في صفوف "السحيجة "، أرادوا إخضاعهم لسلطانهم (بصفتهم حافظوا على مكانتهم كأهم وسيلة إعلامية إلى جانب الدعاة والشيوخ الأجلاء، في مجتمع سماعي يرفض استعمال كماليات القراءة)، فاستأجروا قرائح الشعراء وذممهم، بصفتهم ممثلي الإعلام الشعبي، بعد ضمان الإعلام الإلهي بإعلانهم الرسمي المتكرر أسبوعياً بالورع وطاعة الله وتقديم قرابين الدولارات، وبصفتهم أولي أمره في دولهم وأحزابهم وقبائلهم.
ومع ذلك، تاريخنا يحدثنا عن شعراء لم يخونوا كرامة الكلمة وكرامتهم، وكان مصيرهم الجوع والعوز أو الموت بسيف سياف السلطان.
ويبدو أن الحال لم يتغير في بلاد العرب وفي بلادنا، فما زال الشعر مزايدة تهدف إلى احتلال المكانة في رأس الصف، والحصول على المراد بالموهبة والحق، وهو مجد ما بعده مجد، وتذكرة تسمح بالصولان والجولان في دنيا السلاطين ودنيانا كلها سلاطين.. من السلطان الكبير ووريثه حتى سلاطين الأحزاب والتنظيمات القومية والإلهية.
قرأت للكاتب العراقي الساخر خالد القشطيني مقطوعة عن معاناة الشاعر العراقي معروف الرصافي الذي تمسك بالوطنية والصدق ورفض كيل المدائح الشعرية للملك فيصل في العراق وزلمه أمثال نوري السعيد.. فجاع، ولولا الجيران والأصحاب لمات جوعاً.
الرصافي اختار الموت معوزاً جائعاً على الموت في بحبوبة السلطان، وكان معروف الرصافي يستدين من بقالة في الأعظمية لشخص اسمه جمعة العطار، ولكنه يعجز عن سداد دينه، حتى قرر جمعة العطار وقف تزويد الشاعر بما يسد رمقه، حتى يسد ما تراكم عليه من ديون. ولكن من أين للرصافي أن يسد ديونه المتراكمة، وهو يرفض الخضوع لسلطان زمانه، الملك فيصل، ويمدحه بغير وجه حق؟! فما كان من الرصافي إلا أن كتب بيتين من الشعر يُنفس فيهما عن مشاعره، على الظلم والتعسف الذي لحقه من جمعة العطا، الذي ربما رأى فيه سياف السلطان، الذي يقطع الرؤوس بالجوع، وهي تكنلوجيا حديثة ابتكرها العرب، ولم يحصل مبتكرها على "نوبل"، ولو كان مبتكرها يهودياً لجاء نوبل من قبره ليقدم الجائزة المرجوة.
قال الرصافي:
عجبت لأهل الأعظمية كيف لا يرضون جيرة جمعة العطارجاورته زمناً وكان جواره في منتهى الإنصاف شر جوار
ولكن جمعة العطار لم يتراجع عن موقفه.. ومات الشاعر فقيراً معوزاً جائعاً، ولم يخن كرامته الوطنية ومصداقيته.. وخلد في شعره جمعة العطار، قاطع الرقاب بالجوع..
واليوم أصبح الكثير من الشعراء بغنى عن جمعة العطار وتحكمه، ولكنهم أكثر بعداً عن الرصافي واعتزازه بنفسه وأدبه.
أخرسوا حين كان شعبنا يدفع ثمناً رهيباً بحريته وبلقمة خبزه.
أقنعوا "جمعة العطار" الملأى رفوف دكاكينه بما لذ وطاب من نعم، بأنهم نعم الزبائن.. فابشروا وانشروا تفاهاتكم، ما تزال جوارير السلاطين الصامدين ملأى بالدولار واليورو والشيكل.
أين من ينشر ويكتب اليوم من التحدي السياسي الوطني مثل: "سجل أنا عربي" التي أطلقها محمود درويش و"سجل اسمي في القائمة السوداء" التي أطلقها سالم جبران، في ظل أشرس هجمة للسلطة الصهيونية الغاشمة لتقييد حرية الحركة للأدباء والمناضلين الشرفاء بإقامات جبرية هي أشبه بسجن داخل حدود بلدات ضيقة.. على الذين وقفوا بصدورهم المتحدية، وأكفهم العارية يتحدون بطشها وعنصريتها، ضد الذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً، وما لأي بطش أن يكسر
عزيمتهم وإصرارهم على حقوقهم وحريتهم؟
لم يكسرهم تعسف السلطان، وإغلاق جمعة العطار (الصهيوني) أبواب سد الرمق أمامهم وأمام أطفالهم.شعراؤنا ومثقفونا ومناضلونا وشبابنا وشيوخنا ونساؤنا ورجالنا لم يهادنوا السلطان حتى في أحلك أيامه وأكثرها سطوة وتعسف، ونحن مجرد أقلية فقدت وطنها، وتعلمت أن لا تحلم بنخوة السلاطين لنجدتها وأن تعتمد على ذراعها وقدراتها، وفقدت تواصلها القومي مع الشعوب العربية، التي قهرها سلاطينها بالفقر والإرهاب.
كانت طليعة مناضلة هي توائم لمعروف الرصافي، واجهت وأفشلت بأجسادها، مؤامرة الطرد من الوطن، حين كان المتنعمون اليوم "يقرفصون" على عتبة السلطان. أين هم من شعراء صلبوا في الزنازين (توفيق زياد، صلب في سجن طبريا لإصراره على التظاهر في أول أيار 1958) وشتتوا بالسجون والمنافي؟! أين هم اليوم من مثقفين لم يرضوا حتى بالصمت، وجاهروا بمواقفهم وطردوا من التعليم ومن العمل، وضيقوا مصادر الرزق عليهم، ولم يشتروا رضا السلطان حتى بكلمة كاذبة.
حتى اللغة فقدت قيمتها.. لا أهمية لما تنشر، المهم أن تضبط قواعد اللغة وتملأ صياغاتك بياض الجريدة أو صفحات الكتب.
والويل إذا ألقي القبض على خطأ لغوي.. مسموح لك أن تخطئ في استقامتك، أن تخطئ في مصداقيتك، أن تخطئ في شرفك، أن تخطئ في وطنيتك، أن تخطئ في مدح السلطان، أن تبيع نفسك ببعض الفضة، ببعض الشواقل، ولكن الويل إذا أخطأت بتشكيل آخر الكلمة.
الذين لا شعر أو نثر فيما ينشرون، ولا معنى لما يكتبون، وبلا لغة مفهومة.. فما قيمة اللغة عندما تصبح كلمات لا معنى لها، كيفما قرأتها من فوق إلى تحت أو بالعكس لا يتغير المعنى، ويجب أن تقر رغما عنك، أنك أمام مبدع طال انتظارنا له، أكثر من انتظار اليهود للمسيح.. المهم أن تضرب بسيف السلطان، مهما كانت مرتبته متدنية، أو مجموعة سلاطين إذا كنت عبقرياً، وسنسميك شاعراً وكاتباً وناقداً وأديباً عبقرياً وسياسياً وطنياً بعثياً ناصرياً وشيوعياً وحزبياً إلهياً ومفكراً عربياً في أحضان أمراء النفط ودولاراتهم، ومناضلاً لم يبدأ النضال والصمود إلا مع ظهوره وتجليه بعد أن صمت طويلا، وحين صار ضامنا للدخل من سلطان أو أكثر، تفتحت مواهبه الوطنية والإبداعية.
الشاعر الوطني جداً، على آخر العمر.. لا يفهم ما يكتب، فكيف يفهم القرّاء؟! كان السلطان يستأجر القرائح بالمال والخوف من سيف سيافه، فصار (السلطان) يستأجر القرائح بالألقاب والنشر والمدائح، والتصنيف الوطني.. بعد أن استتب أمن المعاش، وزال الخوف من المجاهرة بالرأي!.
هل الراي الذي يطرح بتفكير واختيار صعب للمعاني، للتحايل على قوانين السلطان، قيمته نفس قيمة الرأي الذي يقال بدون أي حساب وبدون أي تفكير وبدو ملابسات تعرضك للبطش السلطاني؟!
هناك شعراء قتلهم شعرهم، واليوم تقتل التفاهة الشعر، تقتل الأدب الجيد، تقتل المواقف، تقتل العقلانية، تقتل الفكر.. وتقتل اللغة، وتقتل الكرامة الشخصية، وتقتل رغبة القراءة لدى القراء.
أمنيات.. ولكن تجربتنا علمتنا أنه لا شيء مستحيل!