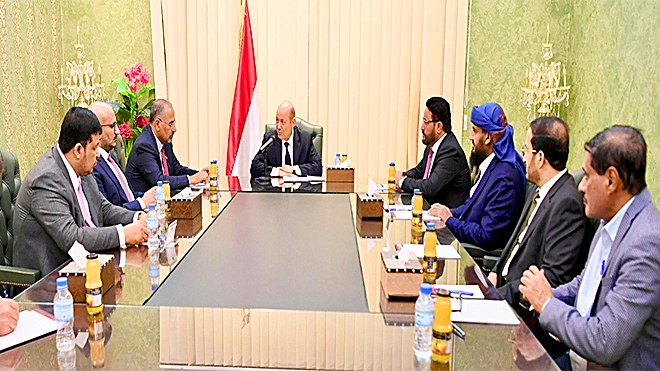> هشام ملحم
الانسحاب الأميركي الفوضوي والدموي من أفغانستان فاجأ القادة السياسيين والعسكريين الأميركيين، كما فاجأ حلفائهم وخصومهم في العالم، وأدى إلى جدل أميركي ودولي حول "دروس" أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، ومضاعفات الانسحاب على سمعة ومكانة وصدقية الولايات المتحدة كدولة عظمى وحليفة، واجهت في السنة الماضية زلزالًا سياسيًا داخليًا، تمثل في اجتياح عنيف لمبنى الكابيتول لا تزال تعاني من تردداته الخطيرة.
في الولايات المتحدة، وصف السياسيون من جمهوريين وديمقراطيين الانسحاب وعملية إجلاء الرعايا الأميركيين والأجانب من مطار كابول "بالكارثي" و "المهين"، وقارن المحللون ومن بينهم ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية "السقوط السريع لكابل يذّكرنا بالسقوط المهين لسايغون في 1975". ونشرت مقالات في الدوريات السياسية بعناوين مثل "نهاية الإمبراطورية" و "عودة الانعزالية" و "أميركا المتواضعة: نهاية النزعة العسكرية بعد هجمات سبتمبر 2001". الأوروبيون، الذين هزتهم صور الفوضى والعنف في كابول، وهم شركاء واشنطن في حربها الطويلة، أجمعوا على اعتبار الانسحاب السريع وفوضى عملية الجلاء على أنها نكسة تتخطى الولايات المتحدة، كما قال نوربرت روتغين "الضرر الذي حدث يطال الصدقية الأخلاقية والسياسية للغرب".
وعلى الرغم من اعتراف الرئيس بايدن بأن الانهيار السريع للجيش الأفغاني ومؤسسات الدولة الأخرى لم يكن متوقعًا، إلا أنه أصر على أن قراره بتنفيذ الانسحاب في موعده كان صائبًا، لأن الخيار الآخر كان إطالة حرب لا يؤيدها الشعب الأميركي واستمرت لعشرين سنة، ولن تتغير موازينها إذا استمرت لسنة أو سنتين أو أكثر.
هذا الجدل الراهن في الأوساط السياسية والعسكرية والأكاديمية الأميركية مرشح للاستمرار في السنوات المقبلة وقطعًا خلال ولاية الرئيس بايدن الذي يريد تركيز جهود وموارد الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية في منطقة شرق آسيا لردع واحتواء النفوذ الصيني في تلك المنطقة التي أصبحت المنطقة الجغرافية الأهم اقتصاديًا لواشنطن في العالم.
النقّاد الكثر للرئيس بايدن في الداخل والخارج طرحوا أسئلة مثل: كيف سينظر خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية لنكسة أفغانستان؟ وكيف سيتعامل مع مضاعفاتها السلبية أصدقاء وحلفاء واشنطن في أوروبا، والشرق الأوسط وشرق آسيا؟ وحتى في هذا الوقت المبكر بعد نكسة أفغانستان، بدأ المعلقون بالحديث عن مزاج أميركي انعزالي بعض الشيء مماثل كثيرًا للمزاج السياسي والشعبي في أعقاب ما سمي "متلازمة فيتنام" أو عقدة حرب فيتنام والتي هيمنت على الأوساط السياسية والعسكرية الأميركية ودفعت بالولايات المتحدة لتفادي التورط في حروب كبيرة ومكلفة.
التدخلات العسكرية التي عقبت الحرب في فيتنام مثل التدخل العسكري في لبنان وغرانادا والصومال وحتى حرب الخليج الأولى في 1991 والبلقان، كانت قصيرة وغير مكلفة كثيرًا للولايات المتحدة. في لبنان والصومال انسحبت القوات الأميركية بعد خسائر غبر مبررة في دول غير مهمة استراتيجيًا للولايات المتحدة. في العراق كان الانتصار العسكري حاسمًا وسريعًا، وفي البلقان نجح التدخل الأميركي في خلق استقرار سياسي مستمر منذ عقود.
الذين تحدثوا أو رحبوا بمتلازمة فيتنام وعقدة تلك الحرب المكلفة، فوجئوا أنه بعد كارثة فيتنام بستة عشر سنة حققت الولايات المتحدة انتصارًا تاريخيًا مذهلًا حين ساهمت حربها الباردة والطويلة ضد الاتحاد السوفياتي بانهياره التام دون إطلاق صاروخ واحد.
بعد نكسات الولايات المتحدة في لبنان والصومال، تساءل الكثير من المحللين والمعلقين كيف يمكن لمجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية محلية إرغام دولة عظمى على الانسحاب العسكري بعد تعرض قواتها لخسائر غير متوقعة وفي ظروف محرجة وحتى مهينة؟ ولكن الأسباب التي دفعت بالولايات المتحدة للتدخل العسكري في لبنان والصومال كانت إنسانية وسياسية آنية وليست استراتيجية: في لبنان توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين بعد تعرضهم للقتل الجماعي، وفي الصومال مساعدة قوات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من ادعاءات ومبالغات الرئيس رونالد ريجان حول أهمية لبنان في السياسة الأميركية، إلا أنه لم يتردد للحظة واحدة بسحب القوات الأميركية من بيروت بعد تفجير مقر المارينز والثمن البشري الفادح للتفجير، لأنه وغيره من المخططين الاستراتيجيين الأميركيين لم يضعوا لبنان ولو لثانية واحدة في خانة الدول المهمة استراتيجيًا للولايات المتحدة.
التقويم ذاته يسري على الصومال. (لا أزال أذكر تحليلات وشطحات بعض المعلقين العرب الذين رأوا في الإنزال الأميركي في الصومال عملية عسكرية تهدف إلى حماية باب المندب). في المقابل، احتلال العراق للكويت كان خطًا أحمر، لأن الكويت، وبعدها السعودية وبقية دول الخليج العربية كانت جوهرية للاقتصاد العالمي وهذا يعني أن واشنطن لن تسمح لدولة إقليمية عدوانية إن كانت العراق أو إيران بالتحكم بأسعار وأسواق النفط في العالم.
من الواضح أن الرئيس بايدن ومستشاريه ينظرون إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان من هذا المنظور. الأحكام السريعة حول الثمن السياسي والاستراتيجي الذي ستدفعه واشنطن لخروجها المحرج من أفغانستان سوف تبدو مع مرور بعض الوقت مبالغًا فيها كما كانت الأحكام والتقويمات الأولية لمضاعفات الانسحاب الأميركي من لبنان والصومال.
وهذا يضعنا الآن أمام الامتحان الذي تمثله الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة بين الصين من جهة وتايوان التي تدعمها واشنطن سياسيًا وتسلحها عسكريًا من جهة أخرى. الولايات المتحدة تعترف رسميًا بوجود دولة صينية ذات سيادة واحدة هي الصين، التي يحكمها منذ 1949 الحزب الشيوعي. طبعًا العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتشعبة بين الولايات المتحدة وتايوان، لا تشمل أي التزام أميركي رسمي أو غير رسمي بالدفاع العسكري عن تايوان في حال تعرضها لاجتياح صيني. طبعًا، أي اجتياح صيني شامل أو محدود لتايوان سوف يؤدي إلى أزمة خطيرة بين واشنطن وبيجين واحتجاجات دولية قوية، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى دخول الولايات المتحدة في حرب مع الصين لحماية أو إنقاذ تايوان.
رد الفعل الأميركي ضد الصين قد يكون قويًا أكثر من رد الفعل الأميركي ضد روسيا في أعقاب احتلالها وضمها لشبه جزيرة القرم وانتزاعها من أوكرانيا في 2014. صحيح أن عدد الأميركيين – في استطلاعات الرأي الأخيرة – الذين يؤيدون تدخل الولايات المتحدة عسكريًا لحماية تايوان يزداد، مع ازدياد التوتر مع الصين، ولكن المخططين الاستراتيجيين والسياسيين في واشنطن يدركون أن التورط في حرب مع الصين قرب حدودها وعلى بعد آلاف الأميال من الولايات المتحدة ليس خيارًا واقعيًا.
الولايات المتحدة ملتزمة منذ عقود بالدفاع عسكريًا عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي، (الناتو) وكوريا الجنوبية واليابان، ولكن لا توجد هناك التزامات مماثلة مع دول عديدة تربطها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.
عملية تخفيض الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج وشرق المتوسط سوف تستمر في السنوات المقبلة، لأن معظم الأسباب التي أدت إلى هذا الوجود إما لم تعد موجودة، أو انخفضت كثيرًا. وعلى الرغم من التوتر بين إيران (وحلفائها مثل التنظيمات التي تخدمها في اليمن والعراق) ودول الخليج العربية، والاعتداءات الإيرانية ضد ناقلات النفط العربية وغير العربية في مياه الخليج أو الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد المنشآت النفطية السعودية في أبقيق في 2019، فإن الولايات المتحدة لم تتعامل مع هذه الهجمات وكأنها ترقى إلى مستويات خطيرة تتطلب ردًا أميركيًا مباشرًا. في يونيو 2019، أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية متطورة دون طيار فوق المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز، ومع ذلك فقد امتنع الرئيس السابق دونالد ترامب، على الرغم من مواقفه النارية ضد إيران عن الرد العسكري على مثل هذا الاستفزاز. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يؤكد الرئيس بايدن بأقواله وإجراءاته أنه يريد تفادي مواجهة عسكرية مع إيران.
إدارة الرئيس بايدن لا تزال تقول – علنًا على الأقل – أنها لا تزال ملتزمة بالسعي لحل الخلاف النووي مع إيران بالوسائل السلمية، وأنها لم تفقد الأمل نهائيًا من عودة إيران إلى مفاوضات فينا النووية. ولكن في حال انهيار هذه المفاوضات كليًا، واقتراب إيران كثيرًا من امتلاك معظم مقومات تصنيع قنبلة نووية، فإن إدارة الرئيس بايدن سوف تواجه معضلة سياسية واستراتيجية قد ترغمها على تعديل سياستها بالانسحاب العسكري البطيء والتدريجي من المنطقة. أي شيء أقل من ذلك لن يوقف مسيرة تخفيض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
"الحرة"