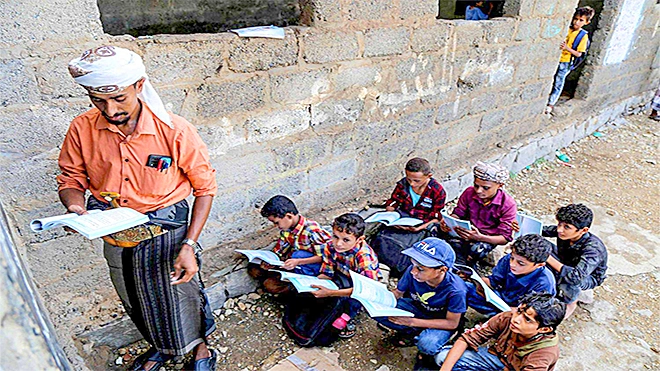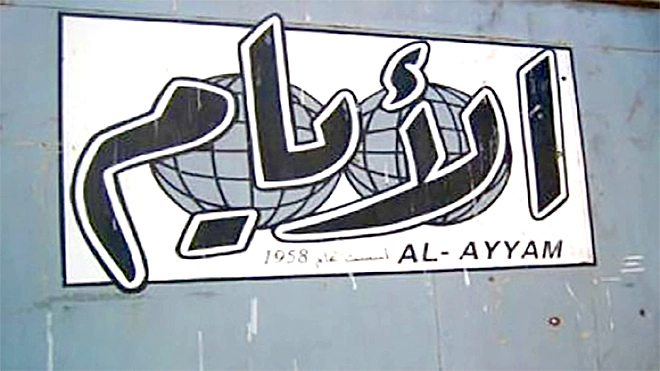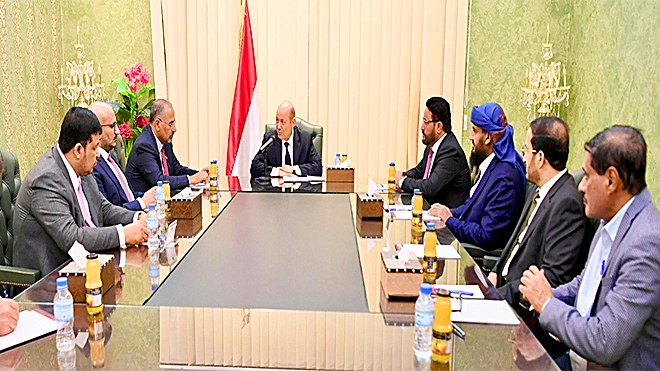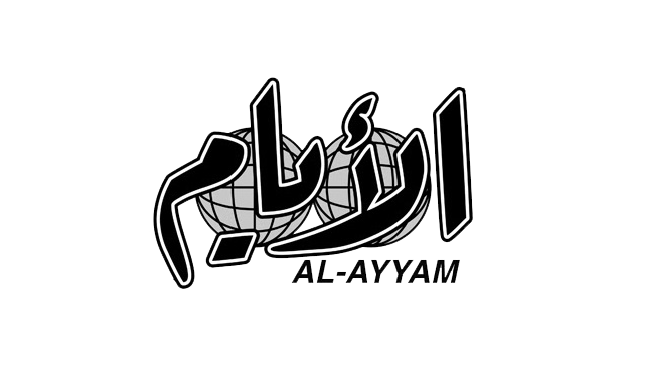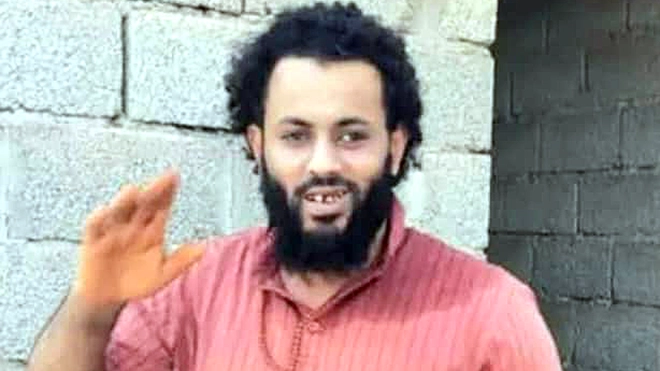> «الأيام» أيمن نبيل*:
في خضم إعادة التفكير، أو بالأحرى نسخ التفكير، في حرب يونيو (حزيران) 1967، تُسرَد كذلك عوامل تلك الهزيمة المروّعة، وكلها تستحق الفحص، ومنها حرب اليمن، ولكن ما ستفحصه المقالة ليس دور الحرب في تلك الهزيمة، بل قرار نظام جمال عبد الناصر في مصر بالتدخل في اليمن (1962-1967) دعمًا لثورة 26 سبتمبر 1962، ومحاولة تسييقه تاريخيًا حتى يمكن فهمه وتعيين مكانه في خريطة الصراع آنذاك؛ لأن فهم هذا التدخل هو مقدّمة جيدة لتقييم دور حرب اليمن في الهزيمة، وهو كذلك مفيدٌ لنقد ثقافتنا السياسية الراهنة والأشكال التي يُصاغ داخلها التاريخ في نقاشات المجال العمومي، يصوّر قرار حرب اليمن غالبًا بأنه مجرّد نزوة حاكم مطلق القدرة تتلبّسه أوهام الزعامة فيذهب للمغامرات بدون حساب. هذا التصوّر للسلطة الناصريّة الديكتاتوريّة ليس شائعًا بين عامة الناس فحسب، بل كذلك عند مؤرّخين تُترجم كتبهم إلى العربية، مثلًا يرى المؤرّخ الأميركي يوجين روجان، في كتابه "العرب"، أن حرب اليمن لم تكن إلا "التباس البلاغة بالسياسة الحقيقيّة". الشيء الوحيد الذي يستفيده المرء من حكم من هذا النوع أن أصحابها لم يفتحوا كتابًا عن تاريخي مصر واليمن، وربما لم يتأملوا في الخريطة، وهم يدبّجون الكتب والمقالات عن الموضوع.
بعد عامين فحسب من إجهاز صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطميّة، واستتباب الأمر له في مصر، بعث أخاه توران شاه على رأس حملةٍ عسكريةٍ لغزو اليمن، وهذا ملفتٌ إذا تذكّرنا الأخطار المُحدقة بصلاح الدين آنذاك من الصليبيين وبقايا الفاطميين. من بواعث صلاح الدين لتجريد الحملة تأمينُ البحر الأحمر وحماية الحجاز، هذا علاوةً على أن في أجزاء من اليمن قوى فاطمية كانت تمحض الولاء للخليفة الفاطمي في القاهرة، أهمّها الدولة الصليحيّة ثم الزريعية التي كانت تحكم عدن، وهذا ملمحٌ آخر مهم في تاريخ مصر واليمن يجب إمعان النظر فيه. وبعد حملة الصليبي أرناط (رينو دي شاتيون) على الحجاز في 1182، تأكّد صلاح الدين من سلامة قراره السابق بالسيطرة على اليمن فأرسل إليه حملة ثانية بعد الاضطراب الذي أصاب سيطرة الأيوبيين هناك إثر عودة توران شاه إلى الشام ثم مصر. بعد إنهاء الرسوليين دولةَ الأيوبيين في اليمن، ورغم الصراع على الحرم المكّي بين الدولة الرسوليّة في اليمن والأيوبيين ثم المماليك في مصر، حرص حكّام مصر على إبقاء علاقات الود مع الرسوليين حفاظًا على عوائد تجارة طريق التوابل؛ التجارة التي كانت تمرّ في البحر الأحمر، شريان تجارة العالم القديم. علينا أن نتذكّر كذلك أن التفكير العثماني باليمن بدأ بعد غزو العثمانيين مصر؛ بدأوا بمهاجمة ساحل اليمن بقيادة سلمان الرومي، ثم بعد قرابة العقد من ذلك الهجوم جُرّدت الحملة العثمانية الأولى على اليمن، وعلى رأسها سليمان باشا الخادم، الوالي العثماني على مصر. ثم بعد ثلاثة قرون جاء عهد محمد علي باشا الذي أرسل حملة لغزو الساحل اليمني للسيطرة على البحر الأحمر وتجارة البن في ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ فسيطرت قواته بقيادة إبراهيم باشا على ميناءي المخا والحديدة، ثم توغلت، فسيطرت على تعز والعُدَيْن وضمتهما للإدارة المصريّة، وكان الخوف من توسّع محمد علي في اليمن وإحكامه السيطرة على ساحلها من دوافع بريطانيا لاحتلال عدن عام 1839.
خلاصة القول إن قرابة الألف عام الأخيرة من تاريخ البحر الأحمر تقول إن من يسيطر على مصر، شمال البحر، يفكّر تلقائيًا في تأمين مدخله الجنوبي (اليمن) بالتحالف أو بالغزو.
بعد ذكر كل هذه الاعتبارات الاستراتيجية، يمكن الحديث عن الدوافع الأيديولوجية والعروبية والتحرّرية لنظام عبد الناصر في دعم ثورة اليمن، ويمكن كذلك الحديث عن حاجة عبد الناصر آنذاك إلى ملعب جديد يرمّم فيه مكانته القيادية في العالم العربي بعد ضربة الانفصال المؤلمة. أما اختزال الأمور في الشعارات والأفراد، فإنه، علاوة على تحامله، لا يقدّم تفسيراتٍ متسقة مع الوقائع لتاريخ هذه الأمة وتحولاتها. رغم كل هذه الاعتبارات التاريخية والاستراتيجية، لم تُجمع أجنحة النظام الناصري في البداية، وعلى رأسه عبد الناصر نفسه، على دعم الثورة في اليمن بقوات عسكرية، وحصلت نقاشات داخله بشأن ما يجب فعله؛ السادات مثلًا كان مؤيدًا بقوة للتدخّل، بينما تحفّظ محمد حسنين هيكل عليه. من الواضح أن عبد الناصر الذي أدرك استراتيجية الموضوع لم يتوقع تكاليفه؛ فالقوات المصرية في اليمن لم تكن، في البداية، إلا تشكيلات بسيطة (كتائب صاعقة)، ولكنها، مع الوقت ومع اشتداد قوة الملكيين بدعم من السعودية والأردن وبريطانيا (ثم إيران وإسرائيل لاحقًا)، أصبحت تشكل ثلث الجيش المصري.
للقرار إذًا عمق تاريخي محكوم بالجغرافيا، يتجاوز نظامَ 23 يوليو، وبالتأكيد شخصَ عبد الناصر، وفيه اعتبارات استراتيجيّة وقوميّة تتجاوز نزوات الأفراد أو غرقهم في الشعارات، أما دور التدخل المصري في اليمن في هزيمة حزيران فمبحث شائقٌ ومفيد، ولكنه موضوع آخر.
*عن العربي الجديد