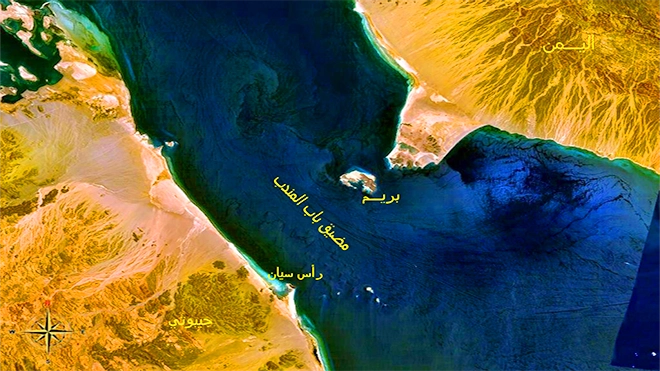> محمد الحمامصي
تساؤلاتنا هذه شكلت جانبا من محور الجزء الأول من تحقيقنا بحثا عن أسباب ودوافع تراجع دور الفلسفة في حياتنا على اختلاف مستوياتها.
مناخ تقليدي معاد
يرى المفكر المصري الأكاديمي نبيل عبدالفتاح أن الفلسفة في الحياة اليومية ضرورة من أجل حل إشكاليات المعنى، وأيضا في تفسير تحولات الحياة اليومية، في ظل التغيرات التقنية، وفي العلوم الطبيعية، في عالم فائق السرعة، والسيولة، والقطيعة مع ما سبق من تطورات معرفية، وفي القيم، وفي الأسئلة الجديدة التي يطرحها تطور العلم الطبيعي، وتحتاج إلى إجابات مثل الاستنساخ البشري، والحيواني وأسئلته، التحول إلى عالم الأناسة الروبوتية، ثم إلى ما بعد الإنسان.
ويشدد على أن كل تغير يطرح أسئلة، وهكذا فإن الفلسفة ضرورة من ضرورات الحياة حتى وإن كانت الفلسفة في حياة العرب المعاصرين تنام في أقبية الدرس الأكاديمي الذي جاوزته الفلسفية في عالمنا إلا قلة قليلة واستثنائية في عالمنا العربي، مع انهيار الجامعات وكليات الآداب والحقوق.. إلخ.
ويؤكد أن غياب الفلسفة في التعليم العام، وفي الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، ناتج عن ثقافة الأجوبة سابقة التجهيز، واليقينيات الدينية والتعليمية على أسئلة قديمة وإيمانية، هي سمة العقل النقلي السائد، هو عقل نمطي في اشتغاله على الموروث، وعلى الإجابات العامة التي تصلح للإجابة على كل سؤال، ولا تجيب على شيء قط.
ويبين أن العقل الحافظ الاستذكاري النقلي عقل متحفي لعالم قديم جدا انتهى إلا لدينا للأسف. من هنا جاءت بعض أسباب التطرف الناتج عن المطلقات في عالم نسبي والتعميمات في عالم التخصص والمعلومات والدقة. غياب الأسئلة، يعني الجمود، وتقديس بعض الموروث والحياة العقلية في المتون والسرديات القديمة المتوارثة.
ويلفت عبدالفتاح إلى أن الإعلام في عالمنا العربي تسلطي، ويمارس التسلية وتزييف الأفكار والأخبار والمعلومات من أجل الهيمنة على العقل العام، لصالح السلطة الحاكمة، والممولين لهذه الفضائيات، وحاليا مهمته نشر التفاهة والسطحية وتغييب الوعي، ويصارع وسائل التواصل الاجتماعي وسطوة الجموع الرقمية الفقيرة.
غالب الإعلاميين ومقدمي البرامج ومعديها، في رأيه، هم أبناء التعليم الرديء، وثقافة الحفظ والتلقين، ماذا تطلب منهم، إنهم يؤدون وظيفة في السيطرة الرمزية على الجموع الغفيرة، وغالبها أمي أو جاهل رغم تعليمه إلا من رحم ربي. إن أسئلة الفلسفة تصدم عقل الجماعة الإعلامية المسيطرة ولا تفهمها، ولا تمتلك إجابات عليها، من هنا تأتي كراهية الإعلاميين والصحفيين للفلسفة، حتى بعض من قرأوا بعض كتبها يحاولون التفلسف في ظل فوضاهم العقلية.
أما كراهية الطلاب للفلسفة فلأن دراستها لا بد أن تبدأ في مراحل تعليمية مبكرة ـ في سلاسة ووضوح ـ وليس في التعليم الثانوي فقط كما في مصر في السنة الثانية أو الثالثة الثانوي الأدبي، في حين لا بد من دراستها في الابتدائي والإعدادي لتكوين معرفة لديهم، لكن العقل النقلي والديني يسيطر على التعليم والمدارسين، وواضعي المقررات التعليمية بدعم من الدولة، الدين وتفسيراته السلطوية أداة ضبط سياسي واجتماعي، وتعبئة لصالح السلطة، والفلسفة طرائق تفكير نقدي، وتشكيك، وثقافة للسؤال، وهذا أمر ضد السلطات التي تمتلك الحقائق المطلقة سياسيا، وتابعها من رجال الدين الرسميين، والجماعات السياسية الإسلامية. كلهم ضد المساءلة والشك والنقد. لا موقع للفلسفة في حياة المواطن العربي أساسا! والاستثناءات محدودة لدى قلة من المفكرين والمثقفين الكبار في العالم العربي. إن حياة المواطن العربي الفعلية مستلبة في سياجات العقل النقلي والموروثات الوضعية.
ويؤكد الأكاديمي مجدي عبدالحافظ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة حلوان، أن الفلسفة ليست ترفا أو رفاهية أوشيئا مضافا إلى حياة الإنسان، إذ منذ وجود الإنسان على الأرض والتفكير الفلسفي يلاحقه كظله، باعتباره جزءا لا يتجزأ من وجوده الحقيقي على قيد الحياة. فالتفكير وحده هو الملكة التي تميز الإنسان عن الحيوان وعن بقية الكائنات الحية الأخرى، ومن دونه يتحول الإنسان من عالم البشر إلى عالم خال من الإنسانية ومن كل القيم النبيلة.
ويلفت إلى أن الفلسفة، وهي ما أطلق عليه الفلسفة المحترفة موجودة فقط في المدارس والجامعات بينما الفلسفة في الحياة والشارع فهي غائبة عن حياتنا اليومية نظراً إلى سيادة جو مجتمعي مزدحم بالعادات والتقاليد العتيقة، التي لا تحب النقد ولا تقبل بالاختلاف ولا تطيق المختلف، لأن الإنسان التقليدي يفزع منه، ويريد دوما أن ينظر إلى الآخر وكأنه ينظر إلى المرآة، بحيث يرى نفسه متطابقا تماما مع الآخر في عاداته وتقاليده ومعتقداته وأفكاره.
ويؤمن الإنسان التقليدي في الوقت نفسه بأن هذه العادات والأفكار التي يملكها صحيحة تماما، ولا يأتيها الباطل من أي جهة، وما عداها أباطيل يجب مقاومتها والتصدي لها، الأمر الذي يؤدي إلى التطرف لانعدام القدرة على طرح الأسئلة الحقيقية وغياب التسامح الفكري أو الانفتاح على الاختلاف، أو آلية فهم الواقع المعيش وتحليل مفرداته لاستيعاب مشكلاته الملحة لإنتاج أسئلة حقيقية تعكس ما في الواقع ذاته من تنوع وتعقيدات، ومن ثم تقترح حلولا واقعية قادرة على تفهم ما استجد في الواقع.
ويرى عبدالحافظ أن الإعلام والسينما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع التقليدي، ومن هنا فهما يعكسان مزاج وفهم المجتمع للقضايا المثارة داخله، ولا ننسى أن بعض الأمهات في مجتمعاتنا يدعون لأبنائهم بأن “يكفيهم الله شر الفكر”، هذا يعبر وبحق عن طبيعة المجتمع التقليدي الذي لم يمر بمفردات الحداثة، ويعتبر أن من ينقد أو يحلل أو يعلق أو يقارن، أو يحاول الفهم أو طرح الأسئلة، متحذلق في أحسن الأحوال أو مثير للشغب في أسوئها، ومن ثم يقابل بمقولة الجمهور الشهيرة “بطل فلسفة”.
ويشير عبد الحافظ إلى أن كراهية الكثير من الطلاب للفلسفة في بلداننا تعود أولا إلى هذا المناخ التقليدي المعادي للتفكير والنقد والتساؤل والشك السائد لدينا، والذي تشبعوا به في تربيتهم العائلية والمدرسية والمجتمعية والإعلامية. وتعود ثانياً إلى طبيعة المحتوى الفلسفي أو المادة الفلسفية المقدمة لهم ومنبتة الصلة عن الواقع، وكأن الأفكار الفلسفية أفكار معلقة في الفضاء ليس لها من واقع أفرزها، وكأن الفيلسوف الذي أوجدها يعيش في معزل عن الواقع أو في برج عاجي، أو نام فاستيقظ فوجد هذه الأفكار.
طبيعة المادة التي تقدم بهذه الطريقة إذن تؤدي إلى قطع الصلة الحقيقية بين التفلسف باعتباره محاولة لرصد وحل المشكلات الملحة والآنية لواقع محدد بعينه، وبين هؤلاء الطلاب الواقعين تحت وطأة وسلطة التقليد في مجتمعاتهم العتيقة. وتعود ثالثاً إلى أساتذة الفلسفة أنفسهم الذين يقدمون المادة العلمية للفلسفة دون الربط بينها وبين واقع الطالب المعيش، ودون ربطها بالتاريخ الذي أنجز هذه الأفكار، إذ أن استئصال الفكرة من سياقها التاريخي كفيل بأن يدفع الطلاب إلى الاعتقاد في لا جدوى ما يدرسونه.
ويضيف “فيما يتصل بالتعامل مع مناهج وطرق التفكير كمقررات دراسية أساسية، فمعظم المؤسسات التعليمية في مصر والعالم العربي تتبنى هذه المناهج في مقرراتها الدراسية، مثل التفكير النقدي أو الناقد، ودليله، ومهاراته، وخطواته، وأدواته، وضوابطه، واستخداماته، ومعوقاته، وتطبيقاته، والمحاججة وأنواعها، والمغالطات المنطقية، والحجج الفاسدة… إلخ، إلا أن التعامل مع مقرر أو مناهج كهذه في مجتمع تقليدي سيتم كموضوعات الفلسفة الأخرى، ولن تؤخذ على محمل الجد، دون تهيئة الأجواء والاستعداد الخاص لها، بإعداد كادر تعليمي مؤمن بضرورة التغيير والارتقاء بالتفكير النقدي لطلابه، لكيلا يكون جهدا لا طائل ولا جدوى منه”.
ويخلص عبدالحافظ إلى أن موقع الفلسفة في حياة المواطن العربي اليومية، أصبح واضحا من خلال ما سقته من أفكار، إذ تظل على هامش حياته وغير فاعلة أو مؤثرة على سلوكه الفعلي في المجتمع الأصولي التقليدي، وغيابها كما ذكرنا سيؤدي إلى التطرف وسيادة المواقف الأصولية وانعدام التسامح، وكراهية الاختلاف والمخالف، وسيظل هذا الإنسان محروما من الأداة التي تمكنه من فهم واستيعاب الأسئلة الكبرى لوجوده، أو إمكانية أن يؤسس لرؤية كونية تؤطر حياته وسلوكه ضمن الفضائل والقيم الرفيعة، وتمنحه الثقة في أن يعيش حياته هنا والآن.
تآكل تاريخي
يعتقد المفكر السوري شادي كسحو أن الإجابة عن سؤال متعدد الطبقات كهذا، يستلزم معرفة ما هي الفلسفة أصلًا. ويقول “الإجابة عن سؤال ما الفلسفة؟ يفتح أفقًا فوريًا للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من مشكلات مجتمعاتنا المزمنة. لو سألتني ما الفلسفة؟ لأجبتك: إنها شرط لممارسة الفكر. إنها الفضاء الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يبدع فيه وجوده ويخترع ذاتيته ويمارس حريته على نحو مطلق. من هذه الزاوية يبدو لي أن التآكل التاريخي لمفهوم الفلسفة في العالم العربي يعادل التآكل التاريخي لتجربة الحرية ذاتها. فلكي تكون الفلسفة ممكنة، في المدرسة، والجامعة، والسينما، والفن، والفضاء العام، يجب أن يكون الإنسان حرًا وسيدًا لنفسه ولا يخضع لأي سلطة مهما كان شكلها أو شأنها”.
ويضيف “لا يمكن للفلسفة أن تعثر على نفسها في العالم العربي قبل أن يتم تفكيك نظام الحقيقة الواحدة “في شكله الديني والسياسي” من غير مراوغة أو تحايل أو نفاق. كذلك لا يمكن للفلسفة أن تعثر على نفسها، طالما أن متوسط الوعي للإنسان في العالم العربي هو متوسط وعي شقي وميتافيزيقي، أي أنه يستمد كل أشكاله من المرجعيات الدينية والأيديولوجية القائمة. قبل كل هذا، ستبقى الفلسفة مخيفة وكوميدية وغريبة ولا تتعدى مجموعة من النخب المعزولة هنا وهناك”.
العقل النقدي
لا يزال سؤال لماذا نرفض الفلسفة منهجا للتفكير والنقد متصلا، بحثا عن الأسباب التي تجعل من رفض حضورها إشكالية داخل مجتمعاتنا العربية؟ هذا على الرغم من أن غيابها يعني عدم طرح السؤال؛ الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الفوضى في رؤية الأفكار والمشكلات والقضايا وتحليلها. ما الذي يقف حجر عثرة في وجه حضورها ليس فقط داخل قاعات الدرس في الأكاديميات والجامعات ولكن داخل الحياة اليومية للمواطن العربي؟.. الإجابة في هذا الجزء من تحقيقنا حول الفلسفة ودورها وحضورها الراهن داخل مجتمعاتنا.
يشير الناقد والمفكر السعودي عيد الناصر إلى أن عدم القدرة على التفكير السليم (طرح السؤال والإجابات الممكنة) قد يكون له نصيب في تسطيح التفكير والاعتماد بشكل كبير على الظاهر والمباشر في الدين والحياة والفن والأدب والسياسة، ولكن ظاهرة التطرف هي ظاهرة معقدة ومن يحركها ويستغلها بشكل أساسي هو النسق السياسي عبر كل العصور، وربما يكون حال المعتزلة في تاريخنا مثالاً مقبولا لتوضيح الحالة، فقد كانوا يمثلون أكثر الحلقات تطوراً في التحليل الديني والجدل والحوار والسؤال، ولكن حين استلموا السلطة صاروا مثل غيرهم فيما يخص التفرد بالسلطة ونفي الآخر إلى درجة التطرف.
ويضيف الناصر أن مشكلة الإعلام والسينما أنهما من أدوات النسق السياسي، في مرحلة من المراحل لم يكن مسموحا بتاتا بأن تكتب كلمة “فلسفة” أو فيلسوف في الصحف والمجلات أو تذكر في وسائل الإعلام المرئي والمسموع لأنها بكل بساطة “حرام”. إن النسق السياسي يريد بناء جدار فاصل بين المجتمع والتفكير النقدي الذي تجلبه الفلسفة معها. أما كره الطلاب لدراسة الفلسفة فلا أعتقد أن الموضوع كره أو حب، مثلا، أكثر الطلبة يكرهون مواد الدين لأن مدرسيها ثقلاء دم (من وجهة نظرهم)، ولأنها مادة لا روح فيها، ويشعر الطلبة بأنها مجرد عبء على ظهورهم لكثرة كتبها، ولكن الفلسفه عدم محبتها ناجم عن موقف الثقافة العامة منها وهي أن الفلسفة حرام، هكذا يسمعون الشيخ يقول في المسجد والمدرس في المدرسة والأب والأم في البيت.. فمن الطبيعي أن تكون الفلسفة مادة غير محبوبة لدى الطلبة.
وحول عدم التعامل مع مناهج وطرق التفكير كمقررات دراسية أساسية، يرى الناصر أن مثل هذا التساؤل يتم توجيهه للسياسين الذين يقرون مناهج التدريس والتعليم من الروضة حتى الدكتوراه، حسب علمي، الفلسفة كمنهج كانت موجودة في المرحلة الثانوية لبعض الدول العربية مثل سوريا والعراق ولبنان، ولهذا حين تتحدث مع الشباب من هذه الدول تجد أن حديثهم واستدلالاتهم مختلفة وأكثر انسيابية ومنطقية من غيرهم من الشباب في الدول التي تخلو مناهجها من أي نفحة عقلية ونقدية، والسبب معروف لأن الفلسفة منهج يعلم الطالب طريقة التفكير المنطقي فيما يعمل ويقرأ ويكتب ويقول.
ويتابع “وإذا امتلك المواطن هذه الآلية فإن السياسي سيكون في ورطة حقيقة. ولكن، حينما وصل السياسي إلى نقطة حرجة مع الأدوات القديمة (التيارات السلفية) ذهب يبحث عن مخرج لمواجهة الخراب الذي بناه بيده، لم يكن أمامه سوى التشجيع على دراسة الفكر الفلسفي، لأن هذا الفكر يمتلك القدرة على اجتراح الأسئلة الجريئة والمحرجة والمنطقية التي يريد بها مواجهة حلفاء الأمس وأعداء اليوم، ومن خلال السؤال (الذي كان ممنوعا) سوف يصبح لأتباع المنهج الحكومي الجديد ليس فقط طرح الأسئلة ولكن أيضاً إحياء الروايات والأحاديث والمواقف والأفكار والإجابات التي كانت موجودة في التراث ولكنها كتمت وتم إظهار الأفكار التي يتبناها أصحاب النسق السياسي السائد، إلى درجة أن المواطن البسيط، هذه الأيام، أصيب بالصدمة حين نبش بعض المواقف الخاصة بالرسول محمد (صلعم) والصحابة، وتساءل: لماذا لم يقولوا لنا هذا الكلام في الخمسين سنة الماضية واكتفوا برأي واحد فقط ونفوا وحرموا غيره من الآراء؟”.
ويرى المفكر والكاتب المغربي عبدالطيف محفوظ أنه لا يمكن الحديث عن وظيفة الفلسفة في الحياة اليومية أو عن ضرورتها، دون أن نستبعد بعض المعاني التي وسمت الفلسفة الكلاسيكية والتي جعلت موضوعها متعددا ومركبا يهم الوجود الذي يضم الأنطولوجيا، ويهتم بالعلل الأربع (المادية والفاعلة والصورية والغائية)؛ والمعرفة التي تضم نظرية المعرفة التي تتساءل هل المعرفة ممكنة؟ وما هي أدواتها ومصادرها؟ والإبستيمولوجيا بمداراتها المتعددة: العقلية والتجريبية والنقدية والطبيعية؛ والقيم الإنسانية التي تضم الحق ومجال دراسته المنطق، والخير ومجاله الأخلاق، والجمال ومجاله الإستيطيقا.
ودون أن نستبعد التعريفات الحديثة التي يكون وفقها موضوع الفلسفة نشاطا فكريا وظيفته إنتاج المفاهيم. وذلك لأن الحديث عن الفلسفة واليومي يقتضي الإبقاء فقط على المعاني التي تجعل موضوعها مرتبطا بالنظر إلى الظواهر والمواقف والتصورات بشكل نقدي، ومن ثمة تحليل كل ما يتجلى في الحياة تحليلا خاضعا للتفكر، يمتاح من مرجعية مناسبة علمية أم معرفية.
ويتابع محفوظ أنه وفق هذا الفهم يمكن عَدُّ التحريض على الفعل الفلسفي في الحياة العامة ضرورة، لأنه يحرر الذهن من الخضوع الساذج للتأويلات الشائعة التي يفرضها نسق الأعراف التي هي مؤسسة، في أغلبها، على معتقدات متجاوزة، ومفارقة لشكل الحياة المعاصرة. وذلك لأن الاستناد إلى العقل النقدي في التعامل، فهماً وتقييماً للظواهر، كفيل باستبعاد كل أشكال السلوك المتطرف، وجعل القول والفعل ناتجين عن تفكر موضوعي يحلل نقديا الوضعية في تفردها وليس في إحالاتها الغيبية على مثيلها المجرد الماثل في الأعراف اللازمنية المتوارثة.
ويبين أن العقل النقدي يتيح كشف مغالطات العقلانية (وما نتج عنها من تقنية) التي قد تقود إلى ما يدمر الإنسان. وإذا كان الإعلام والسينما يُقَصِّرَانِ في الاحتفاء بالفلسفة، أو في اعتمادها آلية لإنتاج موضوعاتهما، فذلك عائد، لا محالة، من جهة إلى طبيعة المتلقين الذين يحبذون الموضوعات البسيطة التي لا تستدعي جهدا فكريا من أجل تمثلها، ومن جهة ثانية إلى كونهما (السينما كما الإعلام) خاضعين لسياسات الجهات الممولة، والتي غالبا ما تعد الفلسفة آلية لخلق وعي مضاد لأيديولوجياتها.
ويختم “من المؤكد أن الفكر الفلسفي مغيب في الحياة العادية، بل مغيب حتى في الإعلام، والبرامج الدراسية التي تحفل أكثر بتاريخ الفلسفة وليس بالفلسفة. كما أن الأرضية الملائمة للانفتاح على الفلسفة غير متوفرة إطلاقا، لأن الغالب في الإعلام هو الفكر السائد المتوارث، كما أن المهيمن في التعليم هو التلقين، والمهيمن في الأشكال الثقافية هو التوصيف”.
مثقفون كسقراط
يرى المفكر أحمد الشرقاوي أن سؤال: لماذا يتم رفض الفلسفة؟ سؤال ترجع الإجابة عليه إلى القرن (6 ق.م) في بلاد الإغريق حيث ظهرت بدايات الفكر الفلسفي على يد أعلام الفلسفة اليونانية (سقراط، أفلاطون، أرسطو). لقد رفض المجتمع اليوناني الفكر الفلسفي لسقراط، ومحاولته التفكير حول الآلهة ووجودها من عدمه؟ وتساؤلاته عن الأخلاق والخير والشر وطبيعة الإنسان؟ ودعوته إلى إحكام التفكير العقلي وعدم تحكيم العواطف، ولم يتوقف المجتمع عند الرفض بل قدم به إلى المحاكمة وتجرع السم، وانتهت محاولاته الفكرية إلى الموت.
ويضيف “بالتالي إن رفض الفلسفة لا يعود إلى الفلسفة نفسها، ولكن السبب يرجع إلى سيطرة الأفكار الدوغمائية، الأفكار التي لا تقبل النقد، فكلما انتشر الفكر المتجمد والجهل، لا يجد الفكر الفلسفي مكاناً لينشأ فيه. فالفلسفة تدفع الفرد باستمرار إلى التفكير وطرح التساؤلات ولا يشبع العقل الفلسفي الإجابات السطحية، بل لديه القدرات التي تجعله يطرح العديد من الأسئلة والتأملات الفكرية، وهذا ما دفع إفلاطون وأرسطو إلى أن يجعلا العمل الفلسفي مهنة طبقة الأحرار وليس العبيد، وعلى الأحرار أن يتفرغوا فقط للنظر الفلسفي في أمور الدولة والوجود من حولهم، ومن لا يستطيع استخدام عقله يعمل بالأعمال اليدوية وأطلقوا عليهم العبيد. وأعتقد أن التفرقة الحقيقية بين الأحرار والعبيد عند اليونانيين ترتبط بالقدرة على التفكير وإعمال العقل.
ويضيف أن عدم الإقبال والاهتمام بالفكر الفلسفي في المجتمعات العربية يرجع إلى سيطرة الفكر المتعصب، ولا يقصد بالتعصب هنا، التعصب الديني فقط، ولكن كافة العقول التي لا تعترف باختلاف الآخر وتحترم هذا الاختلاف في شتي التخصصات، هي تعاني من شكل من أشكال التعصب، ومع وجود التعصب تموت الفلسفة. فالتعصب لا يتيح الفرصة للسؤال وهو جوهر الفكر الفلسفي، فالعقل المتعصب يطالب الآخرين بالتسليم غير المتفهم للأمور وعدم النقاش حولها أو إبداء الرأي حولها.
ويتابع “بالإضافة إلى ذلك فإن المثقفين أو أنصاف الفلاسفة في المجتمعات العربية غير منشغلين بنشر الفكر بقدر اهتمامهم بجمع الأموال وتحقيق المصالح الشخصية. ولكي تنتشر الفلسفة في مجتمعاتنا فنحن في حاجة إلى مثقفين يشبهون سقراط، يجوبون الشوارع ويحاورون الآخرين غير مهتمين بإمكان قتلهم أو إعدامهم، فهل لدينا ذلك النوع من المثقف؟ أم أن المثقفين الآن مشغلولون بقضايا مادية وسلطوية؟”.
الفلسفة ليست غامضة
تؤكد الأكاديمية السورية المقيمة في إسطنبول نادرة خوجه أن “الفلسفة لم تكن ولا في أي لحظة من لحظاتها التاريخية مجرّد ترف فكري أو حالة ترفيهية زائدة عن اللزوم، بل إن الفلسفة في عمقها لحظة عقلية خالصة تضع أفكارنا حول الوجود والذات والمعتقد على المحك. إن غياب تلك اللحظة يترك فراغًا تملؤه الأيديولوجيات والتطرف والثقافة الشعبوية الساذجة التي تشكل أساسًا قويًا للنظام العالمي عمومًا والعربي بشكل خاص”.
وتضيف “لا نستطيع أن نفكر وأن نبقى متطرفين، تلك هي كلمة الفلسفة الأولى والأخيرة. لا شك في أن الفلسفة تواجه صراعات ضد الافتراضات المسبقة والمنظومات اللّاثقافية التي تقود كل شيء اليوم. في السينما كما في وسائل الإعلام، عندما يصبح الإلهاء وتعطيل التفكير أهم من المعنى، تتخذ الفلسفة شكلا كوميديًا يقدّمها كنمط فكري غريب خاص بفئة قليلة جدًا من الناس، لكن الفلسفة لم تكن يوما مقتصرة على الأساتذة والمختصين”.
وتشدد على أن الفلسفة كقوة فعل وخلق وإنجاز وحصول لن نجدها في الجامعات والمقررات والمؤتمرات الأكاديمية، بل في صلب الحياة نفسها، هنا حيث يصبح التفلسف موقفا أونطولوجيا قائما على الانفتاح والانعتاق والارتقاء ضد التطرف بجميع أشكاله الدينية والعلمية والتقنية والفنية أيضًا.
وتتابع “لا أقول إنني ضد المقررات الدراسية، لكنني ضد القولبة والنمذجة التي تسوّر الفكر وتحجبه عن حركته ومهمته الأصلية المتمثلة في خلق موقف جذري إزاء العالم. في العالم العربي الغارق في أزماته، أصبح الفكر بمثابة دعوة إلى الارتداد، والتفكير دعوة إلى التكفير، فما الذي يمكن إنقاذه؟ لابدّ إذًا من استنبات مفاهيم جديدة كلّيًا، مفاهيم تمسّ الوجود ذاته وتدعونا إلى ممارسته وإثرائه وتمزيقه والثورة عليه أيضًا. إننا بحاجة إلى لغة مشتركة تعيد الفلسفة مرة أخرى إلى أحضان الوجود والمعنى، بحاجة إلى عالم يكفّ فيه الفكر وتكف فيه الفلسفة عن تزويق وتنميق الواقع، وتضعنا في مواجهته وقلب صيرورته وتفكيك صورته الزائفة”.
ويرى الباحث المغربي نورالدين عزار أن الفلسفة ـ التطبيقية العملية ـ تساعد الإنسان على العيش بشكل هادئ ومريح، وذلك في حدود الإمكانات الجسدية والنفسية والروحية والمعرفية، مع أخد بالواقع الزمني التاريخي الذي يعيش فيه. بحيث تساعدنا الفلسفة على إيجاد السكينة والسلام النفسي والروحي في أوقات المحن والأزمات، وعلى رأسهم الفلسفة الرواقية. التي لا تربط السعادة والسلام النفسي بالعالم الخارجي الذي لا نمتلك من أمره شيئا.
ويضيف “الفلسفة هي طريقة للحياة، فامتلاك خصائص التفكير الفلسفي (السؤال مثلا..) يحد من ظهور التطرف، وذلك عبر مساءلة ما يبدو لنا هو الحقيقة ومحاولة كشف مدى زيفها. لكن علاقة الإعلام والسينما بالفلسفة ليست خصبة، لأن الأخيرة نخبوية، كما أن الإعلام والسينما ينتجان ـ غالبا ـ الأوهام والخيالات والنسخ المشوهة عن العالم الحقيقي”.
ويتابع “إن عزوف القارئ عن تلقي الخطاب الفلسفي، خاصة في صيغته الأكاديمية المتخصصة، وهي مسألة تثير إشكاليات الغموض والتعقيد في النص الفلسفي. والحقيقة أن كلا المدخلين لأزمة الفلسفة العربية مرتبطان ببعضهما البعض، ذلك لأن أزمة التلقي تجد حلها في حل أزمة الإبداع. فالفلسفة ليست غامضة كما يشاع، وإنما – على العكس – الفلسفة هي التي تعمل على إزالة الغموض. فالفلسفة ليست إذن خطابا غامضا، بل هي خطاب ضد الغموض الذي يستتر وراء وضوح بادئ الرأي، ضد الوضوح الذي يقبله الناس مجانا من اللغة اليومية، لغة المشهور، لا بل لغة الإشهار والموضة. فعلاقة الفلسفة بالجمهور العام، ينبغي أن تكون فيها الفلسفة في عداد “الثقافة العامة”.
العرب