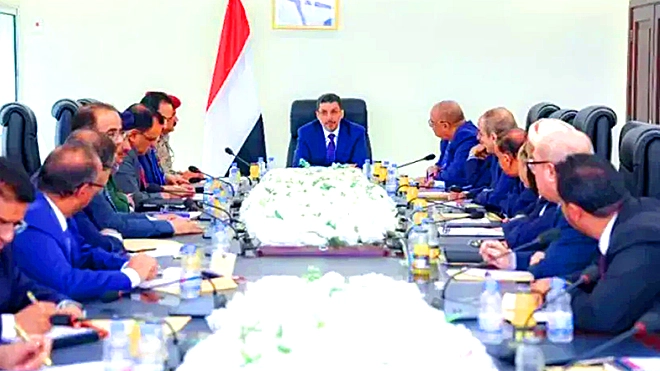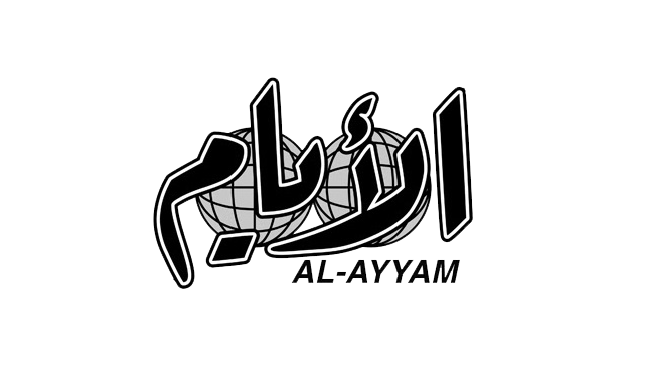تسمى المراحل التي يتم فيها تغيير الأنظمة السياسية الاستبدادية والشمولية إلى ديمقراطية بالمرحلة الانتقالية والإصلاحات الدستورية ومفهوم هذه اللحظة التاريخية يأتي من العقيدة الغربية ومن تاريخ التحول الديمقراطي فيها من أنظمة شمولية إلى ديمقراطية، بالذات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتعزز حضور هذا المصطلح في الساحة الدولية بقوة بعد نهاية "الشيوعية"، أو ما يعرف بعلم "السوفيتولوجيا " في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينيات.
أحيانا تمر عملية بناء النظام السياسي في المرحلة الانتقالية بنوع خاص من اللعبة السياسية على يد مجموعة من النخبة والفاعلين بمواردهم واستراتيجياتهم وأدواتهم، وقبل الوحدة في الشمال والجنوب مرت الأنظمة السياسية في الشطرين في عدة مراحل انتقالية، لكنها انحصرت في شكل انقلابات بين مفاهيم الاشتراكية والجمهورية والقبلية وباسم إعادة تصحيح مسار الدولة ونظامها السياسي دون التخلص من فكرة هيمنة القبيلة الواحدة أو الحزب الواحد من التحكم بمسار المرحلة الانتقالية، مع أنه كان من الممكن تفادي أخطاء المرحلة الانتقالية الواضحة في الشطرين، وأهمها كان يكمن في البدء أولا بالاتفاق السياسي الوطني الحقيقي للتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، الذي يليهما استقرار سياسي دائم.
بعد الوحدة في اليمن ارتبطت المرحلة الانتقالية بدفن النموذج الجنوبي وإعادة إنتاج "الإرث السياسي" الشمالي، الذي كان كذلك بعيدا عن أسس ومفاهيم الديمقراطية وأعاق إلى حد كبير ظهور المشاركة السياسية "المدنية"، وفي نفس الوقت عزز من نشاط الأحزاب الدينية وتطرفها، وبذلك أصيبت المرحلة الانتقالية بانتكاسة وبمعوقات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة ساقت البلاد إلى أول حرب في 1994. التي أسست مرحلة انتقالية "استبدادية " وانقسام حاد في المجتمع.
ليس لدى اليمن الموحد الحالي أي فرصة جديدة لمرحلة انتقالية مشتركة، فغالبية نخبة الشطرين غير قادرة على البناء والإدارة ولم تتخلص من السياسات الإقصائية المتجذرة في ثقافتها، وهذا واضح في الحروب والانقسامات الداخلية حتى على مستوى اتفاق سياسي نحو السلم، كذلك الانقسام بين "المركز" و "المحيط الإقليمي"، بالإضافة إلى منطق "استحالة" التحول الديمقراطي بوجود النخب الحالية من موميات السياسة اليمنية، الذين يعتبرون أنفسهم "ديمقراطيين" دون أن يكون لديهم أي نية لفقدان مناصب السلطة.