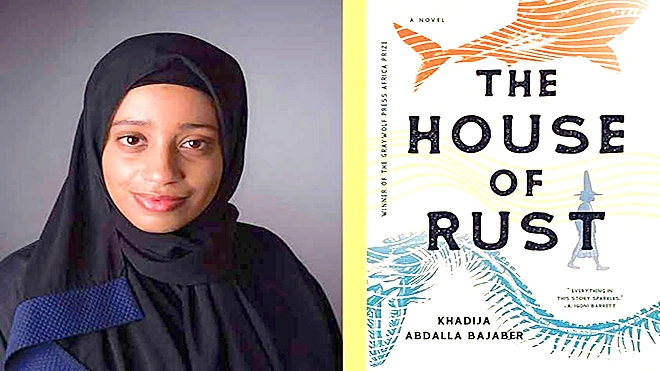> د. عبده يحيى الدباني
إن من أحسن ما قيل في شعر الرثاء العربي قصيدة قالها شاعر العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي (ت: 354هـ) في رثاء جدته لأمه، وكان شعر الرثاء في العصر العباسي قد شهد تجديداً في الموضوعات والمضامين حتى وجدنا رثاء الأولاد والأصدقاء والنساء والمدن والخيل والشباب وغير ذلك، بل وجدنا في القرن الخامس الهجري أبا العلاء المعري يرثي البشرية جمعاء في قصيدته الخالدة التي مطلعها:
نوح باك ولا ترنم شادي
كان المتنبى متعلقاً بجدته أشد التعلق فهي التي قامت بتربيته وتنشئته بعد أن أصبح يتيماً وقد كانت امرأة قوية حازمة حكيمة، عرفت كيف تربي ابنها النابغة الذي صار له معجزة العرب الشعرية عبر الزمان والمكان، بل هو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال عنه الأقدمون، والمعروف في تاريخ الأدب العربي أن أبا الطيب المتنبي يرجع نسبه إلى (جعفي) وهي بطن من بطون قبيلة من مذحج اليمانية التي سكنت الكوفة، بيد أن الدكتور محمود محمد شاكر في كتابه الشهير عن المتنبي فاجأ الجميع حيث قال إن المتنبي يسترد نسبه بعد ألف عام، حيث نسبه الكاتب إلى العلويين من بني هاشم وأبطل نسبته إلى مذحج اليمانية، وقال فيما قال إن جدته هذه هي التي أوصته وصيتها الذهبية بأن يخفي نسبه الحقيقي حتى يتجنب القتل في زمن كان العلويون فيه مطاردين لاسيما حين يشبهون المتنبي في أنفته وبأسه وطموحه واعتداده بنفسه، والحق أن في كلام الدكتور شاكر كثيراً من المعقول والمنطق بما يتفق مع طبيعة الأشياء، فنفس المتنبي قريبة إلى نفوس السادة من بني هاشم في فخرهم بأفضليتهم واعتدادهم بأنفسهم، فهو نفسه القائل:
بها أنف أن تسكن اللحم والعظما
ثم أن أسباب إخفاء المتنبي لنسبه الحقيقي تبدو معقولة ومنسجمة مع السياق التاريخي فضلاً عن أننا لا نجد المتنبي يفخر بقبيلة (جعفي) ولا بأصله من مذحج مع أن الفخر كان شائعاً في شعره.
أما ما يخص قصيدته الرائعة في رثاء جدته، فالمعروف أن المتنبي قد طوى الأرض طياً كما طوى فنون الشعر وأساليبه ومذاهبه، وضرب في الآفاق كما غاص في أعماق النفس البشرية لقد كان صاحب أسفار لأنه كان صاحب همة وطموح لا حدود لهما، فمن الكوفة إلى بادية الشام ومنها إلى حلب ومن ثم إلى مصر ثم هارباً منها وعائداً إلى بغداد من غير طائرة -طبعاً- ولا سيارة بل على جواده الحبيب الوفي حيث يقول:
حتى تعجب مني القور والأكمُ
وعندما لم يطب له المقام في بغداد - بحكم اتساع دائرة الأعداء والحساد من حوله - رمى بنفسه شرقاً إلى بلاد فارس، مع أنه في مطلع حياته قد هجا الأعاجم إذ قال:
تصلح عرب ملوكها عجمً
ومن بلاد فارس أراد العودة إلى الكوفة - مسقط رأسه بعد أن مل الأسفار وملته، وخذلته الأيام وأجهضت طموحه، أليس هو القائل:
مستسقيا مطرت علي مصائبا
طوى المتنبي المسافات والمراحل، وحينما قرر العودة إلى الكوفة في نهاية المطاف قال قصيدة ورد في أحد أبياتها:
نجاة أو أذاة أو هلاكا
وقد حصل ما توقع اذ قتل في الطريق المؤدي إلى الكوفة من بلاد فارس على يد عصابة من قطاع الطرق أغلب الظن أن للسياسة يدها في هذه الجريمة.
كل هذا وجدته المدلهة المشتاقة تنتظره في الكوفة وقد أخذ منها الزمن عمرها وطائرها الوحيد الذي حلق في الآفاق، كانت أعجز من أن تستقبل أخبار العوة وأن تصدق البشير فماتت فرحا ، في حين أن المتنبي نفسه لم يعد كما ذکرنا فما أن تناهى خبر وفاتها إليه حتى فاض بقصيدته الخالدة يرثيها رثاء جديداً جمع بين الحكمة وفلسفة الحياة والفخر الفريد والوعد والوعيد لأعدائه وأعداء جدته بما فيهم الحياة نفسها، حتى الموت نفسه لم يسلم من هجوم المتنبي، وما أعجب أن يبدأ مرثيته بقوله:
فما بطشها جهلا ولا كفها حلما
باتت الضديات عنده شيئا واحداً، لأنه ينظر إلى جواهر الأشياء وليس إلى مظاهرها، ولم يفرض عليه الرثاء مطلعاً آخر بل هو الذي فرض على المرثاة هذا المطلع الجديد انطلاقا من فهمه للحياة والشعر على حد سواء.
وما العشق إلا غرة وطماعة
يعرض قلب نفسه فيصابُ
وقال أيضاً:
مما أضر بأهل المعشق أنهمُ
هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا
قال فيما قال في رثاء جدته:
لك الله من مفجوعة بحبيبها
قتيلة شوق غير ملحقها وصما
أحن إلى الكأس التي شربت بها
وأهوى لمثواها التراب وما ضما
بكيت عليها خيفة في حياتها
وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما
هذا هو رثاء المتنبي مزيج من الفلسفة والحكمة والدموع، ينقل الشاعر تجربتهما القاسية مع الحياة الطويلة ويصور وقع الحدث في نفسه:
تغدى وتروى أن تجوع وأن تظما
ويشير إلى بعض خصال مرثيته، وإلى مكانته منها ومكانتها منه:
مضى بلد باق أجدت له صرما
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا
فلما دهتني لم تزدني بها علما
أتاها كتابي بعد يأس وترحة
فماتت سرورا بي فمت بها غما
حرام على قلبي السرور فإنما
أعد الذي ماتت به بعدها سما
ثم يعود الشاعر إلى التهديد والوعيد والفخر وقد أشرك جدته المرثية في هذه المواجهة من خلال ذكر مواقفها في الحياة وجلدها وصبرها وحكمتها، فإذا كان وراء كل رجل عظيم امرأة فإن وراء عظمة المتنبي تقف هذه المرأة العربية العراقية القوية التي تشرب منها الشاعر صفاته الإنسانية الخالدة المتفردة.
فأصبحت أستسقي الغمام لذكرها
وقد كنت أستسقي الوغي والقنا الصما
هبيني أخذت الثأر فيك من العدى
فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى
ولو لم تكوني بنت أكرم والد
فإن أباك الضخم كونك لي أما
هكذا قلب المتنبي معنى الفخر في البيت الأخير فلجدته أن تفخر وتقر عينا لأنه ابنها، وقد قال أيضاً في هذا المعنى في قصيدة أخرى:
ثم من هم اعداء جدته وكيف يمكن ان يكون لهذه المرأة العجوز اعداء يشير اليهم المتنبي مهددا ؟ الا يكفيه هو كثرة الأعداء من حوله حيث ولى وجهه ؟ لقد ذكر لها اعداء وذكر من شمت برحيلها، ثم يأتي إلى هذا البيت العاتي، البيت الذي يمثل واحدا من مفاتيح شخصية المتنبي إذ يقول:
وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى فماذا كان يريد المتنبي وراء رحيله الدائم عبر الزمان والمكان؟ ما هذا الشيء النفيس الجليل الذي يبحث عنه ؟ أما هو فقد حسم الإجابة حين قال: (ما أبتغي جلّ أن يسمى).
حقاً كان المتنبي يريد الولاية أو الإمارة لكن هل هذا ما أراده فقط؟ وهل كانت الولاية عنده غاية أم وسيلة لما هو أجل وأرفع وأشمل؟ لعلها وسيلة لما هو أجل وأرفع، المتأمل في شعره سيدرك ماذا أراد أن يحقق في حياته، ثم انظر إليه في قصيدة أخرى يقول:
ما ليس يبلغه من نفسه الزمنُ
كأنه هنا يطلب المستحيل، نظراً لعلو همته وطموحه فهو يريد من الزمن ما لم يحققه الزمن لنفسه على أن فاقد الشيء لا يعطيه فهل كان طموح المتنبي يقع خارج الزمان والمكان فإن كان كذلك فكيف يسعى إليه وهو المستحيل عينه ؟ ولعله أراد زمنه هو إذ قال (زمني ذا) بمعنى أن طموح المتنبي كان أكبر من زمنه كما كانت الكوفة وغيرها أصغر من وطنه:
ولا نديم ولا كأس ولا سكنُ
ومثلما بدا الشاعر مرثيته بمطلع عجيب مدهش هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى الرثاء التقليدي فها هو يختتمها بهذا البيت الطريف الذي يحاكي الصخر في صلابته ويعبر عن نفسية المتنبي وفلسفته إذ يقول:
ولا صحبتني مهجة تقيل الظلما
فما أجدرنا اليوم في زمن الانكسار العربي نكبة ونكسة وكارثة أن نستشعر شموخ المتنبي وأنفته وقوة إرادته، كضرب من العزاء والدواء:
تصلح عرب ملوكها عجم
وأيضا:
عش عزيزاً أو مت وأنت كريمٌ
بين طعن القنا وخفق البنودِ
فاذا كانت شخصية المتنبي تظهر في مديحة ولو على حساب الممدوح فهو هنا ايضا يقتسم الرثاء مع جدته ولكن على اعتبارهما شخصا واحدا فهو امتداد لها وهي امتداد له حد تعبيره ومأساة حياتيهما واحدة.