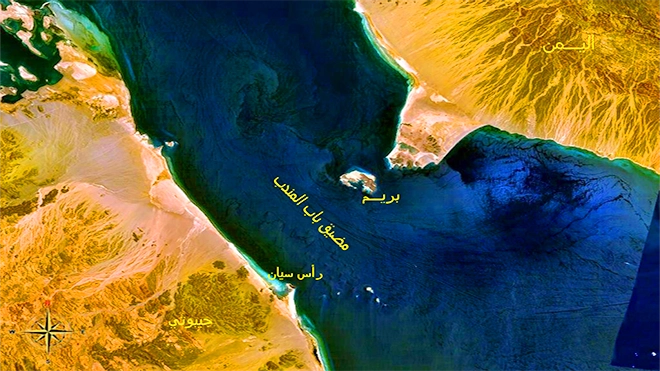أولًا: إن التدبر الصحيح فرعٌ عن فهم المعنى، إذ لا يمكن تصور تدبرٍ صحيح، منطلقًا من فهم خاطئ.
فلو أراد أن يستنبط معنى من قوله تعالى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ}[الأعراف: 176] فلا بد أن يفهم معنى: تحمل عليه، فلو فَهم الحمل على أنه يَحمل على ظهره شيئًا؛ فهذا خطأٌ في فهم المعنى، فمن الضروري أن يخطئ في التدبر المبني على هذا الفهم، وإن فهم معنى الحمل أنه: طرد الكلب، أو الهجوم عليه، فهو فهم صحيح للمعنى، فيبقى النظر في تدبُّره، واستنباطه.
ثانيًا: آيات القرآن -من جهة وضوح معناها، وخفائها- ليست على درجة واحدة، فالقرآن من حيث وضوح معانيه، وخفائها قسمان:
الأول: واضح المعاني؛ من حيث انتفاء الغرابة عن مفرداته، كالآيات التي تقرر معاني التوحيد، واليوم الآخر، أو التي تبين أصول الإيمان، وأركان الإسلام، أو التي ترغّب في الأخلاق الفاضلة، وترهِّب من الأخلاق السيئة، ونحو ذلك، وقد يقع في أثناء ذلك مفردات غريبة تحتاج إلى بيان، والجُزْءَان الأخيران (عمّ، وتبارك) نموذج واضح لذلك.
القسم الثاني: -وهو الأقل- الآيات التي كثر فيها الغريب، وهي التي لا يمكن -لمن عرف خطورة القول على الله بغير علم- أن يتكلم بشيء مِن تدبرها، دون فهم معناها؛ إذ التدبر فرع عن فهم المعنى.
ثالثًا: أحظّ الناس نصيبًا من تدبر كلام الله تعالى هم أهل العلم بالقرآن، فهمًا لدلالاته – بأنواعها الثلاث- وعلمًا بأحكام الشريعة، وعلمًا بالسيرة النبوية -التي هي الترجمة العملية للقرآن- وهكذا، من كان بالله، وأسمائه، وصفاته، ومن كان بسنة رسول الله ﷺ وسيرته أعلم؛ كان أكثر نصيبًا للإصابة، والتوفيق للتدبر، وهم -على تفاوت مراتبهم- ينهلون من معاني هذا الكتاب، ويغترفون من علومه على قدر ما آتاهم الله تعالى من العلم، والفهم فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا.
وأما العامة، فلا يُنْكَرُ أن لبعضهم وقفات قد لا يتفطن لها العلماء، لكن لا يعني هذا فتح الباب! بل يتوقف كلامهم عند الواضح البيّن المحكم.
وهم -أعني غير أهل العلم- يشاركون أهل العلم بعلم ما في القلب، الذي عناه الحسن البصري: بقوله: العلم علمان: علمٌ في القلب؛ فذاك العلم النافع، وعلمٌ على اللسان؛ فتلك حجة الله على خلقه.
فلو أراد أن يستنبط معنى من قوله تعالى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ}[الأعراف: 176] فلا بد أن يفهم معنى: تحمل عليه، فلو فَهم الحمل على أنه يَحمل على ظهره شيئًا؛ فهذا خطأٌ في فهم المعنى، فمن الضروري أن يخطئ في التدبر المبني على هذا الفهم، وإن فهم معنى الحمل أنه: طرد الكلب، أو الهجوم عليه، فهو فهم صحيح للمعنى، فيبقى النظر في تدبُّره، واستنباطه.
ثانيًا: آيات القرآن -من جهة وضوح معناها، وخفائها- ليست على درجة واحدة، فالقرآن من حيث وضوح معانيه، وخفائها قسمان:
الأول: واضح المعاني؛ من حيث انتفاء الغرابة عن مفرداته، كالآيات التي تقرر معاني التوحيد، واليوم الآخر، أو التي تبين أصول الإيمان، وأركان الإسلام، أو التي ترغّب في الأخلاق الفاضلة، وترهِّب من الأخلاق السيئة، ونحو ذلك، وقد يقع في أثناء ذلك مفردات غريبة تحتاج إلى بيان، والجُزْءَان الأخيران (عمّ، وتبارك) نموذج واضح لذلك.
القسم الثاني: -وهو الأقل- الآيات التي كثر فيها الغريب، وهي التي لا يمكن -لمن عرف خطورة القول على الله بغير علم- أن يتكلم بشيء مِن تدبرها، دون فهم معناها؛ إذ التدبر فرع عن فهم المعنى.
ثالثًا: أحظّ الناس نصيبًا من تدبر كلام الله تعالى هم أهل العلم بالقرآن، فهمًا لدلالاته – بأنواعها الثلاث- وعلمًا بأحكام الشريعة، وعلمًا بالسيرة النبوية -التي هي الترجمة العملية للقرآن- وهكذا، من كان بالله، وأسمائه، وصفاته، ومن كان بسنة رسول الله ﷺ وسيرته أعلم؛ كان أكثر نصيبًا للإصابة، والتوفيق للتدبر، وهم -على تفاوت مراتبهم- ينهلون من معاني هذا الكتاب، ويغترفون من علومه على قدر ما آتاهم الله تعالى من العلم، والفهم فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا.
وأما العامة، فلا يُنْكَرُ أن لبعضهم وقفات قد لا يتفطن لها العلماء، لكن لا يعني هذا فتح الباب! بل يتوقف كلامهم عند الواضح البيّن المحكم.
وهم -أعني غير أهل العلم- يشاركون أهل العلم بعلم ما في القلب، الذي عناه الحسن البصري: بقوله: العلم علمان: علمٌ في القلب؛ فذاك العلم النافع، وعلمٌ على اللسان؛ فتلك حجة الله على خلقه.