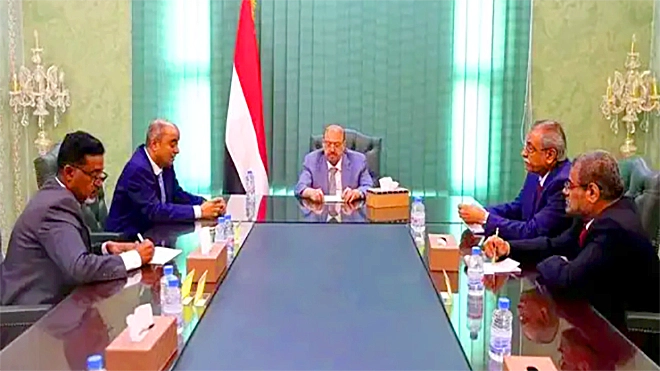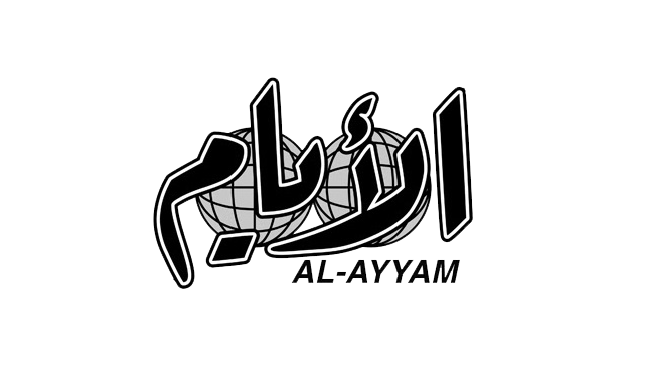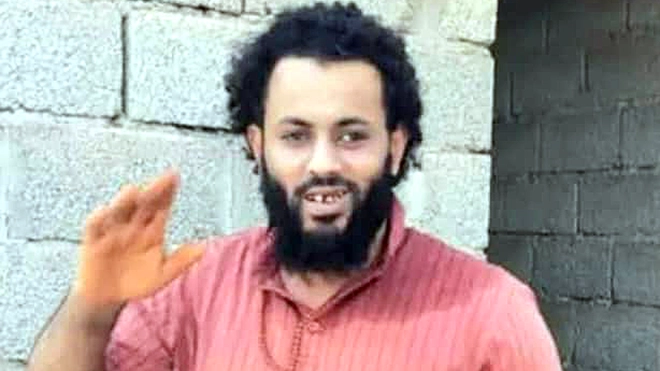> «الأيام» علي محمد يحيى:
وإذا عدنا إلى الدكتور طه حسين في تمهيده لمؤلفه فإنه يعترف بأن البحث في الشعر الجاهلي قد انتهى به إلى «نظرية خطرة » حسب تعبيره، وإنه سيلقى سخطاً على تناوله للموضوع.. وأن منهجه فيه هو منهج (ديكارت) الذي يرى أنه يقبل التطبيق على جميع مناحي الفكر، وأنه نظر إلى الشعر الجاهلي نظرة متجردة من كل شيء كان يعلمه من قبل وأنه استعد لموضوع بحثه وهو «خالي الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً»،ثم قسم موضوعه إلى ثلاثة أقسام أو لنقل كتب.
أولها: منهج البحث ودوافع الشك.
ثانيها: أسباب انتحال الشعر.
وثالثها: الشعر والشعراء.
وقد استنتج بعد هذا كله أن مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن الكريم،لا في الشعر، لأن الشعر الجاهلي الذي رآه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهليين، وأنه بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم أنه قيل فيه، إضافة إلى شكّه في اسماء القبائل العدنانية ونسبة الشعراء إليها، وإلى آخر اعتقاده بأن أنسابهم إنما هي من قبيل الأساطير، لائماً أولئك الذين كتبوا تاريخ العرب وآدابهم بأنهم لم يلموا بتاريخ الامم القديمة أو يقارنوا بينه وبين سواه، وجاءت العرب في مؤلفاتهم كأنها أمة خلت من قبلها الأمم. ولو أنهم تمعنوا في دراساتهم للتاريخ - كما يشير- لعرفوا أن الانتحال كان معروفاً عند اليونان والرومان.
أما مؤلفه (مستقبل الثقافة في مصر) فقد كتبه العميد تحت مظلة إنجاز معاهدة 1936 بين الحكومتين البريطانية والمصرية.. حين رآها من - وجهة نظره - أنها كانت ايجابية ومشرفة على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لم تهدأ من قبل المعارضة الوطنية لها.. والتي كان يرى فيها أيضاً - أي د. طه حسين- انها كانت بداية جيدة لإحياء جذور مصر الحضارية وعودتها إلى المتوسطية الأوربية الأم، من منطلقه الذي يعتبر أن مصر منذ العصور الفرعونية والإغريقية هي إحدى حلقات الحوض الغربي- حوض البحر المتوسط - وأزعم أن العميد حينها كان كثير التفاؤل إلى درجة المثالية حيال رؤيته تلك واستنتاجه أن الفرصة كانت وقتئذ سانحة في ضوء معاهدة 1936، لتحديث النظام الدستوري والذي كان قد بدأ قبل ذلك بإصدار دستور عام 1923 الذي رأى فيه بأن مصر قد عرفت طريقها الصحيح الذي لا يمكن أن تحيد عنه في اعتناق الحضارة الغربية، واستبدال قيمها الشرقية والاسلامية بالقيم الاوربية الخالصة.
فكان أن خرج من بين يديه كتابه (مستقبل الثقافة) ليطرح أفكاره تلك التي كان يدعو اليها من خلال مجموعة المحاضرات التي القاها على طلبته في الجامعة، غير أن الأحداث والتطورات والشواهد في واقع الحياة المصرية اثبتت عكس ما كان يدعو إليه، فترجم هذا الواقع الذي غاب عنه خاصة بعد أن وضعت الحرب أوزارها 1945، وانكشفت نوايا الغرب ومخططاته تجاه حلفائه وأصدقائه من المصريين والعرب في مجموعة مقالات اصدرها عام 1949 في كتابه (المعذبون في الأرض) الذي جاء كأنما كان اعتذارا عن رؤيته التبسيطية وتوقعاته لمصر - الليبرالية - بعد مراجعة ومصارحة مع النفس وفي تسرعه في الحكم على العقلية الأوربية ومن مدى مصداقية شعاراتها التي كانت تطرحها والتي علق عليها آمالا كبارا.
اختتم هذه المشاركة بحكاية يمكن وصفها بالميلودرامية عن هذا الأديب الكبير وعن آرائه وفلسفته الغريبة في الأدب والحياة، التي رواها الاستاذ زكريا تامر في بابه الثابت بمجلة «الدوحة» التي توقف اصدارها منذ زمن بعددها 123 الصادر في مارس 1986 يقول: زعموا أن عميد الأدب العربي كان يضحك بفرح حقيقي وهو يحتضر، فقيل له: أتحب الموت إلى هذا الحد؟ قال طه حسين: لا شيء أكرهه كالموت.
فقيل له: إذن، لماذا تضحك وأنت توشك أن تموت؟ هل المسألة .. مسألة شجاعة نادرة؟ قال طه حسين: لا ضحك بلا سبب وأنا ضحكت، وأضحك لسببين لا لسبب واحد. فسئل عنهما بفضول، فأجاب: السبب الأول أني في بداية حياتي كنت استطيع أن أكون اعمى أو مبصراً، فآثرت أن أحيا اعمى، فعشت حياتي من غير أن أبصر وجوه من يؤلفون كتباً أشد ضرراً من طاعون.. ولو ابصرتها لصرت نزيل سجون ولما صرت أديباً شهيراً.. أما السبب الثاني فهو أني كنت أظن أني ساعيش مئة عام، فإذا ظني مخطئ، وإذا بي اعيش 84 سنة فقط، ونجوت من ذلك اليوم الذي يعاقب فيه القارئ القتيل، ويبجّل الأديب القاتل ويكتب اسمه في سجل الخالدين.
أما لمن اراد أن يعرف ماذا تم بشأن التهم المنسوبة إليه، فقد وقف القانون حينها موقفاً واضحاً منذ تلقت النيابة العامة أول بلاغ في 30 مايو 1926 ضد الكتاب المقصود حتى مثول العميد امامها للتحقيق في 19 اكتوبر 1926، وبعد مناقشة حامية مع المؤلف قررت النيابة حفظ التحقيق، استناداً إلى أن المؤلف «وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر».
أولها: منهج البحث ودوافع الشك.
ثانيها: أسباب انتحال الشعر.
وثالثها: الشعر والشعراء.
وقد استنتج بعد هذا كله أن مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن الكريم،لا في الشعر، لأن الشعر الجاهلي الذي رآه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهليين، وأنه بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم أنه قيل فيه، إضافة إلى شكّه في اسماء القبائل العدنانية ونسبة الشعراء إليها، وإلى آخر اعتقاده بأن أنسابهم إنما هي من قبيل الأساطير، لائماً أولئك الذين كتبوا تاريخ العرب وآدابهم بأنهم لم يلموا بتاريخ الامم القديمة أو يقارنوا بينه وبين سواه، وجاءت العرب في مؤلفاتهم كأنها أمة خلت من قبلها الأمم. ولو أنهم تمعنوا في دراساتهم للتاريخ - كما يشير- لعرفوا أن الانتحال كان معروفاً عند اليونان والرومان.
أما مؤلفه (مستقبل الثقافة في مصر) فقد كتبه العميد تحت مظلة إنجاز معاهدة 1936 بين الحكومتين البريطانية والمصرية.. حين رآها من - وجهة نظره - أنها كانت ايجابية ومشرفة على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لم تهدأ من قبل المعارضة الوطنية لها.. والتي كان يرى فيها أيضاً - أي د. طه حسين- انها كانت بداية جيدة لإحياء جذور مصر الحضارية وعودتها إلى المتوسطية الأوربية الأم، من منطلقه الذي يعتبر أن مصر منذ العصور الفرعونية والإغريقية هي إحدى حلقات الحوض الغربي- حوض البحر المتوسط - وأزعم أن العميد حينها كان كثير التفاؤل إلى درجة المثالية حيال رؤيته تلك واستنتاجه أن الفرصة كانت وقتئذ سانحة في ضوء معاهدة 1936، لتحديث النظام الدستوري والذي كان قد بدأ قبل ذلك بإصدار دستور عام 1923 الذي رأى فيه بأن مصر قد عرفت طريقها الصحيح الذي لا يمكن أن تحيد عنه في اعتناق الحضارة الغربية، واستبدال قيمها الشرقية والاسلامية بالقيم الاوربية الخالصة.
فكان أن خرج من بين يديه كتابه (مستقبل الثقافة) ليطرح أفكاره تلك التي كان يدعو اليها من خلال مجموعة المحاضرات التي القاها على طلبته في الجامعة، غير أن الأحداث والتطورات والشواهد في واقع الحياة المصرية اثبتت عكس ما كان يدعو إليه، فترجم هذا الواقع الذي غاب عنه خاصة بعد أن وضعت الحرب أوزارها 1945، وانكشفت نوايا الغرب ومخططاته تجاه حلفائه وأصدقائه من المصريين والعرب في مجموعة مقالات اصدرها عام 1949 في كتابه (المعذبون في الأرض) الذي جاء كأنما كان اعتذارا عن رؤيته التبسيطية وتوقعاته لمصر - الليبرالية - بعد مراجعة ومصارحة مع النفس وفي تسرعه في الحكم على العقلية الأوربية ومن مدى مصداقية شعاراتها التي كانت تطرحها والتي علق عليها آمالا كبارا.
اختتم هذه المشاركة بحكاية يمكن وصفها بالميلودرامية عن هذا الأديب الكبير وعن آرائه وفلسفته الغريبة في الأدب والحياة، التي رواها الاستاذ زكريا تامر في بابه الثابت بمجلة «الدوحة» التي توقف اصدارها منذ زمن بعددها 123 الصادر في مارس 1986 يقول: زعموا أن عميد الأدب العربي كان يضحك بفرح حقيقي وهو يحتضر، فقيل له: أتحب الموت إلى هذا الحد؟ قال طه حسين: لا شيء أكرهه كالموت.
فقيل له: إذن، لماذا تضحك وأنت توشك أن تموت؟ هل المسألة .. مسألة شجاعة نادرة؟ قال طه حسين: لا ضحك بلا سبب وأنا ضحكت، وأضحك لسببين لا لسبب واحد. فسئل عنهما بفضول، فأجاب: السبب الأول أني في بداية حياتي كنت استطيع أن أكون اعمى أو مبصراً، فآثرت أن أحيا اعمى، فعشت حياتي من غير أن أبصر وجوه من يؤلفون كتباً أشد ضرراً من طاعون.. ولو ابصرتها لصرت نزيل سجون ولما صرت أديباً شهيراً.. أما السبب الثاني فهو أني كنت أظن أني ساعيش مئة عام، فإذا ظني مخطئ، وإذا بي اعيش 84 سنة فقط، ونجوت من ذلك اليوم الذي يعاقب فيه القارئ القتيل، ويبجّل الأديب القاتل ويكتب اسمه في سجل الخالدين.
أما لمن اراد أن يعرف ماذا تم بشأن التهم المنسوبة إليه، فقد وقف القانون حينها موقفاً واضحاً منذ تلقت النيابة العامة أول بلاغ في 30 مايو 1926 ضد الكتاب المقصود حتى مثول العميد امامها للتحقيق في 19 اكتوبر 1926، وبعد مناقشة حامية مع المؤلف قررت النيابة حفظ التحقيق، استناداً إلى أن المؤلف «وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر».