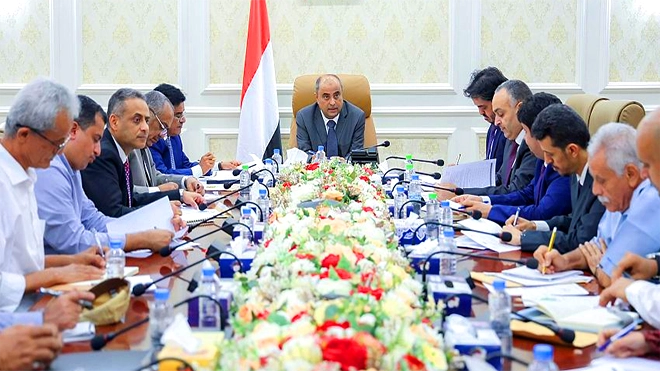> عبدالمجيد سعيد وحدين:
أن تتحدث عن (مشكلة جنوبية) يعني المساس بواحد من الثوابت الوطنية، وهذا وحده سبب كاف لأن تفتح في وجهك خزانة الاتهامات التي يمكن أن تبدأ بالانفصالية، وليس بالضرورة أن تنتهي بالعمالة.
هذا الموقف من جانب السلطة، مفهوم في أسبابه ودوافعه. ولكن ما يستعصي على الفهم هو أن يصدر مثل هذا الموقف عن اطراف ليست محسوبة على السلطة على الأقل بحكم انتمائها الفكري والاجتماعي.
فمن قائل إن الشعب اليمني كله يعاني «والجنوبيون من جيز الناس» وأن الحل هو بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
كما أن الجنوبيين لا يتجاوزن نسبة %10 من السكان وأن الحديث عن (مشكلة جنوبية) أمر لا يخلو من التهويل والتفخيم المقصودين لأغراض ليست بريئة. مثل هذا الطرح لا يمكن أن يصدر إلا عن واحد من اثنين: إما جاهل بما يجري أو مستفيد مما يجري.
ولذلك، ربما يكون من المناسب التوقف، من البدء، عند بعض النقاط التي ترتدي أهمية خاصة في هذا السياق:
-1 إن مشكلة الجنوبيين هي مع النظام القائم وليست مع الوحدة، كمبدأ، وليست مع الشعب في الشمال.
-2 الحديث عن معاناة الجنوبيين لا ينفي (معاناة الآخرين) ولا يعني أنهم يعيشون في نعيم.
-3 تؤكد تجربة السنوات الماضية أن النظام يتعمد التعامل بنفس شطري في كثير من المواقف انطلاقاً من حساباته الضيقة. فمن قائمة الـ(16) إلى عودة الأئمة والسلاطين، ومن التاريخ إلى الثقافة، ومن القطاع العام إلى الوظيفة العامة، ومن شئون الموظفين إلى شئون القبائل. إلا أن المهم في الأمر أن هذا السلوك الشطري لا يرتب أي مسئولية على أي طرف آخر غير النظام نفسه.
-4 إن الإخفاق في إدراك أبعاد المشكلة الجنوبية وحجم الظلم الذي يلحق بالجنوبيين يعني أن هناك خللاً في تصورنا لمفهوم المواطنة ومعايير العدالة والمساواة.
والأمر المؤكد هو أن مثل هذه المفاهيم المعطوبة ليست الوسيلة المناسبة لتعزيز الانتماء إلى الوطن (هذا إن هي أبقت على الوطن من أصله).
-5 إن الاستعانة بالأرقام، عند مقاربة أي موضوع، سلوك يؤشر إلى الرغبة في الاقتراب من لغة العلم والموضوعية. ولكن استخدامها (الأرقام) بصورة انتقائية يعكس الرغبة المبطنة في التضليل.
فالمعروف أن المساهمة في أي شركة لا تحتسب بعدد أفراد الأسرة، إنما تحتسب بحجم المساهمة الفعلية في رأسمال الشركة. وفي هذه الحالة تتحول الـ%10 إلى الطرف الآخر من المعادلة.
ومع ذلك فالجنوبيون ليسوا في وارد المطالبة بـ%90 أو حتى %50 من الأرض والثروة، وكل ما يطالبون به هو العدالة والمواطنة المتساوية واسترجاع الحقوق المسلوبة.
ولذلك فإن الحديث عن المشكلة الجنوبية هو حديث عن الوحدة بامتياز. فالوحدة ليست مجرد شعار، وهي ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق مستوى معيشي أفضل للجميع، والوحدة عزة وكرامة وقوة (قوة اقتصادية قبل أن تكون قوة عسكرية).
وعندما تفشل الوحدة في تحقيق هذه الأهداف تتحول إلى شيء آخر ليست له علاقة بالوحدة.
ومن حقنا أن نسأل، هنا، هل حققت الوحدة شيئاً من ذلك، ربما باستثناء تنامي القوة في مواجهة الداخل؟
فأكبر عملية تفريط في الأرض والسيادة تمت في عهد الوحدة وليس التشطير، واقتصاد اليمن يمر بأسوأ حالاته رغم الوحدة ورغم النفط، ومعدلات الفقر والبطالة والمرض والأمية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل الوحدة.
وضمن هذه الصورة القاتمة يبرز الجنوب والجنوبيون باعتبارهم الخاسر الأكبر، ليس من باب المبالغة ولكن من باب القراءة الموضوعية للواقع.
فإذا تجاوزنا حديث السياسة والقانون، وما آلت إليه اتفاقية الوحدة ودستور الوحدة وانتقلنا إلى الحديث عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية، لتمكنّا من أن نلمس لمس اليد مأساة الجنوبيين.
فهم، من ناحية، يحصلون على نصيبهم كاملاً من (الظلم العام) الذي يعم اليمن من أقصاه إلى أقصاه كناتج طبيعي لنظام مستبد فاسد.
لكن الظلم يأتيهم، وبجرعات أكبر، من مصادر أخرى لعل أهمها: الوحدة الفورية وحرب عام 94م.
فقد كانت الوحدة الفورية شكلاً من أشكال القفز على المراحل وقراراً تنقصه الحكمة بكل المقاييس. فلم يكن هناك ما يستوجب الخجل من الاعتراف بالفوارق والاختلافات التي تتوزع على مختلف جوانب حياة الشعبين، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالاعتراف بها هو الخطوة الأولى للتوافق على الوسائل المناسبة لتقليصها وتجاوزها خلال المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تسبق الوحدة، وأن تحدد مدتها وفقاً لما يتم إنجازه في الواقع من عملية إعادة تأهيل الشطرين بما يلبي شروط ومعايير الدولة الجديدة. وإذا كانت إعادة التأهيل تعني من الشمال، وبالدرجة الأولى استكمال بناء الدولة، فإنها في الجنوب تعني إعادة بناء الدولة (إذا جاز لنا التعبير) وذلك لجهة إعادة صياغة دور الدولة ودور أشكال الملكية المختلفة، ومعالجة تداعيات قرارات التأميم والتعويض على المتضررين ورفع القيود على المشروع الخاص ... إلخ.
ولكن، وكنتيجة فورية للوحدة الفورية تداعى كل شيء في لمح البصر، وصحا المواطن الجنوبي ليجد نفسه وقد انتقل من وضع الدولة إلى ما قبل الدولة، وأن عليه أن يمر من جديد بمراحل تاريخية سبق أن تجاوزها منذ زمن ليس بالقصير، وأن عليه أن يراجع منظومة القيم والمفاهيم التي يعتنقها لتتلاءم مع الوضع الجديد - القديم (يا لها من مهمة). عندها، لا يستطيع أن يمنع نفسه من إجراء المقارنات بين الوحدة التي حققتها دولة الاستقلال عندما وحدت (23) سلطنة ومشيخة في دولة واحدة متجانسة وبصورة سلسة وبين وحدة اليوم التي عجزت، حتى الآن على الأقل، عن تحقيق الاندماج بين دولتين.
من ناحية أخرى، فقد كانت الدولة في الجنوب تسيطر على كل شيء تقريباً، ولكنها في الوقت ذاته، كانت توفر خيمة من الضمانات الاجتماعية تمتد من الرعاية الصحية إلى التعليم المجاني ومحو الأمية إلى حقوق التقاعد. ومن مراقبة الجودة والمواصفات إلى ضبط الأسعار والأجور إلى آخر ذلك من وظائف الدولة المؤسسية.
وما حدث نتيجة الوحدة الفورية هو أن تم نزع هذه الخيمة دون أن يقابل ذلك أية إجراءات تعيد التوازن وتوفر الفرصة المتكافئة للمواطن الجنوبي في ظل الوضع الجديد. فكأن الوحدة تمت بين شعبين، أحدهما يملك والآخر لا يملك. وحتى من يملك من الجنوبيين جاء إلى الوحدة وهو لا يملك حق التصرف في ملكه الذي مازال في حكم المؤمم حتى اليوم.
ومن الأمثلة البارزة، في هذا المجال، أن الوكالات الحصرية للشركات العالمية المختلفة والتي كان يحوزها التجار الجنوبيون انتقلت إلى شركات القطاع العام في سبعينات القرن الماضي لكي تنتقل، بعد الوحدة، إلى تجار آخرين كتحصيل حاصل.
والأمثلة كثيرة يصعب حصرها، ولكنها تتضافر جميعها لتشكل حقيقة واحدة مُرة، وليس أمرّ منها إلا تجاهلها عند التعاطي مع موضوع الوحدة، وهي أن المواطن الجنوبي ظل محروماً طوال عقدين من الزمن من ممارسة العمل الخاص ومن استثمار أملاكه المؤممة على عكس المواطن الشمالي. ويتذكر الكثيرون أنه كانت هناك مادة للتندر مع بداية الوحدة، حيث لم يكن أمراً استثنائياً أن تجد مسؤولاً جنوبياً يسكن بالإيجار في عدن، بينما المرافق الشمالي الذي يعمل معه يسكن في منزله الخاص في صنعاء؟!
والمؤسف، أن معاناة الجنوبيين لم تتوقف عند هذا الحد، وكأنه لم يكن ينقصهم إلا الحرب لكي تأتي على ما تبقى فكانت حرب 94م التي أكلت الأخضر واليابس وأوصلت الجنوبيين إلى حافة المأساة.
ويكفي أن نذكر أن مؤسسات القطاع العام في الجنوب هي ثمرة جهود وتضحيات الجنوبيين خلال سنوات طويلة، ولذلك لا يحق لنا أن نستنكر غضبهم وحنقهم وهم يشاهدون «تحويشة العمر» وقد وقعت فريسة بين أنياب الثلاثي القاتل : الفيد، والخصخصة، والمؤسسة الاقتصادية، التي لا يعرف لها أصل من فصل!
وهكذا تحول القطاع العام إلى غنيمة، وتحول العاملون فيه إلى عبء، أطلقوا عليه اسم (العمالة الفائضة). وكما حرم الجنوب من حقه في ملكية القطاع العام، حرم من حقه في ملكية الأرض (فأرض الدولة) تقاسمها مواطنو الدولة الذين لا يدخل المواطن الجنوبي في تعدادهم، على ما يبدو. ولم يقتصر السطو على أرض الدولة، بل امتد الأمر في حالات كثيرة، ليشمل أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
ومن الأرض إلى الوظيفة العامة حيث تم تسريح الآلاف من المدنيين والعسكريين وأغلقت أبواب التوظيف في وجه الجنوبيين إلا فيما ندر. أما المقاولات، والشركات النفطية وغيرها من الشركات والهيئات العامة فالتواجد الجنوبي فيها يعد من باب رفع العتب.. يضاف إلى كل ذلك، تقليص نشاط مختلف المؤسسات والمنشآت الحيوية، التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، كالمطارات والموانئ، في إطار فلسفة التهميش والإبعاد والمركزية المفرطة.
ولذلك، ليس لنا أن نستغرب التساؤل الكبير الذي يتردد على لسان كل جنوبي، وهو: إذا كان هذا حالنا اليوم، فكيف سيكون حال أبنائنا غداً؟! وأنه إذا كان النظام يتهم قادة الاشتراكي بالانفصالية، فالمواطن الجنوبي يأخذ عليهم أنهم كانوا وحدويين أكثر من اللازم. وأنه مستعد لأن يغفر لهم كل أخطائهم السابقة .. إلا الخطأ الأخير!!
ومع كل ذلك، فمازال الناس يتحدثون تحت سقف الوحدة، إلا أن الإصرارعلى هذه السياسة سيؤدي، حتماً، إلى نشوء حالة مختلفة لا يستوعبها هذا السقف.
هذا الموقف من جانب السلطة، مفهوم في أسبابه ودوافعه. ولكن ما يستعصي على الفهم هو أن يصدر مثل هذا الموقف عن اطراف ليست محسوبة على السلطة على الأقل بحكم انتمائها الفكري والاجتماعي.
فمن قائل إن الشعب اليمني كله يعاني «والجنوبيون من جيز الناس» وأن الحل هو بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
كما أن الجنوبيين لا يتجاوزن نسبة %10 من السكان وأن الحديث عن (مشكلة جنوبية) أمر لا يخلو من التهويل والتفخيم المقصودين لأغراض ليست بريئة. مثل هذا الطرح لا يمكن أن يصدر إلا عن واحد من اثنين: إما جاهل بما يجري أو مستفيد مما يجري.
ولذلك، ربما يكون من المناسب التوقف، من البدء، عند بعض النقاط التي ترتدي أهمية خاصة في هذا السياق:
-1 إن مشكلة الجنوبيين هي مع النظام القائم وليست مع الوحدة، كمبدأ، وليست مع الشعب في الشمال.
-2 الحديث عن معاناة الجنوبيين لا ينفي (معاناة الآخرين) ولا يعني أنهم يعيشون في نعيم.
-3 تؤكد تجربة السنوات الماضية أن النظام يتعمد التعامل بنفس شطري في كثير من المواقف انطلاقاً من حساباته الضيقة. فمن قائمة الـ(16) إلى عودة الأئمة والسلاطين، ومن التاريخ إلى الثقافة، ومن القطاع العام إلى الوظيفة العامة، ومن شئون الموظفين إلى شئون القبائل. إلا أن المهم في الأمر أن هذا السلوك الشطري لا يرتب أي مسئولية على أي طرف آخر غير النظام نفسه.
-4 إن الإخفاق في إدراك أبعاد المشكلة الجنوبية وحجم الظلم الذي يلحق بالجنوبيين يعني أن هناك خللاً في تصورنا لمفهوم المواطنة ومعايير العدالة والمساواة.
والأمر المؤكد هو أن مثل هذه المفاهيم المعطوبة ليست الوسيلة المناسبة لتعزيز الانتماء إلى الوطن (هذا إن هي أبقت على الوطن من أصله).
-5 إن الاستعانة بالأرقام، عند مقاربة أي موضوع، سلوك يؤشر إلى الرغبة في الاقتراب من لغة العلم والموضوعية. ولكن استخدامها (الأرقام) بصورة انتقائية يعكس الرغبة المبطنة في التضليل.
فالمعروف أن المساهمة في أي شركة لا تحتسب بعدد أفراد الأسرة، إنما تحتسب بحجم المساهمة الفعلية في رأسمال الشركة. وفي هذه الحالة تتحول الـ%10 إلى الطرف الآخر من المعادلة.
ومع ذلك فالجنوبيون ليسوا في وارد المطالبة بـ%90 أو حتى %50 من الأرض والثروة، وكل ما يطالبون به هو العدالة والمواطنة المتساوية واسترجاع الحقوق المسلوبة.
ولذلك فإن الحديث عن المشكلة الجنوبية هو حديث عن الوحدة بامتياز. فالوحدة ليست مجرد شعار، وهي ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق مستوى معيشي أفضل للجميع، والوحدة عزة وكرامة وقوة (قوة اقتصادية قبل أن تكون قوة عسكرية).
وعندما تفشل الوحدة في تحقيق هذه الأهداف تتحول إلى شيء آخر ليست له علاقة بالوحدة.
ومن حقنا أن نسأل، هنا، هل حققت الوحدة شيئاً من ذلك، ربما باستثناء تنامي القوة في مواجهة الداخل؟
فأكبر عملية تفريط في الأرض والسيادة تمت في عهد الوحدة وليس التشطير، واقتصاد اليمن يمر بأسوأ حالاته رغم الوحدة ورغم النفط، ومعدلات الفقر والبطالة والمرض والأمية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل الوحدة.
وضمن هذه الصورة القاتمة يبرز الجنوب والجنوبيون باعتبارهم الخاسر الأكبر، ليس من باب المبالغة ولكن من باب القراءة الموضوعية للواقع.
فإذا تجاوزنا حديث السياسة والقانون، وما آلت إليه اتفاقية الوحدة ودستور الوحدة وانتقلنا إلى الحديث عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية، لتمكنّا من أن نلمس لمس اليد مأساة الجنوبيين.
فهم، من ناحية، يحصلون على نصيبهم كاملاً من (الظلم العام) الذي يعم اليمن من أقصاه إلى أقصاه كناتج طبيعي لنظام مستبد فاسد.
لكن الظلم يأتيهم، وبجرعات أكبر، من مصادر أخرى لعل أهمها: الوحدة الفورية وحرب عام 94م.
فقد كانت الوحدة الفورية شكلاً من أشكال القفز على المراحل وقراراً تنقصه الحكمة بكل المقاييس. فلم يكن هناك ما يستوجب الخجل من الاعتراف بالفوارق والاختلافات التي تتوزع على مختلف جوانب حياة الشعبين، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالاعتراف بها هو الخطوة الأولى للتوافق على الوسائل المناسبة لتقليصها وتجاوزها خلال المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تسبق الوحدة، وأن تحدد مدتها وفقاً لما يتم إنجازه في الواقع من عملية إعادة تأهيل الشطرين بما يلبي شروط ومعايير الدولة الجديدة. وإذا كانت إعادة التأهيل تعني من الشمال، وبالدرجة الأولى استكمال بناء الدولة، فإنها في الجنوب تعني إعادة بناء الدولة (إذا جاز لنا التعبير) وذلك لجهة إعادة صياغة دور الدولة ودور أشكال الملكية المختلفة، ومعالجة تداعيات قرارات التأميم والتعويض على المتضررين ورفع القيود على المشروع الخاص ... إلخ.
ولكن، وكنتيجة فورية للوحدة الفورية تداعى كل شيء في لمح البصر، وصحا المواطن الجنوبي ليجد نفسه وقد انتقل من وضع الدولة إلى ما قبل الدولة، وأن عليه أن يمر من جديد بمراحل تاريخية سبق أن تجاوزها منذ زمن ليس بالقصير، وأن عليه أن يراجع منظومة القيم والمفاهيم التي يعتنقها لتتلاءم مع الوضع الجديد - القديم (يا لها من مهمة). عندها، لا يستطيع أن يمنع نفسه من إجراء المقارنات بين الوحدة التي حققتها دولة الاستقلال عندما وحدت (23) سلطنة ومشيخة في دولة واحدة متجانسة وبصورة سلسة وبين وحدة اليوم التي عجزت، حتى الآن على الأقل، عن تحقيق الاندماج بين دولتين.
من ناحية أخرى، فقد كانت الدولة في الجنوب تسيطر على كل شيء تقريباً، ولكنها في الوقت ذاته، كانت توفر خيمة من الضمانات الاجتماعية تمتد من الرعاية الصحية إلى التعليم المجاني ومحو الأمية إلى حقوق التقاعد. ومن مراقبة الجودة والمواصفات إلى ضبط الأسعار والأجور إلى آخر ذلك من وظائف الدولة المؤسسية.
وما حدث نتيجة الوحدة الفورية هو أن تم نزع هذه الخيمة دون أن يقابل ذلك أية إجراءات تعيد التوازن وتوفر الفرصة المتكافئة للمواطن الجنوبي في ظل الوضع الجديد. فكأن الوحدة تمت بين شعبين، أحدهما يملك والآخر لا يملك. وحتى من يملك من الجنوبيين جاء إلى الوحدة وهو لا يملك حق التصرف في ملكه الذي مازال في حكم المؤمم حتى اليوم.
ومن الأمثلة البارزة، في هذا المجال، أن الوكالات الحصرية للشركات العالمية المختلفة والتي كان يحوزها التجار الجنوبيون انتقلت إلى شركات القطاع العام في سبعينات القرن الماضي لكي تنتقل، بعد الوحدة، إلى تجار آخرين كتحصيل حاصل.
والأمثلة كثيرة يصعب حصرها، ولكنها تتضافر جميعها لتشكل حقيقة واحدة مُرة، وليس أمرّ منها إلا تجاهلها عند التعاطي مع موضوع الوحدة، وهي أن المواطن الجنوبي ظل محروماً طوال عقدين من الزمن من ممارسة العمل الخاص ومن استثمار أملاكه المؤممة على عكس المواطن الشمالي. ويتذكر الكثيرون أنه كانت هناك مادة للتندر مع بداية الوحدة، حيث لم يكن أمراً استثنائياً أن تجد مسؤولاً جنوبياً يسكن بالإيجار في عدن، بينما المرافق الشمالي الذي يعمل معه يسكن في منزله الخاص في صنعاء؟!
والمؤسف، أن معاناة الجنوبيين لم تتوقف عند هذا الحد، وكأنه لم يكن ينقصهم إلا الحرب لكي تأتي على ما تبقى فكانت حرب 94م التي أكلت الأخضر واليابس وأوصلت الجنوبيين إلى حافة المأساة.
ويكفي أن نذكر أن مؤسسات القطاع العام في الجنوب هي ثمرة جهود وتضحيات الجنوبيين خلال سنوات طويلة، ولذلك لا يحق لنا أن نستنكر غضبهم وحنقهم وهم يشاهدون «تحويشة العمر» وقد وقعت فريسة بين أنياب الثلاثي القاتل : الفيد، والخصخصة، والمؤسسة الاقتصادية، التي لا يعرف لها أصل من فصل!
وهكذا تحول القطاع العام إلى غنيمة، وتحول العاملون فيه إلى عبء، أطلقوا عليه اسم (العمالة الفائضة). وكما حرم الجنوب من حقه في ملكية القطاع العام، حرم من حقه في ملكية الأرض (فأرض الدولة) تقاسمها مواطنو الدولة الذين لا يدخل المواطن الجنوبي في تعدادهم، على ما يبدو. ولم يقتصر السطو على أرض الدولة، بل امتد الأمر في حالات كثيرة، ليشمل أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
ومن الأرض إلى الوظيفة العامة حيث تم تسريح الآلاف من المدنيين والعسكريين وأغلقت أبواب التوظيف في وجه الجنوبيين إلا فيما ندر. أما المقاولات، والشركات النفطية وغيرها من الشركات والهيئات العامة فالتواجد الجنوبي فيها يعد من باب رفع العتب.. يضاف إلى كل ذلك، تقليص نشاط مختلف المؤسسات والمنشآت الحيوية، التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، كالمطارات والموانئ، في إطار فلسفة التهميش والإبعاد والمركزية المفرطة.
ولذلك، ليس لنا أن نستغرب التساؤل الكبير الذي يتردد على لسان كل جنوبي، وهو: إذا كان هذا حالنا اليوم، فكيف سيكون حال أبنائنا غداً؟! وأنه إذا كان النظام يتهم قادة الاشتراكي بالانفصالية، فالمواطن الجنوبي يأخذ عليهم أنهم كانوا وحدويين أكثر من اللازم. وأنه مستعد لأن يغفر لهم كل أخطائهم السابقة .. إلا الخطأ الأخير!!
ومع كل ذلك، فمازال الناس يتحدثون تحت سقف الوحدة، إلا أن الإصرارعلى هذه السياسة سيؤدي، حتماً، إلى نشوء حالة مختلفة لا يستوعبها هذا السقف.