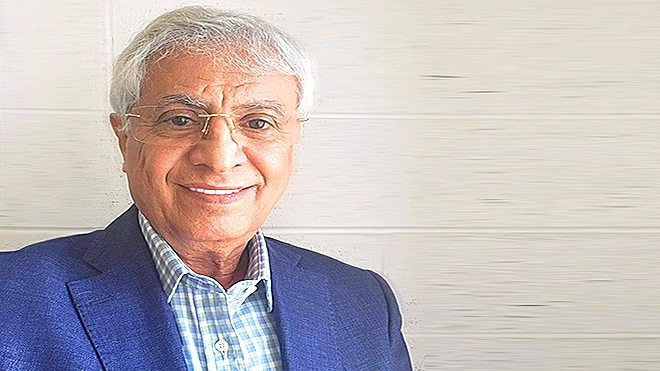> «الأيام» عبدالعزيز محسن:
وأنا أقرأ رواية الكاتب محمد علي محسن صاحب الكلمة المبشرة بأدب قصصي وروائي قد يتجاوز بما يملكه من معجم لغوي ومخزون أدبي وإنساني حدود رواية أدبنا اليمني «كالرهينة» وغيرها.. أقول وأنا أقرأ كلمات وعبارات قاموس هذا المبدع دار في ذهني هذا التساؤل:
أي المناهج النقدية ترى أنها مناسبة لوضع ماهيتها تحت القيود النقدية؟
ومن البنيوية التي انهارت مع أحداث 1967م في فرنسا مرورا بالواقعية والرومانسية والرمزية.. لأجد نفسي أمام باكورة أدبية جعلتنا نتساءل ونحن نطالع الركام النقدي الأدبي الإنساني في هذه التساؤلات.
إذا كان لكل أدب هويته السياسية والعقائدية والمنهاجية والفلسفية.. فما الذي ينهار من هذه القيم بانهيار سياسي؟
ولأن مؤلف رواية «حقل الفؤاد» هذا الاسم الذي وضع اللغويين أمام حيرة التساؤل عن العلاقة مابين الاسم «حقل» والصفة «الفؤاد».. أقول إن هذا الكاتب درس في المدرسة العليا للفكر الذي تبنى منهجية الأدب الواقعي الاشتراكي، وكذلك فن المدرسة النقدية «البنيوية» التي طورها «شيوسير» بقوة مبدئه المتمثل بـ«اعتباطية الرمز اللغوي».
ولأننا نؤمن بأن الماضي بالنسبة للحاضر بمثابة «أمر كلاسيكي» فإننا كذلك نرى في يومنا بالنسبة لغدنا سيكون حتما ليس بمنأى عن كل محاولة تجديد لحاضر، فتغدو في المستقبل كلاسيكية، وهي إشارة منا لتجنب أي تناول منهجي أو أكاديمي لنص الرواية، ذلك أن كل من يصوغ نصا أدبيا لايكتبه إلا من خلال قاموس ومعجم لغته، ولأن كل كلمة من هذا المعجم تحمل معها تاريخا فريدا ومتنوعا، وعى الكاتب ما وعى من لغته وغاب عنه ما غاب من منهجه، كذلك فإن لكل قارئ معجمه الذي قد يضيف إلى لغة المبدع ما قد يكون «غائبا عنه» أو تجاوزه أو تتداعى الأفكار للنظر في ما لم يدر بخلده.
وهكذا نجد في «حقل الفؤاد» أهم وأبرز ما قرأناه من محاولات أدبية تتمتع بنفس طويل ولغة إيقاعية إلا أن تكسر مايتوجب في القواعد الفنية كسره مع المحاولة الجادة لرسم واقع ماضوي مأساوي.
للأسف الشديد وقع المؤلف في أحداث الفصل الأول تحت النظرية الداعية أو المؤمنة بمسئولية الإنسان المطلقة عن صنع نوع واقعه، وهذا ما أفقد الجزء الأول الكثير من القيم المعاصرة والنابعة من أصول فنية وأدبية مرتبطة بالحس الأدبي والفني الإسلامي، حيث يلحظ القارئ ماوضعه المؤلف من وصف لمن سماهم «بالمنبوذين» وبمن تسيطر عليهم «عقدة النقص» على عكس المتمردين والمنبوذين من صعاليك العرب، إلا أن لغة هذا الفصل وبراعة المؤلف واستخدام «دراما الفانتازيا» أبعدت أحداث الفصل الأول عن جمود تقليد «الرهينة»، لكن ذلك لم يمنع القول من أن مثل هذا الخطأ هو ما كان وراء عزل أحداث القصة «شعوريا» عند القارى، حيث إننا نلمس في الفصل الثاني ومن الوهلة الأولى مايذكرنا بكتابات أعظم المبدعين ومواقف إنسانية (إحسان عبدالقدوس).
إن كل سؤال يطرحه واقعنا المعاصر من تداعيات مؤلمة للسياسة على الواقع والحياة الاجتماعية والفردية قد يجدها القارئ بشكل أو بآخر مابين أحداث الفصل الثاني وغيره ففي ص54 جاء الآتي «فظروف عالم خارج لتوه من حرب كونية قضت على الأخضر واليابس» هذا الوصف الموحي لا بحربي الكون الأولى والثانية، وإنما بحرب الكون المعاصرة، حيث يضيف المؤلف «بكل تأكيد (ما يجري) أقوى بكثير من أمنيات شابين في الحصول على فرصة عمل ذات نفع وفائدة»، وفي محاولة الكاتب رسم صورة لواقع وحياة من ولدوا على نتائج الحرب الكارثية الثالثة، والمتمثلة في زمن تداعيات عالم «سقوط الايديولوجيات وغياب التصورات ووحدانية الخطاب الديني»، ولأن الماضي القائم على الصراعات والأحقاد كما يقول في ص 55 وعلى لسان البطل الباحث عن الحق والحقيقة والحامل اسم «صابر »، بينما هو على عكس ذلك تماما «من قال إن الحياء عيب، من قال إن حب الجمال جريمة؟ أسئلة لا إرادية تنداح من ذاكرة صابر في خلوته وفي وجه عمته غالية أو أترابه في الحقل المنغمسين في قعر الفضول أغبياء سذج هم يظنون أن مقياس الرجولة بفتل الشاربين، وزرع بذرة الشر والحقد والكسب غير المشروع» «والحقيقة أن الحب دلالة لقوة صاحبه ونقاوته وصفائه وطهارته» الصفحة نفسها.
ويصف المؤلف موقف كل من تعرض لتاريخ آبائه ممن «طغت فكرة الانتفاع لتشريد أبيه ومصادرة أرضه وكرسي المشيخة المغتصبة» ص56 .
مثل هذه الرؤى وجد المؤلف وببراعة التقطها حسه الأدبي من سماحة الرسل والأنبياء عليهم السلام، ومن بين ركام الإرث الإنساني اختار المؤلف أن يكون البديل لحل جميع معضلات الماضي والحاضر هو الحب والتسامح، فأخذ من «حقل الفؤاد» المليء بالمتناقضات الثري بالتنوع الثقافي والاجتماعي والديني أخذ اسم «راحيل» المستمدة اسمها من «راحيل» الجميلة أم النبي يوسف عليه السلام» ص47 كما يرى «باستطاعة هذه الفتاة (اليهودية) الحسناء اختراق القلوب القاسية الصلبة والصدئة بنظرة من عينيها الحوراوين أو بابتسامة من ثغرها الوردي المحروس بسياج وصفوف من اللؤلؤ المكنون».
إذن فماهية القصة التاريخية يتعامل الؤلف مع الواقع والوقائع، لا بصفته مؤرخا ولكن بصفته أديبا وإنسانا ومبدعا، ثم يجد من يشعل فتيل الحب وبمشيئة الخالق في قلبين يحملهما جسد وروح شابين هما:
صابر المسلم الثائر المقاوم، وراحيل -رائقة- التي تحمل اسم أم النبي يوسف عليه السلام، ليدخلنا الروائي في أحداث ممتعة وشيقة لا تفسد على القارئ متعة الشوق ولهفة الاطلاع وثراء المنفعة وبحور الجدل التاريخي.
غير أننا لابد من أن نتساءل: كيف يحيل شلال المحبة وتياره الجارف الأحقاد إلى جنات من «اللؤلؤ المكنون»، ثم هل يصمد هذا الحب في واقع مليء بالمتناقضات؟ ألم يكن حب صابر للحسناء اليهودية صرخة من صرخات يومنا الفاقد أو كاد يفقد عذرية قداسة هذا الحب..؟
ومن ثم إلى أين وكيف ينتهي المطاف بحب ولد في زمن كهذا أو مثله؟ اقرؤا الرواية ففيها ماخطر على البال ومالم يخطر على البال من أحداث ووقائع اجتماعية وتاريخية مثيرة، وصراع حاد مابين مكونات المجتمع في ظل حركة سياسية واجتماعية حبلى بالمنغصات وموعودة بالخيرات .. رغم ذلك يبقى لنا التحفظ على الكثير مما لا يخل أو يقلل من فن الرواية.
أي المناهج النقدية ترى أنها مناسبة لوضع ماهيتها تحت القيود النقدية؟
ومن البنيوية التي انهارت مع أحداث 1967م في فرنسا مرورا بالواقعية والرومانسية والرمزية.. لأجد نفسي أمام باكورة أدبية جعلتنا نتساءل ونحن نطالع الركام النقدي الأدبي الإنساني في هذه التساؤلات.
إذا كان لكل أدب هويته السياسية والعقائدية والمنهاجية والفلسفية.. فما الذي ينهار من هذه القيم بانهيار سياسي؟
ولأن مؤلف رواية «حقل الفؤاد» هذا الاسم الذي وضع اللغويين أمام حيرة التساؤل عن العلاقة مابين الاسم «حقل» والصفة «الفؤاد».. أقول إن هذا الكاتب درس في المدرسة العليا للفكر الذي تبنى منهجية الأدب الواقعي الاشتراكي، وكذلك فن المدرسة النقدية «البنيوية» التي طورها «شيوسير» بقوة مبدئه المتمثل بـ«اعتباطية الرمز اللغوي».
ولأننا نؤمن بأن الماضي بالنسبة للحاضر بمثابة «أمر كلاسيكي» فإننا كذلك نرى في يومنا بالنسبة لغدنا سيكون حتما ليس بمنأى عن كل محاولة تجديد لحاضر، فتغدو في المستقبل كلاسيكية، وهي إشارة منا لتجنب أي تناول منهجي أو أكاديمي لنص الرواية، ذلك أن كل من يصوغ نصا أدبيا لايكتبه إلا من خلال قاموس ومعجم لغته، ولأن كل كلمة من هذا المعجم تحمل معها تاريخا فريدا ومتنوعا، وعى الكاتب ما وعى من لغته وغاب عنه ما غاب من منهجه، كذلك فإن لكل قارئ معجمه الذي قد يضيف إلى لغة المبدع ما قد يكون «غائبا عنه» أو تجاوزه أو تتداعى الأفكار للنظر في ما لم يدر بخلده.
وهكذا نجد في «حقل الفؤاد» أهم وأبرز ما قرأناه من محاولات أدبية تتمتع بنفس طويل ولغة إيقاعية إلا أن تكسر مايتوجب في القواعد الفنية كسره مع المحاولة الجادة لرسم واقع ماضوي مأساوي.
للأسف الشديد وقع المؤلف في أحداث الفصل الأول تحت النظرية الداعية أو المؤمنة بمسئولية الإنسان المطلقة عن صنع نوع واقعه، وهذا ما أفقد الجزء الأول الكثير من القيم المعاصرة والنابعة من أصول فنية وأدبية مرتبطة بالحس الأدبي والفني الإسلامي، حيث يلحظ القارئ ماوضعه المؤلف من وصف لمن سماهم «بالمنبوذين» وبمن تسيطر عليهم «عقدة النقص» على عكس المتمردين والمنبوذين من صعاليك العرب، إلا أن لغة هذا الفصل وبراعة المؤلف واستخدام «دراما الفانتازيا» أبعدت أحداث الفصل الأول عن جمود تقليد «الرهينة»، لكن ذلك لم يمنع القول من أن مثل هذا الخطأ هو ما كان وراء عزل أحداث القصة «شعوريا» عند القارى، حيث إننا نلمس في الفصل الثاني ومن الوهلة الأولى مايذكرنا بكتابات أعظم المبدعين ومواقف إنسانية (إحسان عبدالقدوس).
إن كل سؤال يطرحه واقعنا المعاصر من تداعيات مؤلمة للسياسة على الواقع والحياة الاجتماعية والفردية قد يجدها القارئ بشكل أو بآخر مابين أحداث الفصل الثاني وغيره ففي ص54 جاء الآتي «فظروف عالم خارج لتوه من حرب كونية قضت على الأخضر واليابس» هذا الوصف الموحي لا بحربي الكون الأولى والثانية، وإنما بحرب الكون المعاصرة، حيث يضيف المؤلف «بكل تأكيد (ما يجري) أقوى بكثير من أمنيات شابين في الحصول على فرصة عمل ذات نفع وفائدة»، وفي محاولة الكاتب رسم صورة لواقع وحياة من ولدوا على نتائج الحرب الكارثية الثالثة، والمتمثلة في زمن تداعيات عالم «سقوط الايديولوجيات وغياب التصورات ووحدانية الخطاب الديني»، ولأن الماضي القائم على الصراعات والأحقاد كما يقول في ص 55 وعلى لسان البطل الباحث عن الحق والحقيقة والحامل اسم «صابر »، بينما هو على عكس ذلك تماما «من قال إن الحياء عيب، من قال إن حب الجمال جريمة؟ أسئلة لا إرادية تنداح من ذاكرة صابر في خلوته وفي وجه عمته غالية أو أترابه في الحقل المنغمسين في قعر الفضول أغبياء سذج هم يظنون أن مقياس الرجولة بفتل الشاربين، وزرع بذرة الشر والحقد والكسب غير المشروع» «والحقيقة أن الحب دلالة لقوة صاحبه ونقاوته وصفائه وطهارته» الصفحة نفسها.
ويصف المؤلف موقف كل من تعرض لتاريخ آبائه ممن «طغت فكرة الانتفاع لتشريد أبيه ومصادرة أرضه وكرسي المشيخة المغتصبة» ص56 .
مثل هذه الرؤى وجد المؤلف وببراعة التقطها حسه الأدبي من سماحة الرسل والأنبياء عليهم السلام، ومن بين ركام الإرث الإنساني اختار المؤلف أن يكون البديل لحل جميع معضلات الماضي والحاضر هو الحب والتسامح، فأخذ من «حقل الفؤاد» المليء بالمتناقضات الثري بالتنوع الثقافي والاجتماعي والديني أخذ اسم «راحيل» المستمدة اسمها من «راحيل» الجميلة أم النبي يوسف عليه السلام» ص47 كما يرى «باستطاعة هذه الفتاة (اليهودية) الحسناء اختراق القلوب القاسية الصلبة والصدئة بنظرة من عينيها الحوراوين أو بابتسامة من ثغرها الوردي المحروس بسياج وصفوف من اللؤلؤ المكنون».
إذن فماهية القصة التاريخية يتعامل الؤلف مع الواقع والوقائع، لا بصفته مؤرخا ولكن بصفته أديبا وإنسانا ومبدعا، ثم يجد من يشعل فتيل الحب وبمشيئة الخالق في قلبين يحملهما جسد وروح شابين هما:
صابر المسلم الثائر المقاوم، وراحيل -رائقة- التي تحمل اسم أم النبي يوسف عليه السلام، ليدخلنا الروائي في أحداث ممتعة وشيقة لا تفسد على القارئ متعة الشوق ولهفة الاطلاع وثراء المنفعة وبحور الجدل التاريخي.
غير أننا لابد من أن نتساءل: كيف يحيل شلال المحبة وتياره الجارف الأحقاد إلى جنات من «اللؤلؤ المكنون»، ثم هل يصمد هذا الحب في واقع مليء بالمتناقضات؟ ألم يكن حب صابر للحسناء اليهودية صرخة من صرخات يومنا الفاقد أو كاد يفقد عذرية قداسة هذا الحب..؟
ومن ثم إلى أين وكيف ينتهي المطاف بحب ولد في زمن كهذا أو مثله؟ اقرؤا الرواية ففيها ماخطر على البال ومالم يخطر على البال من أحداث ووقائع اجتماعية وتاريخية مثيرة، وصراع حاد مابين مكونات المجتمع في ظل حركة سياسية واجتماعية حبلى بالمنغصات وموعودة بالخيرات .. رغم ذلك يبقى لنا التحفظ على الكثير مما لا يخل أو يقلل من فن الرواية.